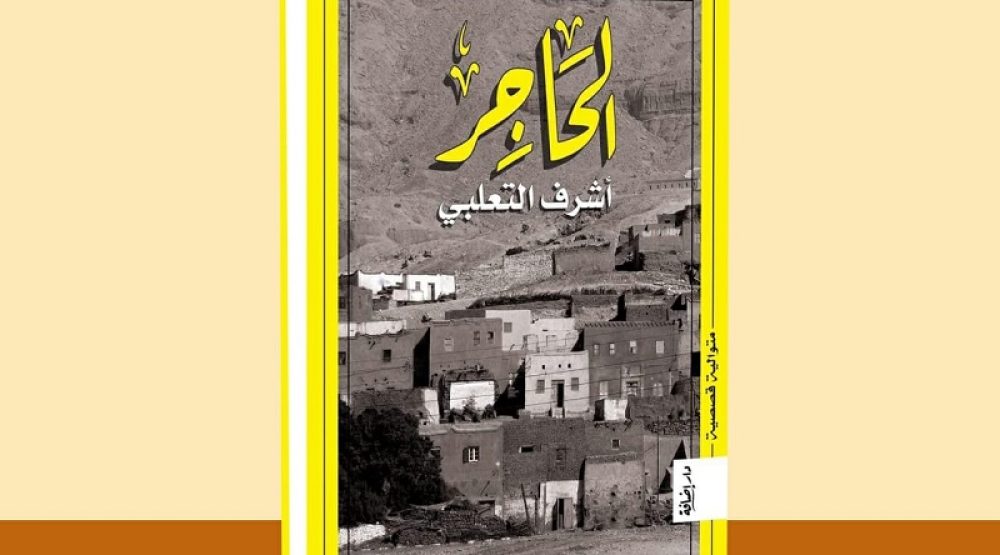شوقى عبد الحميد يحيى
عندما كان العرب، فى الجاهلية، حيث كانت القبلية هى المسيطرة على الحياة –عموما- كانوا يحتفلون بميلاد الشعراء، لا لأنهم فقط شعراء، ولكن لأن الشاعر كان لسان حالهم فى التفاخر أمام القبائل الأخرى – قبل أن يأتى سارتر فى منتصف القرن العشرين، ويُخرج الشعر من الالتزام-. ولا شك أن صعيد مصر لم يزل يعيش تلك القبلية، حتى يومنا، برغم مرور الزمن، وتقدم الحياة، حيث اقتصرت مجهودات الحكومات المتعاقبة على المركز، العاصمة، حتى وإن تعالت الشعارات التى تَعِدُ بالكثير، ولا يتحقق منها إلا القليل، فضلا عن اقتصار هذا القليل على النواحى الخارجية الشكلية، دون أن تسعى لإنهاء ذلك الموروث الناهش فى عصب المكان. فمثلما كان ظهور الشعراء فى الجاهلية، كان ظهور العديد من الأسماء التى حفرت فى عالم (الإبداع) من تلك المنطقة من أمثال يحيى الطاهر عبد الله ومحمد مستجاب ويوسف فاخورى وأحمد أبو خنيجر، الذين حملوا هَمْ التعبير عن الصعيد، وأحواله وهمومه وقضاياه، ليلحق بهم أشرف التعلبى، الذى حمل على كاهله مهمة توصيل صوت الصعيد إلى العاصمة، مستخدما ذات الوسيلة –الإبداع- تعبيرا عن المجتمع، و(التزاما) بقضايا بيئته، ومجتمعه، مثلما هى طبيعة الإبداع، فى كل زمان ومكان -وفق قناعتنا- حيث المبدع ليس إلا إنسان يعيش بيئة ومجتمعا يفرض سطوته عليه، ويسعى –هو- إلى التأثير فيه، سعيا للوصول إلى المدينة الفاضلة.
فالمتأمل للمجموعة القصصية “الحاجر”[1] للكاتب الشاب أشرف التعلبى، سيلحظ حضور الهم العام فى كل قصص المجموعة، التى لم يحدد بها تواريخ كتابة القصص، وإن كنا نستطيع تتبع ملامح الكتابة عنده من ترتيب القصص، التى يتضح أنه رتبها زمنيا من الأحدث فالأقدم، وفقا لتقنية الكتابة وتدرجها، وانتقال الكاتب من اللغة الشاعرية، التى تُبطن أكثر مما تُظهر، إلى اللغة الأقرب للإخبارية، والتى جاءت ككشف عن بعض ما يدور فى الصعيد، وخاصة تلك القبلية، وما تؤدى إليه من انقسام، يصل حد الاحتراب والاغتراب، فى أرض الآباء والأجداد، فلا يجد الإنسان فيها نفسه إلا متلبسا بحالة الهجرة والبحث عن إنسانيته فى أرض أخرى، مثلما نجد فى أولى قصص المجموعة “مقهى الغزالى” حيث المقهى، كما هى –كرمز- فى كل مكان، هى مركز التجمع، للتسلية أو عقد الصفقات، أو ملتقى أصحاب المصلحة. حيث تبدأ القصة –دون أن تفصح- عما يحدث داخل أقسام البوليس، وكيف أن الداخل إليها غيره حين يخرج منها{يومها خرج من قسم الشرطة.. لم نره منذ ثلاثة أشهر، ولا نعرف عنه شيئا.. خرج بذقن طويل، متناثر الشعر، يتوه داخله “القمل” كما تاه هو فى الأيام الماضية، جلبابه متسخ، رائحته نتنة}. فهكذا كانت ضربة البداية، وكأنها تعلن عن الحالة العامة-فى الداخل-، لتدخل بعد ذلك فى الحالة الخاصة، فنتعرف على أن صاحبنا، باع كل ما يملك، كي يسافر إلى أرض الأحلام، إلى الخليج، ليأتى بالراديو الصينى والفيديو، غير أنه لم يجد هناك أفضل من هنا، حيث مثلما يعيش بالدخل مقهورا، فقد عاش فى الخارج اكثر قهرا، فلم يستطع الاستمرار، وتمكن من الهروب، غير أن أوراقه كانت لدى الكفيل، الذى أستطاع تتبعه بها، والزج به إلى السجن. ولم يأت الكاتب بضربة البداية، لإقامة المقابلة بين الداخل والخارج فقط، وإنما لنتعرف على وسيلة الكاتب فى التغلب على امتداد الزمان والمكان، اللذان تحتويهما القصة، أى الأسلوب الدائرى، الذى سنتعرف عليه لاحقا. كما أن الكاتب لم يقدم قصته بهذا التجريد، وإنما من خلال القصة نتعرف على طبيعة البيئة، وحياتها الاجتماعية.. السياسية، التى أدت إلى تلك الواقعة التى غيرت مصير ذلك المقهور المهزوم، مثل {مازلنا نحافظ على التحطيب بالعصا كل خميس على ربابة رمضان أبو بهلول…. لعبنا “الدمينو” على المشاريب، فوق طبلية مربعة…. ونشاهد تليفزيون الحاجر.. ينطلق من وصلة للقنوات المشفرة.. } حيث تُزيع تلك القناة المحلية أخبار البلدة- المحلية- والتى تؤكد خصوصية المكان من جانب، وانفصاله عن المركز وما وصل إليه، من جانب آخر. وليصل إلينا مدى قهر الإنسان وضياعه من جانب آخر.
وهى ذات الرؤية التى تُحدثنا عنها قصة “دينار ليبى” التى تتحدث عن مشاق الرحلة إلى ليبيا، جريا وراء الراديو والمسجل.
يصور الكاتب فى قصة “بئر عزيزة”، واحدة من أهم صفات الصعيد، وهى الازدواجية، التى تعيد إلينا رواية خيرى لبى “الوتد” حيث أن ما هو معروف عن تسيد الرجل فى الصعيد، إلا اننا نجد هنا قصة “بئر عزيزة” الأمر غير ذلك، حيث نرى أن المرأة هى الفاعل الأصلى، فهى التى تقوم بملئ الزير من بئر عزيزة، ليشرب الإنسان، فهى أيضا التى –رغم الإنهاك- تملأ من ذات البئر ليشرب الحيوان، بينما الرجل {أبى الذى كان يجلس بالقرب منى، يشد الأنفاس من جوزة “نحاس” يُخرج الدخان من منخاره، ثم يتبادل إخراجه مع فمه.. أمامه النار مشتعلة فى جذع شجرة سنط}.
ثم تأتى الأم بينما الأب الذى {لم يكن معنا فى السابق، عقله وقلبه مشغولان بجذع السنط بعد أن ازداد دخانها. صرخت أمى فى وجه أبى.. وقالت: كل همك الجوزة والمعسل}. بل الأم هى التى تخاف على الذكريات، أو بمعنى أشمل، هى التى تخشى من الحاضر أن يهدم الموروث، ويخفى معالم الماضى، فالأم فى المفهوم العام هى حاملة الموروث، والمحافظة عليه، وهو ما وعيه الكاتب واضمره دون التصريح به، حيث قدم الحالة، وترك للقارئ أن يتعرف هو على الحقيقة. فبينما كان { بيتنا وبيوت أعمامى متلاصقة بعضها البعض، تشبه القلعة الحصينة.. لكل عم بيت فى محيطها}..ثم..{لقد زاد عدد البشر، ضاقت البيوت، نصفنا “هج” ليبنوا بيوتا أوسع لأبنائهم.. ما زلنا نحتفظ بالقديمة نربى فيها الماعز والفروج}. وفى المقابل، يسعون لردم البئر، بئر عزيزة” المسمى عل اسم ابنتها التى ماتت، ولم يعد منها غير الذكرى، غير أنها “الأم” {لا تريد أن يخفى عمال الردم ملامح عزيزة.. ظلت لسنوات طويلة تنظر إليها كل صباح ومساء، تتطلع إلى مائها، تملأ منها ما تشاء، وهى تفيض كعادتها}. حيث تتحول البئر هنا إلى رمز للموروث، وللحياة، فمنها يشرب الإنسان، ويشرب الحيوان، والماء سر الحياة. والأم هى التى تسعى للبقاء على الحياة، بينما الأب (الرجل) ليس فى همومه إلا (الجوزة والمعسل).
وكذلك تصبح الذكرى، والبكاء على ما كان، هو محور قصة “فاطنة” والتى حرص الكاتب على الاحتفاظ بالكلمة المنطوقة، فى الكثير من القصص، مثل عنوان هذه القصة “فاطنة” وكأنه يقدم ذلك العالم الصعيدى بكل ما فيه، أو كما يقال(بعبله). وكأنه يصنع صورة بالكلمات لتلك الطبيعة المميزة.
ويستمر الكشف عن ناس الصعيد، وعاداتهم، وطبائعهم التى ليس من اليسير تغييرها، والتى يأتى من أهمها موضوع الثأر، وصراع القبائل. حيث تأتى مجموعة من القصص (المباشرة) التى تعتمد على الإخبار، لتأتى وكأنها رسائل لمن يهمه الأمر.
ففى قصة “رصاصة ساخنة”، تلك التى يتسمع الناس فيها صوت الرصاص، المعتاد، فيُهِمُ السارد تاركا طعامه، مخافة أن يكون والده أو أخوه من يتعارك، ليكتشف أن العراك يدور بين أبناء المالك الجديد من شباب الحاجر الغربى، وأبنا الحاجر الشرقى الذين يرون أن القراريط ورثوها عن آبائهم. ويتطاير الرصاص كزخات المطر، إلى أن يصيب شقيق السارد، لتكشف عن ذلك النسق الآتى من بعيد، والمتحكم، والقابض بكل قسوته على ناس الصعيد. بعد أن يُصاب الأخ بطلق نارى، يخترق ساقه، يأتى البوليس ليسأل الأخ:
{س: الإسم والسن والعنوان. ج: كرم محمدين، السن 21 سنة. العنوان الحاجر الشرقى.
س: من أطلق النار عليك؟ ج: لم أر من أين جاءت الرصاصة، كنت أسير فى أحد الشوارع.
س: من يكون من وجهة نظرك. ج: لا أعرف شيئا.
س: هل لك أعداء؟ ج: كل الحاجر أعمامى وأخوالى.
س: هل تتهم أحدا؟ ج: لا أحد}.
فهكذا أنكر الأخ وجود العاركة، انتظارا لأخذ الثأر، حيث لا يؤخذ العزاء إلا بعده.
وكذلك تأتى قصة “فارس” التى تتحدث عن تدهور الأوضاع الصحية فى ذلك الصعيد المنسى، حيث تموت زوجة العم الذى يعمل فى ليبيا، بعد أن يستخرجوا منها المولود الآتى بعد ثمانية عشر شهرا, الأتية من القاهرة التى “طفش العم إليها، قبل أن (يطفش) إلى ليبيا، حيث يواصل الكاتب استخدام الكلمة المنطوقة “طفش”. كما تستمر عملية (الطفشان) من الحياة داخل المنطقة.
وذات الرؤية –تقريبا- نقرأها فى قصة “فاطنة” التى يأتى الثأر ليقضى لها على الزوج والابن الوحيد.
ويستمر الكاتب فى الكشف عن معاناة الصعيد الذى سبق للكاتب تناولها فى كتابه “جمهورية الصعيد” وكأنه يعلن انفصالها-المعنوى- عن جمهورية القاهرة، فيكتب قصته “حورس” مستخدما ذلك الاسم المستند إلى عالم الصعيد البعيد، ليقدم لنا فيها عبر القطار “حورس” نماذج متعددة من عشوائية ما يعيشه ناس الصعيد، القادمين إلى القاهرة، لأغراض تعددت، ومعاناة يعيشها الجميع.. لتنتهى القصة بانقلاب القطار فى البدرشين، وكأنه يعلن أن أهل هذا الصعيد البعيد المنسى من قبل حكومة القاهرة، وكأنى بالكاتب يرسل رسالة لتلك الحكومة بان هناك أناس يعيشون العشوائية، المادية والمعنوية، ليتها تضعهم فى الحسبان.
فإذا ما عدنا إلى القصة التى منحت اسمها للمجموعة “الحاجر”، والتى جاءت فى بدايات المجموعة، أى إلى تلك القصص المحملة بالشاعرية، والتى خطى بها الكاتب إلى مرحلة متقدمة من إبداع القصة القصيرة، والتى أتت من طين الواقع المعيش، ومن بيئة الكاتب القادم من “قنا” فى قلب الصعيد، الذى لم يتخلص من موروثه، والمُعَادى للحضارة، ينحت الكاتب قصته لتفرض سطوتها على رؤية المجموعة، وتجعل منها بؤرة مشعة، تفيض على القصص كلها، بأوضاعها الاجتماعية، والثقافية، والجمالية الإبداعية، والتى تثير-عند قراءتها على رأس المجموعة، كعنوان- الكثير من التساؤل، خاصة لمن لا يعرفون “الحاجر” قبل أن يبحثوا عنها بين السطور، ليتبين لهم أنها اسم بلدة تابعة لمحافظة قنا- على الرغم من وجود قرية بذات الاسم فى القليوبية، بل وفى السعودية، كما سيتأكد –القارئ- أن الكاتب مهموم بقضايا بيئته، ومن عجين تشكيلها، يشكل إبداعه، مؤمنا بدور الإبداع التنويرى، المبتعد عن الخطابة المرفوضة فى الفن، أو الوعظ الذى كان عامل طرد للمصلين، هروبا من المنابر. مؤمنا بأن لغة الإبداع، غير هذا وذلك، فهو يسلط الضوء، ويكشف الواقع، ويترك للقارئ أن يستشف، هو ويكشف أبعاد ما يئن الواقع تحت ثقله، الذى يجره للخلف، بينما العالم يسير –حتما- للأمام.
فيتناول فى (القصة القصيرة) موضوع الثأر، كاشفا عن العقول التى سكنها الواقع، والرافضة للتغيير او التخلى عنه، مبينا أسباب استمراره، حيث هناك دائما مستفيد من تواجده، كما تسعى الدول المتقدمة للدفع بالبنزين فى وقود الحروب الأهلية داخل الدول فى العالم العاشر، لتستفيد ببيع الأسحلة، وتشغيل مصانعها، والناس هنا، يبتلعون الطُعم وهم يعلمون. كما تبين القصة نتائج تلك العادة-الثأر- التى تقودهم إلى المزيد من التقهقر والتخلف، حيث تغلق المدارس، وينتشر الجهل بظلامه، على العقول قبل الأجسام. فلا يلجأ –الكاتب- لتعداد اسباب تلك القضية، وأسبابها ونتائجها، بالعرض عن طريق الإقناع المباشر، بل بالصياغة الأدبية التى تُحرك الوجدان، وتؤجج المشاعر، ليتفاعل معها، وكأنها دقات الطبلة الى تتوالى، فلا يجد الحاضر إلا الاندفاع للدخول فى حلبة الرقص، تاركا همومه الراكدة فوق صدره.
استخدم الكاتب الصيغة الإدريسية فى رسم ملامح القصة – والمجموعة-، حيث استخدم الشكل الدائرى، الذى يُتيح له السير وراء الواقعة، المتباعدة زمانيا ومكانيا، لتعميق الرؤية، مستخدما الصيغ الشكلية فى السرد، حيث اللغة البسيطة، لسرد الأحداث، المحملة بالكثير من الوسائل الإبداعية التى تخرج بالسرد عن العادى والمألوف فى سرد الواقع.
فبينما تبدأ القصة -هنا- بلقاء السارد بالشباب الحامل للسلاح، والمخبئ للموت فى السيالة، وسط جو يوحى بالتربص، والتأهب للقتل. ثم ينتقل السارد للحديث عن الطعام والأم و عن حالة القرية التى استشرى فيها طاعون الثأر، ثم يعود فى النهاية {.. وها نحن هنا بين عيدان القصب فى حاجركم}. وكأننا ما برحنا المكان. وأدركنا أن السرد ينصب من البداية فى بؤرة واحدة، هى “الثأر”. كما لابد أن نلحظ أن الكاتب بدأ الجملة الأخيرة بنقطتين، وكأن السارد يأخذ نَفَسَهُ، أو يتنهد، بعد طول رحلة سرد الأسباب التى قادتهم لهذا المكان، ولهذا الفعل، وطول اللهاث والتنقل بين الانفعالات المختلفة. حيث يأتى التعبير عن القلق والخوف والترقب، بجمل متسارعة لاهثة. فحين قابل –السارد- أناسا يحملون الموت فى جيوبهم، وطلبوا {العيش والجبن والسجائر} فأصاب السارد الخوف والقلق، والحيرة، وهل يلبى طلب أناس لا يعرفهم فى مثل هذا الجو، أم بستغل الفرصة للهرب؟ { الخوف أحاطنى، الموت فى عودتى، الهرب لبيتى مخرجى من أزمتى، الفضول كان قاتلى.. ثلاثون دقيقة فقط أخذتها فى طريقى للدكان}.
كذلك استعمال الفواصل بدقة للتعبير عن الحالة. فبينما استعمل الهمزة، للتعبير عن للهاث والتسارع، وكأنها لحظات الغل والانتقام.. جاء استعمال النقط (نقطتان) بين الفعل ونتائجه، وكأنما السارد يستريح ويلتقط أنفاسه بعد طول اللهاث{خطوات معدودة، كانت محسوبة، طلقات متتالية، أجساد مزقت، استقرت بصدورهم.. الفرحة عمت بين قبيلتنا، أقمنا سرادق العزاء}.
كما تكشف القصة عن رسم الطبع الصعيدى على الأطفال وشخصياتهم، وكأن الرجولة-فى نظرهم- تأتى مبكرة {تحت سفح الجبل كنا نعيش سويا، نلعب بين النخل والنبق –الحامية والفطة والشبر شبرين- نسرق البطيخ من أرض ولاد حسين، نذهب وأولاد النجع إلى مدرسة ناصر المشتركة.. كبرنا وكبرت معنا الهموم والمشاكل، أصبح الطفل منا شابا يلبس جلبابه الفضفاض وعمته المزهرة، ولا نحلق شواربنا، نتميز بالخشونة كالجندى وقت الحرب، حتى مشاعرنا كنا نخفيها وراء الكشرة}. كما لا يغيب استخدام اسم المدرسة، حيث شاع فى كل بلد، بل وكل شارع إطلاق اسم الرئيس على أحد الأبنية. وكأننا أمام عملية توسيع للرؤية، لتشمل مرحلة من عمر الوطن ككل، لم يكن الصعيد بأفضل من غيره فيها.
وفى كلمات قليلة، يصف الحالة التى تعبر عن شخصية (الصعيدى)، وكأنه ينفذ إلى أعماق النفس {حاول الدمع أن يفر من عينيه، فوضع فوقهما يده اليسرى، ليغلقهما، أو يمسحهما فلا يرى أحد انكساره}. كما جاء استخدام اليد اليسرى تحديدا، لما لليد اليمنى من أهمية تأتى بها فى المقدة، ولتزداد فاعلية التمويه التى يحاولها الصعيد، الذى يرى فى دموع الرجل.. عيبا، فاليسرى اقل استعمالا، وكأننا أمام عملية استزادة فى التخفى.
ثم يسوق الكاتب، دون افتعال، أو مباشرة كيف أن الثأر مزق وحدة أبناء العمومة {الود ربط بيننا، كنا نتسابق المرماح، نذهب للموالد الملاح، نقف يدا واحدة فى العزاء قبل الفرح، والزائر للنجع يعتقد أن السبع عائلات، أسرة واحدة، المصاهرة جمعتنا، وجعلت لكل شاب منا خال من عائلة أخرى}.
وكذلك نستكشف سبب الثأر {السبب تجار السلاح أعدوا سوقا روجوا لها، اشتروا الأرض بملاليم.. المدارس أغلقت بالسلاسل}.
فنحن هنا أمام الأسباب والواقعة، والنتائج، وكأننا أمام عملية متكاملة الأركان، صيغت بلغة إبداعية، بعيدة عن النمطية، أو التقريرية.
غير أن الكاتب، إنسان فرد، له أحلامه وتصوراته، وانفراداته بنفسه. حيث تنتقل المجموعة إلى مرحلة جديدة من التناول، فيعود السارد إلى ذاته، و يتيح له امتداد مساحة الفضاء، والانفتاح على السماء، فضلا عن وجود الظلام، الذى يتيح للإنسان أن يرى السماء، ويتابع تحركات النجوم، مثلما ننظر للسحاب فى الشتاء، ونتصور الأشكال المختلفة التى تشكلها، وكما كنا ننظر للقمر فى الصيف، ونتأمل فيه وجه محمد نجيب. فيشكل السارد فى قصة “الغجرية”. عالما من الخيال، يتجسد فيه المكبوت نفسه. فعلى الرغم مما يوحيه العنوان “الغجرية” من رؤى غيبية، مع تلك التى تضرب الودع، وتعرف البخت، يهيم السارد فى عالم من الرومانسية الملموسة بمسحة مادية، يؤججها شوق للارتواء. حيث تتحول النجمة إلى معشوقة غجرية الطباع، تُقربه منها، وتبعده عنها، وتتعدد صور اللقاء، حتى يُضاء النور، فيخرج صاحبنا من الحلم إلى الحقيقة.
ويتمثل التغيير فى هذه القصة، انتقال الكاتب إلى مرحلة جديدة، هى رسم الصورة الشاعرة، فإذا ما تأملنا الحركة فى القصة، فسوف لانجد (دراما)، حيث تغيب الحركة الظاهرة من القصة، فالسارد ساكن فى المكان، والزمان، لكنه السكون الضاج بالانفعالية، والحركة الداخلية، التى تتنقل من السعى للوصول، ثم الاقتراب منه، فالابتعاد عنه. فالذات الساردة هنا فى حركة دائمة، وهو ما يجعل القارئ لا يشعر بالسكون.
وقد أخفى -الكاتب- معالم المحبوبة “الغجرية” ليترك لنا نحن القراء، تصويرها وتصورها، غير أنه منحنا بعض المفاتيح التى عن طريقها يمكن أن نتعرف على تلك المحبوبة، والتى تبدأ منذ البداية {تدور بى فى دورات متتالية، تسبح فى الفضاء، تهيم بى وأنا عاجز عن هيامها، أخذتنى من يدى لتتركنى أسبح فى ساحتها، الظلامية، القمرية، أتطلع للنجوم، أدور حولها كما تدور الأرض}. فالمحبوبة هنا ليست بشرا، والسارد يوحى لنا بذلك {خلعت حذائى وألقيته بعيدا، لأجاريها فى السباحة، إنها تغوص.. وأنا مازلت أطفو فوق بحرها} ليستحضر الكاتب تلك الرؤية التى تغوص، وتختفى عندما يطيل الناظر النظر إلى شيء محدد لفترة طويلة، فالمحبوبة هنا (تغوض) أى تختفى، بينما هو لازال يسبح فوق بحرها، ذلك البحر غير الموجود. ولتتكشف الصورة أكثر عند النهاية {لكن القدر لم يدعها كثيرا.. رحلنا.. بعد أن أضاءوا الأنوار فوقنا وصفق الجمهور بحرارة}. لتتجلى المشهدية، وكأننا امام مسرح الحياة الداخلية للسارد، وما يعيش عليه الإنسان فردا، متعايشا مع ذاته، رغم الضجيج من حوله. فالرؤية هنا، رؤية شعرية. استطاع الكاتب فيها أن يجسد لحظة وجودية، أرضية، فى الوقت الذى تسبح فيه القصة فى عالم خيالى رومانسى، يحلق فيه السارد فى الخيال.
فقط، ذيل الكاتب عنوان المجموعة، على الصفحة الداخلية ب(متوالية قصصية) الأمر الذى يجعلنا نتوقع تصاعدا رأسيا فى القصص، بينما قراءة العمل تضعنا أمام تجاور أفقى، يتضافر فيما بينه ليصور عالم الصعيد، وكأننا أمام لوحة تنوعت فيها الألوان، فتظل فى النهاية تمنح قارئها إحسا كلى محدد الأبعاد. إلا أنه بالنظر إلى المجموعة على أنها المجموعة القصصية الأولى للكاتب، فإنها تحمل من السمات التى تضعه على بداية الدخول لعالم القصة القصيرة من أوسع أبوابه.
………………….
[1] – أشرف التعلبى – الحاجر – دار إضافة للنشر والتوزيع – ط1 2021.