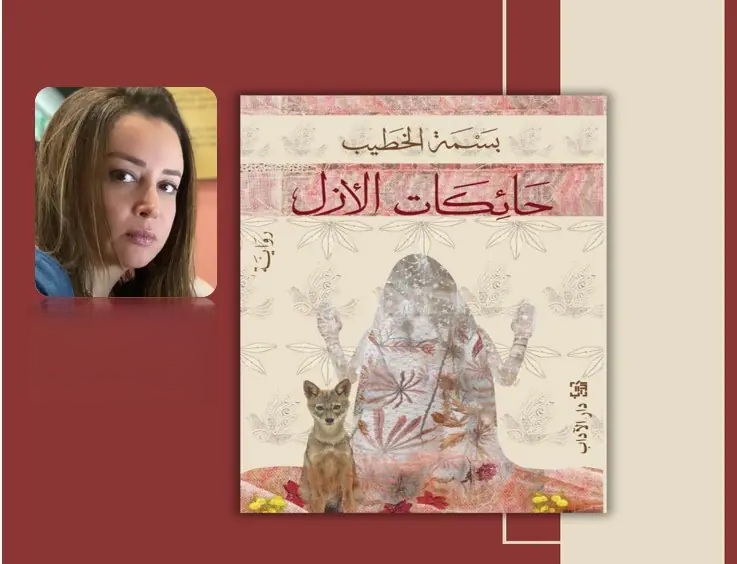لا أعرف ما سيحدث في المستقبل! مِن الصعب الركون إلى اختيارهما، ربما لن يُفضّلا البقاء مع أي منكما، الاستقلال عن الأهل في الخامسة عشرة سِمة هذا البلد، يوسف على عتبات المراهَقة، تلحظ انفعالات المرحلة التي لا يَقدر على كبتِها، إذا أهملته يغضب بشدة، وإذا فاز في ماتش الكُرة يسرف في فرحته، وكلما تفقدته في غرفته وجدته يستعرض عضلاته أمام المرآة، سيحشد شجاعته بعد حين ليخبرك أنه معجب بزميلة له، لا مَفر من خضوعه لجينات أجداده، حتى إذا كانت من ناحية الأُم فقط، وسيلحقه يحيى بعد عام، سنوات معدودات ويقرران الانفصال بعيدًا، مهما دللتهما أمهما!
لماذا تفكر بها الآن؟ لو ظلت علاقتكما مستمرة لَمَا تغيرت أحاسيسك. اعترفْ بالسبب الحقيقي، لقد وصلتَ إلى مكانتك بالخديعة، ارتضيتَ أن تفعلها منذ أكثر من عشرين عامًا، كل ما حدث بعد ذلك ليس سوى تبعات، هل تَذكر؟ نعم. لقد بدأت قصتي فعليًا وقت أن جاءني ماهر، بعد ساعتيْن مِن استيقاظي فزعًا على اهتزاز السرير وصراخ نسوة الشارع. سألني إنْ كان بمقدوري عملُ تقرير عن الآثار التي تأثرت بالزلزال. كنتُ عاطلا لا أجد عملا، على الرغم من تخرجي وإنهاء فترة التجنيد. سألته: “لماذا تريد تقريرًا؟” أعرفه جيدًا، لم تكن له أيه علاقة بالآثار! على الرغم من بعض الثراء الذي يبدو عليه بين الحين والآخر لم يكن يعمل شيئًا، يَظهر أيامًا على المقهى الذي اعتدنا الجلوس فيه بأحد الممرات في حي الحسين. يشاطرنا الجلسة، يشتكي من ندرة العمل، ويسب أوضاعَ البلد، يَسخر من جمودنا وانخراطنا في لعب الطاولة، ويخبرنا كل مرة أن أميركا تلقي القمحَ للأسماك كل عام في المحيط كي نظل جوعى ثم يرحل، يختفي أيامًا إلى أن يعاود الظهور، لم يكن صديقَ أيٍ مِن فتحي أو النوبي أيضًا، لكنه جاء تلك الليلة، سخِر من اهتمامي الزائد بأهداف أحمد الكاس، وسَب الأهلي لأنه ليس في فورمته المعتادة، وسيسمح لفريق الزمالك بأن يستحوذ على الدوري، ثم قال إنهم سيجازونني ماديًا بما يجعلني لا أتوقف عن لعب الطاولة فحسب، بل سأقوم بنسيان صاحبيّ والتعرف على أصدقاء أرقى، وقَبل أن يغادر أخبرني بأنهم يريدون التقرير خلال ثمان وأربعين ساعة فقط. لم يندهش عندما أبديتُ استرابة وشكًا، بل لم يحاول أن يغلِّف ما قاله بأية براءة، ثم تركني، واندهشتُ مِن نفسي وأنا ألحق به مناديًا قَبل أن يقفز السلالم ويَخرج إلى زحام الشارع، وعندما سمع ندائي توقف، فقلت: “مِن الصعب إعداد التقرير هكذا، أريد معلومات أكثر” فدعاني لملاقاته ليلا في المقهى الذي يرتاده دومًا ببِركة الفيل قرْبَ ميدان السيدة زينب وعاودَ السير!
قمتَ من فورك. مِن الصعب حصر كل الآثار المتضررة جرّاءَ الزلزال خلال يوميْن، لكنك كنتَ مُصِرًا على استغلال الفرصة. أبقيتَ ذهنك حاضرًا أكثر من أي وقت مضى، وضعتَ خطة سريعة وسرتَ كمُحصلِ نور دؤوب مِن أثر إلى آخر. كنتَ ترى الناس وهُم يفترشون الأرصفة، بعد سقوط كثير من المنازل القديمة. أعمال التنقيب عن موتى أو أحياء ما زالوا تحت الأنقاض. في لحظة تغيَّر وجه القاهرة وسقطت تحت الركام. منازل نصفها مهدم، انكشفتْ غُرَف النوم وتدلت الملابس من الدواليب! بان ما كان الجميع حريصًا على إخفائه، حمَّامات بائسة ومطابخ أشد بؤسًا، صافرات بعضِ سيارات الإسعاف ما زالت تدوّي، ولجان الجمعيات الخيرية. لم يَعنِكَ سوى المهمة الغامضة. سرتَ بجانب الخراب هنا وهناك لا تتحرك مشاعرك. بدأت منذ هذه اللحظة التواجد دومًا بمحاذاة الأهوال، تستفيد منها. مِن مسجد أصلم السلحدار إلى فاطمة الشقراء. صعدتَ القلعة وهبطتَ إلى مصر القديمة. مِن مجموعة تغري بردي إلى قصر بشتاك، حتى أحصيتَ الآثار المتضررة. ربما فاتتك بعض الآثار، وأضفتَ أثرًا أو اثنين كانا متضرريْن سلفًا مِن جور الناس عليهما، واتخاذهما مَسكنًا. لكن ما أنجزتَه كان كبيرًا. ذهبتَ إليهم في الموعد حيث كانوا يعملون بخنقاواة الأمير شيخو، بعد الانتهاء لم تستعِن بماهر، بل اتجهتَ مباشرة إلى رالف مسئول بعثة الترميم، في مقرها الذي ذكَره عندما جمعك به ماهر في المقهى قبل يوميْن.
لم يكن موجودًا عندما دخلت، انتظرتُ بإلحاح دون أن أخبر أحدًا عن السبب الذي جاء بي، ثم وجدتُ شابًا لم أعرف إلى أي جنسية ينتمي يقترب مِني، دعاني بإشارة من يده للجلوس حتى يأتي رالف، شكرتُه وعاد إلى عمله. إلى جواره كانت ثمة فتاة واقفة تحاول ضبط حامِل الكاميرا، تتأهب لالتقاط صور للترميم الحديث في الجدران والقباب الخشبية والبوائك. ظللتُ أراقبهما، في هذه اللحظة تمنيتُ لو أكملَ الحظ لعبتَه معي إلى النهاية، وأوجَد لي عملا معهم، وقَبل أن أعرف أن ما تمنيته بدأ فعليًا يَحدث دعاني المصوّر بإشارة من يده لأساعده في تثبيت الحامل وتسوية الأرض من الحَصى تحتَه، فبادرتُ فرِحًا.
اكتشفتَ ذاك اليوم موهبتك في التصوير! وأنت تقترح زوايا التقاطٍ مبتكرة، توظّف فيها حِزم أشعة الشمس الآتية من خلف الأرابيسك وهي تتفرق على الموجودات، وتمنح الظلالَ سحرًا مباغتًا، كنتَ تتقافز لا إراديًا كقرد يريد الحصول على الانتباه، لاقت اقتراحاتك التي حاولتَ شرحَها بالإشارة استحسانَ الفتاة والمصور، وضحكا كثيرًا وأنت تحاول إمساك شعاعٍ متسلل يفضح ما يحمله الكون من غبار، لتوصِّل لهما فكرتك. ثم، دخل رالف، نسيتَ ما كنتَ تفعله واتجهتَ إليه، سلَّمتَه التقرير وقلت: “سبع وعشرون أثرًا تضررت، بين فاطمية ومملوكية وعثمانية. كلها بحاجة إلى ترميم ودعامات عاجلة!” نظرَ إليك منبهرًا، كأنك قمتَ بمعجزة، ولأنك كنتَ تشعر بالفخر الداخلي توارَى إحساسك الدائم بالضآلة، بدوتَ واثقًا من نفسك في هذه اللحظة. لم يهمك لصالح مَن ستوظف هذه المعلومات، ولا لماذا كان عامل الوقت مهمًا، ولا لأي سبب يريدونها. فكرتَ فقط أن غنيمةً ستصيبك مِن ورائها، ولا تريد أن يقتسمها معك ماهر! مهمةٌ جاءت بالصدفة عن طريق فهلوي، بموازاة زلزالٍ لا يحدث كثيرًا في هذه الأنحاء، رافقتها لحظة توفيق نادرة، فتغيرت حياتك التالية برمَّتِها!
كان لا بُدّ من توثيق التقرير بالصوَر، كي يكتسب الأهمية اللازمة. قال رالف إن ماتياس وأشار إلى المصور وأكمل سيصحبني للمواقع، ابتسمَ وهو يواصل: “كلاوديا سيسعدها أن تستعينا بها” النطقُ باسمها جعلها تقترب. كانت في مثل سني تقريبًا، ربما أقل عامًا أو عامين! لها شَعر أشقر منسدل، ونظارةٌ سميكة تموج فيها الدوائر الزجاجية، ملامحها كانت تشي بجديتها. قالت بالعربية إنها خلافَ حبِّها لأجواء الآثار الإسلامية، تهوى المناطق الشعبية، التي غالبًا ما يقع الأثر في قلب صخبها. أدهَشني إجادتها للغة، خاصةً وأنها تركتني أوضح قَبل قليل وجهة نظري بالإشارة! هكذا تكوَّنَ فريق العمل من ماتياس المصور وكلاوديا وأنا، هل كان أحد أبواب السماء مفتوحًا وقتذاك؟ ارتقى الدعاء بسرعة البرق وأُخذ به بلا قائمة انتظار!
كان ماتياس مُصِرًا على وضع خطة، لم يعرف أبدًا أنها على الرغم من صعوبتها تطيل أمد استمراري على قيد العمل، بأن يتم تصوير المواقع حسب انتمائها للحِقبة التي بُنيت فيها، حتى إذا تواجد أثر عثماني متضرر إلى جوار آخر من العصر المملوكي، يتم إرجاء المملوكي حتى يأتي دور تصوير المواقع المملوكية المتضررة. كان كل شيء يسير وقتذاك كما لو كان لصالحي فقط، أستيقظُ صباحًا، أرتدي ملابسي التي قمت بغسلها وكيِّهَا الليلةَ السابقة وأنا أُصفِّر بألحان الأغنيات التي أحِبها، وأذهب إلى المكان المتفق. ومع الوقت علمتُ أن البعثة تتبع إحدى مؤسسات جامعة كولن، تقوم بترميم بعض آثار شارع الصليبة وفقَ برنامج الحفاظ على الآثار الإسلامية لديها.
أتاحت لي تلك الأيام التعرفَ على كلاوديا. لم يكن ماتياس يتحدث العربية إلا “شوية” كما قال، لكنني اكتشفت أن كل ما يجيد نطقَه من اللغة هذه الكلمة فقط، لكنه كان يفهمها جيدًا، وكان يلزمني لأفهم ردوده بالألمانية دومًا توسيط كلاوديا، ربما لهذا توطدتْ علاقتي بها أكثر، وربما لأني سعيت منذ اللحظة الأولى لهذا. وقتذاك، كانت شغوفةً بكل ما تراه، تسألني عن كل شيء، كإسفنجة تريد امتصاص ما يحيط بها، قالت إنها قطعتْ شوطًا لا بأس به في دراسة اللغة، بعد الانتهاء من دراسة الإعلام، وتؤهل نفسها كي تُعِد فقرة في أحد البرامج التابعة لقناة ألمانية ناطقة بالعربية، لكنها تجتهد لإتقان العامية أيضًا، ورتبت لدراستها في أحد المعاهد. لم أكن أعرف أن العامية تدرَّس بشكل أكاديمي، وعلى الرغم من دراستها تلك، باغتتني في أحد الأيام بفخر قائلة:
– “أنا فتاة قحبة“
لم أملك المقدرة على منع ضحكتي، سألتها باستنكار: “لماذا تقولين عن نفسك هذا؟” فأكدتْ لي أن زميلها أخبرها بأنها كلمة تعني الافتخار بالنفس، لم أستطع أن أخبرها بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا بعد سفري إلى ألمانيا، وحتى هذا الوقت ظلتْ كلما عَرَفت شيئًا جديدًا ترفع رأسها عاليًا وتؤكد بثقة أنها قحبة!
كان العمل بالتصوير يستمر منذ الفَجر إلى ما قبيل الغروب بقليل. حدّد رالف عشرة أيام، وعلى الرغم من كثرة العمل التزمَ ماتياس. توقعت أن ثمة تعليماتٍ صارمة بخصوص الوقت، تَمنع أحيانًا من حفلة الغداء الصغيرة التي كانت تحرص كلاوديا عليها، لا لشيء إلا للتعرف أكثر على الأماكن: ملابس النسوة، وطريقة عراكهن، ونوعية الأطعمة. أمورٌ صغيرة كانت تدهشني، وفشلتْ محاولاتي لإقناعها بتفاهتها وحدوثها بلا سابق تعمد! كقيامها بالمقارنة بين مكونات طبقي الكُشَري في الحسينية والدرَّاسة، حيث اختفى مِن الأول العدس أبو جبة وكثر في الثاني! وعندما استدعاني رالف بعد ذلك، كان بهدف دفْع ما وعدَ به، تم كل شيء بسهولة وسرعة خاطفتيْن، فقط قال:
– “أتمنى أن تنسى قيامك بإعداد هذا التقرير!“
واريتُ إحباطي خلف ابتسامة، ورددت قائلا:
– “ليتك تنسى هذا أيضًا“
نظر إلي مليًا وابتسم، هكذا انتهى الأمر، وبعد أسبوع عدتُ إلى حالة الكمون في البيت، باستثناء وجود ظرف يحتوي على ألف دولار، أخذَته أمِّي وخبأته كما تخبئ كل مقتنياتها الثمينة في دَرْفة الدولاب المغلقة، ثم شددتْ علىّ ألا أقول لمجدي أو مديحة عنه شيئًا. بعد أسبوعين بدلت المبلغ وأصبحت أمتلك ثلاثة آلاف جنيه، لكن شيئًا ما تغيّر بداخلي، لم أستطع الذهاب إلى المقهى، أو ملاقاة النوبي، وعندما جاء فتحي يسأل عني، شددتُ على أمّي بألا تخبره بوجودي، لكنه جلس كأحد أفراد البيت، يتحدث معها عن ظروفه، وهي أخرجت لي لسانها بدعوته للبقاء، انصرفتُ عن صوتيهما لأتذكر كلاوديا، عندما طلبت عنواني كي نتواصل، وكتابتي له على ورقة احتفظتْ بها في الحقيبة التي اعتادت على حملها على ظهرها، لا أظنها ستفعل، دعوة التواصل جاءت كامتنان لِمَا قمتُ به معها، حتما ستنسى وجودي بمجرد اختفائي من محيطها، قالت إنها ستنهي إقامتَها نهاية العام وتعود، ما حاجتها لشاب مصري لن ينفعها بشيء! كنت أسمع حديث فتحي وصخبه، لكنني بقيت في عتمة الغرفة تأكلني الحسرة إلى أن رحل.
هكذا مرت الأيام، إلى أن استردتْ أمّي الحالة السابقة، نظرات الاستخفاف بي، وكلامها المبطن: “هفضل أصرف على العواطلية لغاية ما رِجلي تيجي في القبر” أصبح مجدي معلِّمًا للغة العربية، ومديحة بعد حصولها على دبلوم الصنائع قِسم التطريز تنتظر العريس، الكلام كان موجهًا لي فقط، أهربُ مِن نظراتها بالنوم، وأهرب من سؤال النوبي وفتحي بالاختباء، إلى أن عادت لطلبها السابق الصريح، ودون إخباري اتجهتْ إلى قريب لها، كان يقوم بشحن الشبان للعمل في السعودية. التأشيرات بتسعيرات متفاوتة، حسب قيمة وراتب كل مهنة، والمكان الذي سيتم السفر إليه، طلب منها ثلاثة آلاف جنيه ليفعل، لكن، عندما أعطته بطاقتي الشخصية ليبدأ إجراءاته قال: “لا بُدّ من تغيير المهنة أولا”. جلست في مساء ذاك اليوم، كل ما قالته أذكره، نظرتْ إلى كل شيء إلا عيني، قالت بصوت خفيض منكسر:
– “ناصر.. همّا مش عايزين مرممين، هتغير المهنة، هندفع للموظف في السجل المدني، هتلاقي شغل مش هيحوجك لحد في المستقبل“
سألتها بريبة:
– “أغير المهنة إلى…؟“
صمتت قليلا وقالت:
– “لنقّاش“
كان وجهها جامدًا أكثر من كل مرة، أنا أيضًا كنت يائسًا، لم أستطع الحصول على عمل منذ انتهاء التجنيد وعودتي من أنشاص، حتى محاولات النوبي لإلحاقي كعامل باليومية معه في المتحف القبطي باءت بالفشل! واختتم كلامه قائلا:
– “حتى لو لقيت فرصة، مفيش ميزانية اليومين دول، متحصلتش على مرتبي من شهرين“
شرعتُ في الإجراءات مستسلمًا، اكتشفت أنني كي أغيّر المهنة إلى نقّاش، عليّ أن أدفع رشوة! مبلغ سيلتهِم المكافأة، إذا دفعت لموظف السجل المدني لن أجد المال الذي سأشتري به عقد العمل! وإذا أخفقت في الحصول على التأشيرة سأظل في مصرَ بوظيفة نقّاش في خانة البطاقة! انسحقتُ تمامًا وقتذاك، وعندما جلست مستندًا إلى الحائط أسفل الشبّاك، أعلنتْ أمّي استسلامها بأن قالت مَثلَها الأثير:
– “رضينا بالهم، والهم مرضيش بينا“
لكنّ تلغرافًا وصلني بعد أسبوعين من كلاوديا، تخبرني فيه بأنها غيّرت عنوان شقتها إلى شقة أخرى في المهندسين. أدهشني الأمر، استنبطت أنها تولى اهتمامًا خاصًا لعلاقتي بها، وهذا شجعني على إعادة التواصل معها، بعد أعوام عرَفتُ أنها أرسلت التلغرافات بعنوانها الجديد إلى كل معارفها. في المساء اتجهتُ إلى العنوان، شارع هادئ متفرع من شارع محيي الدين أبو العز، صعدتُ بالأسانسير إلى الدور الخامس، وضغطت على الجرس، سمعت صوتًا قادمًا من الداخل، وفتحتْ لي شابة في أوائل العشرين، ارتبكتُ، حاولت سؤالها بالإنجليزية، لكن لغتي لم تسعفني فاكتفيت بأن قلت:
– “كلاوديا... “
واربتْ البابَ ونادت بصوت خفيض، دقائق وجاءت، ترتدي بنطلونًا وتي شيرت، وتلبس جوربًا في قدميها، ابتسمتْ ودَعتني للدخول. كانت الشقة مرتّبة، الكتب مرصوصة فوق بعضها كالأعمدة الصغيرة على الطاولة. رحبتْ بي، لم أستطع تخطي حالة الصمت التي لازمتني، حكيت لها بكلمات قليلة عما حدث، وعدت لحالة الصمت مجددًا، فسألتني عما أنوي فِعله فقلت:
– “لا شيء“
ابتسمتْ بما يشبِه الرثاء، ولأني تطلعت منذ اللحظة الأولى أن تسفِر علاقتي بها عن شيء يساعدني، حتى لو كان الالتقاء مرة أخرى برالف، حاولتُ أن أوطدها، بإيجاد فرص أخرى للقاء. استجمعتُ شجاعتي واقترحت عليها وضع خطة لزيارة الأماكن التي تحتوي على صناعات أو حِرَف كادت تنقرض. لم أخطئ في انتقاء ما يوافق هواها، هي ككُل الأجانب يهوى الأشياء التي مِن فرط عتاقتها صارت عالَمًا مسحورًا. في الأيام التالية، زُرنا الحسينية وشُبرا الخيمة لرؤية المكوجية القليلين الذين ظلوا يقومون بالكواء بالطريقة القديمة نفسها، ولم يتحولوا إلى الكي بالبخار. استمعت إلى أبو الليل وهو يشرح كيفية تطويع حركات قدمه لتنزلق المكواة بسهولة على الملابس. كنت أبتسم، أواري معرفتي بكل التفاصيل، وأكتفي بالاندهاش!
وفي الغورية عثرتُ على محل ينفخ الطرابيش، وكما فعلت مع المكوجي فعلت مع صاحب محل الطرابيش، منحته الاهتمام اللائق حتى انثال حديثه عن مهنته التي كادت تندثر، أمّا أمّي فعرفتْ عن طريقها كيف تجهز المرأة المصرية وليمة في ظروف غاية في الفقر، عندما دعتها لتناول الغداء ووجدت مائدة عامرة بكل أنواع الأكل المصري الذي لا تعرفه. وفي إحدى المرات، طلبتْ مِني الذهاب معها، لنلتقي رالف، قَبل أن يعود تاركًا مصر. خفق قلبي بشدة، شعرت بسرور مباغت، تحمستُ للذهاب، وأثناء الجلسة طلب مني أن أنطق كلمة “Eine Katastrophe” فيما بعد عرفتُ أن الكلمة التي اختارها ليختبر نطقي بالألمانية تعني كارثة! ثم قال:
– “مَخارج الحروف لديك جيدة، لماذا لا تسافر إلى ألمانيا لتتعلم اللغة؟“
كل ما كنت أسعى إليه الالتحاق بعمل مع البعثة في مصر، أجبت مندهشًا:
– “حقًا؟ حصلت على درجات مرتفعة في الفرنسية عندما كنت في الثانوية العامة، لكني كدت أرسب في الإنجليزية“
ابتسم سريعًا، كان ردي مباغتًا، لكنه عاد ليرتشف الشاي ثم قال:
– “لا عليك، درجاتك ليست مقياسًا“
لم أجد ما أقوله، تململت في جلستي، كنت أعرف أنني لا أقول الكلام المناسب، لكنني اندفعت:
– “لكن، أود العمل وليس الدراسة“
– “ناصر، أنت تريد بيضة وأنا أدلك على حظيرة الدجاج “
صمتَ قليلا ثم أكمل:
– “دعنا نفجِّر طاقاتك أولا، على وعدٍ مني بالمساعدة“
كان مُقتٍّرًا، لكنه وعدَني وكفى. حتمًا كل شيء هناك سهل عكس هنا! على الرغم من تشجيع كلاوديا وقولِها إن مستقبلي سيسير ببطء لكنه سيتغير برمَّتِه ظللت قلِقًا. لم أعرف كيف سأشرع في الالتحاق لدراسة اللغة هناك، لكنها قالت إنها تعرف! وكيلا يداهمها الشك، واصلت بحماسة جولاتنا، زُرنا مستوقدًا لتدميس الفول في المقطم، ومحلات الخيامية في الغورية، وذهبنا إلى القناطر لترى صناعة الأثاث من الجريد والخوص، ومصر القديمة لرؤية حِرَفيي الفخار ومصانع نفخ الزجاج وتعشيقه يدويًا. استدنتُ مِن مديحة ومجدي وأمّي لأوفر تكلفة المواصلات، والكشري أو سندوتشات الطعمية بالطحينة التي كنا نأكلها في طريقنا. ثم، دعتني إلى شقتها أمسيةَ سفرِها، لم تكن صديقتها موجودة. توجهتُ إلى بائع ورد واخترت باقة حمراء. ثم واصلت مشيًا حتى وصلت العمارة. كنت مرتبكًا، ومتأكدًا أن دعوتها ليست كسابقاتها! دققت الجرس ودخلتُ، كانت كل أغراضها معبأة في حقائب. دخلتُ المطبخ لإعداد الشاي، وهي انتظرتني في الصالة. كنت حزينًا وقتذاك لاقتراب فراقها! لم أكن متأكدًا إنْ كان شعوري صادقًا أم لا! وهي بدت حزينة أيضًا. وضعتُ الكوبين واقتربت منها. طوال الفترة السابقة لم تتطور علاقتنا إلى شكل محدد، كنت أوقن أحيانًا أنني بدأت أحبها، لكن في اليوم التالي لا أشعر تجاهها بأي شيء، أصارح نفسي بأن ما جعلني أستمر في لقائها هو الأمل. لكنها كانت تريدني هذه المرة. عيناها كانتا تفضحانِها. أمّي ومنذ دعوتها لتناول الغداء كانت تُحذرني من إقامة علاقة جسدية معها، لكن كل شيء في هذه الليلة حدث دون أن أتذكر كلامها، حتى أَمَلي في مساعدتها توارَى، كانت الرغبة والفرصة المتاحة الآمنة يحركانني. تبادلنا النظرات سريعًا قَبل أن أضمها بعنف. لا أعرف كيف وصلنا للسرير، اعتقدتُ أن الفارق بيننا سيقف حائلا، أو أن انعدام خبرتي وخجلي سيجعلانني متهيبًا، لكن الانجراف مع الرغبة في هذه الحالة أفضل من أي خبرة! كانت تمرغ وجهها في الفراش، جسمها يبدو صغيرًا بين يدي، تترك تأوهاتِها لتمتصها الوسادة، وأراني كعملاق يغزوها. أدهشني استسلامُها. كلما انتهيت وهدأت عاودت الكَرة، دون استراحة لالتقاط الأنفاس! كم مرة؟ ربما ثلاث أو أربع مرات! اعترفْ، خلافَ متعة المرة الأولى، أخذتْ علاقتك بها -بعد ما حدث تلك الليلة -شكلا معلومًا! ارتحتَ لأنها رغبت فيك، وكنت تعرف أنها لا تنساق لعلاقة عابرة. أيقنتَ أنها اختارتك لتكون شريكها، وبهذا حفرت نفق عبورك! ستسافر مطمئنًا بشكل ما، لو لم يحدث ما تشجعت. علاقتكما قَبل تلك الليلة لم تكن كافية لتغامر! وقَبل أن تسافر كانت إجراءات السفر التي ستتبعها معلومة تمامًا بالنسبة إليك!
هل بإمكاني كتابةُ قصةٍ موازية تحمل الحقيقة؟ أهدم مخطط توم وهاينز وألكسندر في قلعته هناك! “يوشع”! ماذا سمعَ؟ نَعَم، سأبدأ بـ “يوشع ابن أيهو”، يجب أن أتبنّى طريقة توم في الكتابة، الخيال الممتزج بالحقائق التي وردت في البرديات، هل سأنجح؟ نَعَم يجب أن تجرّب! اذهَب إلى المكتب، وتناول الأوراقَ البيضاء، وابدأ:
اقتربَ “يوشع” من الجدار، كان كهنة معبد “خنوم” مجتمعين! بصيصُ الضوء يشبِه السيخَ المغروز في الجدار، يُظهِر أشباحَهم وهي تتحرك في الداخل، اقتربَ “حرودي بن فلطو” من الباقين وقال:
– “المصريون لم يعودوا قادرين على دفْع الضرائب، الفُرس يأخذون نصف ما يُستخرَج من باطن الأرض، يبعثون بالرجال لاستخراج الذهب من الجنوب، والسفن تذهب إلى شوشن* محملةً بالأحجار، قال “رخميرع” إن زوجتَه كي تقدر على تدبير ضريبة الرؤوس لها ولأولادها تربِّي الطيورَ وتبيع بيضَها لنسوة الجزيرة!”
جاء صوت أحد الكهنة مِن خلف الجدار ليعقِّب:
– “ليس هذا فقط، اليهودُ يساندونهم، هل تَذكر أيها الكاهن، عندما ثُرنَا قبل عامين، وبدلا من وقوف اليهود جوارَنا، بعد أن فَتح لهم “أبريس”· أبوابَ مصر على مصاريعها، وآوَاهُم مِن الشتات في الجهات، وقفوا إلى جانب المُحتَلين الفُرس، لن أنسى أبدًا ضربَ اليهود لأخي حتى مات، ومَن لم يَقمعنا منهم، التزمَ بيتَه، تركونا أمام جنود “فيدرنجا” وحدَنا!”
يَسترجِع الكاهن “حرودي” تلك الأيام، كان قد مضى على تولِّي “داريوش” ملك الفُرس ثلاثةَ عشرَ عامًا، تمتلك “برايزاد” زوجتُه مفاتيحَ عقله، دفعته للتخلص من أخيه “سجديانوس” كي لا ينافِسَه أحد على العرش، ظنت أن قلبَه قادر على الاستمرار بعد هذه الفعلة، لكنّ شبحَ أخيه المقتول ظل يتعقبه، وكلما نظر إلى يديه تخيل أن دماءَه تلطخهما! ورويدًا رويدًا، لم يعد قادرًا على إحكام سيطرته على الولايات البعيدة ومنها مصر! عندئذٍ انتهزَ “قد بوني” في غرب الدلتا الفرصة، وتحركت قواتُه في تكتمٍ شديد، كانت أخباره تأتيهم في جزيرة “يب”، وقتذاكَ اجتمع المصريون في معبد “خنوم”، وطالبوه بإعلان الانضمام إلى الثورة، لكنّ وجود “فيدرنجا” حاكم الإقليم الفارسي بجنودِه في قلعة “سيني” جعله يتخوف، لا بُدّ أن يثق أولا بأن “قد بوني” نجح وبدأ في السيطرة على المُدُن الشمالية، وقام بطرد الحاميات الفارسية. ولمّا وصلت “يب” الأخبارُ بأن المصري الشاب والثوارَ نجحوا، طردوا حاميةَ “تانيس”· و”بوباستيس”· و”نوف”، وبايعَه كهنةُ المعابد في الشمال، أسبغوا رضاهم عليه ومنحوه اسمًا جديدًا لم يُسَمَّ به أحد من الملوك السابقين: “آمون إر_ديسو” خرج “حرودي” من معبد “خنوم” في “يب” إلى المصريين المتأهبين للثورة، وقال إن المصريين نجحوا في استرداد مصر السفلى، دخلَ كل مصري على الجزيرة إلى بيته، وخرج بما خبَّأه من أسلحة، وتجمعوا في ساحة الجزيرة خلف قلعة الحصن، ثم اتجهوا بكامل غضبِهم إلى “سيني”. خرجَ النسوة والأطفال من بيوت الجزيرة، وراقبت العيون عبورَهم المَهيب إلى الضفة الشرقية، لكن قبل وصولهم انهالت السهامُ فوق رؤوسهم، وتساقَط الواحد تلوَ الآخر في المياه! كان المنظر شنيعًا، لم يتبق أي منهم، طفت الجثثُ على سطح المياه، وبعد حِين جرَفها التيار إلى الضفتين، ظلت المراكب فارغة تتأرجح على سطح المياه! ولم تكتمل الليلة إلا والصراخ ينبعث من حول المقتولين في كل بيت!
كاد الموقف ينتهي بفرض الفُرس سيطرتَهم مجددًا، لكنّ الشبان المصريين اجتمعوا، صار لكل منهم ثأرٌ لدى الفُرس، امتلأت قلوبهم بالحَنَق على اليهود القابعين في بيوتهم، لأن أيًا منهم لم يُبدِ تعاطفًا يُذكَر، بل خرج مَن يعمل منهم في الحصن كأن شيئًا لم يكن متوجهًا إلى نوبة حراستِه المعتادة، وخرجَ عمّال المحاجر إلى الوديان والجبال، وظلت نساؤهم يتمتعن بالنسيم الآتي من الناحية الشمالية، وهُنّ جالسات يفلِّينَ شَعرَ الصبية من القمل! اجتمع الشبان وقرروا التمرد، بالانضمام إلى صفوف الثوار في الشمال، كي يتمكن “قد بوني” مِن بسْط سيطرته كاملة، ويختتم بطرد اليهود من الجزيرة، لكن حاكم طيبةَ المصري أرسل لهم رسالة، قال فيها إنه تلَقّى الأوامر من القيادة نفسِها، بأن على كل مصري الصبرَ حتى تستقر الأمور، الصبر لشهورٍ أخرى نوعٌ من النضال أيضًا، وهكذا، تَراجَع الشبان كلٌّ إلى بيته قامعًا حماستَه إلى حين، وكي يتحصنوا من هجوم “فيدرنجا” إذا فكَّرَ في القبض عليهم، اقترح أحدهم حفْرَ خندق أسفل درب المصريين، يختبئون فيه كلما جَن الليل!
هل تبدو هذه القصةُ مكتمِلة كقصص توم؟ أنت لستَ كاتبًا! فلِمَ تحاول الكتابة؟ لديك المعلومات الحقيقية فقط، ولديه القدرة على خلْق شخصيات من لحم ودم! هل سيصمد خيالك أمام خياله؟ وهل سيأخذ بما كتبتَه؟
لا أعرف! لا أعرف!
لا تَلُم نفسك، نعم سعيتَ إليهم بقدميك، ما أكثرَ القِطعَ الملقاة! هل نسيتَ آخر قصص النوبي عن المتحف؟ تركتَ مصر ولم يكمل لك، هو نفسه لم يعرف باقي القصة، منذ العثور على أقدم نسخة معروفة لكتاب مزامير “داود” في بلاص فخاري في إحدى قرى بني سويف، والمهربون يسعون للحصول عليه، ولم يعدموا الحيلة، لم يكن عاطلا مثلك مَن بدَّلها، بل أحد المرممين المعينين في المتحف القبطي بالاشتراك مع كبار المسؤولين هناك، قال النوبي إن المرمم وقّع على استلام كتاب المزامير بحجة ترميمه، وبدلا من الذهاب به إلى قاعة الترميم خَرج به تحت أعين الأمن حتى من دون إيقاف، قال إنه سيصوره للاستعانة به في بحث يُعِده وسيعود به لاحقًا، مبرر لا ينطلي على أحد، خبر خروجه بالمزامير انتشر بين الموظفين، لكن أحدًا ممن ظَل محتفظًا بغَيرته على تراثه لم يستطع إثبات الواقعة، على الرغم من تحرير محضر، الجميع تأكد أنه تم استبداله، كل ما حدث بعد ذلك كان يؤكد هذا: تجهيز فاترينة العرض بالزجاج المزخرف بالصلبان، كان تمويهًا كيلا تُرى جيدًا من الخارج، والتوقف عن ملء الفاترينة بالنيتروجين كي تتحلل الأوراق، ويُقضى تمامًا على أثر الجريمة. المرمِّم سافرَ بعد ذلك في بعثة إلى سويسرا، حتمًا كانت المِنحة هي المكافأة على ما فعله، عاد بعدها ليصبح مسئولا أكبر! ربما حقدَ الآخرون عليه، لأن فرصة سرقتِه أتيحت له دونهم. لا أحد يهمه أَنْ كانت النسخة الموجودة الآن أصلية أم لا، لماذا يتم الاهتمام بأصالتها؟ هُم بحاجة إلى نسخة للعرض، حتى إذا كانت مقلدة!
هل نسيتَ؟ عندما كنتَ في الكُلية، وكنتم تصنعون نماذج جصية تحاكي التماثيلَ الأصلية، لمعرفة طريقة الصب، وأحيانًا كنتم تهشمونها لإجراء تمارين الترميم على الكسرات، واختبار أحدث الطرق وملاءمتها لكل مادة. كان الأساتذة يكافِئون الطلاب المجتهدين منكم بوضع التماثيل الجيدة في باحة الكلية، لكن الطلبة السلفيين كانوا يباغتونكم كل حين، يتجمعون في ساحة دار العلوم ويغزون الكلية جماعات، يقومون بالدوران حول التماثيل مرددين أغنية:
“لبيك اللهم هُبَل..
لبيك يحذونا الأمل..
نحن غرابا عك عك”
ثم يَبدؤون في مهاجمة كل مَن يستطيعون الإمساك به، أنت نفسك لم تَسلَم منهم، مزقوا ثيابك هاتفين الله أكبر، وعُدتَ إلى الوايلي مكشوفَ الساقيْن! انفضْ أفكارك، حتى جلْد الذات فات أوانه. فقط، اجعلِ السعادةَ تغمرك، لقد استطعتَ أن تخلق لولديك طفولة مغايرة لطفولتك البائسة.