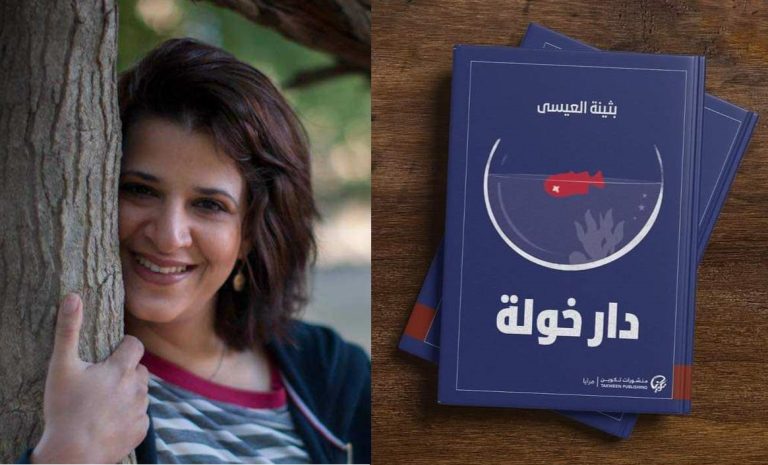د. رشا الفوال
يُعدّ المكان في القصة القصيرة أحد العناصر الجوهرية التي تتجاوز حدود الوصف الجغرافي لتغدو مجالًا للتجسيد النفسي والدلالي، إذ تتكثّف فيه خبرات الذات وهاجسها بالانتماء والفقد والبحث عن الأصل. في مجموعة: الأمثال في الكلام تُضيء الصادرة عن سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عام 1992م للكاتب: محسن يونس، تتجلى جماليات المكان بوصفها مرآة للداخل الإنساني، لا مجرد خلفية للأحداث؛ وهو الأمر الذي سنتناوله بمحاولة الفهم والتحليل من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: البحيرة كمكان أصلي ومرآة للاشعور الجمعي
في قصة: البحث يبتكر الكاتب فضاءات متعددة منها: البحيرة، الجُحر، الجزيرة، الوسعاية، وكلها أماكن تتجاور لتكوّن خرائط سيكولوجية تعكس رحلة الطفل(الراوي) من الواقع إلى المتخيل، معنى ذلك أن المكان ليس مسرحًا ثابتًا للأحداث، بل كيان نابض يعيد إنتاج التجربة النفسية للطفل ويُسهم في بناء معنى للعالم. تُقدَّم البحيرة في القصة بوصفها الأصل المائي، أو الحاضنة الأولى التي تتفرع عنها الأمكنة الفرعية، بالتالي يمكننا النظر إليها باعتبارها رمزًا للأم الكبرى في لاوعي الطفل؛ يقول الطفل: قعدت العب في رمل الجزيرة، أبني بيوتًا وأصنع أناسًا من الطين أكلمهم ويردون علي، جاء الولد حسونة وعطا ومحمد يسوقون الحمير ودخلوا بلدتي وهدموا البيوت وفعصوا الرجال والنسوان الطين “ فهى الفضاء الذي يحتضن ويغذي ويُخيف في آنٍ واحد. صفاؤها وغموضها يعكسان تناقضات النفس الأولى في علاقتها بالعالم حيث الانجذاب إلى الداخل المائي بوصفه مأمنًا، والخوف من غمرته في الوقت ذاته، البحيرة أيضًا تختزن الذاكرة الجمعية للقرية وللأطفال.
ثم يأتي: جُحر السمك ورمزية الداخل واتساع الخيال، حين يصف الطفل الجُحر بأنه ” بابه ضيق لكنه من جواه واسع “؛ فيفتح أمامنا استعارة سيكولوجية دقيقة للذات الطفولية، إذ يبدو العالم ضيقًا في الظاهر، لكنه يتسع في الداخل عبر الخيال. فالجُحر يمثل اللاوعي الفردي، المساحة الداخلية التي يحتمي بها الطفل من الخارج الواقعي. ومن منظور فرويدي تحليلي، يُعدّ هذا الجُحر رمزًا إلى الرحم مكان الأمان والتحقق الأول. كما أنه يوازي في بعده الإبداعي عملية الخلق الفني، إذ يدخل الراوي إلى عمق ذاته ليُنتج من ضيق التجربة اليومي اتساعًا دلاليًا جديدًا.
ثم تتجلى الجزيرة والوسعاية كفضاءات لللعب وإعادة بناء العالم؛ فالجزيرة التي يستريح عليها الأطفال بعد الصيد تمثل العتبة الفاصلة بين الواقع والمتخيل. هناك يتحول اللعب في الرمل إلى فعل خلقٍ مصغّر مكتظ بالمشاهد الوصفية، أما الوسعاية كمكان فرعي، فهي بمثابة امتداد للحركة النفسية نحو الخارج، نحو المسافة التي تُختبر فيها الحرية والمغامرة. يمكن القول إن الكاتب يرسم عبر هذه الأمكنة المتتالية مسارًا نفسيًا من الانغلاق إلى الانفتاح، ومن الانعزال إلى المشاركة في العالم. جماليات المكان هنا تكمن في تحوّله من مرسومٍ خارجي إلى مرآة باطنية، من فضاء محسوس إلى صورة ذهنية تعيد تشكيل تجربة الطفولة والوجود معًا.
ثم تأتي قصة: البحر والبر حيث الاغتراب بين فضاءين ومحنة الانتماء، يُعمّق الكاتب هنا اشتغاله على ثنائية المكان بوصفها انعكاسًا لثنائية الذات الممزقة بين الأمان والضياع؛ فالمكان ليس مجرد خلفية لصيادٍ يُدعى: عراقي، بل هو مسرح لقلق الهُوية ولتجاذب الداخل والخارج في النفس الإنسانية. تتوزع القصة بين فضاءات متعددة: خزنة المركب، الخُنّ، حلقة شيخ الصيادين، البيت، البحر والبر؛ وجميعها تشكل دوائر من الانغلاق والانفتاح تُعبّر عن توتر الشخصية مع محيطها. مع ملاحظة أن: البحر كمكان للمغامرة والرزق، لكنه في الوقت نفسه يشكل موضع خطر وغموض. أما: البر فهو مجال العودة والطمأنينة المزعومة، لكنه سرعان ما ينكشف عن برّ هشٍّ لا يمنح الاستقرار. هذه الثنائية تُمثّل صراع الذات بين الرغبة في الانطلاق والخوف من الفقد، وهو ما يتجسد في حركة: عراقي الدائمة بين الخروج والدخول” من البحيرة إلى البيت، ومن البيت إلى البحيرة، كأن المكان الخارجي لا يكتمل إلا بظلٍّ داخلي يعادله “، تُشير هذه الثنائية إلى حالة من الاغتراب الوجودي؛ فكل انتقال مكاني هو في حقيقته محاولة فاشلة للعثور على مركز نفسي مفقود. نلاحظ أيضًا أن اللون الرمادي الذي يكسو القارب ومركز البوليس والحوائط ليس مجرد تفصيل واقعي، بل إشارة نفسية إلى التباس العالم وفقدان الحيوية. الرمادي هنا هو لون السلطة والجمود، لون الحكومة كما يرد في النص، لكنه أيضًا لون الحياد الوجودي الذي يعيشه الصياد. ومن منظور التحليل النفسي، يمكننا النظر إلى هذا اللون كعلامة على كبت الانفعال وغياب الدفء الانساني، وكأن العالم الخارجي أصبح انعكاسًا لداخلٍ ميت. لا غرابة إذًا في البطل الذي يُشبه القارب بـ “غراب الموت “ حيث تتكثف الصورة لتعبّر عن تحوّل المكان إلى رمز للفناء؛ فالبحر لم يعد منبعًا للحياة، بل ساحة لتهديد الذات وابتلاعها.
ثم يأتي الموال بوصفه بناءً سرديًا ونفسيًا، حيث تم تقسيم القصة إلى: موال أصلي، و: موال البر، و: موال البحر يُحيل ذلك التقسيم إلى بنية تكرارية تشبه الهوس النفسي حيث يُعاد الفعل ذاته بصيغ مختلفة بحثًا عن المعنى أو الخلاص.
فالموال الذي يقوم في الثقافة الشعبية على الشجن والتكرار الإيقاعي، يُعد هنا بنية للذاكرة والحنين، تتيح للصياد أن يحكي وجوده على نحو دائري، كما لو أنه يدوّر الألم ليحتمله. ومن اللافت أن المثل الشعبي ” الرزق يحب الخفية “ يتحول في سياق القصة إلى شعار للغموض والخضوع للقَدَر، كأن الوعي الجمعي ذاته يكرّس حالة القبول بالمجهول التي يعيشها الصياد.
المحور الثاني: المكان بين الجسد والأسطورة والتاريخ
قصة: الأمثال في الكلام تُضيء هى قلب المجموعة، إذ تُوجز فلسفة: محسن يونس في النظر إلى المكان بوصفه حافظة للذاكرة الجمعية ومسرحًا للتحولات النفسية. تنقسم القصة إلى أقسام يفتتح كلٌّ منها مثل شعبي يُوجّه المعنى، ويعمل كبنية تأويلية تربط بين الحدث الفردي والوعي الجمعي، هنا يتجاوز المكان حدوده المادية(البحيرة، القرية، سيناء…) ليغدو فضاءً رمزيًا متعدّد الطبقات: جسد الإنسان، أرض الوطن، وذاكرة الجماعة.
فنجد أن الأمثال شكلت بنية للمكان النفسي، وكل مثل شعبي يُشكّل عتبة رمزية تؤسس لفضاء جديد في الوعي، فالمثل” اللي ياكل حلوتها يتحمل مرّتها “ لا يُقدَّم كحكمة جاهزة، بل كمفتاح نفسي لفهم صراع البطل: يونس مع الحياة. والأمثال في هذا السياق ليست مجرد تراثًا لغويًا، بل خرائط داخلية تنظّم علاقة الإنسان بمصيره، أي أنها تمثل اللاوعي الثقافي الذي يوجّه أفعاله ويحدّد معنى المكان لديه، من هنا تتجلّى جمالية العنوان نفسه: الأمثال في الكلام تُضيء حيث تحوّل اللغة الشعبية إلى مصدر ضوءٍ يضيء العتمة النفسية للشخصيات، لكنها أيضًا تفضح ما يختبئ خلف هذا الضوء من مرارة وقهر متوارث. يتضح ذلك من خلال أولًا: المكان الموشوم على الجسد حيث التماهي بين الداخل والخارج، يقول: يونس: ” وشم السمكة التي تبتلع مدينة على صدري، ووشم المركب على زندي” وهى صورة بصرية كثيفة تختزل علاقة الإنسان بالمكان إلى أقصى حدودها؛ فلم يعد المكان خارج الذات، بل صار منقوشًا على الجسد، والوشم ليس للزينة، بل علامة وجودية على إنه ذاكرة مطبوعة في اللحم، تربط الفرد بجغرافيته وبألمه معًا.
ثانيًا: التناص مع السيرة الهلالية واستعادة الأصل الأسطوري للمكان، تم ذلك من خلال استدعاء أسماء: يحيى ومرعي إلى جوار يونس فيتحول الفضاء الواقعي إلى ساحة أسطورية، ويُبرز كيف أن الذاكرة الشعبية تتسلل إلى البنية النفسية للشخصيات؛ فكما ينتقل أبطال السير في الفيافي والبحار طلبًا للمجد أو الفداء، كذلك يونس وإخوته يعيشون رحلة وجودية تتراوح بين التمرد والضياع، حيث تختلط البطولات بالخذلان، ويصبح الوشم بمثابة ختم الأسطورة على الجسد الحديث.
ثالثًا: المكان كجرح وذاكرة حرب في هذا القسم يتسع الفضاء الرمزي ليشمل المكان الوطني في بعده التراجيدي، وأرض: سيناء لا تُقدَّم كموقع جغرافي، بل كمكانٍ تُستعاد فيه تجربة الحرب بوصفها فقدًا للأخ ولجزء من الذات، إنها النقطة التي تتقاطع فيها الذاكرة الفردية بالذاكرة الجماعية، حيث يُصبح الفقد الشخصي صدى لصدمة وطنية، هنا يتحول المكان الحربي إلى فضاء للحداد، بينما يعمل المثل الشعبي كآلية دفاع ثقافية تبرّر الخسارة” اللي يخسرك مالك يخسرك روحك “ وتحوّل الألم إلى حكمة.
وفي قصة: حكايتان عن مقابلة عرابي مع الخضر وتبادل الرأي والمشورة تتجلى المساحة الرمزية التي تربط المكان بالزمن والذاكرة التاريخية، وتمزج بين الحكاية الواقعية والأسطورية، وهو الأمر الذي يعمّق البعد السيكولوجي الذي يسري في المجموعة كلها. تقوم هذه القصة على ازدواج الحكاية: حكاية حسنين وحميدة في الحاضر الشعبي، وحكاية الجد العجوز وعرابي في الماضي البطولي، هذا البناء المزدوج يجعل المكان يتحول من فضاءٍ للحدث إلى ذاكرة سردية تلتقي عندها أزمنة متعددة. والكاتب يستخدم الحكايتين ليعيد ربط المكان المحلي(الشط، البلاص، البيت الريفي) بـ المكان التاريخي(ساحة الجهادية، ميدان عرابي) في شبكة واحدة من الانتماء والخذلان والحنين.
يتجلى أيضًا المثل الشعبي” سعد الراجل بمراته ونكده بمراته “ كوعي جمعي موجِّه ومفتاح لتفسير البنية النفسية للعلاقات داخل المجتمع الشعبي، بهذا الشكل يربط الكاتب بين الحكمة الشعبية والنزعة التحليلية النفسية، ليجعل المثل يعمل كآلية تفسير خفية للعلاقات والمصائر. وحين تستدعي القصة حكاية: الجد العجوز الذي” مشي حافيًا يحمل بندقية تشبه العصا مع عرابي” ، ينتقل المكان من واقعه الضيق إلى فضاء الذاكرة التاريخية، تقنية التناص هذه المرة تحوّل المكان الشعبي إلى أرضٍ تشهد على التاريخ، وسيرة الجد تمثّل اللاوعي الجمعي المقاوم والذاكرة التي تحفظ معنى الكرامة رغم الهزائم. ثم تأتي بنية المفارقة التي تجمع بين الهزيمة الخاصة والانتصار الرمزي في قول الجد لحفيده: ” جوز أمها طواك، وعرابي رفض أن يطويه الخديوي “
مع ملاحظة أن الإشارة إلى سيدنا: الخضر في عنوان القصة تضيف بعدًا صوفيًا رمزيًا، إذ يجسد الخضر الحضور الغامض للمعنى في العالم، أو الحكمة التي تظهر وتختفي بين الأجيال، ولقاء: عرابي بالخضر وتبادل المشورة ليس حدثًا واقعيًا، بل استعارة نفسية عن رغبة الإنسان الشعبي في التواصل مع المعنى الأعلى وسط واقعٍ رمادي خانق؛ فمن الشط الذي تملأ فيه: حميدة البلاص، إلى ميدان: عرابي الذي سار فيه الجد حافيًا، يسري الوعي بالمكان كقيمة أخلاقية ونفسية، لا كمجرد مساحة مادية. ويتقاطع الزمان مع المكان ليشكّلا معًا الفضاء النفسي الجمعي الذي يعيد الإنسان الشعبي تعريف ذاته أمام السلطة، أمام التاريخ، وأمام الذاكرة التي لا تموت.
المحور الثالث: المكان كأداة لكشف البنى النفسية والاجتماعية المتوارثة
رأينا في المحاور السابقة أن الكاتب من خلال(خزنة المركب والخُنّ وحلقة شيخ الصيادين)، يرسم خريطة اجتماعية مغلقة، حيث تتقاطع الفضاءات المادية مع فضاءات القهر الرمزي؛ فالمكان الذي يُفترض أن يكون موئلًا للرزق يصبح سجنًا للوعي الشعبي، وتتحول البحيرة من فضاء حي إلى مسرح للتكرار المأزوم، والصياد كصورة للإنسان المقهور الذي يعيش في حدود مكان رمادي، يكرر طقوس العيش دون أن يبلغ المعنى. في قصة: العم بركات تتجلى المندرة بوصفها فضاءً أنثويًا للمقاومة والصمت؛ وهو الأمر الذي جعل المكان مسرحًا للتداعيات الثقافية والسيكولوجية المكثفة؛ إنه فضاء بين الحياة والموت، بين الطقسي واليومي، بين السلطة الأبوية والمقاومة الصامتة، على المستوى البنائي، المندرة مفتوحة فيزيائيًا، لكنها مغلقة رمزيًا؛ إذ تتحرك فيها النساء في دائرة مغلقة من التكرار الاجتماعي، هذه المفارقة تُجسد بمهارة الازدواج النفسي للفضاء الأنثوي الشعبي حيث الانفتاح الظاهري مقابل القهر الخفي، يمكننا أيضًا النظر إلى المندرة كمكانٍ يعكس اللاوعي الجمعي الأنثوي في القرية، حيث تتحول الممارسات الطقسية(كالختان) إلى آليات دفاع رمزية ضد الخوف من العار أو الاختلاف. مع استدعاء المثل الشعبي” الحي أبقى من الميت “ الذي يعكس استراتيجية ذهنية للبقاء في وجه السلطة الاجتماعية، الجمال في معالجة الكاتب الدرامية أنه لا يُدين الشخصيات، بل يعرّي البنية النفسية التي تجعلها تبرر الألم باسم البقاء، وذكر نينه: محفوظة باعتبارها ” الجزيرة التي تحوطها المياه “ من أجمل الاستعارات في قصص المجموعة؛ لأنها تمثّل الأنا الأنثوية المحاصرة بالموروث الذكوري، المياه التي تحيط بها هي حدود المجتمع، والخوف، والرقابة، لكنها أيضًا تمنحها خصوصية وكيانًا.
إنها ” جزيرة “ لأن بقاءها مشروط بالانعزال، لكنها في الوقت نفسه مركز جاذبية لكل النساء، هكذا تتحول إلى رمز للأم الكبرى التي تحتضن وتخاف وتعالج في مفارقة إنسانية بالغة التعقيد.
المحور الرابع: المكان كفضاء للحدس والمعرفة
تبدأ قصة: الكلاب بجملة دالة ” يُقال إن الكلب كان حارسًا باب أهل الكهف “وهي جملة تحمل بذرة أسطورية تضع القصة منذ بدايتها داخل فضاء يتقاطع فيه الديني بالرمزي، والمعرفة بالغرابة. فـ” الكلب ” هنا ليس مجرد حيوان، بل رمزًا للوفاء الملتبس بالحراسة والنبذ، أي للوجود على الحدود: لا داخل ولا خارج، وهذا المدخل يكشف عن طبيعة الفضاء الذي ستتحرك فيه القصة حدّيّ، انتقالي، متوتر تمامًا كما هي” خنقة الوسعاية “ التي تطل على طريق البحيرة، وتصب فيها كل أزقة البلدة. ” الخنقة ” كمكان ضيق يتسع باتجاه البحيرة تمثّل صورة مصغّرة للعالم النفسي في القصة. إنها المنطقة الفاصلة بين البلدة حيث(الوعي الاجتماعي) والبحيرة حيث(اللاوعي الكوني). كل أزقة البلدة تصب فيها، أي أن كل التجارب اليومية والحكايات والموروثات والأسرار تنتهي إلى هذا الفضاء الذي يطل على الماء، حيث يختلط الواقعي بالغامض.
ومن منظور سيكولوجي، تمثل الخنقة منطقة العتبة بين الشعور واللاشعور، بين النظام والجنون، حيث تتكشّف الحكمة الشعبية بوصفها نوعًا من المعرفة الرمزية التي لا تخضع للمنطق العقلي، وحين يُستدعى الكلب في العتبة الأولى من القصة، فإنه يعمل كـ رمز للوعي الحارس، أي لذلك الجزء من الذات الذي يراقب الحدود بين الداخل والخارج. لكن الكلب في الثقافة الشعبية كما في علم النفس الرمزي كائن ambivalent مزدوج الدلالة باعتباره رمزًا للوفاء والحماية، لكنه أيضًا يرمز للخطر والنجاسة والنبذ، في هذا التناقض يتجسّد الصراع النفسي للراوي، الذي يعيش في فضاء الخنقة بين الحماية والخوف، بين المعرفة والانغلاق. ويأتي استدعاء الحكمة الشعبية ” لن يصير عطارًا صاحب حكمة إلا حين يسوق حمارًا أعمى “ فالعطار هو من يتعامل مع الأعشاب والعطور رموز العلاج والمعرفة، لكن القول يشترط لاكتمال حكمته أن يسوق حمارًا أعمى، هذا يعني أن المعرفة الحقيقية لا تُكتسب إلا عبر السير في العتمة، أي عبر اختبار اللاوعي دون خوف، وإطلالة خنقة الوسعاية تُعيدنا إلى المكان الأول في المجموعة: البحيرة بوصفها الأصل والمصب، لكنها هنا تختلف عن بحيرة الطفولة في قصة: البحث؛ لأنها لم تعد مكانًا للعب، بل فضاءً للتأمل والحدس، حيث تتقاطع الحكاية مع الأسطورة والمثل الشعبي، إنها تمثّل اللاوعي الجمعي الذي يحتوي كل حكايات البلدة وأمثالها ومخاوفها، وبين الخنقة والبحيرة يتجلى الفضاء النفسي في صورته الأعمق حيث الحركة الدائمة بين حدود التجربة الفردية والأفق الجمعي، بين الضوء والظل. هكذا يربط الكاتب بين الكلب كرمز للحراسة، والعطار كرمز للحكمة، والبحيرة كرمز للأصل ليؤكد أن المكان في القصة ليس مسرحًا للأحداث، بل خريطةٌ للوعي ذاته.
المحور الخامس: الدنيا كمكان كليّ واكتمال الدائرة النفسية
يواصل الكاتب بناء عالمه القصصي انطلاقًا من المكان بوصفه بنية رمزية وتتجلى جماليات الفضاء النفسي عنده في أبهى صورها، حيث الأماكن التي تبوح بما تعجز الشخصيات عن قوله، وتكشف هشاشة العلاقة بين الإنسان والعالم. في قصة: حكاية في حكاية يجمع بين الحكاية التاريخية والمتخيلة، وبين المثل الشعبي والحكاية الكبرى عن القوة. العنوان نفسه ” حكاية في حكاية “ يوحي بآلية التضمين السردي التي تستخدم لتفكيك الحكاية التاريخية الكبرى عن: محمدعلي الكبير عبر عيون السارد الشعبي، هنا يصبح السرد الشعبي وسيلة لإعادة تأويل التاريخ من الداخل، أي من منظور المهمّشين الذين يرون السلطة لا من قصورها، بل من هوامشها الطينية، وفي هذا السياق يكتسب المثل الشعبي ” كل ديك على مزبلته صياح “ قيمة مضاعفة، باعتباره مفتاحًا لفهم بنية الوعي الجمعي تجاه السلطة، فـ” الديك “ هو رمز الفحولة والسيطرة، والمزبلة ترمز إلى ضآلة الفضاء الذي يمارس فيه سلطته، المفارقة الجمالية هنا تتضح من خلال التاريخ الذي يُروى من أسفل، من موقع المقهور، فيتحوّل إلى ساحة رمزية لاستعادة الصوت الشعبي.
وحين ينهي الكاتب المجموعة بالدنيا كمكان أصلي في قصة: أهل القرية يرحلون، فهو لا يعود إلى الجغرافيا، بل إلى الوعي بالوجود الذي تتحول من خلاله الدنيا إلى فضاء رمزي شامل يضم البحيرة والجُحر والجزيرة في بنية واحدة، كأن التجربة الطفولية الخاصة قد صارت نموذجًا للحياة كلها. وكأن النهاية تمثل لحظة نضج رمزي للشاب الذي لم يعد أسيرًا للمكان الواحد، بل صار قادرًا على إدراك تعددية العوالم ونسبيتها. وكأن المجموعة كلها تتحرك في دائرة تبدأ بالبحيرة وتنتهي بالدنيا أي من الداخل إلى الخارج، من الذات إلى العالم.
خاتمة استنتاجية:
في مجموعة: الأمثال في الكلام تضىء تم توظيف المكان بهذه الكثافة الرمزية، إذ يحوّل الكاتب محسن يونس القصة القصيرة إلى مختبر نفسي يكشف فيه عن علاقة الإنسان بالمكان بوصفها علاقة بالذات أولًا. فكل مكان في القصص هو طبقة من طبقات الوعي، وكل انتقال مكاني هو عبور داخلي.
الكاتب لا يعرض الأمثال بوصفها حكم عابرة، بل كآليات ذهنية تُشكّل علاقة الجماعة بالمكان والسلطة، أي باعتبار المثل نفسه فضاء نفسي يعكس موازين القوة.
المكان في قصص المجموعة لا يُرسم بتفصيل جغرافي بل بذاكرة حكاياتية، إنه فضاء يُستدعى بالكلمة لا بالوصف، وكأن الحكاية ذاتها هي المكان الذي تتحرك فيه الشخصيات، وهنا تبلغ رؤية الكاتب ذروتها الفنية؛ فكل مكان هو انعكاس لحالة وعيه بالذات والآخر، حتى لو كان موضعه هامشيًا أو متخيلًا.
تتكشف في قصص المجموعة البنية السردية التي تتخذ من المكان الشعبي البحيرة، الوسعاية، المندرة، الخنقة، الجزيرة، المقهى مرآة للوعي النفسي والوجودي للإنسان المصري في بيئته اليومية؛ فالمكان عند الكاتب ليس إطارًا للحكاية، بل حالة شعورية تتغير بتغير موقع الذات من الذاكرة والأسطورة. بداية من البحيرة التي تمثل فضاء الطفولة والخلق واللعب إلى خنقة الوسعاية والمندرة والبحر والمقهى، ثم يتدرّج الفضاء من الداخل الحلمي إلى الخارج الاجتماعي، في حركة تشبه رحلة النضوج النفسي للإنسان من الخيال إلى الواقع، ومن الذات إلى الجماعة.
كل مكان في المجموعة يحمل صدى الموروث الشعبي — أمثال، حكايات، إشارات أسطورية لكنها لا تعمل كزينة لغوية، بل كآليات دفاع نفسي ضد الخوف، الفقد، والسلطة.
فالمثل الشعبي هنا يضطلع بدور اللاوعي الجمعي الذي يوجّه السلوك ويفسر الوجود بلغة مألوفة، بينما المكان يجسّد هذا اللاوعي في صورة حسية.
في قصص المجموعة يتجلّى الفضاء المائي بوصفه رمزًا للأصل، للمخيلة، ولللاوعي، بينما في المندرة والخنقة والمقهى يتجسّد الفضاء الاجتماعي الذي يفرض القيد والنظام، هكذا يتحرك النص بين الانفتاح والانغلاق، اللعب والسلطة، الحلم والواقع، ليكشف أن الجمال في السرد يتلخص في تواطؤ الجغرافيا مع النفس. من ثمّ تغدو البحيرة التي تبدأ بها الرحلة بمثابة المكان الأمّ الذي يفيض بالحياة والمعنى، وتغدو الدنيا في نهاية المطاف فضاءً للإدراك والوعي بالذات والعالم.