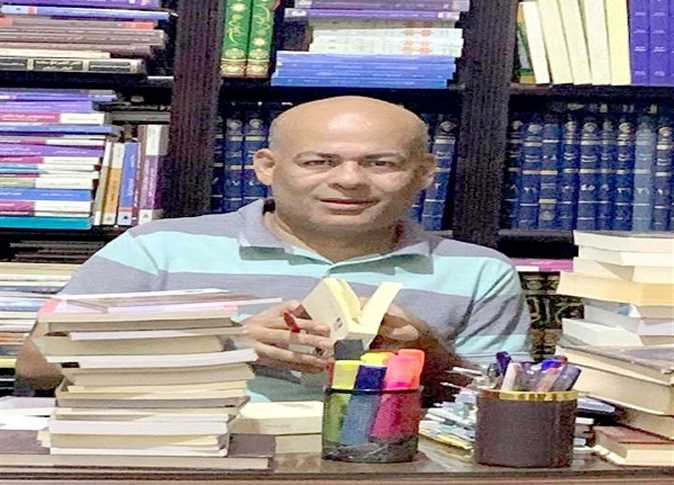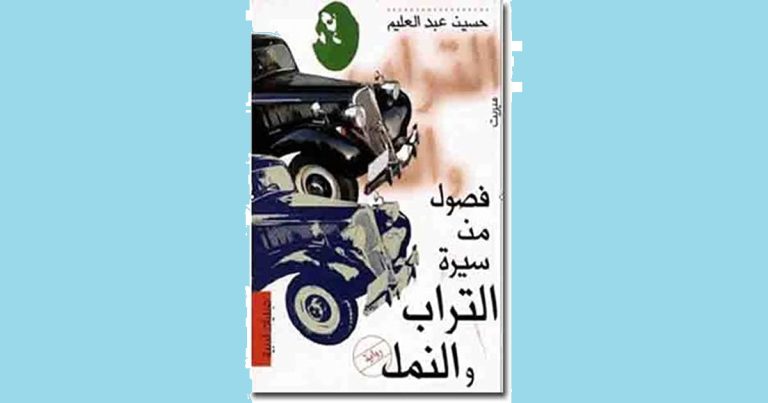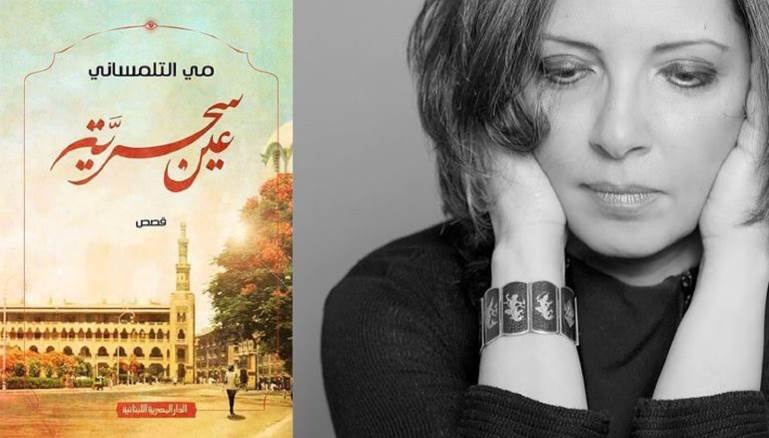د. نعيمة عبد الجواد
أكمل زينته في المرآة، ثم مرر يديه في خصلات شعره الأسود اللماع، وكأنه يضع اللمسات الأخيرة على تحفة فنية. وبحركة لا إرادية، مرر يده على ذقنه، وظهرت على قسماته إمارات حبور غير مفهوم لمجرد أن ذقنه حليقة، وناعمة كالحرير. توجه لخزانة ملابسه الصغيرة، التي أظهر عليها الزمن علاماته من تشققات، وسقوط بضع قطع من الطلاء، وأخرج معطف البزة الأنيقة التي لطالما ادخرها لمناسبة هامة مثل تلك. لم ينسى قبل خروجه من الحجرة أن يضع رشة سخية من عطر أخاذ لطالما أدار عقول النساء صوبه، قبل رؤوسهم. لم يرغب في هذا اليوم أن تعوزه ولو حتى لمسة أخيرة، أو يعكر صفو ذهنه ولو حتى موقف بسيط؛ فكل ما كان يخطط له من سنين، صار وشيك. زمن هذا المنطلق، ألقي نظرة أخيرة من نافذة غرفته على سيارته الصغيرة المتواجدة أمام بوابة العمارة التي يقطنها. وهو يصمم على ركنها في ذاك المكان بالتحديد الذي يقع في مرمى نافذته حتى يتأكد أنه لن تعبث بها يد، وأن حارس العقار يبقيها دوماً نظيفة. استراح قلبه عندما تيقن أن سيارته الصغيرة ذات الموديل القديم نظيفة لماعة، فجُلَّ مبتغاه في ذاك اليوم هو ترسيخ مظهره الأنيق في ذاكرة الحضور لأبد الآبدين.
هبط الدرج واستقل سيارته صوب مكتب المحامي وهو يراجع في رأسه ما سوف يردده حين دخوله، ويتخيل سيناريوهات كثير للحوارات التي سوف يجريها، مع وضع الردود المثلي التي تتواءم وكل موقف. وبينما كان مستغرقاً في أفكاره، رن جرس هاتفه النقال، وانفرجت أساريره عندما وجد المتصل خطيبته، والتي بادرته فور ضغطه على زر الإجابة بقولها:
“أخبارك إيه اليوم؟ يارب تكون أحسن! كنت في صوان العزاء في حالة مذرية، أنا كنت خايفة إن يحصلك حاجة. وبعدين إنت قفلت ليه الموبايل اليومين اللي فاتوا؟ أنا كنت قلقانة عليك.”
رد عليها على غير المتوقع بصوت مبحوح أعياه بكاء وعويل قائلاً: “أشكرك على السؤال، لكن خالتي اللي ماتت دي كنت بعتبرها زي أمي تمام وأكثر. أنا اللي كنت في السنين الخمسة الأخيرة برعاها، وأمرَّضها، وأشوف كل طلباتها. الله يرحمها كانت وحيدة، ولم تنجب أطفال، وطاعنة في السن. وبعد موت زوجها من سبع سنوات لم تجد من يرعي شئونها. أنا حقيقي مصدوم! ربنا لا يحرمني من سؤالك الغالي عني يا خطيبتي وحبيبتي وأمي.”
– حبيبي، إنت بجد إنسان جميل ونادر الوجود. أنا بشكر ربنا أنه جمعني بإنسان وفي وحنون زيك،إنت تستاهل كل خير. وليها حق خالتك لما كانت بتثق فيك كل الثقة العمياء دي، أظن علشان كده وعدتك بشقتها الرائعة. لكن، لو أنا منها، كنت أديلك كل الدنيا، وهتكون برضه مش كفاية.
قاطعها برقة، وبعد أن انفجر باكياً، “أرجوكي، أنا ما كنتش عاوز منها أي حاجة. دي . . . دي كانت غالية عندي أوي.” وفي وسط بكاء مكتوم، أخبرها بصوت متقطع: “أكلمك بعدين يا حبيبتي، سلام.”
بعد أن أنهى المكالمة، نظر لانعكاس صورته في مرآة السيارة، وألقى لها قبلة شغف في الهواء، وهو يبتسم ابتسامة عريضة. في هذه الأثناء، أضاءت إشارة المرور اللون الأحمر، فوقفت بجانبه سيارة فارهة تقودها فتاة جميلة. نظر لها نظرة أخاذة جعلها ترتبك، لدرجة أنها لم تستطع أن تشيح نظرها بعيداً عنه. فابتسم لها ابتسامة عريضة مغرية، أجبرتها على مبادلته الابتسام. ولم يعكر صفو تلك اللحظة إلا تحول الإشارة للون الأخضر، وتلاها زمور السيارات التي تعوقها سيارتهما من المرور. مرت سيارة الفتاة، فضحك بصوت عالي منتصر وهو يهنئ نفسه على قدرته الفائقة لاجتذاب ما يريد بأسهل الطرق، وأدواته تتلخص في: أدب جم ووسامة فائقة.
تذكر خطيبته التي ضمها لطابور علاقاته النسائية منذ أربعة أشهر. فلقد قابلها في إحدى المستشفيات القريبة من شقة خالته بينما كانت تجري فحصاً لمخالطي المصابين بفيروس الكورونا، في حين كان يرافق خالته ليجري لها تحليلاً يطمئنها أنها ليست مصابة بالكورونا. وبتجاذب أطراف حديث خاطف مع والدة خطيبته حينئذٍ، علم أن “علا” هي إبنتها الوحيدة، وغير راغبة في الارتباط ، بالرغم من أن المعارف وأولاد الجيران في حي الزمالك الذين يقطنون فيه يتهافتون عليها. في ذلك الوقت، لم يَعِر “خالد” كلام الوالدة كل الانتباه، حيث كان محور اهتمامه حينذاك ملابسها الأنيقة التي تنتمي لماركات فخمة، وشنطة يدها الأصلية التي ثمنها يربو على الثلاثة عشر ألف جنيه، ناهيك عن ساعة يدها. خرجت “علا”، فابتسم لها، وهنأها مقدماً على نتيجة التحليل السلبية، وكأنه يعرفها منذ سنوات. وعندما بدت عليها دهشة ختلطت فيها مشاعرها، أخبرها أنهما جيران لخالته، التي ظهرت نتيجة تحليلها سلبية. ومنذ ذاك الحين، صار يرابض “خالد” في بيت خالته. وبدلاً من زياراته المتقطعة لها كل أسبوعين أو ثلاث، صار يزورها شبه يومياً على مدار أربعة أشهر متخذاً من الاطمئنان عليها بعد انتشار فيروس الكورونا ذريعة. وبالطبع، كانت “علا” هي الهدف الحقيقي من تلك الزيارات، التي تفنن في لقاءها لقاءات كانت في بادئ الأمر عابرة، وحاول بكل الوسائل أن يوطد علاقته بأمها. لقد استطاع أن يسحر “علا” وأهلها بأدبه الجم، وحديثه عن مستقبله الذي يخطط فيه أن يكون مهندساً معمارياً مشهوراً. لكن، وقبل أي شئ، سحر الجميع بوسامته الأخاذة، وحسه المرهف، وصوته الرخيم، وحديثه الناعم، بالإضافة إلى نظراته الخبيرة القادرة على تحريك أكثر المشاعر تصلباً.
وبغض النظر عن خالته الميسورة الحال، كان “خالد” الابن الثاني لموظف بسيط، ويقطن في حي شعبي في شقة تحاول جاهدة أن تدخل في غمار الطبقات المتوسطة، لكن دون جدوى. لكن بذكاءه العملي، استحوذ على قلب “علا” الميسورة الحال، ذات السيارة الفارهة، والمتخرجة حديثاً من الجامعة، ولا زالت تسعى إلى الرومانسية، والحب الحقيقي. كان فيروس الكورونا بمثابة هدية السماء له. فبسبب الكورونا، تعرف على “علا”، وبسبب التباعد الاجتماعي، جعلها تعيش في حالة من الرومانسية لم تكن لتراها إلا في الأفلام الرومانسية القديمة. فكانت تستمتع بانتظاره لتلوح له من الشرفة، وتستمع معه لنفس الأغنية الرومانسية التي يرسلها أي منهما للآخر في نفس اللحظة. وكم كان محبباً لديها عندما كان يتناول كلاهما الطعام في نفس الوقت في البلكونة ويتحدثان طوال الوقت على تطبيق الميسينجر بالصوت والصورة وكأنهما في موعد غرامي. لقد أعطاها ما تحلم به أي إمرأة رومانسية: الحب، والاهتمام، والاحتواء. فتغاضت عن رقة حاله، وعدم قدرته على أن يماري مستواها المادي. شخصيته الحالمة الرقيقة جعلتها تتمنى أن تعيش مع فارس الأحلام هذا طوال العمر. وبالطبع، وافقت عليه عائلتها لضمان سعادة ابنتهما، وخاصة وأنه أخبرهم أنه لسوف يعيش مع خالته المسنة التي قاربت التسعين بعد الزواج بناء على طلبها. وأنها أيضاً وعدته أن تملكه شقتها شاملة كل محتوياتها بعد موتها. لقد كانت الكورونا بمثابة نعمة كبيرة عليه حين عرفته ب “علا”، وجعلته يواعدها دون أن يتكبد جنيهاً واحداً، وكذلك لأنه لم يتكلف مصروفات حفل خطوبة، ولن يتحمل أيضاً آية تكاليف في حفل الزواج؛ لأنه سوف يتم أيضاً سريعاً في أضيق الحدود بسبب تفشي فيروس الكورونا.
وطوال فترة مغازلته لابنة الجيران “علا”، دأب الإلحاح على خالته أن تكتب له الشقة ليتزوج فيها لطالما أنه لا وريث لها، وأنه بمثابة ولد الولد الذي لم تنجبه. وكلما فاتحها في الموضوع، كانت تنظر له وتبتسم برقة وعيون تفيض عذوبة، فيطمئن ويهدأ باله. ومن ثم، كان يعمل ما في وسعه ليظل معها في نفس الشقة لأطول وقت، وكان يخدمها بابتسامته الزائفة وهو يتمنى موتها في كل صباح. ولقد أحزنه عندما كان يرى صحة خالته تتحسن كل يوم تلو الآخر. وفي أوقات كثيرة كان يتمنى دس السم لها في الطعام، أو كتم أنفاسها بالوسادة بينما كان يعدلها لتستقر في جلستها. وأخذ ذلك الشعور يتفاقم لديه لدرجة أنه زار صديقاً له مصاباً بالكورونا، ثم ذهب إليها مباشرة لعله يكون حاملاً للمرض فتصاب بالكورونا، وتفارق الحياة. لكن على عكس توقعاته، أخذت صحتها في لتحسن، وكانت حالتها المزاجية ومعنوياتها مرتفعين جداً. وذلك بالإضافة إلى السعادة العارمة التي كانت تغمرها، وكأنما تحررت من هموم ومصاعب السنين. وصار الابتسام والضحك لا يفارقانها. إلى أن فوجئ ذات صباح أنها ماتت؛ ماتت وعلى وجهها ابتسامة عريضة رائعة.
وصل خالد لمكتب المحاماة، وتصنع البكاء والحزن، منتظراً أن ينال حظاً وافراً من الوصية التي تركتها خالته؛ لأنه تقريباً لن ينل شيئاً يذكر من الميراث الشرعي. وحلم أن تكتب له خالته بجانب الشقة مبلغاً سخياً من المال يساعده على فتح مكتب الاستشارات الهندسية الذي يحلم به. وعند دخوله مكتب المحامي خالته، فوجئ بوجود العديد من الأقارب، الطامعين أيضاً في ميراث تلك العجوز الثرية التي حرمها الزمن من الأبناء. دخل المحامي الغرفة بكل جدية، وسلم على الحضور بحرارة وود، ثم أكد أنه جمعهم هكذا بناء على وصية تركتها المرحومة وشددت على تواجد أقاربها الأعزاء أجمعين. وبالرغم من تكدس الأقارب في غرفة المحامي، لم تحظى جنازة العجوز إلا بثلاث من هؤلاء الأقارب الذين أتوا مهرولين والأمل يغمر كل منهم أن العجوز الشمطاء قد جنبت له مبلغاً إضافياً من مالها الذي لا يعد ولا يحصى. تناول المحامي مظروفاً أخضر اللون من درج مكتبه. ثم، فتحه مشيراً أنه يحتوي على رسالة توجهها السيدة “بهيرة” لأقاربها الأعزاء. تلى المحامي الخطاب على مسمع الجميع، وبعد مقدمة قصيرة أكدت فيها السيدة “بهيرة” أن عمرها الطويل وخبراتها المتراكمة بشئون الحياة جعلتها تعي كيف تقدر ما سبغه الله عليها من نعم، وإحدى تلك النعم تيقنها من عدم صدق مشاعر أي منهم تجاهها. وعلى ذلك، عمدت إلى التخلص من ثروتها في السنوات الأخيرة من عمرها، جزء تلو الآخر في شكل تبرعات للجمعيات الخيرية. وأما شقتها، فلقد باعتها بعد موت زوجها منذ ثلاثة أعوام ماضية، مع الاشتراط بالاحتفاظ بحق الانتفاع بها إلى أن يحين أجلها. وفي نهاية الخطاب، أكدت أنها تشكر الجميع على جهودهم الزائفة لإسعادها، وأنها كانت تعلم أن من كان يشتري لها طلباتها الشخصة من غذاء ودواء كان يأخذ ثمنه أضعاف ظناً منه أنها لم تعد تدري ما يدور في العالم من مستجدات. وأما الطعام الراقي المبالغ فيه الذي اكتظ به مبردها، لم تكن تطال منه إلا دفع فواتيره، وفواتير خدمات من يزورها للتمتع بكل ما تملكه.
نزلت الكلمات كالصاعقة على الحضور، وانصرفوا واحداً تلو الآخر. وازداد حنق “خالد” عندما تيقن أن الجزء الأخير من الخطاب في أغلب الظن كان موجهاً له وحده. وبينما كان ينصرف الحضور، لاحظ وجود سيدة أربعينية تظهر عليها إمارات الثراء، وقد أخذت تسب وتلعن في العجوز الماكرة. فاقترب منها وهو يضبط الكمامة على وجهه، ويعرض عليها أخرى نظيفة بدلاً من الكمامة التي مزقتها عندما ضاق صدرها. وقدم لها نفسه، وعرفها أن اسمه “خالد”. وفي ثوان معدودة، علم أنها إحدى أقارب زوج خالته “بهيرة” التي كانت الأخيرة تدأب على مهاتفتها سراً عند الاحتياج لإنجاز مهمة صعبة بعيداً عن عيون أقاربها الطامعين في أموالها. ولقد وعدتها الراحلة بمبلغ مالي ضخم لقاء تسهيل تبرعاتها للجمعيات الخيرية. وأن ما يثير حنقها هو التلاعب بمشاعرها، وليس فقط فقدانها للمبلغ المالي الضخم. فلقد كانت تنتظر ولو حتى كلمة شكر، بدلاً من نكران الجميل.
أخذ “خالد” يواسيها، وتحولت مواساته لملاطفة بعد أن علم أنها أرملة وحيدة، ورثت عن زوجها أموال وعقارات، ودائمة السفر للدول الأوروبية للاستجمام والاستمتاع. عندما شعر تيقن “خالد” أنه قد حرك مشاعرها، وأنها أظهرت ميل له، تبادلا أرقام الهواتف النقالة على أمل اللقاء في وقت آخر. لكنه لم يلبث وأن أقنعها بتناول وجبة الغذاء سوياً. لكنها أصرت أن يكون على حسابها. وبعد نظرة عميقة، لامس يدها برقة وهو يأخذ مفاتيح سيارتها، ويخبرها أنه يعلم مطعم فاخر سوف يستمتعان بالجلوس فيه. ركبا السيارة، وتبادلا الابتسام، والنظرات الخبيرة. ولم تمانع وهو يضمها إليه، فوضعت رأسها على كتفه، وهي تحلم به زوجاً، بينما كان يرسم الخطط ليستولي على سيارتها الكرايسلر، وفيلتها في التجمع الخامس.