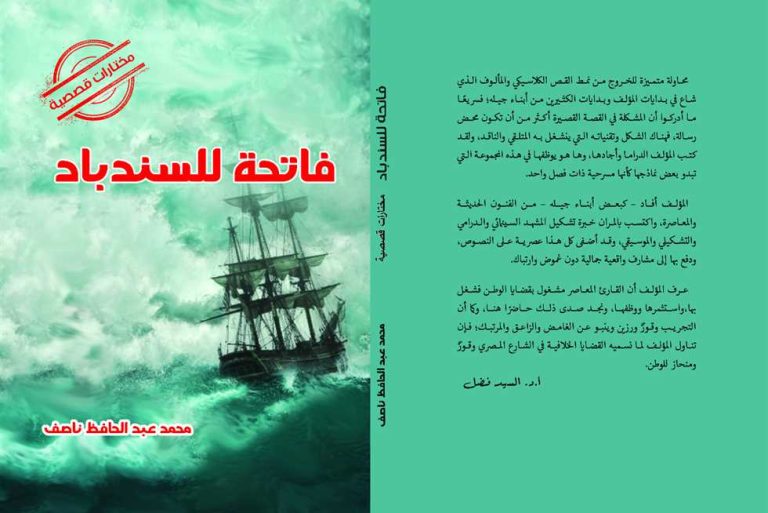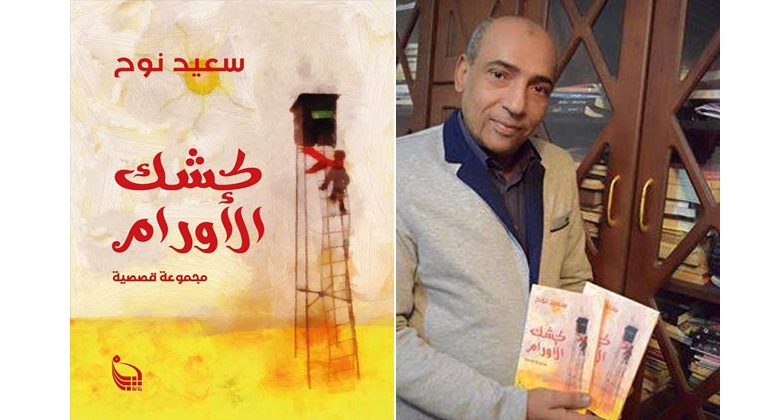“باب الليل” أبوابٌ؛ كلّ واحد منها ينفتح على جزيرة، وكلّ جزيرة تُسلِّمك إلى امرأة، وكلّ امرأة تدعوك إلى حكايتها، وكلُّ حكاية ماكينةُ إدْهاشٍ وَقُودُها المالُ والجنسُ والبوليسُ والسياسةُ، وهديرُها الخيانةُ والجنونُ والنضالُ والتيهُ. يدعوك الراوي إلى مقهى “لَمّة الأحباب” بحيّ النّصر، وهو أشهر الأحياء الجديدة بتونس العاصمة، ويلوذ بضيق المقهى سبيلا إلى اتساع عمارة التخييل التي تبنيها معه بمزاجٍ “مصريٍّ” حكايةً حكايةً، ومشهَدًا مشهَدًا، وجسدًا جسدًا، بل قُلْ: وشهوةً شهوةً. يفعل ذلك وكأنه يعدّ لك طبقا وصفيًّا يغريك بلذاذة وَصْفِه ومَوْصوفه معا.
ولأنّ مقهى “لَمّة الأحباب” فضاءٌ تشاركيٌّ واعترافيٌّ بامتياز، فيه يتشارك الجلّاسُ في سماعِ الأغنية نفسها، واستنشاقِ دخان السجائر نفسه، وتبادلِ النوايا والنمائم نفسها، واستعمالِ الحمّام نفسه، واشتهاءِ المرأة الجميلة نفسها، وممارسة الخيانة نفسها، وفيه يعترفون بخوفهم من جاسوس الدولة نفسه، وبعدم اطمئنانهم للآتي المظلم نفسه، فإنّ عدوى المشاركة ستصيبُك أيضا وتجعلك تشارك الراوي في الترحّل من طاولة إلى أخرى، ومن حكاية إلى غيرها، إلى أن تنتهي أبواب الرواية الخمسة عشر دون أن تُهدّئَ فيك ثورةَ أسئلتك التي ستظلّ تكثِّفُ وعيَك بمرارة تهافُتِ قيمة الجسد وأخلاقياته أمام تعاظم قيمة المال، وتجرح من حواليك حقيقةَ عنف دولةِ البوليس، وتكشف لك عن حتمية النهايات المأسوية للمناضلين الحقيقيّين على غرار مناضلي القضية الفلسطينية التي تحضر في الرواية حضور الاستعارة المُحيلة على واقع الوطن العربيّ الذي تتعاوره سهام الضياع والتبعية والتخلّف والتطاحن العابث على السلطة.
ستتنبّه في “باب البنات” إلى وجود سُوقٍ سوداء لبيع اللذّة وفتنة الحكايات، فلكلّ جسد بالمقهى حكايته وخسارتُه، ولكلّ واحد من جُلاّسه مغامرة يبحث عن واحدة ليحكيها لها، و”كلّ شيء يحدث في الحمّام، حمّام المقهى طبعا. تتحرّك البنات صوبه واحدة واحدة أو اثنتيْن اثنتيْن، في الغالب اثنتيْن، خلفهنّ بمسافة معقولة رَجُل أو اثنان، يلِجون بابَه بدفعة ناعمة لا تحدث صريرا”. وهناك يتمّ تبادل أرقام الهواتف للتفاوض وتحديد مواعيد التسليم والتسلّم أو ما يجوز معه استعمال المصطلح التجاري “الدَّفْعُ والرفعُ”، يحدث ذلك تحت مراقبة خفيّة من “دُرّة” صاحبة المقهى وسيّدة الشبق فيه، والفقيهة في طرائق ترويض الرجال، والماسكة بجميع حبال المغامرات العشقيّة، حيث تُوجّه حركةَ أبطالها صوب تحقيق أهدافٍ لها ترسمها بمكرٍ مدهونٍ “بابتسامة طريّة ساحرة، كأنما أخرجتها للتوّ من جراب روحها” وهي في ذلك كلّه “تبحث عن النّقود، وأحيانا عن النفوذ، وفوق كلّ ذلك تستمتع بأنّها نجمة، تزهو بأنها السيّدة الأولى على حفنة كبيرة من راغبي المتعة والقرب”.
ولمّا تشتدّ فيك حيرتُك من سهولة الحبّ ويُسرِ تبادُله بين زبائن المقهى، أو هكذا سيبدو لك الأمر، يقرّبُك الراوي من “نعيمة”، تلك المرأة التي نزحت شابّةً إلى العاصمة وعملت نادلةً وظلّت “تشاهد ما يجري دون أن تشارك سوى بالضحك الخفيف، كان يكفيها أن تنقل رقم هاتف من زبون لزبونة، وتحاول أن تزيد في إيرادها كي تكفي مؤونة العيش. في البداية كانت تخشى أن تخلع سروالها، كُلُّه على النَّاشف وتعود لحجرتها، لكنها بعدما جرفها التيار وتعرفت على ماء الآخرين ونقودهم صارت تنساه في مكان قد لا تعود إليه”. ستصارحك نعيمة بأنْ “لا غرام في هذه المدينة، بل لا غرام في هذه الدنيا، الفلوس، الفلوس فقط”، وذلك لأنّ “مخ التونسيّ هكذا، لو فتحوه لن يجدوا خلايا وأعصابا، سيجدونه محشوًّا بأوراق نقديّة من كلّ الأنواع والألوان، وإن لم يجدوها فسيجدون صُورا ضوئيّة منها”. وستُذَكّرك بحقيقة مُرّةٍ صورتُها أن فتيات مقهى “لمّة الأحباب” إنما هنّ “كسروال العساكر، يخلعه جنديّ مجهول لا تعرفه، ليلبسه جنديّ مجهول آخر لا تعرفه”، وستحدّثك عن حيرتها من عدم معرفة مصير أخيها الذي هاجر إلى ألمانيا وانقطعت عنها أخباره، وعن ألمها من خيانة أختها لها لمّا افتكّت لها عشيقها الإيطاليّ رغم قناعتها بأن “الأجنبيّ في النقود أفضل، وابن البلد في الفِراش أفضل، والثأر مطلوبٌ”.
من “باب البنات” تلجُ أبواب الرواية الأخرى: باب الفتح، باب الهوى، باب الأقواس، باب العسل، باب الملكة، باب النحل، باب الوجع، باب الجسد، باب الريح، باب النار، باب البحر، باب الرجال، باب النساء، باب للّا دُرّة. وستتعرّف في كلّ واحد منها حكايةَ واحدة من الزبونات: حلّومة ورحمة وحبيبة وباربي وألفة وزعيمتهن “درّة” مالكةُ المقهى ومَلِكتُه. وهي حكايات تفيض فيها الأجساد بغلالِها ويتنامى حولها نُباح رغائب الرجال، وتمتزج فيها لذّة الذكور بمكر الإناث، وقوّة المال بسياسة الجسد، ومفهوم الحرّية بهيمنة السلطة، وماضي النضال بحاضر التيه. ولا تني تفاصيل كلّ هذه الحكايات تذكّرك بحقيقة أن بيع المرأة لجسدها ليس طبيعة فيها وإنما هو نتيجة ظروف اجتماعية وسياسية عنيفة غالبا ما تُجبر الشابّة على عرض جسدها أمام مَن تحدس أنّ لديهم المال لضمان قوت يومها. وعلى فساد واقع المرأة التونسية الذي تحرص الرواية على كشف ما تعانيه فيه من هوان وابتذال لم تنفع في الحدّ منهما مقولةُ “تحرير المرأة” التي عمل الرئيس بورقيبة على تنزيلها منزلةَ الواقع في ثقافة المجتمع التونسي، يحملك الراوي إلى طاولة حكايات أخرى، حكايات المناضلين الفلسطينيّين الذين رفضت إسرائيل عودتَهم بعد معاهدة أوسلو، و”لم يجدوا أسماءهم في كشوف السلطة الفلسطينية. وفي القوائم الإسرائيلية كانوا وما زالوا، ممنوعين من العودة، أياديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين، وأرواحهم ملعونة أيضًا، وعليهم إن تنفسوا أن يفعلوا ذلك في مكان آخر يستحسن أن يكون قبرًا سحيقًا في جوف الأرض”. ومن هؤلاء “أبو شندي” الذي اغتالوا زوجتَه اللبنانية “أم زينة” بتفجير سيارتها خلال وجوده بلبنان، ثم انتقل إلى أوروبا “يُطارد الذين طاردوا أهله وأخرجوهم من ديارهم” باستخدام نادٍ للعاهرات مكانا يخطّط فيه لعملياته لأنه يرى أن “كلّ شيء يحتاج للمومسات حتى الثورة”، و”شادي” الشاعر السوري الذي تنقّل بين كثير من الأسماء خوفا من الوقوع في مصيدة المخابرات الإسرائيلية، بل هو يبدّلها “أسرع من تبديل ملابسه” وظلّ “طوال مدة نضاله في الثورة الفلسطينية متنقلًا بين المنافي بعشرات جوازات السفر”، و”فاروق جعفر” الثوري الفلسطيني الذي أحبّ عراق صدّام حسين وهرب منه بعد الغزو ولا يعلم شيئا عن مصير عائلته، وخميس بريجنيف الذي “لم يستطع أن يصبغ سنوات النضال بطابعه فصبغ شَعرَه على سبيل التعويض”. وأمام تصحُّرِ أحلام هؤلاء في العودة إلى فلسطين أو إلى إحدى البلدان المجاورة لها، لاذوا بمقهى “لمّة الأحباب” وراحوا يتعلّقون فيه بحبال أوجاعهم ليجترّوا مرارة تاريخِ نضالاتهم، وفصولَ غدر العالَم بثورتهم، ونسيانَ القيادة الفلسطينية لهم ولسان حالهم يردّد: “أصبحنا بقايا، الحكاية كلّها بقايا، بقايا نضال، وبقايا حياة”. تسمعهم يتحدّثون بذلك همسا خفيفا خوفا من آذان مخبري أمن الدولة الذين يرتادون المقهى وتربطهم بصاحبته “درّة” علاقات خاصّة تستفيد منها في قضاء حوائجها وحوائج زبائنها المستعصية، وتفيدهم عبرها بأسرار أهل السرّ من رجال الأعمال والساسة والأجانب.
وفي “باب الليل” ستقف على حقيقة روائية مهمة صورتُها أن السرد العربي يمكن أن يكون جميلا في انصبابه على معيش الناس دون كبيرِ تعلُّقٍ منه بالرمزيات الكبرى التي لم تعد تُثير انتباهَ مُواطنٍ مكدودٍ ومشدودٍ إلى رمزياته الصغرى كجوعه إلى الجسد، وعبادته للمال، وكرهه للسلطة، وسعيه إلى رتق تمزّقات أحلامه البسيطة المنكسرة. كما يمكن أن يكون جميلا في سلاسةِ انسيابه الحكائي دونما وقوعٌ منه في تعقيدات التجريب الفنيّ ومطبّاته التي نلفي لها حضورا جليا في مروياتنا العربية المعاصرة. ويمكن أيضا أن يكون جميلا في صفاء لغته وهي تغرف رَواءَ معانيها من مَعين الأمثالِ الشعبية وحرارة لهجات الناس ومكر استعاراتهم فيها. وهي أمور من السّردِ نجحت رواية “باب الليل” في استثمارها خلال مغامرتها الحكائيّة استثمارا واعيا بشروط اللحظة والقارئ والمقروء، حتى لتخال كلّ جملة من الرواية طبقا لذيذا لا تميّز فيه بين الوصف والموصوف، لا بل إنّك سترى موصوفات الراوي تحوم حولكَ بكلّ ما فيها من تفاصيل، فتسمّيها وأنتَ تعبُر الشارع: هذه درّة، وتلك نعيمة، والتي خلفها ألفة، وذاك “سي المنجي” المُخبر الأمني الذي كلّفته الدولة بأن يؤمّ المصلّين بالجامع، إنه ما زال يراقبنا جميعا رغم إحالته على المعاش.