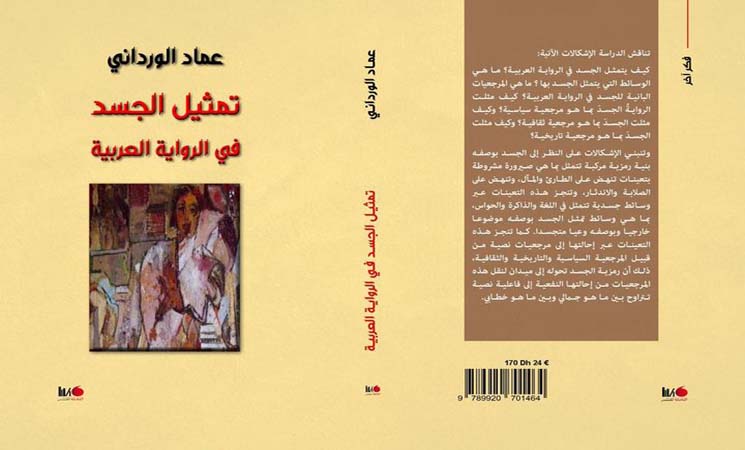جمال القصاص
تراهن مي التلمساني في أعمالها القصصية والروائية على الكتابة، ليس بوصفها تيمة أو نمطاً أو وسيطاً بين الكاتب والعالم، وإنما متعة، يمكن العيش والاختباء فيها واللعب والتنزه تحت ظلالها وممارسة أسمي الحيوات الإنسانية.. إنها متعة، تنحل فيها العقد والفواصل السميكة في الزمن والبشر والأشياء، مفتوحة بحيوية على الواقعي والغرائبي والفانتازي والمهمَّش والأسطوري واليومي، سواء في فضاء الذات الخاص، أو في الوضعيات المحيطة بها، عبر واقعها المعيش.
من السمات اللافتة في هذه الكتابة أننا أمام ذات مبدعة تبدو بمثابة مخزن للصور، تعيد تكبيرها وتصغيرها، وتظليلها، بل تهشيرها أحيانا، لتكتشف نفسها من جديد، ربما في نقطة أقرب أو أبعد أو مبهمة، نقطة تختزل العالم داخلها كإمكانية للتحرر والانعتاق، من سطوة المواضعات التقليدية في الكتابة نفسها، ومن سطوة الصورة أيضا؛ كما أن هذه الذات تحرص دائما على ألا تكرِّر نفسها في حزمة من الأسئلة والأفكار والرؤى، ثم أنها ليست في سباق مع الآخر، فهي تعرف طرقا عديدة لاحتوائه، واللحظة المناسبة التي يمكن أن تفتح له الباب، ليصبح عنصرا فاعلا في الكتابة، يأخذ منها ويضيف لها، بكل سلبياته وايجابياته. لذلك ليس ثمة سباق زمني مع الآخر، إنما السباق الجوهري هو ما تمارسه الذات مع نفسها، من أجل الوصول إلى هذه المتعة.
تكتب مي تفاصيل عوالم تعرفها، عاشتها وتماست معها، واختلفت وتمردت عليها، لكن ليس إلى حد القطيعة التي تعني العدم، وإنما من قبيل التنوع في الإدراك والرؤية، ما يمنح كتابتها رحابة فنية، يحضر فيها الهم الإنساني بضعفه وقوته وهشاشته، ولا يغيب.
تكتب عن الطفولة والأحلام والذكريات، عن الوطن والعائلة والأصدقاء، عن الأمكنة والأزمنة، باعتبارها بيت النص الحميم، تكتب عن الفراغ والرغبات المقموعة المحرَّمة، ومواجهة الموت في أقسى أقنعته إيلاما فوق سرير الأمومة.
تذهب مي التلمساني إلى نصها مسلحة بكل هذا، لكن لا بأس أن يوقعها النص في شباك أسلحة أخرى، لتجرب وتوسع من فضاء المغامرة، بحثا عن هذه المتعة، عن البصمة التي تمنح نصها علامة خاصة، تحفز قارئها على التعاطي معه بمحبة خالصة.
فمن تفاصيل عالم أدركته، تنسج هذه الأحلام والذكريات بأناقة مخيلة ولغة سردية شيقة، تشدك إلى ما هو أبعد مما تعنيه، لترى نفسك من زوايا عدة في مرايا النص. حتى أنه يمكنك التحدث مع الشخوص، وتتخيل أنكم تقومون بلعبة تطهير عظيمة، لطرد الأرواح الشريرة من المكان، لتخلص اللعبة إلى نفسها بعيدا عن الطاعة الأرضية وسلوكياتها الأخلاقية العمياء، والبحث عن صيغة أخرى ملائمة للحياة والحلم، قد يشير إليها النص في جملة خاطفة، أو يتركها كامنة وراء رمز ما، أو علامة حائرة أشبه بالنقش الغائر في جدار النص نفسه.
هكذا أتعامل مع نصوص مي التلمساني، أتفق وأختلف معها أحيانا، لكن في كل الأحوال أظل مشدودا لخصوصيتها ورهافتها، وأحس أنها تحرضني على امتلاك حاسة أخرى للتلقي، تتجاوز الأمكنة والأزمنة، ولعبة الضمائر الرخوة، حيث يصبح القص حالة إنسانية متشابكة الرؤى والأبعاد، يصبح فعل وجود وحياة، يمارس انزياحاته بقوة النص والواقع الذي لا يكف عن الحركة في داخل الذات الساردة، وكأنه أنثى على وشك أن تضع مولودها الأول.
قد يكون من البديهي هنا، أن ترتبط هذه المتعة وهذه الخصوصية بفكرة الشخصية، وطبيعتها المتفردة المستقلة، لذلك أحسب أن هذه الفكرة من الأشياء المهمة لدى مي التلمساني، فهي كاتبة لها شخصية، تتمتع بحضور خاص، داخل النص وخارجه، وقبل كل شيء داخل جيلها الأدبي التي تنتمي إليه، ولو من قبيل التصنيف النقدي.
الأمر المدهش أن هذه الطبيعة الخاصة المتفردة ليست منفصلة عن عوالم مي الروائية والقصصية، بل تشكل ركيزة أساسية في بحثها عن شخوصها وطريقة بنائهم والتعامل معهم داخل النصوص، وتسليط الضوء والظلال على هواجسهم ورؤاهم وصراعاتهم الداخلية الدفينة، في لحظات البوح الحميمة، ولحظات اشتباكاتهم مع الواقع والعالم.
تنهض هذه الطبيعة الخاصة على فكرة التمرد، فكل كائن يملك نوازع دفينة للتمرد في داخله؛ التمرد على ذاته وواقعه ونمط حياته المؤطرة المستلبة، حتى أن مهمة النص في الكثير من الأحيان، تصبح تعرية قشرة هذا التمرد، وجعله شاخصا في انساق السرد والتفاصيل، بالرغم من التمويه أحيانا على فعل الحكي، وتسريبه من وراء حائط أو ستار أو قناع، تماما مثلما فعلت “ميكي”، واختارت الحكي من وراء قناع “الماريونت” في روايتها الأولى “هليوبوليس”، لتوفر للعبة الروائية مساقطَ وأصابعَ غير مرئية، تشد خيوط السرد وتدفع الشخوص بتلقائية شديدة إلى ذروتها دراميا، وكأنها تلخيص لجذرية أحلامنا وأفكارنا المتناثرة فوق سطح الحياة.. هليوبوليس رواية المكان، لا تصعد إلى هذه الذروة باعتبارها عقدا فريدا انفرط من رقبة الطبقة المتوسطة التي تمثلها العائلة، وإنما باعتبارها مخزنا للصور، تتلاقح في ظلالها مشاهد الطفولة بالصبا، ببدايات التكوين، وتلمُّس حبر الكتابة، وكأنه الشهوة الأولى لملامسة الوجود.. نستطيع أن نحس نبض شوارع مصر الجديدة، بسمتها المعماري المميز، ونتذكر محلاتها ومكتباتها ومقاهيها، وقصورها المغمورة في ملح الخرافة، وكأنها صورة مصغرة لملامح وطن تخذله السياسة دائما.
هذه الصور التي وثقت للمكان بروائحه ومفرداته من اللون والملبس والأكل والشراب والعادات والتقاليد، عبر محيط العائلة والواقع في “هليوبوليس”، تطالعنا من منظور متغير في روايته الثالثة “أكابيلا”، حيث تعود “ميكي” إلى مسرح الأحداث، مستبدلة بقناع الماريونت قناعَ “ماهي” الاسم التي وسمت به نفسها في الرواية، وخلف كينونته تمارس لعبة الإخفاء من جديد، إخفاء رغباتها المشبوبة في التحرر والتمرد على التقاليد التي تفرضها عليها حياتها النمطية كزوجة، إخفاء نوازع القوة والضعف والتستر عليها بنزعة عقلانية، ترى الحياة دائما في معقوليتها ورشدها السوي.. بينما في الصورة تقبع صديقتها “عايدة” الفتاة المتحررة التي تعيش رغباتها وحيواتها وتستمتع بالحياة بكل تفاصيلها، بشكل مطلق إلى حد الهوس والجنون، والتي تصفها “ماهي” قائلة: “اليوم أتأملها بعين الخيال، فلا أكاد أصدق أن هذه الفتاة النحيلة التي تعشق الأوبرا وتتحدث الإنجليزية بطلاقة هي ابنة قرية في الجنوب لا يظهر اسمها على الخرائط”.. وبينما يتم التموية على ماهية المكان في الرواية، فلا نستطيع أن نقف على ملامح محددة له وواضحة جغرافيا، اللهم بعض التخمينات عن مدينة ما، تومض بشكل خاطف في ثنايا السرد، وفي ظل صراع مشدود أكثر إلى الداخل، تتناثر حكايات شخوصه على حافة لحن يوهم بأنه عمل جماعي لجوقة من الأصدقاء، وعلى عكس ما تقتضي أدبيات الأكابيلا، كونها تراتيل دينية جماعية لا تصاحبها الموسيقى، نجد أن كل شخص يعزف اللحن وينخرط فيه وفقا لحدود وقيود، تتفق مع أهوائه ورغباته وعالمه الخاص، إلا “عايدة” البطلة المركزية للرواية، فهي تمثل الاستثناء الوحيد من كل هذه الدائرة النمطية وما يعتورها من تنقاضات ومفارقات، لذلك تدركك “ماهي” أن ما يربطها بهذه الصحبة (الشلة) مرهون بها لا أكثر ولا أقل، وأنها لا تنظر إلي عايدة كمجرد صديقة تعيش حياة متقلبة منفلتة من كل أسوار الوعي واللاوعي، بل تنظر إليها كمثال لزمنها الهارب، يصلح للاختباء خلفه والاحتماء به كتعويذة ضد الموت والزمن.
ومن ثم، فعمق الصورة لا يكمن في تفاصيل وروتوش عابرة، تعْلَق في مساقط النور والعتمة لأشياء تلتقي وتفترق، ثم تعود، إنه عمق الزمن وجوديا، تشكله إرادتان، تتفاوتان في أقصى لحظات الهشاشة والقوة إنسانيا، يمثل طرفها الأقوى عايدة التي تعيش الأشياء وتعتصر أقصى ما فيها من ألم ولذة بحرية، بينما “ماهي” طرفها الآخر الهش، تقبع على رصيف الانتظار، تترقب الأشياء وكأنها على وشك الحدوث.
يخلِّص موت “عايدة” المباغت “ماهي” من عقده هذه “الوشكية”، كما يخلِّص الصورة من حبسة الإطار، ويمنحها عمقا أكبر في مرآة النص والوجود؛ حيت تتقمص ماهي صورة صديقتها/ مثالها الحميم؛ تعيش في مسكنها، وتقيم لها معرضا لرسوماتها وأشعارها. وتعدِّل في دفتر يومياتها ليتوافق مع إيقاع الحياة الجديدة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل يلعب الموت ولو ضمنيا، أو بالمصادفة، أو على سبيل المجاز والتخييل دور المخلِّص، صانعا مأزقه الدرامي الخاص، وهل ثمة حضور له في إبداعات مي السابقة؟.
إن فكرة الاختباء في النص والاحتماء به كوجود بديل، تصلح برأيي كإجابة دالة عن هذا السؤال، فما الذي يملكه الكاتب، في مواجهة شرور العالم وآثامه، وموت القيمة والمعنى والحب سوى ذلك.
لقد عاشت مي التلمساني فعل الموت عن قرب، ولم يكن الأمر لعبة أو دالا رمزيا في حكاية ما، بل حياة استلبت منها فجأة، لتستيقظ من حمى المخدر فوق سرير الولادة بالمشفى على خبر فقدها لطفلتها الوليدة في روايتها الأولى “دنيا زاد”.
تقول مي وهي تتذكر هذه الواقعة المفجعة موجهة خطابها ضمنيا إلى الآخر القارئ: “ليس من السهل أن تخرج من مأزق التفكير اليومي في الموت، دون أن تفقد بعض ذرات من وجودك الملموس، قد تتساقط خصلات شعرك، في هدوء الأيام التالية، وقد تظل في الليل مفتوح العينين على الأرق، وقد تقضم أظافرك عن آخرها وأنت تقرأ جريدة الصباح”.. ثم يصل الخطاب إلى ما يشبه الحكمة أو المرثية المطمئنة، حيث تتابع قائلة، على سبيل الاستدراك والإشارة المنبهة وفي بوح تمتزج فيه بصيرة الشعر والسرد معا : “لكنك تعرف الآن جيدا لعبة الموت. فلا تراوغ، ولا تندفع ثانية فوق الملاءة البيضاء، التي ترفعك إلى قمم الأشجار، وتلتقطك ثانية زائغ البصر. فقط أنظر في مرآة الحمام إلى شحوبك الجميل. وتذكر أنك لا زلت تحيا”.
إنها ربكة وجود انحرف عن مساره الطبيعي، ولا سبيل أمام الذات الساردة، الذات الكاتبة لتجاوز ذلك سوى الاختباء بالنص كملاذ آمن، فيه يمكن أن تعيد ترتيب المشهد من جديد، يمكن أن تنصت بقوة وبلا حواجز إلى أصوات كلِّ الضمائر الغائبة والمستترة والمنسية والمهمَّشة، أمس واليوم وغدا، ناهيك عن الإنصات لنفسك.
تحية لمي التلمساني، مبدعة متميزة، وصديقة عزيزة تتفجر نبلا وعطاء.