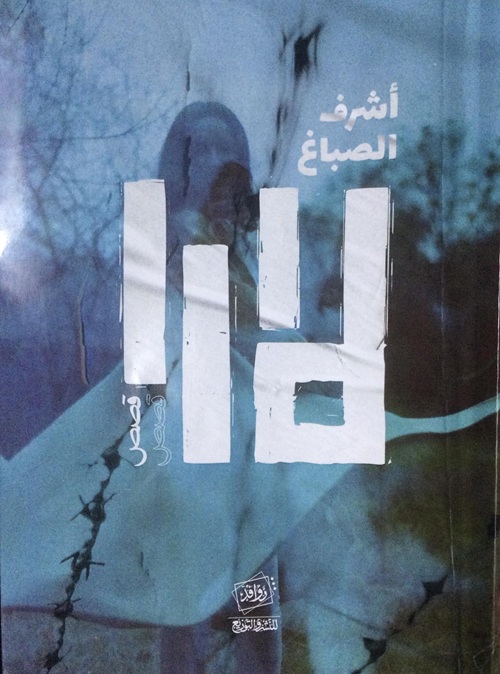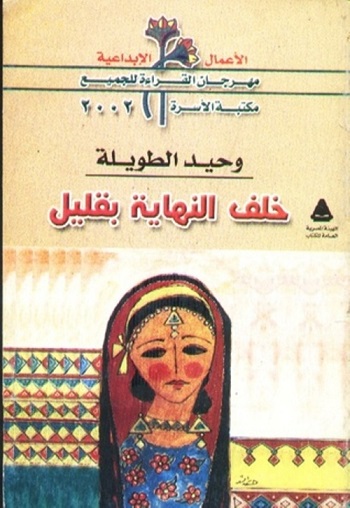حسني حسن
وقف على غُسله، ساهماً وذاهلاً، عن حقيقة ما يراه أمامه. كان صديقه ممدداً عارياً، من الصدر حتى الخصر، الذي وارى القائم على الغسل سوأته بملاءة قطنية بيضاء. راح يحدق في وجهه الشمعي المزرّق، وعينيه المغلقتين بجفنين مثقلين، ربما، بحلم لا لون له، وفكيه المطبقين والمعصوبين برباط، مشدود، من الشاش. دقائق ظل المغسِّل يُقلّب فيها الجثمان، إلى الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ويرشرش الماء عليه من خرطوم بلاستيكي موصول بصنبور غرفة الموتى. بلغه صوته أخيراً:
– فليدخل أهله لإلقاء نظرة الوداع.
وجدها فرصة للهرب، إلى الخارج، ليأخذ نفساً، استشعره محبوساً في صدره طويلا. تسلل قاصداً نور الشمس وظل الشجرة القريبة، ووقف ينفث دخان سيجارته، مفتشاً عن دمعة لم تبلل مقلتيه.
من أي مادةٍ، تُرى، تُصَاغ الأحلام والهواجس والانتظارات؟ أمن مادة الأمل؟ أم من مادة الخوف؟ وكيف يقدر الإنسان على حمل كل ذلك الوجود، الثقيل الهش والمُتخَم بالرؤى الملحية العذبة في محيط الروح وأوقيانوس القلب، يوماً بعد يوم، وأبداً وراء الأبد؟ وهل من معنى لذلك أصلا؟ أم أن الأمر لا يتجاوز كونه مجرد حلم آخر، يسري مسرى حقيقة نهارية مخاتلة، في قيلولة وجود منهك آخر؟ حلم يغتذي بحلم، يخترقه، يتلبسه، ويفيض عليه! في زيارته ما قبل الأخيرة له، بمعهد الكبد بشبين الكوم ، أدرك أن النهاية قد اقتربت جداً، لكنه خادع إدراكه وخادعه . همس مغتصباً ابتسامة:
– تريد أن تعرف غلاوتك عندنا، وحسب.
– لا ، فقط تعبت، وضجرت.
– الطبيب يقول إنك ستخرج بعد أيام، وإنك بحاجة لفترة نقاهة في مكان منعش، فلنذهب إلى الإسكندرية .
– يكذب، أعلم أنه يكذب.
لثلاث وثلاثين سنة، لم يسمع منها، ولا عنها. كانت كحلمٍ عبر سماء شبابه ومراهقته ليحرمه النوم واليقظة لبضعة أشهر، قبل أن يضيع، ويسقط، في جب النسيان!
– غير معقول!
كتبت تقول، على صفحته على الفيس بوك، بمجرد قبوله طلب الصداقة الذي أرسلته.
– لم أصدق نفسي، ظننت أني لن أعثر عليك أبداً، لكن هذا أنتَ، أخيراً!
– هذه أنتِ، أخيراً!
اندفعت تسأله عن أحواله، وعما فعلت تلك الأعوام، الثلاثة والثلاثون، به منذ غادرا الجامعة، وفي نفس الوقت، تحكي له، بعجلة وتشوش، وبأنفاس مبهورة، أبرز محطاتها الشخصية في العالم، طوال ثلاث وثلاثين سنة. روت له عن زيجتها الفاشلة، وعن طليقها الذي سلبها صديقتها المقربة وتحويشة عمرها في الغربة معاً، وعن ابنها الذي صار كل حياتها الآن.
– لا أفهم، ولكن هل في الكنيسة، عندكم، طلاق؟
ضحكت، وهي تُجيب:
– معك حق، لكني لست في الكنيسة عندنا، أنا مهاجرة إلى كندا منذ عقدين.
– يعني ركبتِ آلة الزمن، ورحلتِ إلى المستقبل!
– شيء بهذا المعنى.
ردت بغموض.
يفكر، دوماً، أن لا شيء في الوجود يفوق، في عذوبته وعذابه، اندياح الزمن. آمن، باستمرار، أنه، في حقيقة الأمر، لا يحيا لا هناك ولا هنا، لا في هذا المكان ولا في ذاك، وإنما يحيا، وحسب، في السيرورة. منذ طفولته الباكرة وهو يحلم بالسفر، ليس إلى كندا ولا إلى استراليا، ولا حتى إلى النجوم، بل إلى نهاية الزمان ومبتدئه. لم يكن قد قرأ شيئاً، بعد، عن نسبية “اينشتاين” الزمكانية، وحتى لما قرأ شروحاً تبسيطية لها، فيما بعد، لم يفهم منها الكثير، وبالرغم من ذلك، أسّر لنفسه، فرحاً، أن هذا الرجل الشهير كان، بعد كل شيء، يُشاطره حلمه الصبياني، ويسعى لتأسيسه، علمياً، لإقناع الناس بواقعيته ومعقوليته. لا يعيش العلماء في أحلامهم فقط ، وإنما يعيشون بأحلامهم، ولها.
– لكن، ما الذي يعذبك كل هذا العذاب؟ لماذا لا تؤمن، وتستريح؟
– أنا مؤمن.
– من أيام الجامعة، الكل يعرف، كلنا ، وسامحني للقول، إنك شيوعي.
المصيبة الكبيرة أن هذا الكل، كلهم، لا يعرف أنه لا يعرف. والمصيبة الأكبر أنهم لا يحترمون، في قرارة أنفسهم، المعرفة أصلا!
– ذات مرة، شاهدت فيلماً وثائقياً عن حياة وموت رائد علم الفضاء وهندسة الصواريخ السوفيتية، أو بالأحرى عن حلمه بالطيران مذ كان صبياً، وعن فقده لكل شيء، حتى حياة واحترام ومحبة ولده البكر، بسبب استمساكه بذلك الحلم، العنيد المدمر، الذي أنكره الكل، كلهم، كما تقولين، عليه. في نهاية حياته، أدرك بعض هؤلاء الكل أن الحالم، ربما، كان أكثر واقعية، في حلمه المستقبلي، من الجميع، وتكالبوا على تكريمه، كمثال عظيم للعالم السوفيتي ، لكن ستالين، وهو يكرِّمه، كان يشعر بغصة، هل أقول لكِ لماذا؟
– لماذا؟
– لأن الحالم، بنظر ستالين، وبالتالي بنظر كل أولئك الكل، لم يكن، في نزوعه نحو المستقبل، شيوعياً كفاية!
أخبرته زوجته أن ابنتهما وزوجها والحفيدة سيصلون بيت العائلة على الغداء اليوم، وأن عليه أن يزيد من كميات السمك البلطي والبوري المعتادة، وأن ينتبه للبائع الذي يغشه ويدس له السمكات الميتة وغير الطازجة، وأن يشدد عليه بشوي السمك، جيداً، لأنه، المرة الأخيرة، كانت الأسماك مدماة، وأن وأن … أومأ لها، مستسلماً، وهو يضع سماعة “النوت” في أذنيه، ويشغِّل موسيقى “أوبرا كارمن لبيزيه”. غادر خفيفاً، مبتهجاً بالموسيقى، وبفكرة الجلوس على المقهى المواجه للبحر، والخالي من الرواد في صباح الجمعة، بانتظار انتهاء الصلاة والعودة لاستلام السمك المشوي، كما يفعل كل أسبوع. كان الشيخ أحمد، السلفي، خريج كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، الشاهد على لا سلمية اعتصام، من سمَّاهم، الخوارج في رابعة، الحالم، برغم ذلك، بدولة الإسلام والخلافة، و الذي لا يوفِّر، أبداً، النظر، خلسةً، إلى أية امرأة أو فتاة مارة، يبتسم، باشاً، لسيدة أربعينية غير محجبة، ترتدي بلوزة وجونلة سوداوين، ويحادثها بلطف وهمس مثير:
– كم كيلو يا أم ملاك؟
– كيلو واحد يا شيخ.
– الظاهر عندكم عزومة!
داعب الشيخ أم ملاك التي ابتسمت ابتسامة، بسيطة، جعلت وجهها، الأربعيني، بتقاطيعه الدقيقة اللينة، يشرق بفتنة عابرة، توامضت في عيني القادم، مجللةً بحزنٍ شفيفٍ منسحب.
– منور يا أستاذ، طلباتك.
أمر بما يريد. وفيما انهمك الشيخ بإعداد الطلب، لبث هو، جامداً في وقفته، إلى جوار المرأة الصامتة. أحس بحضورها ثقيلاً وباهظاً على حواسه. وبرغم أنه نجح في كبح رغبته في النظر، مباشرةً، إلى عينيها، فقد استشعر، ملتذاً ومستنكراً، بوجود أنثوي طاغٍ يلفه ويسكره. أدار بصره باتجاه حوض السمك الذي غطست فيه الأسماك بانتظار المصير المحتوم. لمح بلطية، بحجم كف اليد، ظلت تتقافز وتنط بحثاً عن الأكسجين الذائب في الماء، أو ربما محاولِةً استخلاص ما تيسر منه من الهواء. كانت تكافح، بعناد وبآخر نبضة في الخياشيم، من أجل البقاء. شعر بشفقة عميقة تزلزل روحه. همس، كأنما لنفسه:
– مسكينة.
ضحك الشيخ أحمد ضحكة راضية، ومستكفية بذاتها. ردّ:
– قدرها. هي تسبّح ربها بطريقتها. تفترس السمك الصغير، ونفترسها نحن!
أفاق من بحرانه، الرومانسي، على حكمة السماك السلفي. بغتة ، ومن دون سابق إنذار، عاوده إحساس الخطر، الذي يخض الدم العجوز المتخثر في العروق، لمَا رفع بصره ليواجه عيني أم ملاك، المكحولتين، وقد جمدتا على عينيه، الزائغتين، المروعتين بمشهد الحياة والموت. فكّر لنفسه:
– مفترسات. كُلنا، الكل، مفترسات.