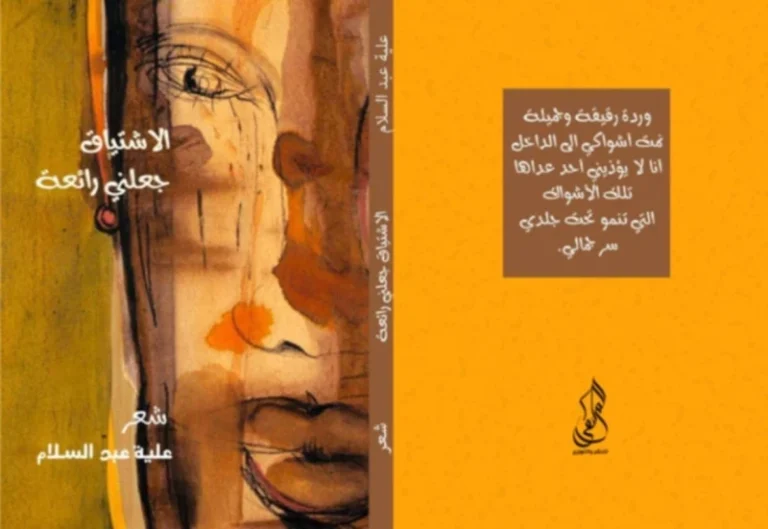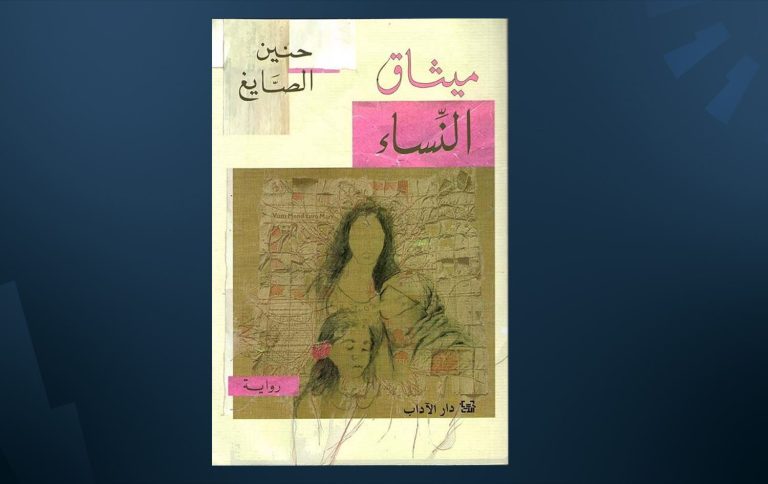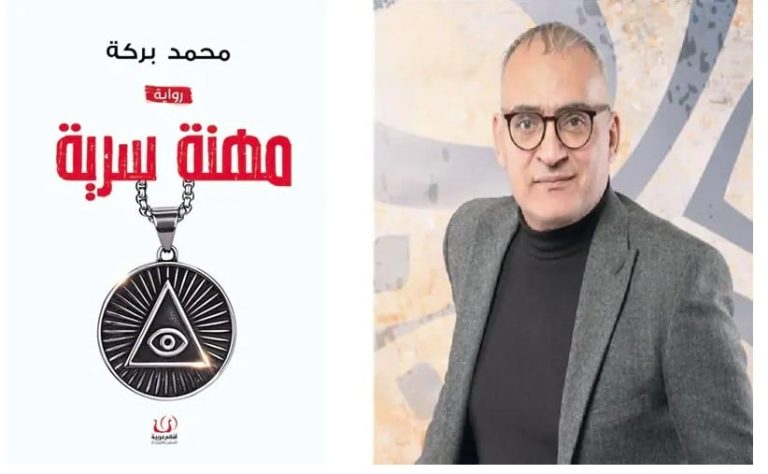د.نيفين مسعد
هذا هو المقال الثالث في سلسلة المقالات التي أخصصها لتحليل الشخصية القبطية في الأدب المصري بعد ٢٠١١ وذلك في محاولة للإجابة علي السؤال التالي: هل اختلف التناول الأدبي للشخصية القبطية بعد ثورة يناير عما قبلها؟ والمدخل لمقال هذا الأسبوع هو مجموعة قصصية بعنوان “ألعاب قد تنتهي إلي ما لا تُحمَد عقباه ” صدرت العام الماضي عن دار ميريت للكاتب حسين عبد العليم.
اخترت هذه المجموعة القصصية كما فعلتُ من قبل في المقالين السابقين، لأنها آخر ما خطّه الكاتب وبالتالي فإنها الأكثر تعبيرا عن تطور فكره بخصوص الموضوع الذي أبحث فيه، وفي حالة حسين عبد العليم تحديداً فإن هذه المجموعة ليست مجرد عمل أخير له بل إنها العمل الأخير له بألف ولام التعريف، فقد ودعّنا عبد العليم “بألعابه التي قد تنتهي إلي ما لا تحمد عقباه” وذهب لخالقه في فبراير ٢٠١٩.
***
فَتَحَت لي المجموعة الأخيرة لحسين عبد العليم النافذة علي أدب له رائحة، بل ورائحة مميزة، رائحة يمتزج فيها عطر المكان: الفيوم مسقط رأسه ومُلهمة الكثير من أعماله، وعطر الزمان: الخمسينيات والستينيات التي تَشَكل فيها وعيه وماضيه فأحبها.. أحبها بزخمها واشتراكيتها ووحدتها المصرية -السورية وناصريتها، فإذا بهذه الفترة تهّف عليه بين الحين والآخر فتقتحم خط سرده التاريخي وتخطفه من الواقع خطفاً حتي إن كان يكتب عن التسعينيات أو حتي الألفية الثالثة، فعنده الماضي يكسب. حاسة الشم عند عبد العليم كانت قوية، حتي أنه أعطي للروائح عنوان اثنين من أعماله المميزة: رائحة النعناع عام ٢٠٠٠ والروائح المراوغة عام ٢٠١٥، هذا عدا عن عناوين بعض قصصه القصيرة كمثل الرائحة القديمة والصوت والرائحة في ألعابه التي قد لا تُحمد عقباها. شممتُ رائحة حسين عبد العليم في قارورته/ مجموعته القصصية الأخيرة فوجدت أني لأحكُمَ عليها أحتاج أن أفتح قواريره الأخرى كلها.. هذه القوارير التي ملأها بعطره الخاص جدا وغادرنا.
***
في مجموعة “الألعاب التي قد تنتهي إلي ما لا تُحمد عقباه” كما في معظم أعمال حسين عبد العليم توجد مساحة معتبرة للشخصية القبطية فلا تكاد تجد للكاتب عملاً يخلو منها، كما أن بعض الأعمال مخصص لها بالكامل، وهكذا هى مصر بمسلميها ومسيحييها. أما فيما يخص موضوع المقال فإن قارئ الألعاب لا يلحظ فيها تأثيراً لثورة يناير، وذلك أن الكاتب بدا معنياً أكثر بالحكي عن ظاهرة الهجرة للخارج وانعكاساتها علي الحراك الطبقي وكذلك علي العلاقات داخل الأسر المصرية. ومع أن الخليج كان له نصيب الأسد من أسفار شخصيات المجموعة القصصية إلا أن بعضها الآخر كانت وجهته أوروبا، أما وطأة الاغتراب عن الوطن والأهل فكانت واحدة على الجميع. وهكذا تكرر مشهد توديع المسافرين للشوارع والمحلات والبيوت وهم في طريقهم إلي مطار القاهرة، وأوجعتنا لوعة الأم التي خطف الابن قلبها وطار فإذا بالكوابيس تطاردها كل ليلة وتحلم الشر بره وبعيد أنها “تفرط عنب”. وفي هذا الإطار المحدد قام الكاتب بتسكين شخصية نادية موريس-تلك الفتاة الحلوة التي هام بحبها محمد من طرف واحد، ذهب لأجلها إلى الدير وتناول معها القربان وانبهر بترانيم عيد ٧ يناير، أما هى فلم تأخذ أبدا مشاعره بجدية لأنه يصغرها، تزوجَت من فريد ڤيكتور وهاجرت معه إلى فرنسا وفي البعد لقنت مريم ابنتها أن “محمد أخو ماما”.
***
بذلك يمكن القول إن حسين عبد العليم بعد أن رمي لنا في روايته “فصول من سيرة التراب والنمل” الصادرة عام ٢٠٠٣ خيطاً، كان يمكن أن يسحبه إلى الآخر في أعماله الأدبية التي جاءت بعد الثورة ومنها رواية الألعاب التي قد لا تُحمَد عقباها، نجد أنه قد تركه معلقا في الهواء، أما هذا الخيط فهو السلوك السياسي للأقباط. لقد جسد الدكتور عزيز بشري فانوس في رواية “فصول من سيرة النمل والتراب” شخصية القبطي الذي بات ينفر من السياسة، ففي حواره مع ابنه المهندس فاروق يقول عزيز “حياتنا لازم يكون فيها استقرار وأمان، نبقي زُعَمَا معلش في الحياة الاجتماعية والوجاهة، لكن السياسة لأ”. وفي الحقيقة فإننا لسنا نعرف إذا كان قد مدّ الله في عمر حسين عبد العليم هل كان سيعيد النظر في علاقة الأقباط بالسياسة أم لا، كل ما نعرفه أن عزيز بطل قصته توقف حتى عن ممارسة النقاش السياسي بعد انكسار المشروع الوطني وزحف الدين على السياسة منذ مطلع السبعينيات، وعندما سألته زوجته ذات يوم عن السبب في هذا العزوف السياسي رد عليها مُحبطا “خلاص ما بقينا خارج اللعبة”. فيما بعد مات عزيز وهو علي هذه الحالة من السلبية السياسية، وأودع سلبيته تلك في نفس ابنه المهندس فاروق رغم أن الأخير كان في لحظة معينة على استعداد لأن يتفاعل سياسياً مع الواقع وأن يلعب دوراً سياسياً ما، لكنه لبس جلباب أبيه أو أُلبِسه بتعبير أدق، وعندما حاول أن يخلعه فشل وقال “أبويا لابِد جوايا زي السرطان”. تأقلم إذن فاروق مرغماً على ما رباه عليه أبوه وعاش في منفاه/ مهجره لندن وفيه مات وحيداً.. وحيداً.
***
هذه السلبية القبطية كسلوك سياسي تماثلها سلبية أخرى في المجال الاجتماعي، ففي رواية “سعدية وَعَبد الحكم” الصادرة عام ٢٠٠٦ توجد شخصية الصاغ سعد أفندي بسادة، ذلك الضابط بمديرية العاصمة الذي لم يمسك مسدساً ولا أطلق ناراً ولا ترك أثراً في عمله ولا حتى في دائرة علاقاته الخاصة، وها هو يصف نفسه فيقول “طول عمرك يا أسعد في الوسط لا فوق ولا تحت”. لكن هذه السلبية أو الشخصية الرمادية موجودة في كل مكان وكل الأديان، واحتمالات أن تكون السلبية سمة فطرية تلقائية تتساوى مع احتمالات أن تكون صفة مكتسبة وتُستَخدَم كآلية من آليات الدفاع عن النفس. أما سلبية فايزة حنا في رواية “المواطن ويصا عبد النور” الصادرة عام ٢٠٠٩ فكانت من ذلك النوع المكتسب الذي تفرزه البيئة المحيطة ويتولد عن السياق العام . قبل أن تترك فايزة حنا الدراسة تعرضت لاستفزازات دينية من تلاميذ تالتة رابع في مدرسة سنهور الابتدائية المشتركة، استفزازات تراهن على أنها لن ترد أبداً، هم كانوا يعرفون ذلك وهى قبلهم، وعن هذا تقول فايزة “طب كنت هعمل إيه يعني بطولي قصاد فصل فيه تلاتين أربعين عيل وعيلة ولاد عفاريت”، فكانت تناور وتداور وتتجنب الصدام وتكتم في قلبها. وهذا الخيط أيضا رماه لنا حسين عبد العليم ولم يشده في أعماله بعد الثورة، رغم أن الشخصية القبطية اختلفت كثيراً علي الصعيد الاجتماعي كما على الصعيد السياسي، وانتقلت من دور المفعول به إلي دور الفاعل، ومن دائرة الظل إلي ذروة الانخراط والمشاركة .
***
بعدما انتهيت من قراءة حسين عبد العليم تشبَعَت رئتاي بروائح كتبه ومكتبته ونعناعه وزمان وصله، لكن كما راوغته روائحه فإنها راوغتني.. نعم راوغتني فزاغ مني أثر يناير في الأقباط المصريين .