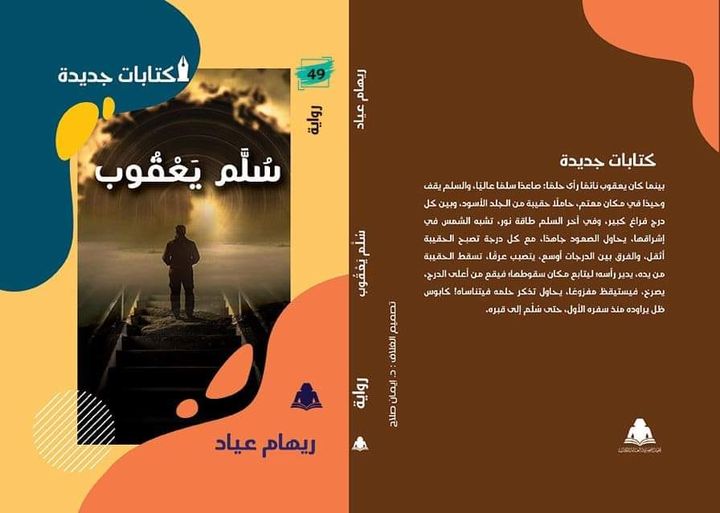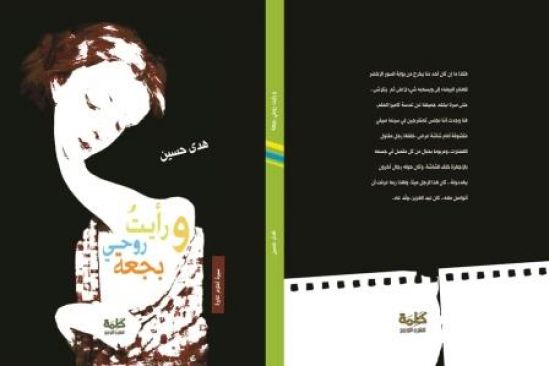حسني حسن
جلس بقاعة الانتظار الواسعة المكتظة بالمرضى. كانت عيناه جامدتين على باب الحجرة المكتوب أعلاه عيادة القلب والأوعية الدموية. رأى الممرضة الشابة واقفة أمام الباب، نشطة، لكن برمة، وهي تقلب نظراتها في الجالسين والجالسات، وكأنها تخمِّن من منهم بالضبط ستأخذ منه، عما قريب، تذكرة الحجز لاستشاري القلب، الذي تعمل معه، في هذا المجمع الطبي الشعبي الكبير. أدرك أن دوره لا يزال متأخراً، فحاول التشاغل بالاستماع لموسيقى “رودريجو” وهي تنساب بعذوبة، عبر سماعة الموبايل الحديث، في كونشيرتو الجيتار المعروف باسم “الأندلس”. أحس براحة عميقة، واستبد به حنين جارف، هادئ وثابت الإيقاع، إلى أراضٍ لم تطأها قدماه، وأجواء لم يسبق له أن تنفس هواءها، ومسرات، وأعياد، ربما آمن، دوماً، أن لا وجود لها، لا في هذا العالم، ولا في كل العوالم الأخرى الممكنة. أوشكت دمعة جذلى أن تطفر من مقلته. لسبب ما، وبكيفية ما، شعر بامتلاء بطاريات كيانه بفيض من طاقة الامتنان، رأى جسده يذوب وينحل، وحواسه تصفو وتحتد، تُشحذ وتبرق كحد الموسى، حواس من وميض ترابي، من تراب يتوامض، فخشعت روحه لصلاة من صمت وتلاشٍ، صلاة لحضور الغياب.
كان قد استجمع جرأته، ونفض عنه خجله، ذات مرة، واستفسر من الطبيب عن حقيقة ما يلم به من أعراض عضوية، وأحيانا عقلية، بدت له غير مطمئنة، فاعترف الطبيب أن كل تلك الظواهر ما هي إلا تأثيرات جانبية، لا مفر منها، للأدوية التي يتعاطاها. ابتسم له ابتسامة عريضة، كمن يزف بشرى سارة، قائلا:
– ستعتادها بمرور الوقت.
فكّر أن كل شيء، وأي شيء، يبقى مرتهناً بالزمن، لكن ما الزمن، حقاً، في نهاية المطاف؟ هل ثمة وجود حقيقي، في ذاته، للزمن؟ أم أن الزمن ليس أكثر من وهم اخترعناه، خلال مسعانا الفاوستي البائس، لقياس وحبس الحركة والتغير؟ للقبض بأمراس من فولاذ على مطلق سيّال كلي التفلت؟ الزمن هو موج المحيط، جرب أن تحبس موج المحيط، ولتقل لي ماذا سجنت؟ أجل، الزمن هو ألق العتمة، ونور الظلمة.
على المقعدين، المقابلين له، جلسا متلاصقين، يتهامسان. كان الفتى، في لباس الجندية، يلوح وكأنه عائد، لتوه، من حرب ضروس، لابد وأنه قد هُزِم فيها، من دون أن يعي هزيمته. ممشوق القامة، أسمر البشرة، وسيم التقاطيع، لكنه أشعث أغبر. وبرغم ذلك، راحت عيناه تبرقان بلهب حانٍ، وتلفّان رفيقته بوميض. أما الفتاة، فبدت لعينيه مهدمة تماماً. انزوت في كرسيها، متهالكة، بوجه شاحب مصفر، وجسد ضامر مضمحل. أخذ الفتى كفها الناحل في كفه، وظل يروي جنان أذنيها الذاوية بكلماته. ود من أعماق قلبه لو يقدر على سماع ما يهمس به الفتى لفتاته، لو يمتلك سمع النبي سليمان للحظات، أو لو يستحيل إلهاً كلي القدرة، مُخوّلاً له التصرف بحرية، لا محدودة، في حياة وموت الشابات والشبان، الكهول والأطفال، الآباء والأبناء، النمل والشجر، النسور والأفاعي، الكواكب والأقمار والنجوم والسدم، الكون والأكوان بعد الكون، وكل شيء، كل شيء.
قال لزوجته:
– الحياة غير عادلة، وينبغي على المرء أن يتقبل هذه الحقيقة، بأريحية وسعة صدر.
كانت تتحسر على الشباب الذي ولى، والعمر الذي ينقضي، من دون أن يُنجز الإنسان أياً من أحلامه التي توهم، يوماً، أنه ما قُذِف به، في هذا الوجود، إلا لتحقيقها!
– ومع ذلك فقد تحققت بعض الأحلام.
يقول.
قد تُولد لأسرة فقيرة، ولا تأكل اللحم، إلا في المواسم والأعياد، ولا ترتدي إلا أرخص الثياب، كسوة وحيدة للصيف، وأخرى وحيدة للشتاء، لا مصايف ولا رحلات، وخوف مستمر من السقوط في وهدة المرض لأنك، ربما، لا تجد ثمن العلاج، وتواصل الكدح، طول عمرك، من أجل تغيير هذه الأحوال، تُفني زهرة شبابك، وتقايضها بحساب في البنك وشقة وسيارة وشاليه في الساحل، لكنك حين تصل لهناك تكتشف، فجأة، أنك قد بلغت الحافة، وأن كل شيء صار يستوي، لديك، مع كل شيء آخر، أو أن الحياة قد انقضت، وما عشت بعد! والأدهى، والأمَر أنك ما عدت، حتى، متحمساً للعيش!
استرسل رئيسه في شرح أبعاد المؤامرة، الصهيونية الأمريكية الشيوعية الإسلاموية الكونية، على وجود الوطن. راح يُصغي إلى تحليلاته، المسهبة المعمّقة المتشعبة المتراكبة، وهو يهز رأسه، بين الحين الآخر، دلالة اليقظة والمتابعة النشطة والاتفاق مع ما يطرحه عليه من أفكار ومعلومات ورؤى.
– أراك متفقاً مع ما أقول.
– نعم، ولكن ….
– لكن ماذا؟
– الأندلس!
زفر بصوت متهدج وأنفاس مبهورة.
– الأندلس! ما لها الأندلس؟ ما دخل الأندلس بما أقول؟
– يتباكون على سقوطها يا ريس. يقولون إننا كنا رسل تمدين وحضارة، بخلافهم! لكني أحب موسيقى “رودريجو”، هل تسمع “رودريجو” يا ريس؟
سقط سؤاله في جب الصمت المتوسع بين الرجلين. دقيقة احتوت دهراً، ثم أجابه الرجل:
– أظنك بحاجة إلى بعض الراحة. خذ إجازة واذهب إلى الشاطئ.
على ذؤابات الموج المتكسر عند عتبات الرمل، لم يكتب، أبداً، أن العالم لا يعاني من الشُح في الإيمان، بل، وعلى العكس، تماماً، من الإفراط فيه، ولا أن العالم يلوح مُتخَماً بالإيمان! يُثقِل الإيمانُ العالمَ حتى يكاد يُغرِقه في لُجة الظلمة، ذلك الإيمان، الكثيف المصمت والمصبوب من رصاص ويورانيوم مُنضَّب، إيمان يدعي أنه يرفع راية الإله، وهو يحني هامة أنفاس الإله، إيمان يكفر بالجسد، ويكرِّز بالرمز، يُنكِر الصوت، وُيبشِّر بالصدى، إيمان يرفع الرب على الصليب، ويصلي لأيقونته!
أما هي فقد كتبت له معترفة:
– كلماتك تقتنص أعمق ما بروحي، ويستعصي على قلمي.
– إنه مَذاق الهباء يا صديقتي!
– تعرف أنك شاعر وتتنكر.
– ليس سوى مذاق الهباء يا صديقتي!
حالما تصحو من قيلولتك السرمدية، يا أبي، أرجوك أن تأخذني لزيارة المُتحَف، لقد سعيتُ وحدي، بعد أن تبدد أملي في قيامتك، لكن المُتحَف الذي قادتني خطاي إليه، كان مؤثثاً بالهباء!