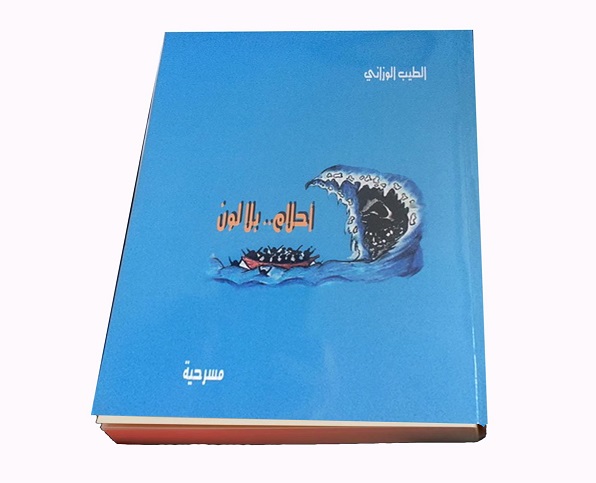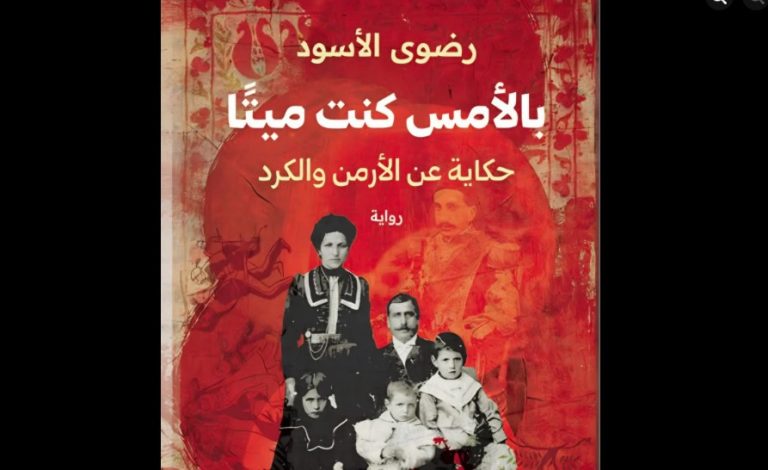خالد البقالي القاسمي
صدرت عن مطبعة الخليج العربي بمدينة تطوان بالمملكة المغربية سنة 2020 مسرحية ” أحلام بلا لون ” للمبدع المسرحي والقاص ” الطيب الوزاني “، والمسرحية في طبعتها الأولى تضم بين طياتها ستين صفحة متوسطة، وتعد هذه المسرحية رابع إصدار للمبدع بعد مسرحياته الثلاث: ” بيتزا…همبوركر…سوشي… 2017 – آلهة بالطابق السفلي 2018 – شربيل حليمة 2020 “، ويدل هذا المنتج على شغف ” الطيب الوزاني ” بالمسرح الذي مارسه، وكتب عنه، وعايشه لمدة طويلة.
بعيدا عن التوضيب الدراماتورجي وتدخل المخرج المسرحي المتخصص الذي سوف يشتغل على لعب المسرحية مع ممثلين مؤهلين، فإن المسرحية تتشكل من سبعة مقاطع أو فصول، كل فصل يرتبط بلاحقه ويستند إلى سابقه، وقد اختار المبدع لمسرحيته عنوانا مثيرا للتأمل والتفكير، حيث عندما نتحدث عن أحلام لا لون لها يفرض علينا التقابل المنطقي أن نركز على أحلام لها لون، ويظل هذا التصور رهينا بعمق فلسفي واضح، فالأحلام التي تعتبر في التداول العادي ملكا طبيعيا وعاديا للجميع، لا تخضع بالمقابل لتصنيف مسبق يلون كل حلم بلون مغاير، وهذا يدخل في باب التخييل الذي يعيشه كل واحد مع أحلامه التي يحتضنها، ويعيش بها، ويستمر في تحمل ثقل الوجود بواسطتها، لأنه لكي يرتاح الفرد ويحقق درجة مقبولة ومعقولة من التوازن النفسي عليه أن يغوص في الأحلام، ومن المتصور أن كل واحد يحلم بطريقته الخاصة، وحتى لو افترضنا بأننا نتقاطع ونتشارك نفس الأحلام فحتما نحن نختلف في طبيعة الألوان التي نضفيها على أحلامنا هاته، حلم واحد مشترك بين كثيرين ولكن ألوانه تمتلك خصوصية تعود للطبيعة النفسية لكل واحد، وهنا نستحضر الدلالة، فرغم أننا نشترك في الأحلام فإن طبيعة الألوان التي نضفيها عليها قد تغير دلالاتها، وهنا يمكن أن نستنتج بأن حلمنا لأحلام مشتركة هو مجرد وهم، كل له عالمه في الأحلام، ويصعب جدا تقديم إيضاحات مقنعة من طرف الحالمين بأنهم قد يستطيعون الانخراط في مشاريع جماعية من الأحلام، وحتى هذه الصعوبة تظل موضع تساؤل، ومحل شك، لأن الذي يحلم لا يستطيع بتاتا تقديم تصور متكامل عن أحلامه يمكن أن تؤهله لبناء مشاريع حقيقية ومفيدة مع الآخرين، ألوان الأحلام ترتبط بسحرها، وشفافيتها، وفاعليتها، فهي عندما تصل بصاحبها إلى درجات فارقة من النشوة والنشاط والفرح العارم نقول إنها أحلام لها ألوان، وألوانها هي التي تحقق التوازن العقلي، والاستقرار العاطفي، والاكتفاء النفسي، فتكون بذلك عبارة عن أحلام وردية. وعندما تصل بصاحبها إلى الانهيار العقلي، والخراب العاطفي، والجمود النفسي، نقول إنها أحلام ليست لها ألوان، ورغم ذلك فهي أحلام بألوان سوداء. يظل إذا التوصيفان المشار إليهما قائمين في الدلالة، والتداول، والتصور المنطقي، والحضور اللغوي، فنحن جميعا لا نستعمل في ألوان الأحلام إلا الوردية والسوداء، أو لنقل في الغالب لا نستعمل إلا هذين اللونين، ولا أعتقد أن وصف الأحلام بالوردية يكون كافيا للحكم على صاحبها بأنه في حالة متعة واستقرار وسعادة، ونفس الشيء بالنسبة للأخرى، حيث لا يكفي أن نصف الأحلام باللون الأسود لكي نكون على يقين من أن صاحبها في حالة نفور واهتزاز وشقاء، يبقى المقبول تقريبا هو اعتبار ألوان الأحلام من المكونات التي تدخل في باب التقسيمات العقلية التي تعمل على تسهيل وتبسيط التصورات والرؤى المرتبطة بسبر أغوار وأعماق النفس الإنسانية، إن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من نشدان الإشباع، والتماس الأفضل في عالم الرغبات، والطموحات، والنزوعات…
بما أن المبدع المسرحي ” الطيب الوزاني ” اختار لمسرحيته أحلاما لا تحمل ألوانا فأعتقد أن تتبع العمل المسرحي سوف يعطينا تصورات وأفكارا قد تقنعنا بمدى جدوى وقيمة توصيف الأحلام بالألوان أو بدونها، يقدم المبدع مسرحيته وفق تقسيمات وتقطيعات مسرحية تظهر احتراف المبدع في الكتابة المسرحية، وتبين تمرس الأستاذ بالمسرح وتقنياته، وآلياته التي تعتبر ضرورية في إضفاء الطابع المسرحي الفعلي على المسرحية، وإلا فإن الحقيقة في هذا المجال تؤكد لنا أن العمل المسرحي تتم عملية كتابته لكي يعرض على الركح، ويلعبه ممثلون شغوفون بأبي الفنون، ويشير المبدع في نصه المسرحي إلى هذه المعطيات عندما يؤكد على هذا بقوله في الصفحة.9: ” ملحوظة: الإرشادات الواردة بالنص خاصة بالقارئ للاستئناس، ويبقى المخرج حرا في تصوره “، ويعتبر هذا التوضيح طبيعيا، إذ إن المسرحية تنتظر باعتبارها نصا مكتملا جاهزا، مخرجا قديرا متمرسا يقوم بتقديمها كعرض فرجوي، معرفي، ثقافي.
يقدم ” الطيب الوزاني ” مسرحيته عبر لعب وحركة شخوص عدة:
- مامادو MAMADOU: مهاجر إفريقي شاب، أسود البشرة، يميل بطبعه إلى الرزانة واللين.
- سامبو SAMBOU: مهاجر إفريقي شاب، أسود البشرة، عموما مشاكس وذو طبع حاد، لكن طيب السريرة.
- أبدولاي ABDOULAY: مهاجر إفريقي شاب، أسود البشرة.
- قاسم: شاب مغربي يافع أبيض البشرة.
- عباس: شاب يافع من أحد بلدان شمال إفريقيا، أبيض البشرة.
- أومو OUMOU: امرأة إفريقية سوداء البشرة، أم لرضيع.
- أمينتو AMINATOU: فتاة إفريقية سوداء البشرة، حامل.
- الرضيع: دمية سوداء الملامح.
- الآخر: شخصية وهمية تحيل على مسؤول بمكتب إثبات الهوية.
- كومبارس: كثر عند الاقتضاء.
- وجوه نساء ورجال من إفريقيا وبلاد العالم بتعابير مختلفة تستحضر بالإسقاط عند الاقتضاء.
يمكن لكل متتبع للأعمال المسرحية أن يتصور موضوع العمل بمجرد اطلاعه على كشف الشخوص، فالعمل المسرحي يخوض في موضوع شائك ومعقد، وفي نفس الوقت عادي وطبيعي، فالهجرة أو الهجرات البشرية عرفت منذ القديم، في جميع ربوع المعمور، ومن العادي جدا أن تتم عملية هجرة البشر بناء على أسباب وأغراض متعددة ومختلفة، والعادي في الهجرة هو طلب الاستقرار، والبحث عن المعيشة، وتجنب الأخطار المحدقة، وبهذا تعمل الهجرة على تلقيح الشعوب، وتجديد دمائها وحيويتها بواسطة الاختلاط، والتزاوج، والاندماج، لذلك فإن الطبيعي في حياة البشرية منذ قديم الزمان هي الهجرة والحركة وتغيير الأمكنة، في مقابل سلبية الجمود، والركون إلى مكان واحد، واجترار الخيبات والفشل في الوصول إلى تحقيق عناصر الحياة الطبيعية.
وتصبح الهجرة شائكة ومعقدة عندما تتحول إلى موضوع تتداخل فيه المتغيرات، والأحوال، والشروط، والظروف. النص المسرحي يركز في موضوعه على هجرة الأفارقة إلى أوروبا عبر دول شمال إفريقيا، وبالضبط يصور النص المهاجرين الأفارقة وهم في حالة عبور بأراضي هذه الدول، تغمرهم أحلام عبور البحر للوصول إلى الدول الأوروبية التي يعتقدون جازمين بأنها الفردوس، أو على الأقل إنها شيء أقرب من ذلك.
الفصل الأول: ليلة المداهمة
الأجواء فوق الركح تصور منطقة غابوية يوجد بأحد أركانها كوخ بئيس، وبقايا قارب تبدو عليه علامات التلاشي والتآكل، ” مامادو ” الإفريقي يستيقظ على لفحات البرد القارسة المشبعة برطوبة البحر، حيث الزمن يصبح عصيا على تسهيل فعل الحركة، يلتصق الجمود بهذا الزمن الذي لا يخفي خيرا أو تفاؤلا، وتعتبر هذه الصورة عادية، وسريانها جار بين راغبي وطالبي الهجرة السرية، علاماتها ترتبط بالهروب، والتخفي، والابتعاد جهد الإمكان عن الأعين لحين اغتنام الفرصة المواتية لركوب الأمواج العاتية والخطيرة أملا في تحصيل الحلم الذي يفقد لونه الوهمي، كل من ” مامادو وسامبو وأبدولاي ” يحاولون تلافي عيون الحرس التي تترصد المهاجرين السريين، لأن هجرة من هذا النوع تظل دائما مرصودة كونها تدخل في مجال المنع والحظر، خطاب المنع والحظر هذا يخرج في هذه الصيغة من مكوناته التي تستهدف المواضيع ذات الحساسية الفكرية والثقافية، وينكب على إنتاج علامات جديدة لها علاقة بالسلوكات التي تجد خلفيتها في نتائج العولمة البغيضة، فالهجرة السرية واحدة من عناصر الحظر التي كانت العولمة وراء تحريك مياهها العكرة، أصحاب نظرية العولمة لم يضعوا في اعتبارهم أن سريان الفكر الأحادي بين جميع الناس سوف يفكك خطاب التغني بالحقوق الإنسانية على المستوى العالمي، وكأن طالبي الهجرة كانوا يتصيدون مثل هذه الأفكار لكي يجاهروا بعصيانهم لمفهوم الثبات والاستقرار، ويبادروا إلى ولوج العوالم التي تدعي العولمة فتحها وإتاحتها لجميع قاطني العالم.
حوار الأفارقة الثلاثة يحذر من إمكانية اقتلاع واجتثاث جميع مخيمات المهاجرين السريين، والأمر تحقق فعليا في أحد المخيمات. يمكن هنا أن نقول إذا جاز لنا أن نقر بحقيقة الألوان التي نضفيها على الأحلام بأن العدمية بدأت تنخر جسم الأحلام، وتحيطها بغلالة من الكآبة، والحزن، واليأس، فالحلم الذي ترعرع وشب في الأعماق البشرية وتصور الجميع بأن الألوان شرعت تتدفق في شرايينه بدا أمام الأعين بأنه سراب، وبأنه لم يعد يستطيع الثبات أمام تحول الألوان، وانحسار بريقها، هناك من يرفض سير الحلم في طريقه، مع العلم أن الأصل في هذه الطريق أنها غير طبيعية لتحقيق الأحلام، واللاطبيعي هو الذي يسهم بطريقة طبيعية في خنق هذه الأحلام، ويرفض وصفها بأنها أحلام تتوفر على ألوان، خطاب الحظر يرفض دائما الاعتراف بالمواضعات، والتوافقات التي تخرج عن نطاق السيطرة.
في حوار الأفارقة الثلاثة إصرار عنيد على مواجهة المشاكل والصعوبات، وعزم على عدم العودة إلى بلدان تصدير الهجرة في إفريقيا العليلة، ويطرحون فكرة الموت تحديا لكل الصعاب التي تحول دون تحقيق هدف الهجرة، رغم أن الموت غرقا هو كذلك أضحى ترفا في التفكير، يقول ” مامادو ” في صفحة 13: ” ( بتهكم )، البحر!!.. لقد حصنوا الشواطئ أيضا.. لم يعد هناك سبيل حتى للموت غرقا “، ويزداد إصرار الثلاثة قوة وعتوا على الهجرة أو الموت بأية وسيلة، جوعا، أو عطشا، أو غرقا…
يقول ” مامادو ” في صفحة 13: ” ( حالما )، كان يوما أغبر عندما قررنا الهجرة نحو الشمال.. كنا هنالك، رغم فقرنا المدقع، أحرارا.. تحفنا البساطة “، هذا التصريح المصاحب بموسيقى إفريقية هادئة ورتيبة وشريط قصير لواقع حياة إفريقية كلها هم، وبؤس مع أطفال يحملون كل أنواع الأمراض والأوبئة يقدم صورة أخرى، صورة مغايرة عن الرغبة العارمة في الوصول إلى تحقيق الهجرة المأمولة، تصريح يدل على الرجوع إلى الداخل، إلى عمق الباطن الإنساني، هنا بالضبط تبدو الحقيقة الإنسانية عارية من الحواجز، حقيقة تدل على العمق الإثني، وغور الانتماء، والاستمرار في الارتباط بالأصل، والتطلع إلى سحر الهدوء والبساطة في مقابل الإحساس الحاد بخواء مكونات الهجرة وعناصرها المؤثثة، ويتساوى في هذا التصور، وهذا النزوع كل من صاحب مشروع الهجرة والمهاجر الفعلي، حيث نجد أن المهاجرين في الدول الأوروبية وغيرها من الدول يظلون أسرى لهذا النوع من الحلم والتفكير، مثخنين باستمرار بجراح الأصل، والمنبت، وعمق البداية، ونفس الشيء نجده لدى هذا المهاجر الإفريقي ” مامادو ” وأصحابه الذين يلوذون بجمال ورونق الماضي من أجل القدرة على مواجهة قبح وتغول الحاضر، مع التوجس الشديد من المستقبل المجهول. الإحساس باليأس، والإحباط دائما يدفعان الإنسان لمحاولة استرجاع الوضعية الخلفية التي مهما كانت درجة إقناعها الضئيلة كفيلة بإضفاء نوع من السلام، والأمن، والطمأنينة، ولو بطريقة مؤقتة، بسيطة، باهتة، إنها تعزية هشة، ومتلاشية. والمعنى المقصود هو أن الهجرة السرية يكتنفها خطاب يتميز باللايقين، ويحتاج إلى عناصر متينة لتكثيف مكوناته، وتقويتها، والإسهام في تحقيق صلابتها.
موضوعة البحر لها في ثقافة الهجرة السرية حضور طاغ، وقوي، لأن البحر اكتسى طابعا جديدا لدى المهاجرين حيث لم يبقى فقط رمزا للحرية بل أصبح كذلك عنصرا مؤثثا لفكر الهجرة وأدواتها، لا يمكن التفكير في الهجرة إلى أوروبا واجتياز الضفة إلى الضفة دون التفكير جديا في البحر، ينبغي احترام البحر جيدا، اللذين لم يحترموا البحر حق الاحترام، واستهتروا بهيبته وجبروته انتهوا بدون ضجيج في أعماقه، طعاما سائغا للقروش وباقي الأسماك، ويبدو حسب المسرحية أن الفكرة بدأت تنضج جديا في أذهان الأصدقاء الأفارقة الثلاثة المقيمين في مخيمات الهجرة ” مامادو وسامبو وأبدولاي “. فقد ناقشوا بينهم بجدية وجود مركب متهالك مخفي في إحدى الزوايا يحتاج إلى الإصلاح لكي يصبح مطية جاهزة تعبر بهم نحو الحرية والخلاص كما يعتقدون، أو بالأحرى يتوهمون، خصوصا وأنهم ضيعوا أموالا كثيرة دفعوها لعصابات تهريب البشر التي خذلتهم بعد أن استولت على نقودهم، ثم رمت بهم في قوارب مكتظة، دارت بهم دورة سريعة في نفس المكان والضفة، ثم ألقت بهم إلى البحر، منهم من نجا بنفسه وظل أسيرا لكوابيس وأحلام مزعجة لمدة طويلة، ومنهم من غاص في أعماق البحر، وقضى غريقا، وباد أثره تماما.
لقد كان المبدع موفقا في رسم صورة ” مامادو ” وهو يصف ليلة الخروج في مركب الموت الذي طوحت به التيارات البحرية، وألقت به في نفس الضفة، ويتضح من خلال الحوار في النص المسرحي المقابلة التي يقيمها المهاجرون السريون بين الموت والحياة، يعود هذا الإحساس إلى التأكيد على سبر أغوار نفسية المهاجر السري عند نقطة الانطلاق، من أعماق إفريقيا وأدغالها، هذه النقطة التي هي البداية تشكل مشروعا مفعما بالأمل والطموح في الوصول إلى الإمساك بلحظة من الحياة مختلفة تماما عن الواقع الإفريقي المرير، لحظة لا تتجسد إلا بالرغبة والحلم، الرغبة في الخروج من طوق الألم والعنف الإفريقيين، والحلم بتحقيق معالم حياة كلها حرية، وكسب، ونعيم، وانعتاق. بعد نقطة البداية تتحدد معالم نقطة الشك التي تنذر بموت أو هلاك ممكن أو قريب، نقطة الشك هاته تشرع معالمها في الظهور بمجرد وصول المهاجرين السريين إلى بلدان العبور، حيث تقع الصدمة، ويظل الممكن والمحتمل لصيقا بمصائرهم، كما يظل الأمل ضعيفا في تحقيق رغباتهم، وتنعدم الألوان من أحلامهم الطموحة، وتحل محلها الكآبة، والسوداوية، والعدمية.
الفصل الثاني: قارب الأحلام
تقدم الصورة المسرحية جوا يظهر منه أن الوقت هو النهار، وتحتفظ الصورة بنفس المنظر السابق تقريبا، حيث المنطقة الغابوية التي تحتضن المخيمات الهامشية للمهاجرين السريين الذين يقيمون بها بطريقة غير قانونية، الجديد في المشهد هو انخراط الصديقين الإفريقيين المهاجرين السريين ” مامادو وسامبو ” في إصلاح قارب يبدو به عطب في جانبه الخلفي، ويتوفر الصديقان على إدراك تام بأن مهمتهما سوف تكون صعبة للغاية، ورغم ذلك فهما ينكبان بكل همة ونشاط على محاولة إصلاح أعطاب القارب، تداعبهما أحلام مبنية على خيال فياض يصور لهما قدرتهما على إصلاح القارب والانطلاق به نحو الضفة الأوروبية والحصول بكل سهولة وبساطة على العمل، والإقامة، والنقود الكثيرة، والطعام الوفير، والشقراوات الجميلات، والعيش الرغيد…
يدفع المبدع المسرحي في هذا الفصل الثاني للمرة الأولى بالأبيضين اليافعين صغيري السن ” قاسم وعباس “، يقومان بتقديم نفسيهما إلى الإفريقيين ” مامادو وسامبو ” على أنهما صديقان يلتمسان الوصول إلى ميناء تجاري كبير خلف الجبل الذي يعلو المنطقة الغابوية قصد الحصول على فرصة الهجرة إلى الضفة الأخرى عن طريق ترصد مكان مناسب في إحدى الشاحنات الضخمة التي تربط بين الضفتين محملة داخل سفن تجارية كبيرة، والمكوث في إحدى زواياها بين صناديق السلع، أو داخل تجاويفها… لحين وصولها بشحنتها بعد اجتياز البحر، ثم الانطلاق بحرية، والركض في ربوع الضفة الجديدة.
يوظف المبدع ” الطيب الوزاني ” القارب هنا باعتباره وسيلة حيوية في تحقيق الأحلام، ويكتسي القارب بهذه الوسيلة مشروعية النظر إليه بصفته أصبح زادا ثقافيا للمهاجرين السريين، لأنه عندما يصبح الحديث والنقاش منصبين بكل حيوية، ونشاط، وإصرار على أداة معينة، تصبح تلك الأداة منتمية إلى الحقل الفكري الذي يسود المجموعة المهتمة بتلك الأداة، وعندما ينكب المهاجرون السريون الأفارقة على محاولة إصلاح القارب فإن هذا العمل ينتج كلاما متنوعا كثيرا، مراكمته تضفي عليه مشروعية تسمية الزاد الثقافي، فيصبح بذلك واحدا من الثوابت التي لا يمكن الحديث عن الهجرة السرية دون إثارتها واعتمادها للحصول على الهدف، وتحقيق المطلوب.
في هذا الفصل يبدو أن المبدع المسرحي كان ذكيا في بناء وضعية مسرحية تتشكل من ثنائيين اثنين، كل ثنائي له مواصفاته الخاصة، وخصائصه المميزة، وثقافته الأصلية، وإثنيته التاريخية والقومية. ” مامادو وسامبو ” مهاجران إفريقيان بشرتهما سوداء، وثقافة البشرة السوداء تتحدد بالنظر عند مقابلتها بثقافة البشرة البيضاء، حيث إن الإفريقي ذو البشرة السوداء ينمو وعيه ويتكامل عندما يستطيع إدراك لون بشرته، ويزداد وعيه تكاملا وتجذرا عندما يدرك مرة أخرى بأن بشرته السوداء تختلف عن البشرة البيضاء، وقد سادت هذه الثقافة التي كانت مبنية على تصورات عنصرية لمدة طويلة، كانت ثمارها آدابا، وفلسفة، وفكرا عن الزنوجة وامتداداتها في العمق الإنساني بالمقارنة مع وهم تفوق الجنس صاحب البشرة البيضاء، هذه التصورات تظل ملتصقة بوعي المهاجرين السريين، ومتغلغلة في أحلامهم التي لا يرون إمكانية تحقيقها إلا بواسطة الإنسان صاحب البشرة البيضاء. صاحب البشرة البيضاء هو الذي يمثل الخلاص بالنسبة لصاحب البشرة السوداء، ولذلك فإن ثقافة الهجرة السرية كثيرا ما تجعل أصحاب البشرة السوداء ينتقصون من قيمتهم، وأهميتهم الإنسانية والعرقية، والإثنية من أجل الحصول على الأغراض المادية الضرورية للحياة، والحياة فقط دون الحديث عن نوعيتها، وقيمتها، وجدواها، وجودتها. وعلى هذا الأساس تظل الثقافة المبنية على التمييز العنصري تتسلل بأظافرها المقيتة إلى عمق ثقافة الهجرة السرية، وتعمل على إصابتها بأعطاب، وتشوهات، تمس في العمق قيمة الإنسان، وتجعل أحيانا كثيرة موضوع ” حقوق الإنسان ” موضوعا باهتا، مستهلكا، منزوعا من أسسه وأهدافه. والثنائي الثاني ” قاسم وعباس ” هما بدورهما ينخرطان في سيرورة الهجرة وأحلامها، رغم أن بشرتهما بيضاء، والمبدع المسرحي يريد أن يوضح للجميع بأن المعاناة من شظف العيش، والتشرد، والإحساس بالألم والفاقة، أمور أصبح الإنسان الأبيض يعرفها جيدا مثله مثل الإنسان الأسود، لا فرق إذا بين العرقين، نوائب الدهر لم تعد تفرق بين الأبيض والأسود، لقد أصبح الجميع يتقاسم نفس الهموم.
ويبدو أن اختيار المبدع المسرحي لثنائي أبيض كان له تأثير بليغ في توجيه المسرحية نحو هذه الوجهة التي تعمل على تفتيت وتفكيك خطاب زمن العنصرية، الثنائي ” قاسم وعباس ” يسجل حضوره هنا لكي يبرهن على أن الواقع المعيش أصبح يفرض مساواة في النظرة والتعامل مع البشرة السوداء والبشرة البيضاء، فهما يتقاربان، ويمتزجان، ويذوبان في تصور واحد وهو استقرار النزعة الإنسانية على الخضوع، والاقتناع بجدوى مفهوم ” حقوق الإنسان ” على المستوى الكوني. يسعى الثنائي صاحب البشرة السوداء إلى ممارسة طقوس الهجرة السرية، ونفس الشيء ينطبق على الثنائي صاحب البشرة البيضاء، الكل أصبح يعاني، ويسعى إلى الخروج من ورطة الحياة الرتيبة، المؤلمة، البئيسة، ولذلك كان التقابل بين الثنائيين لافتا للأنظار والاهتمام في نص المسرحية، فقط يختلف الثنائيان في الأسلوب الموظف لممارسة طقوس الهجرة السرية، ففي اللحظة التي نجد فيها أن الثنائي صاحب البشرة السوداء يأخذ أكثر بالأسباب الموضوعية، ويعتبر أن مسألة عبور البحر والانتقال إلى الضفة الأخرى تتطلب استعدادا لوجيستيا ولو كان متواضعا، ويعتبر بأن الأمر جلل، ويحتاج إلى تخطيط مسبق، يتعامل الثنائي الأبيض مع المسألة بقليل من الحذر، وبكثير من التهور، والتسرع، والاستعجال، وبرغبة كبيرة في ركوب المغامرة في أسرع وقت ممكن.
الفصل الثالث: انتظار على الرصيف
ينفتح مشهد هذا الفصل على الإفريقيين ” مامادو وسامبو ” حيث يتواجدان بأحد بحدبإحدى أرصفة المدينة، وهما ينتظران امرأتين تتسولان قرب إشارة مرور ضوئية، ويدخلان في سجال مبعثر حول السياسة، والجدوى من الوجود، وينتقدان وضع الدول التي تضع بينها حدودا مصطنعة منتهكة بذلك القوانين الطبيعية، ثم يعودان مرة أخرى لإثارة الحديث حول الثنائي صاحب البشرة البيضاء ” قاسم وعباس ” اللذين أسهما معهما بجهد كبير في عملية ترميم القارب المتهالك، وتوجها مسرعين إلى الميناء التجاري لتحين فرصة التسلل داخل إحدى الشاحنات المعدة للعبور إلى الضفة الأخرى. في هذا المشهد سوف تظهر ” أمينتو ” بالإضافة إلى ” أومو “، وسوف نعرف أنهما عشيقتان للإفريقيين، إحداهما مرضعة، والأخرى حامل، وهما تقومان بالتسول في المدينة من أجل كسب المال اللازم لمستلزمات المعيشة، ويشرف كل من ” مامادو وسامبو ” على تسخيرهما لهذا النوع من النشاط المعيشي.
من الملاحظ أن السجال الفكري الذي أنجزه المبدع المسرحي على لسان الثنائي الإفريقي كان سجالا يرقى إلى درجة نقاش منظم، مضبوط، مستواه ليس بالعادي والبسيط، وهنا يبدو أن المبدع آثر أن يعمل على إضافة دسم ثقيل إلى مسرحيته لما قام بالصعود بالإفريقيين إلى مستوى رفيع لا يبدو أن أحدهما يمتلكه، فهما عندما يناقشان مسألة الحدود المصطنعة بين الدول، وأهمية الحدود الرمزية، وطبيعة الوجود الإنساني مع مقارنتها بطبيعة الوجود الحيواني، ومسألة الهوية، ومواضيع أخرى ذات أبعاد فكرية، وسياسية، وفلسفية، ووجودية، فهذا يدل على أنهما يمتلكان ثقافة متميزة، ومعرفة عميقة بتدبير الأفكار، وتنظيمها، وترتيبها، والحال أنهما يظلان من ضحايا الفقر، والجهل، والأمية ، والحرمان، ويبقيان أبعد ما يكون عن ولوج هذا المسلك الصعب من النقاش المنصب حول قضايا حيوية، وحاسمة. والواضح لقارئ المسرحية، أو لمشاهدها فوق الخشبة هو طغيان وعلو صوت المؤلف المبدع المسرحي على صوت الشابين الإفريقيين، ولذلك أجرى هذا النوع من الحديث الجدي عالي المستوى بينهما فقط لكي يقوم بتمرير تصورات كان يراها لصيقة بثقافة الهجرة، وضرورتها، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأفكار يمكن طرحها والاشتغال عليها انطلاقا من الضرورة التي تفرضها منظومة ” حقوق الإنسان ” التي تلغي الحدود الجغرافية، والسياسية، وجميع الاعتبارات، ولا تحتفظ إلا بالتصورات والقواعد التي تدخل في مجال الحفاظ على الكيان الإنساني بغض النظر عن انتمائه، ودينه، وثقافته، وإثنيته، وبلده… ورغم ذلك يبقى الأساسي هو النظر إلى سلوك الإفريقيين وغيرهما من المهاجرين السريين في حدود ثقافة الهجرة في حدودها الدنيا التي تناقش أبسط شؤون إمكانية القيام بترتيب رحلة الهجرة، والعبور إلى الضفة الأخرى.
الفصل الرابع: حوار على الرصيف
يحتفظ المبدع المسرحي بنفس المشهد السابق، إذ يبدو الرصيف الذي كان يوجد به المهاجران سابقا، ويظهر في المشهد كل من الرجلين، والمرأتين، ويحمل ” مامادو ” رضيع المرأة الشابة ” أومو ” متعهدا إياه بالرعاية، وتعترف المرأتان بأنهما كسبتا مالا كافيا للعيش، ممنوحا من كرم الناس وعطفهم اللذين يحيطان بهما المهاجرين السريين، وتثير ” أومو ” حديثا له قيمة بالغة عندما تطرح فكرة إمكانية استقرارها في نفس البلد، وتجنبها الهجرة الخطيرة عليها وعلى ابنها، وتعتزم طلب مساعدة الجمعيات التي ترعى شؤون الأمهات العازبات، ورحبت ” أمينتو ” بنفس الفكرة . وتحدث الأربعة عن كيفية التفكير في الاستقرار في البلد المضيف لهم مع أن أبناءه هم بدورهم يسارعون إلى ركوب نفس المخاطر، بالعبور إلى الضفة الأخرى عن طريق الهجرة السرية، كما تحدثوا عن العصابات التي تمارس الاتجار في البشر وآلامهم، بالإضافة إلى مقارنتهم بين أوضاعهم وأوضاع أهل بلد العبور…
الهجرة التي أتقن المبدع وصف تجلياتها عبر الحركية التي تميز شخوص المسرحية تعتبر هجرة متعددة، هجرة بالجملة، فهي لا تقتصر على الرجال، بل تشمل حتى النساء، وكذلك الأطفال الرضع، والحوامل هن أيضا موجودات في المشهد العام للهجرة. الرجال الذين يهاجرون يعتبرون سواعد للإنتاج، تم هدرها من طرف البلدان المصدرة للهجرة، ثم النساء هن كذلك طالهن فعل الهجرة أو التهجير، بمعنى أن الدول المصدرة للهجرة لا تكترث بتاتا بمواردها البشرية، ويبدو أنها تعد تلك الموارد من الأعباء الزائدة التي تثقل كاهلها بمسؤوليات إضافية، والأفواه التي تهاجر تعتبرها تلك الدول أفواها مستهلكة لموارد اقتصادية منهكة بشتى أنواع التشتت. وتظل قضية الأطفال المهاجرين عالقة بجروح عميقة لا تندمل، منبثة بأجسام هذه الدول اللامبالية بأبنائها، هؤلاء الأطفال يظلون ضمن مجال الإضافات غير المطلوبة، وغير المرغوب فيها، ويتم إصدار أحكام مسبقة على مصيرها بكونها عبارة عن هوامش منبوذة لا قيمة لها.
ولا يغفل المبدع المسرحي من اهتمامه الإشارة إلى ما يصطلح عليه بهجرة الأدمغة، ويظهر للعيان أن الهجرة السرية من أجل البحث عن حياة جديدة، يمكن أن تكون كريمة، ويحتمل أن توفر العيش المقبول، والاستقرار، والأمن، وهي بذلك لا تختلف عن مثيلتها هجرة الأدمغة، لأن الأمر في النتيجة والهدف يبقى واحدا، إذ كل من المهاجرين من هذا الطرف أو ذاك يوصف بأنه مهاجر، أي مفارق لبلده الأصلي، ومتجه لبلد آخر، أجنبي، وغريب، ولكنه يمكن أن يقبل احتضان المهاجرين من كل نوع، رغم الاختلاف والتباين بين الدول في قبول الهجرة، وإدماج طالبيها، لأن الأصل هو أن البلدان المصدرة للهجرة تضيق جنباتها بصاحب الدماغ اللامع، وبصاحب المعدة الفارغة، وفي بلاد المهجر يكفي أن يحصل كل واحد من النوعين على موطئ قدم، ولا يهم بعد ذلك أن نميز بين العالم، والمثقف، والبسيط، والعادي، يكفي أن يستعيد الواحد إنسانيته لكي يستكين إلى واقعه الجديد.
الفصل الخامس: رقصات.. على إيقاع الطبل
في هذا الفصل يعود المبدع بشخوصه المسرحية من المدينة حيث الرصيف الذي يقتاتون من هوامشه عن طريق التسول إلى ملاذهم الأصلي الذي يهجعون فيه جميعا داخل أكواخهم البئيسة المتهالكة، فنلفي نفس المشهد الذي يوجد به قارب الأحلام، والزمن صباح باكر، ويستمتع الجميع بقرع طبل بيد ” سامبو ” على نغمات إفريقية مع غناء وضحك وانشراح، ويبدو أنهم جميعا في حالة نشوة ناتجة عن مظاهر سكر وعربدة، فأدى بهم الأمر إلى رقص جماعي يتميز برقص إفريقي صادر عن شريط بخلفية الركح. توقف الرقص، والضرب على الطبل، وشرع الجميع في التعبير عن ابتهاجه باللحظة التي قضوها في اللهو والغناء، والتي خففت عنهم وطأة الواقع القاسي الذي يعيشونه، وتزيد القسوة والمرارة بسبب الاحتكاك المزعج والمستمر بين ” سامبو ” والمرأة ” أومو “، مما دفع المرأة للحديث عن مضايقات، واعتداءات، وتحرشات، واغتصابات، تتم ضد النساء أثناء الرحلة من بلد الهجرة إلى بلد العبور، ويستمر نفس الوضع كذلك أثناء الاستقرار في مخيمات الهجرة ببلاد العبور.
تقول ” أومو “في الصفحة 48 – 49: ” يبدو أن الفردوس المنشود وهم، لا يوجد إلا بخيالنا.. كان أجدر أن نبحث عن فردوس أكثر واقعية في دواخلنا وفي تفاصيل أدغالنا وصحارينا… الظاهر أن الهجرة لم تكن من أوطاننا، بل من ذواتنا، من كرامتنا وهويتنا. ندوب التجربة غيرت ملامحنا.. نفوسنا.. غيرت طباعنا.. حولتنا إلى غرباء عن كينونتنا “. يعود مفهوم ” الهوية ” لكي يسجل حضوره من جديد بين رفاق الهجرة نساء ورجالا، حيث يعمل المبدع المسرحي على ابتداع واحد من الشخوص المسرحية الجديدة الأخرى سماها ” الآخر ” ودفع بها بين المهاجرين لكي يعمق أكثر جراح الحديث والبحث عن الهوية، هذا ” الآخر ” يتوفر على وجود لامسرحي، فهو كيان غائب لا يسهم في أي من الأنشطة، أو الحوارات، أو العلاقات التي تدور داخل المسرحية، فهو محض تخييل ساعد المبدع المسرحي رفاق الهجرة على ابتداعه من أجل الدخول معه في حوار يتميز بالخواء، واللامعنى، واللاجدوى، فوجوده المعدوم وغير الموجود يسمح فقط ” لأومو ” وغيرها أن يخاطبوه دون رجع للصدى، فهو يسكن فقط في لاوعي الذين يخاطبونه، ويكفل لهم بوجوده في العدم إمكانية تحريك الراكد في عقولهم المنهكة من أجل التساؤل عن عبثية الحياة، والواقع، والهجرة، فواقع الهجرة السرية يظل محاطا دائما كما قلنا سابقا بسياج متين من خطابي الحظر، والمنع.
الفصل السادس: عناق خلف السحاب
يفتتح المبدع المسرحي هذا الفصل بمشهد يبدو فيه الفضاء قريبا من البحر وبجوانبه، يستمر ظهور قارب الأحلام المتهالك، مع صوت للموج مؤثث للأجواء، يحاول الإفريقيان بكل جهد إتمام إصلاح القارب، يقدم لهما يد المساعدة ” قاسم ” الذي يوجد الآن بقربهما وهو يجر أذيال الخيبة بعد أن داخله الخوف من الهجرة داخل الشاحنات، ويتحسر على تراجعه في آخر لحظة، بينما استمر الفتى ” عباس ” في مشروعه واستطاع أن يتسلل داخل شاحنة، وبعد ذلك انقطعت أخباره، وشرع ” مامادو وسامبو ” في لوم ” قاسم ” على تراجعه عن قراره، ثم عمل الشابان الإفريقيان على تجهيز القارب للإبحار وركباه بمساعدة قاسم وشرعا في الغناء بفرح وحبور، يتابعهما ” قاسم ” بنظراته ملوحا لهما بيديه مودعا ومشجعا، وهو يتراجع إلى الوراء ويندس بين الجمهور، في حركة مسرحية دالة على عودة الفتى إلى الصواب، وجادة الطريق الطبيعي، وعزم على استعادة الموقع بين الأهل في البلد الأصلي.
يحتفظ المبدع المسرحي في خضم كل علامات اليأس والإحباط بعناصر مضيئة من الأمل في وجود فكر تنويري يقابل فكر الهجرة السرية المقلق، بمعنى فكر الحياة مقابل فكر الموت، حيث عندما يتراجع إنسان عن قرار الهجرة ويعود إلى رشده، ويستفيد من توجيهات ونصائح نشطاء حقوق الإنسان في التحذير من سلبيات الهجرة السرية فإن هذا يدل على أن الوعي الإنساني لم يفقد صوابه تماما، بل ما زال هناك من يلتفت حواليه، ويمعن النظر في الأشياء، ويفكر بعمق، ويستبطن دواخله، ويصل إلى نتيجة إيجابية تثبت خطأ القرارات المعتمدة من طرف كثير من البؤساء في الارتماء داخل المجهول، فيعود إلى رشده، ويلغي من اعتباره موضوع الهجرة السرية، ويشرع في الإعداد لترتيب حياته في بلده الأصلي. ويثبت المبدع المسرحي الأمر عن طريق رسم طريق مجهول، ومسار غير واضح لانطلاق الإفريقيين بقارب متهالك داخل بحر جبار بأمواجه، ورياحه، ورعده وبرقه، بمعنى أن الهجرة بهذا الشكل هي فقط سراب لا وضوح في رحابه، بالإضافة إلى أن بلد المهجر ضاقت جنباتها بالمهاجرين، ولم تعد لديها أي فرص تقدمها لهم من أجل ضمان كرامتهم بواسطة وسائل العيش الكريم، فهم يظلون عالة في الديار الأوروبية، بدون عمل، ولا هوية، فيسقطون بسرعة ضحايا الانحراف، والإجرام، والتسكع غير المجدي.
ومن أجل تأكيد هذا المعنى يختم المبدع مسرحيته بأغنية محلية فيها دفء، وراحة، وأمل، واحتضان، وتعبير عن عمق الانتماء، والحب للبلد الأصلي:
يا وليدي.. يا حبيبي..
رد بالك هذي بلادك را أنت محسود عليها
حبك لبلادك أمانة عليك
ربي عليها أكبادك كيف ربيتو فيك
يا وليدي يا حبيبي
رد بالك هذي بلادك را أنت محسود عليها
ابنيها وعليها تعطيك كثير
ابنيها وعليها تعطيك كثير
يا وليدي يا حبيبي
لا يغفل المبدع المسرحي وهو يعالج في نصه موضوع الهجرة السرية عبر استحضار الأفارقة المهاجرين السريين الذين يقتحمون دول شمال إفريقيا من أجل اتخاذها مراكز للعبور لأوروبا التأكيد والتنصيص على المعطيات التقنية المرتبطة بالإخراج المسرحي، واللعب فوق الركح، ولذلك فهو في كل مرة يشير إلى طبيعة الديكور، والأجواء في مختلف المشاهد والفصول، ويقوم بتقديم وصف مفصل، دقيق لجنبات الركح في جانبه الأيسر، وجانبه الأيمن، ووسطه، مع عدم نسيان تقديم مختلف التفاصيل الأساسية للتعبير، بتسليط الأضواء القوية أو الباهتة حسب المطلوب في المشهد، والمستهدف من المشاعر حزنا كانت، أو فرحا، أو انتصارا، أو انكسارا. ويوجه القارئ بين الحين والآخر بتفسيرات إضافية يضعها بين قوسين تسهم لديه في مزيد من بيان، وتوضيح ما لم يفهم من الحوار بين الشخوص، أو ما لم يرد قوله وتوضيحه على لسانهم في حواراتهم، ويقف بدقة عند توضيح علامات الزمن، وتغيره، فيشير إلى ضوء النهار، وحلكة الليل… وقد عمل المبدع المسرحي كذلك على تأثيث نصه المسرحي بتوظيف مقاطع موسيقية تعمل على تأجيج مشاعر المشاهد والمتتبع، وتقحمه بسلاسة في عمق المشاهد المتنوعة، ويعمل المبدع على إسناد هذا النوع من المصاحبة الموسيقية بإسقاطات كثيرة من الصور التي تزيد في إغناء الديكور، فهو تارة يستعمل إسقاطا لصور أو أشرطة لقرية إفريقية بسيطة، ثم يعود لتقديم خلفية صوتية مرتفعة أو منخفضة لأمواج البحر، ويشتغل بعناصر الإنارة التي يظهرها ويخفيها، ثم يعود إلى بسط عناصر الظلام أو الإظلام، ويعمل على المزج بين المؤثرات السمعية والبصرية لإخفاء بعض التفاصيل، وإظهار بعضها الآخر، ويمزج بين الصمت الجماعي والفردي، وبين الصخب الجماعي والفردي… ولا ينسى المبدع الإشارة إلى ضرورة الاستعانة بالكومبارس لضبط بعض المشاهد والمقاطع… كل هذا يدل على أن ” الطيب الوزاني ” كان يعرف جيدا الأرضية التي يقف عليها، ويشتغل بها، إذ كان يكتب نصه المسرحي بصيغة يمزج فيها بين تجربة غنية بالأفكار والآراء المرتبطة بموضوع الهجرة من جميع جوانبها، وحنكة وصنعة تقمص دور المخرج المسرحي الذي يعرف جيدا وبدقة المتطلبات التقنية للكتابة المسرحية، ولذلك كانت مسرحيته هذه موضوعا لتنويه كثير من المسرحيين، وإضافة نوعية للنصوص المسرحية العربية الجادة.