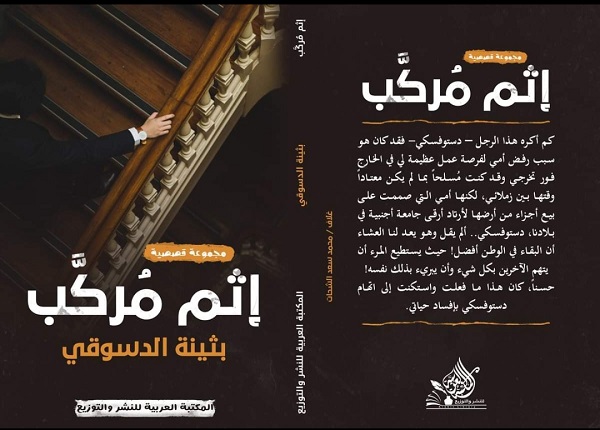لا أدرى هل ما أسمعه صرخات فزع أم بهجة، هناك صراخات كثيرة حولى، لا أعرف طبيعتها، هدفها، لا أميز غير صرختى، ولا أعرف غير أننى أصرخ فعلًا، وأننى خائفة ومضطربة وفاقدة لاتزانى، حامض مر يصعد من معدتى مع كل هذه الشقلبات الجديدة، لا يبدو جسدى فى حالة اتزان، يتلقى ضربات من كل اتجاه، صفعات خفيفة، تبدو مرحة لكنها تترك بصمامتها على جلدى. رضوض متدرجة الألوان بين الأصفر والأزرق والبنفسجى الغامق. بدأت الملاحظات الناقرة مبكرة.. ربما فى ليلتى الأولى بعد أن وصلنا لشقتنا.
– ما هذه الأطباق؟
أنزلت حماتى كل الأطباق التى خصصتها للاستخدام اليومى. وصعدت لشقتها وأوضعت مكانها ستة أطباق بيركس عسلية اللون، فى هذه اللحظة ابتسم لى:
– نحن لا نأكل فى الأطباق الملامين.
كانت أسنانه ناصعة البياض، تبرق بشكل مبالغ فيه، وكان بريقها صاعقة ألجمتنى، فلم أتكلم، ولم أدافع عن اختياراتى، بل شعرت بالخزى.. بالتواضع.. وازداد فارق الطول بيننا، وغطانى ظله على الحائط المرسوم على المطبخ الخشبى.. وكانت بداية الشك والتسفيه لكل ما أقوله وأفعله.. وعرفت معنى توزيع الأدوار.. هناك من يباغتنى أو يهاجمنى منهم.. قد تكون والدته رأس الحربة أو هو أو والده.. يتبادلون الأدوار.. بحيث لا يزيد الضغط حتى يصل إلى الانفجار، الدائرة دائمة، مغلقة، محكمة.. ودائمة أنا.. سرحانة، مشوشة، لم أركز، فهمى بطىء، لا أنفذ المطلوب تمامًا. أفعل كل شىء إلا كثيرًا، لا شىء تمام، لا شىء مما أفعله يرتقى للمستوى المتوقع.. تصدير الإحساس الدائم بالخسارة، وأننى دون المستوى ودون التوقعات.. وبكل استسلام تشوهت صورتى لدىّ.. كنت كطفل يزرعون فيه الإحباط وعدم الثقة.. كما لو أننى فى معسكرات تعذيب.. وفى جهاز مخابرات.. لم يكونوا فى حاجة لاعترافات منى.. كان كل شىء فى حياتى واضحًا وصريحًا.. حكيته له عندما التقينا.. وكل ما كنت أرويه بصدق وعفوية كان يؤخذ ضدى.. يوظف للاستشهاد على صحة موقفهم ونظرتهم الدونية لى.
لم تكن هناك مقدمات أو مواعيد منضبطة لجلسات التقويم النفسى التى أتلقاها، لم يكن هناك نظام أو ترتيب معين للخناقات.. فجأة يتصاعد صراخ من فم أحدهم، وفجأة تهدأ العاصفة، وتسترد وجوههم راحة مقبضة، ويتلقى جلدى ابتسامات، وبريق أسنان وكلمات.. «يا حبيبتى، خدى بالك، إحنا عارفين إنك مش هتعملى كده تانى، اعمليلنا بقى كوبايتين شاى.. فين علبة البتيفور؟»، كنت أرتجف، داخليًا وخارجيًا، كانت يدى تهتز، وكنت أنسحب للمطبخ، أو أظل جالسة فى مكانى، تنهمر الدموع منى، على نفس الكرسى، ولا أحد يرانى، كأنه لم يحدث شىء، فى كثير من المرات كنت أبكى حتى أتعب من البكاء وأصمت وحدى، دون اعتذار أو طبطبة، هذا الدلع أو الدلال الذى يجعل البعض يبكى كى يتعاطف معه المحيطون به أو يشفقوا عليه، رفاهية لم تكن متاحة لى، لم يكن صوت نشيجى يفسد عليهم متعة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك أو مصارعة المحترفين، أو فيلم محمد سعد الجديد.
ولم يكن يحلو له أن ينام معى.. إلا بعد هذه المشادات وجلسات التعذيب.. فى أول الأمر كنت أدافع عن نفسى، وأشترك بجدية فى دائرتهم، أحاول أن أدافع عن موقفى.. أوضح وجهة نظرى.. لكن بعد موقف، اثنين.. ثلاثة.. عشرة.. انسحبت من الدائرة وجدتهم لا يسمعون.. مهما قلت لا يسمعون.. كأنهم محطة بث إذاعى لا يوقفها غير فصل الكهرباء، وكانت طاقاتهم لا تنفد وقدرتهم على الجدل لا تنتهى.. بدوا ككائنات فضائية.. مضبوطة على تردد معين.. وكنت أستنزف طاقتى، أعصابى وصوتى، وأنجر معهم لمستنقع تغوص قدماى فيه.. لكسر الدائرة الكهربية.. لم يكن صمتى كافيًا لفصل الدائرة، لقطع التيار.. كان وجودى ذاته هو المكمل للدائرة الجهنمية، لم يكن هناك من حل غير أن أفتح الباب وأخرج، لكنى لم أفعل.