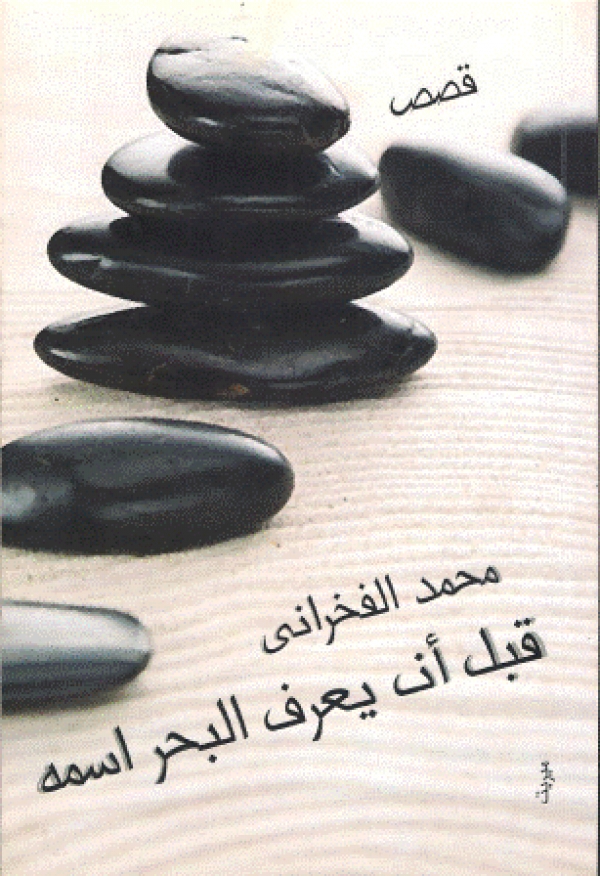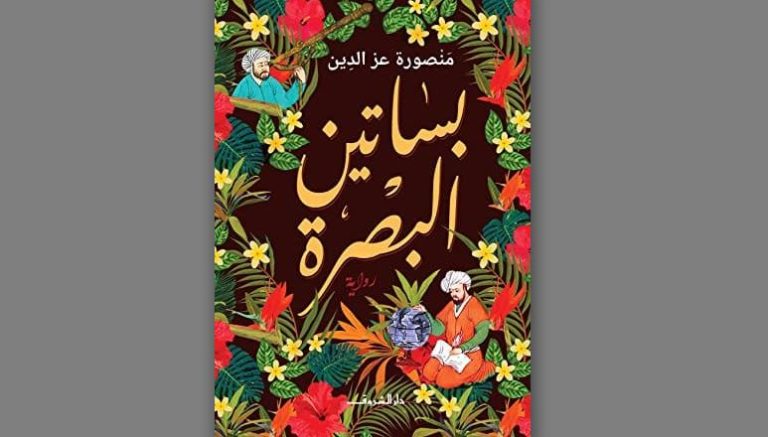د. أشرف الصباغ
يتخلى الكاتب فؤاد مرسي عن السرد التشيخوفي التقليدي الذي يدهش الكُتَّاب والقراء المبتدئين، ليورطنا في الجوهر التشيخوفي للكتابة، في “الحالة التشيخوفية” التي تشبه “الصمت التشيخوفي” أو “السكتة التشيخوفية” في الدراما، أو الهمس التشيخوفي الذي يشبه النصل الحاد للمشرط. كل شيء هادئ في العالم التشيخوفي: في السرد والدراما. وكل شيء هادئ وسلس تمامًا عند فؤاد مرسي، لدرجة أن القارئ لا يشعر بأنه أنهى العمل المكوَّن من (93 صفحة)، في 3 أجزاء، لا أكثر. لكن المفاجأة أن نهاية العمل هي بداية الشعور بالوجع، وبطنين الوعي، وبالدهشة المشوبة، ربما بالخجل، وربما بالمكابرة والتمترس خلف حلم كاذب بدلًا من الاعتراف بالفشل والسقوط.
بين الـ “هُنا” والـ “هُناك” يراوح بطل الرواية “الأستاذ عبد المجيد رسلان”، ليذكرنا في كل لحظة بالأفخاخ التي نُصِبَت لنا أكثر من مرة، ووقعنا فيها، ولا نزال نقع فيها، كأننا لا نملك ذاكرة. وبين الهُنا والهُناك نسير مع سرد الراوي تارة، ومع حكي عبد المجيد تارة أخرى، لنكتشف من زاوية هادئة للغاية تفاصيل حياة قطاعات مختلفة من المصريين، سواء في ميدان التحرير أو في المدن النائية عن القاهرة ذاتها، خلال الأيام الأولى لأحداث 25 يناير 2011 حتى بيان التنحي في 11 فبراير من نفس العام. إننا محاصرون بالسرد والحكي عبر الراوي والبطل وعبر رسائل طلبة وعبد المجيد، ورسائل طلبة وصنع الله. نرى الناس في سيارة الأجرة، وفي “اللجان الثورية” التي تحرس مداخل ومخارج الأحياء والمناطق والمدن، تلك اللجان التي تشبه قطاع الطرق، وماذا يجري في الشارع، وفي المرافق العامة ومواقع تقديم الخدمات.. نسير في هدوء تشيخوفي كامل، مرعب وثقيل، لنستطلع أحوال النساء، وتصرفات الرجال، ونشاهد نفس أنماط حياتنا، وإعلانات أغطية الرأس تحت عنوان “ست البنات”، والتناقضات الصارخة في سلوكيات الناس التي تتأرجح بين الملائكية وبين الشر المطلق.. كل ذلك في ومضات سردية مذهلة ومدهشة تحتاج إلى قراءة- بل قراءات- متأنية.
هذا العالم الهادئ، البعيد تماما عن الصخب والزعيق، يصنع مقطعًا عرضيًّا من الحياة مدجج بمسامير ناتئة لا تسمح بالسير بسهولة على سطحه. في كل خطوة، هناك مسمار ينخر القدم أو القلب أو العقل، يذكرنا بالفخ الكبير الأخير المؤلم الذي يشبه عشرات ومئات الأفخاخ التي وقعنا فيها، ولم ننتبه أبدًا. هل أننا لا ننتبه فعلًا، أم أننا لا نريد دفع ثمن موجع ومؤلم الحلم؟
معظم الأفخاخ السابقة- إن لم تكن كلها- كانت متمحورة حول فكرة “النجاة الفردية”. وفي الفخ الأخير، لم تفلح “النجاة الفردية” في تحقيق أي حلم، بل حولت الحلم إلى كابوس. كل ذلك يسير أمامنا كشريط سينمائي عبر تحركات عبد المجيد رسلان وركاب السيارة من مكان الإقامة (أي مكان على أرض مصر) إلى ميدان التحرير (كعبة الحرية والخلاص والنور) في الأيام التي سبقت تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم إلى أن يأتي خبر التنحي على لسان شخص عابر. نحن هنا لسنا بصدد شرح قوانين الثورة، ولا استعراض الحشود من جهة، ولا الهتافات السردية المضادة للفن من جهة أخرى، بل بصدد سرد يتميز بهدوء قاتل ومرعب، وفي الوقت نفسه مفعم بالقلق والتوتر، وبصدد أمراض مختلفة تصيب البطل، وأوهام وتهيؤات ومخاوف تحيط به وتحاصر عقله ووعيه، وتجعله- ربما- يعيد اكتشاف نفسه من جديد بعد أن مر قطار العمر وتأخر الوقت كثيرًا. وخلف هذا الهدوء أو تحته، وفي عمق كل هذه الأمراض والمخاوف، تمور الروح بالقلق والرعب والحركة والعنف.
من الطبيعي أن يؤدي فشل الثورة، في تحقيق نتائج مباشرة، ليس فقط إلى الإحباط، بل وأيضا إلى “الانتحار”: انتحار الشباب الذي تم وأد حلمهم. إنها نتيجة مباشرة وحاسمة وصارمة للغاية تعكس مدى الألم الناجم عن الفشل: ذلك الفشل المتكرر، والأفخاخ المتكررة. إن رسائل عبد المجيد رسلان وصديقه طلبة (الأجيال القديمة) تهمس بالكثير عن الأوضاع النفسية للشخصيتين وتذهب إلى وضع كل منهما في عمله وفي حياته، تحيطنا من بعيد بحركة المجتمع بشكل ناعم وهادئ من دون أي صخب أو مبالغات فنية أو واقعية أو درامية، وفي الوقت ذاته توضح حالة كل منهما، وحالة المحيطين بهما، وجانبًا من حياتهما السابقة، والنزوع الفردي لدى الناس حتى وإن كان مغلَّفًا بالقلق والرغبة في الخلاص، بينما رسائل صنع الله رضا الهادي وطلبة تنتزعنا من الواقع وتُحَلِّق بنا في فضاء آخر مواز من أجل تعميق الألم: ألم التأخر ثلاثين عاما، وكأننا لا نتعلم، ولا نريد أن نتعلم.
في رسائل طلبة وصنع الله نتورط في علاقة بين رجل وامرأة، بعيدًا عن الرموز والترميزات، وعن الإسقاطات الساذجة. إننا ببساطة أمام حالتين إنسانيتين لرجل وامرأة لم يتبق لديهما سوى حلم الشباب الذي لم يتحقق رغم تكرار المحاولات التي لم تكن إلا أفخاخَ ومصائدَ: أمام مراوغات أبعد عن المكر، وأقرب إلى استشراف الواقع. ففي الصفحتين (80 و81) نكتشف الخدعة، وندرك أننا أمام وهم، وصلنا إليه عن طريق كابوس. وبالتالي، من الطبيعي أن يصاب عبد المجيد رسلان بأمراض القلب، ويتعرض لحوادث، ويعيش كوابيس وأوهامًا.. ومن الطبيعي أيضا أن ينتحر الشباب. هذا هو الواقع الذي لا يستطيع أي فن في العالم أن يجمله، أو يمنحه رخصة بالحلم أو بالأمل. لا حلم ولا أمل في ظل هذا الواقع الرديء والمزرى، سيموتان ببساطة وبدون أي رحمة أو شفقة مثلما يموت الشباب.
إن تجميل الواقع، وتمجيد القبح، وزرع الآمال الكاذبة، وصناعة الصور الذهنية المزيفة، ليست إطلاقًا من بين وظائف الأدب. ولذلك كان من الطبيعي أن يموت الشاب، حتى لو كان طيفًا، أو حلمًا، أو شبحًا، أو حتى انعكاسًا لذات ما فردية. وهذا ليس فقط تجسيدًا للواقع، بل وأيضا تماشيًا مع العقل والمنطق. فالأفخاخ المتشابهة، المتكررة، لا يمكن أن تسفر عن نتائج مختلفة!
في هذه الرواية القصيرة، التي تمثل ومضة “تاريخية” من حياة مجتمع يتأرجح بين اليقظة والنوم، بين المرض والوهم بالصحة، بين الاستكانة والحلول الفردية وبين الكذب والخداع والتوحش، نتعرض لاختبارات نفسية شتى، وأفخاخ لا تقل حدة وخطورة عن الأفخاخ التي عاشها أبطال الرواية في شبابهم وكهولتهم وشيخوختهم. نعيد النظر في أوهامنا وهلوساتنا عن الثورة، وعن الأثمان الفادحة التي يجب أن تُدْفَع من أجل تحقيق ولو حتى بعض شروطها، والأثمان الأخرى للحفاظ على ما تحقق. والأهم من ذلك هو الاستعداد لدفع تلك الأثمان، والوعي بها وبأهميتها.