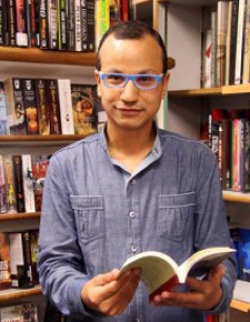من الواضح أن هذه رواية موضوع بامتياز، تكاد تتطابق لغتها في بعض الفقرات مع لغة البحث والتحقيق الصحفي، وإن لم تخلُ كذلك من مستوى شعري بدائي إلى جانب حرص على وصف الأشخاص والأماكن بولع زائد عن الحد. المركز الذي ينطلق منه كل شيء هو بهاء، في حالة صارخة من كتابة الذات ومحاولة اكتشافها، خاصةً في الأجزاء التي يروي فيها حكايته بنفسه، وهي أغلب أجزاء الرواية؛ نشعر أنه في معركة على الدوام سعياً وراء الحقيقة، الإجابات، الحلول القصوى النهائية لكل مشكلاته، بدايةً من ميوله المثلية التي لم يتصالح معها أبداً، وربما انتهاءً بمشكلة العدالة والكرامة الإنسانية. يفيض بهاء بالحكايات الكثيرة الصغيرة من هنا وهناك، متتبعاً مراحل تطوره من الطفولة للرجولة بتأني وتمهل وتفصيل، كأنه بالحكي فقط سيفهم، سيكشف السر، سيعرف ما الذي أدى به إلى هذا الموضع. ولولا قصة حبه وزواجه بشوق، لأمكن أن تمضي الرواية بكاملها متنقلة بين الأحداث الهامشية والفرعية بغير هدف ولا سياق. غير أن استقصاء كل شيء حولنا حتى نهاية مداه هو طموحٌ مستحيل، علاوةً على أن درجة الجدية والجهامة التي تُطرح بها الحكايات والقضايا بلغت حداً في بعض المواضع كاد يقلب التراجيديا إلى كوميديا ولو سوداء.
من الصحفات الأولى للرواية سيغرق القاريء في عالمها بلا صعوبة، بما أن مسائل التقنية والشكل غير حاضرة ولن تعوقه عن تتبع حياة بهاء وأسرته وأصدقائه، والمحيطين به التي تُقدَّم مباشرةً بلا حواجز. يمكن للقاريء أن يتبع الخيط، ولو على سبيل الفضول أو بنازع التلصص، وسوف يفاجئه الراوي رغم هذا في بعض المواضع بمشاهد حُلمية (قد تكون كابوسية أحياناً) مكتوبة برهافة حس ولغة أنيقة؛ فلا يمكن نسيان مشهد بحث بهاء عن صديقه ناجي في قرية مجهولة حولها المطر الغزير إلى مستنقعٍ مُرعب، هو أقرب تمثيل لحياة بهاء نفسها. ونعود لنكرر إن فيض الحكايات والمشاهد والحوارات قد أخفى تلك اللحظات المشحونة والمكثفة وكاد يبتلعها تماماً بداخله. ولعلّ هذا الكرنفال الواسع من الشخصيات والحكايات جاء عفواً وبغير قصد، ربما لأن الرواية كانت تكتشف نفسها وهي تتقدم بلا بوصلة، تريد أن تقول كل شيء خشية أن تفقد ذلك الشيء الجوهري، تلك العلامة الثمينة التي يمكنها أن تنير كل ما حولها فجأة وببساطة، لهذا كان من الممكن أن تقترب صفحات الرواية من 300 صفحة من قطع كبير نسبياً وبنط صغير، وكان يمكن أن تكون ضعف هذا الحجم أو نصفه، بما أن كل شيء يمكن أن يرد في تداعينا الحر حول أنفسنا وحياتنا وما جرى لنا بأدق تفاصيله.
في عبارة موحية، يتكلم بهاء عن هذه المذكرات – هذه الرواية بمعنى ما – قائلاً: “وقد استطعتُ كتابة هذه المذكرات دون خجل لأنني أكتب لنفسي وليس لأحد آخر”، وبقدر ما يمنح هذا حريةً شبه تامة لكاتب السطور، بقدر ما يبتعد به عن قصدية العمل الفني ومكر البناء وشجاعة الحذف. وإذا ما تناسينا قليلاً الهموم الجمالية للفن الروائي، سنجد أمامنا تجربة سردية من أشجع ما كُتب في السنوات الأخيرة، وخاصةً في تناول المثلية الجنسية، ورد الفعل عليها، سواءً من المثليين أنفسهم أو من المحيطين بهم، تكاد الرواية تكون مرجعاً في النماذج المثلية والقضايا القانونية الخاصة بهم وسُبل العلاج المفترض لهذا الميل. هل نحن بحاجة إلى هذه النوعية من الكتب، سردية أو غير سردية؟ تلك الكتب التي نتعرف بها على مناطق أو فئات أو حالات خاصة في المجتمع؟ هل من “العيب” استضافة هذه التجارب في عباءة الفن الروائي؟ أسئلة صار طرحها أمراً مُلحاً في السنوات القليلة الماضية، بعد أن صار طموح الرواية والروائي ينافس طموح الباحث الاجتماعي أو الناشط السياسي ويزاحمه على الكشف والتعرية والتوثيق والتحقيق.
إذا كان خليل أبو شادي في روايته الأولى بذل جهداً مضنياً ليرسم هذه الصورة البانورامية لمجتمع متفسخ، يشوّه أبناءه ويحرمهم كل فرصة لاكتشاف الذات والتصالح معها، فإن مهمته التالية لن تكون أسهل، حين يتوجب عليه أن يوثق علاقته بالنوع الروائي، بتاريخه وآلياته، حينها لن تكون الصدمة ناشئة عن كشف المستور وفضح تناقضات المجتمع بقدر ما ستنشأ كذلك عن الدهشة الصافية أمام حضور الجمال؛ جمال تنتزعه اللغة انتزاعاً من عالمنا المريض.
ـــــــــــــــــــــــــ
بريفيو:
رواية شوق
خليل أبو شادي
دار صفصافة