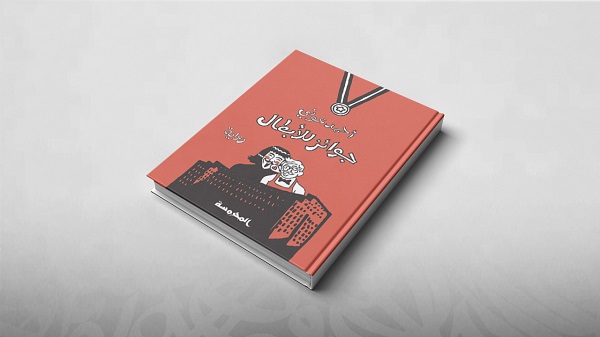محمد عبد النبي
ماذا لو استيقظَ شاب ثري ومدلل قليلًا ليجد نفسه وقد تحوَّل إلى ثائر مؤثّر، يقود ويقاد، يهاجم ويطارِد ويواجِه بطش السُلطة؟ ولنذهب إلى أبعد مِن هذا: ماذا لو استيقظ هذا الشاب ليجد نفسه وقد تحوَّل إلى أيقونة مِن أيقونات الثورة، أو إلى أحد الأبطال المختفين وشهداء الثورة المحتملين؟ ألا بدَّ أن تتغيَّر صورنا – لدى أنفسنا ولدى الآخرين – لكي نستحق البطولة والشهادة والفداء؟ ألا يكن لأشخاص عاديين ومرتبكين ومضطربين و(فيهم كل العِبر) أن يقدموا نموذج للتضحية والجسارة في لحظات بعينها دون أن يتحوَّلوا بالضرورة إلى ملائكة مجنَّحة بهالات نورانية حول رؤوسهم؟ هذه بعض أسئلة تسري بين سطور رواية أحمد عوني الأولى جوائز للأبطال الصادرة هذا العام عن دار المحروسة، عبرَ حكايات متوالدة من بعضها البعض تمض على مسارات متوازية ومتداخلة.
يستدعي عنوان الرواية عبارة كانت تتردد في أوبريت طويل للأطفال غنَّته ليلى نظمي في ثمانينات القرن الماضي من إنتاج التليفزيون، واشتهرت بعض عباراته مثل ملك الغابة يا ملك الغابة، والعبارة التي أقصدها هي آخر أجزاء الأوبريت التي تبدأ بتكرار عبارة: “جوايز للشطَّار، للشطَّار، للشطَّار”. هل يُقصَد هنا، ومنذ العنوان والغلاف بدرجةٍ ما، إضفاء طابع طِفلي على حُلم البطولة البرئ الذي يرواد شخصية الراوي، رامي مصطفى، أو كأنَّ الكاتب يضعه منذ البداية على جسرٍ ضيق بين بحرين يتبدلان، بين الطفولة والنضج، بين أوهام البطولة الملونة وحقائق الواقع المضجر، وبالطبع بين قناع فانديتا ووجه الخواجة كنتاكي، وهُما أوضح قطبين تنازعا صاحبنا، رامي، بينهما، على مدار سرد حكايته، وهما أيضًا معادل بصري واضح وقوي للخلفية الكبرى التي تدور أمامها أحداث الرواية، أي ثورة 25 يناير.
مِن ناحية نجد رامي، بطلنا مؤقتًا، غارقًا معظم الوقت في دلو قِطع دجاج كنتاكي ومستمتعًا بحياته الاستهلاكية الرخية منذ صِباه، ولا يؤرقه شيء إلا مسائل عائلية تبدو عادية وإن كانت لها بُعدها النَفسي المهم. من ناحية أخرى نراه منجذبًا للثورة والتمرد على الدور المرسوم له سلفًا، فيتورَّط في أحداث يناير مبدئيًا على سبيل سوء الفهم ثم من باب الفضول ومحاولة دَفع الضجر والتعرف على أشخاص جدد، ثم البحث عن دور حقيقي في قضية كبرى عادلة، ظلَّ يحلم بأن يختمها بصورة بطوليةٍ ما ولو رغم قدراته ولو بَلي عنق الظروف والسياق، حتَّى وإن اضطر للقفز إلى داخل (نعم داخل، وليس خارج) لوري شرطة يجمع المقبوض عليهم بالقرب من شارع محمد محمود في عز الاشتباكات، وهي لحظة أعتربها كاشفة بشدة عن ورطة رامي مصطفى النفسية، تلك اللهفة على المواجهة مع وجه البطش والرغبة في إنهاء مباراة ما بلا إبطاء أو مُراوغة.
ولعلَّ أكثر ما أثارَ اهتمامي في هذه الرواية هو طرحها غير المباشر لمفاهيم البطولة، في لحظةٍ استثنائية من تاريخ مصر، ومن خلال شخصية لم تتخمَّر بداخلها عناصر البطولة على مَهَلٍ ومع الأيام والنضالات، بل وجدت نفسها فجأة على خط النار، أي مثل الآلاف مِن الشباب غيره في حقيقة الأمر، سواء كانوا مُسَيسين قبل ذلك أم لا.
يقول رامي: “لم لا يتكثف كل شيء في لحظة واحدة أقبض فيها على الجمر، وأناضل وأتشجع وأعاني وأواجه وأتذوق الخطر وأموت من الرعب وأنجو بالقفز بين الرصاص، وأصاب وأتعافى وأُضرِب عن الطعام وأختار الصح وأدفع ثمنه؟ ثم تلهث الأيام من الجري، وتسير بمَهلٍ على زِمن من حرير، أجني فيه الثمار وأذكر الماضي بسَكينة المعتزِل. لا تهمني النتائج انتصرنا أم فشلنا، المهم أن أنتهي، ألا يبقى في شيء ليُطلَب، ستكون هذه أسعد الأيام، سواء بحصيلة المنتصر أو بذلك الاكتئاب الرقيق بعد اليقين من الفشل، لا يهم كم يؤلمني ظهري الآن، إن كنت أعرف أنه حين ينتهي الوجع، سيصبح جديرًا بالاحتفاء.”
فكأنه متعجلًا على إحراز هدف يحسم المباراة في الثواني الأخيرة، بل كأنه غير مكترث حتَّى لنتيجة المباراة بقدر ما يطلب نهايتها، بنفس الدافع الذي أدخله في المعمعة، وهو الضجر. كأنَّ رامي يتعجَّل الشيخوخة في الظاهر، يلح في طلب الخبرة والتجربة بأي ثمن، كأنه وجيله قد خسروا وقتًا طويلًا قبل أن تبدأ بشاير تجاربهم الشخصية في التكوّن لذلك لم يعد لديهم مزيد من الوقت ليضيع، لذلك فهم يريدون حتى هزيمة نهائية وواضحة لتشكيل حكاية لها رأس وذيل، لها مغزى ودرس مستفاد.
في مشهد اقتحام مبنى أمن الدولة، لا يجد رامي ملفًا له بطبيعة الحال لأن مستجد على كل هذا، فيقول: “… ذلك الشعور بالنقصان الذي ملأني، والناس تجد ملفاتها بين ركام الأوراق التي كانت متناثرة في كل مكان بالمبنى، أوسمة المحاربين القدامى، التي عاهدتُ نفسي ألَّا أفوّت فرصة الحصول عليها قبل أن ننتصر، أو ننهزم، بالكامل.”
المقصد إذن واضح، أن أمتلك وسامًا، بصرف النظر عن النصر أو الهزيمة، أن أنضم لصفوف المحاربين القدامى الراسخين على صدورنا يعيروننا بحكاياتهم وذكرياتهم ليلًا ونهارًا، من أي معسكر كانوا، فقط لأنهم مروا بالتجربة ولأنهم أكبر سنًا. رامي يبدو مثل ريتشارد قلب الأسد في أحد مشاهد الناصر صلاح الدين، سكران ومحبَط وضجر، لذلك فهو يريد البركة فورًا أو اللعنة فورًا.
لكن لماذا لا يطرح رامي النصر كخيارٍ وحيد، أو على الأقل كخيار أحب وأجمل؟ ربما لأنَّ: “في كل مرة لعبت، لعبت للفوز، إلا أني كنتُ أجد رومانسية الهزيمة أكثر بريقًا.” كأننا، في هذا الجزء التعيس من العالَم، ليس لدينا نماذج واضحة وقابلة للتصديق على النصر، الفردي أو الجماعي، كل ما لدينا حكايات الهزيمة وشجنها وأغانيها ورومانسيتها، وندوب الجراح التي يتباهى به المحاربون القدامى كأنها أوسمتهم الوحيدة. وفي نهاية الأمر، وكما قال رامي: “لم أعد أخشى الهزائم، بل أخشى أن أظل عالقًا بلا هزيمة ولا نصر،…”
إعجابي بكيفية طرح مثل تلك الأفكار والهواجس عبر السرد لا يمنع إحساسي بارتباك العَمل في بعض الأحيان، أو تحركه بتثاقل في نفس الموضع أحيانًا أخرى، وهي مسائل حرفية لا بد من الانتباه إليها، بنفس قدر الانتباه الموجَّه للحكاية والمفاهيم المحمَّلة بها. ولعلَّ ما أثقل إيقاع الرواية تلك الرغبة الغلَّابة في قول كل شيء والاعتراف بكل شيء، وفي هذا درجة من الشك في خيال وذكاء القارئ. ورغم كل ما يرويه رامي، من ناحية الكَم والحجم، يظل شيءٌ من التشوَّش مسيطرًا على بعض الخطوط المهمة حتَّى لا نكاد نستطيع أن نرى صورة صافية ومستقرة لهدير، الفتاة التي أفقدته عقله بدرجةٍ ما، بعيدًا عن التحيز أو الشبق أو التحامُل، فبدت طيفًا غائمًا يتسع لأن يكون كل شيء ولا شيء، رغم حلاوة وسلاسة المواقف التي جمعتهما وأتاحت للرواية بُعدًا عاطفيًا ناعمًا وسط تقلبات الثورة وإحباطاتها.
يبقى مع هذا أن نقطة القوة الحقيقية هنا تكمن في المصداقية، والمقاربة المباشرة والفجَّة للواقع كما يراه راوينا، بلا ذواق ولا زخارف ولا لف ولا دوران. فما من مساحات للخيال والشطح والفانتازيا خارج بعض أحلام وكوابيس تتكرر فيها تيمات بعينها ذات صلة بتكوين رامي، مثل فيلم تيتانيك ومشاهد الغرق. وإذا أتت صياغة بعض الجمل مرتبكة وملغزة في بعض الأحيان، فعلى المجمل أحسست بلغة طازجة وعارية من الزخارف الباطلة، تفتح صدرها لاحتضان التجربة كما هي، بأصواتها وصورها وشظاياها ونشازها وغازها المسيل للدموع وتوترها المفجر للضحكات والأحضان والقبلات.
في النهاية، أفضل ما اقترحته هذه الرواية هو ألَّا ننحصر عند تناولنا لأحداث كبرى وطاغية بين قطبين يتيمين، فإمَّا الحنين والبكاء على الأطلال وإضفاء نور القداسة المريض وإمَّا المراجعة الجذرية وجَلد الذات وإعلان الندم والتوبة، لأن كلا القطبين ينزع من تحت قدمي الفن بساطه السحري العزيز الغالي، ذلك البساط الذي يتيح للفن أن يطرح الأسئلة العصية والمتوارية والحرجة، التي قد يصمت عنها التاريخ أو الروايات الرسمية أو حتى كتب سير الثوار، يطرحها لا كعالِم أو ثائر أو فيلسوف، بل في براءة الأطفال الشطَّار الذين ينشدون جوائزهم الآن فورًا، وإن كانت قطعة دجاج كنتاكي أو قبلة مختلسة وسط الغاز والدموع.