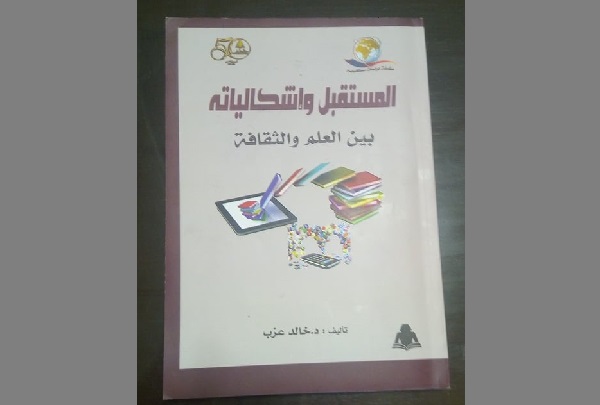آمال فلاح
“المطلوب رج الشعب قبل الاستعمال”
شارل موريس دي تالييراند (دبلوماسي فرنسي 1754 ـ 1838)
هل حدث الأمر فجأة، أم استغرق وقتا أكبر، لكي تنحرف فرنسا روسو وفولتير، بهذا الشكل، عن المبادئ التي من أجلها قامت بثورة صدرتها للعالم أجمع؟
لماذا، بعد طول إدانة “للحروب القذرة” والترفع عن الالتحاق برهط المتكالبين على الدول الضعيفة، يتورط مثقفو فرنسا في الدعاية لحروب “نظيفة” تحمل فيها الديمقراطية على فوهات الدبابات؟
كيف تحول مثقفو الغرب ـ بدعم من إعلام ذكي ـ إلى ركائز للمعارك العسكرية المتلاحقة؟ يبدو أن خرافة التدخل العسكري لأغراض إنسانية ما زالت صالحة وسارية المفعول، رغم توالي المآسي. أفزعتني هذه الحقيقة وهي تتكرر على لسان عراب الثورات العربية، الفيلسوف برنارد هنري ليفي، حين سئل عما شعر به، وقد تحطمت ليبيا بعد الغارات الجوية، فأجاب: “من المؤكد أننا أحسنا الصنع، فقد أسقطنا ديكتاتورا”.
زاد رعبي وأنا أشاهد ـ على القناة نفسها ـ الطبيب والوزير الاشتراكي السابق، برنارد كوشنير، يتشدق بلامبالاة، عن جدوى التدخل في يوغوسلافيا وكوسوفو والعراق وليبيا: “لو لم نتدخل لما سقطت الأنظمة الاستبدادية في هذه البلدان”.
لقد اخترقوا الضمير الإنساني بمصطلحات ناعمة: “حرب على الإرهاب.. تدخل إنساني.. تدخل وقائي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية”. لو التزم المثقف بزرع الوعي والصحفي بتقديم المعلومة والطبيب بالعلاج، لما حدث (ويحدث) كل هذا الدمار؟
في كتابه “سلطة المثقفين في فرنسا” (1979) تساءل الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبريه العضو في أكاديمية جونكور العتيدة للجوائز الأدبية، عن حقيقة سلطة المثقفين في فرنسا، وتأثيرهم الكبير على الرأي العام، تأثير كان في السابق حكرا على الكهنة، ليقع في النهاية في أيدي وسائل الإعلام. يري دوبريه أن وسائل الإعلام تلعب، داخل الأنظمة الليبرالية، الدور الذي كانت تلعبه الأيديولوجيا الرسمية في الأنظمة الشمولية، فالسلطة التي يتمتع بها المثقفون كانت في الأصل من سمات الدولة نفسها: “لقد أصبحوا يمارسون وظيفة سياسية لمصلحة تلك الدول، وبتواطؤ مع “البرجوازية الرأسمالية”.
بعد أن أعلن ريجيس دوبريه بمرارة موت المثقف، ظل يكتب وينشر ويحاضر، إلى أن “ارتكب” مقالا لم يغفره له زملاؤه، يقول فيه: “سلطة المثقف تلك قد تصبح خطرا على الجمهورية”، فكان المقال قنبلة انفجرت في وجهه، وتعالى دخانها ليغمر الفضاء الثقافي برمته.
نشر المقال في جريدة “لوموند” الفرنسية عام 1999؛ وفيه أكد دوبريه: “لقد شن حلف شمال الأطلسي الحرب على الشعب الصربي لا على زعيمه ميلوسوفيتش”.
كان المقال قنبلة؛ أقفلت في وجهه كافة الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمنابر الفكرية. تم تهميشه وإبعاده، وهو الذي شغل منصب مستشار فرانسوا ميتران، وكان رفيقا لتشي جيفارا.
رجل آخر سنسمع باسمه كثيرا في خيباتنا العربية اللاحقة، برنارد هنري ليفي، وعلى صفحات الجريدة نفسها كتب مقالا عنوانه: “وداعا ريجيس”.
ففي فرنسا/ الحرية، لم يجد ريجيس دوبريه جريدة واحدة تقبل نشر رده، ولا منبرا فكريا يتسع لمناقشته.
وجاء 11 سبتمبر 2001 لتشهد الساحة الثقافية انحسارا كبيرا لمساحة التعبير، وليحمل غالبية المثقفين شعار: “كلنا أمريكيون”. أصبح النقاش شبه محرم، وبدأت حملة الإقصاء والمقاضاة والمحاكمات: روجيه جارودي، إدجار موران، الإعلامي دانييل ميرميه، الرسام سينيه، سفير الأمم المتحدة ستيفان هيسيل، وغيرهم.
يقول جون بريكمون، أستاذ الفيزياء النظرية بجامعات بلجيكا (والعضو في محكمة بروكسل وهي محكمة رأي شعبية تحقق في الجرائم المرتكبة في العراق، وتأسست عام 2004): ” أصبح التفكير ممنوعا منذ حرب كوسوفو، فصناع الرأي الذين حرضوا على مبدأ التدخل العسكري، بحجة حماية المدنيين، منعوا الخوض في الموضوع، وكأنه مساس بالمقدسات”.
تحولت فرنسا ـ وبخاصة بعد رفضها حرب العراق ودفعها ثمن ذلك ـ إلى تابع مؤيد للدور الأمريكي في جميع التدخلات العسكرية، لم يعد هناك من يعارض التدخل العسكري “الإنساني”، لا الحزب الشيوعي الفرنسي، ولا الحزب الجديد التروتسكي المناهض للإمبريالية، ولا الجمعيات المناهضة للعولمة، فقال بريكمون: “اليسار واليمين أصبحا متفقين على السياسة النيوليبرالية في مجال الاقتصاد والتبادل الحر، وعلى الحروب، ولكنهما يختلفان فقط في القضايا المجتمعية مثل زواج المثليين، الهجرة غير المشروعة، الغجر، المنظومة التعليمية والأمن. لقد تخلوا نهائيا عن قضايا مثل حرية التعبير والسيادة الوطنية”.
يسار أطلق عليه بريكمون في كتابه (جهود الإمبريالية الإنسانية في نشر حقوق الإنسان عن طريق التدخل الخارجي وفرض منطق الأقوى)، اسم اليسار الأخلاقي: “أصبحوا يدعون للفضيلة، ويهتفون ضد العنصرية؛ وبتهمة الفاشية ومعاداة السامية، يقصون من أحزابهم كل من لا يتفق معهم في الرأي، ويقيمون ضده دعاوى قضائية. لا ندري ما إذا كان التدخل هو أحسن وسيلة لتحرير تلك البلاد من الدكتاتورية؟ ولا نعرف كيف نسهم في التخفيف من آلام تلك الشعوب؟”.
ففي فرنسا/ الحرية والمساواة والإخاء لم يعد هناك من يفهم لماذا أصبح أقصي اليسار يبيح الحروب ـ التي تقوم بها أمريكا ـ ويهاجم كل من يعارضها، ويوصد عليه أبواب النشر والإذاعة والتلفزيون؟
تجاوزت محاصرة وإقصاء معارضي الحروب مجال النشر، وكافة وسائل الإعلام، إلى منعهم من إلقاء المحاضرات، والتعدي عليهم بالضرب. حدث ذلك لباسكال بونيفاس، عالم الاجتماع ومدير مؤسسة العلاقات الدولية والإستراتيجية بباريس، حيث فصل من الحزب الاشتراكي الفرنسي، نظرا لمواقفه المؤيدة لقضية فلسطين، وتم الاعتداء عليه بالضرب أمام بيته، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في يوليو 2014.
صناع الرأي خطر على السلام العالمي
في كتاب رفضته أربع عشرة دار نشر، تجرأ باسكال بونيفاس، وفضح بعض المثقفين الفرنسيين: “المثقفون المزيفون” 2011، (وكتب بعده كتابا آخر بعنوان: “المثقفون النزهاء”)، إذ عرض أسماء الجاثمين على صدر الساحتين الثقافية والإعلامية؛ أولئك الذين تعدوا دورهم، في التفكير، إلى تبرير التدخلات العسكرية باسم الإنسانية:
برنارد هنري ليفي (الفيلسوف االيساري الغني)، كارولين فوريست (الصحفية المعروفة بهجومها المتكرر على طارق رمضان قبل أن تطالب بالوقوف إلى جانب القاعدة ضد القذافي)، ألكسندر أدلير (الصحفي المشهور بولائه الشديد لإسرائيل)، فيليب فال (المدير السابق لشارلي ايبدو المسئول عن إعادة نشر الرسومات المسيئة للرسول) وغيرهم من الإعلاميين البارزين الذين يطلون علينا بانتظام من صفحات الجرائد والفضائيات، ونراهم في الصفوف الأولى للمظاهرات (الخاصة بسكينة الإيرانية المحكوم عليها بالإعدام، وبفتيات بوكو حرام اللواتي سرعان ما دخلن طي النسيان).
أسماء اقترنت بحروب ومذابح بحجة أننا: “لا نحارب التنين الأصولي المتعدد الرؤوس بقفاز أبيض”، (والمقولة لبرنارد هنري ليفي لحظة تبريره للمجازر الجماعية، التي تغاضي عنها حكم الجنرالات في الجزائر). يحدث ذلك رغم أن مواد حقوق الإنسان لعام 1970 تنص على: “حظر كل تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واعتبار كل شكل من أشكال التدخل السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي مخالفا للقانون الدولي.. لكل دولة حق ثابت في اختيار النظام الذي يلائمها من دون أي تدخل خارجي”.
لكن هؤلاء يعيدون المشهد ذاته، في كل مرة، بالسيناريو والإخراج نفسه، مع تغير مكان التصوير: يوغوسلافيا وأفغانستان ثم العراق وليبيا؛ وكانوا يحاولون إقناع الرأي العام بصدق نياتهم في إنقاذ البشر، بواسطة قصف يضمن سلامتهم. يزعمون أنهم يقودون حربا لمقاومة القهر والاستبداد، حربا لا تقتل أحدا، حربا بلا صراخ، حربا نظيفة كما يقول الخبراء الذين خصص لهم بونيفاس فصلا عنوانه (خبراء الكذب)، يقول فيه: “المثقفون أصبحوا فجأة خبراء في العلاقات الدولية والمسائل الإستراتيجية، فاستعملوا حججا كاذبة ومغالاطات خطيرة، إنهم يتصرفون من موقع متقدم جدا؛ ففي حرب العراق، وحين كنا نشاهد الطائرات تقصف وتزرع الموت، قالوا لنا إنهم يقومون بحماية الناس وحفظ حقوقهم، وبدا المشهد وكأنه فرجة واستعراض”.
ما لم يذكره بونيفاس أن كلمة “حرب” اختفت من قاموس الإعلام تماما، واستبدل بها “الأمن والسلام العالميان”. فبعد أن أصبحت سيادة الدول عائقا أمام حماية حقوق الإنسان الأمنية والسياسية، وتأمين حاجات البشرية الأساسية، كان لا بد للمجتمع الدولي من تخطي حاجز مبدأ السيادة، وتم الإلحاح على أن “حقوق الإنسان والأمن البشري، مسألة دولية ولم تعد داخلية، ويشكّل انتهاكها تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، ولم يعد مقبولاً من الدول التذرّع والتخفَّي وراء مبدأ السيادة المطلقة، ليست هناك بعد اليوم سيادة مطلقة”.
وابتداء من عام 1992، تبنت الأمم المتحدة سياسة التدخل الوقائي، بمبادرة من فرنسا والمنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية، بهدف ضمان أمن الأفراد؛ عماد المجتمع المدني العالمي ـ المؤلّف من مواطنين عالميين ـ حسب تصور النظام العالمي الجديد الذي يري أن حقوق الإنسان أهم من الدولة ومن سيادتها، حيث تم إنشاء جهاز إنذار مبكر يضمّ مؤسسات الأمم المتحدة، والمنظّمات العاملة في الحقل الإنساني والبيئي (الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والوطنية، ومنظمتا أطباء بلا حدود وأطباء العالم، منظّمة العفو الدوليّة، ومنظّمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم)، ويعنى هذا الجهاز بمراقبة تطوّر الأحداث والنزاعات، والإفادة مسبقًا عن الأخطار التي قد تهدّد البيئة، والكوارث الطبيعية، والتطهير العرقي، الإثني، والإبادة الجماعية، وانتشار الأوبئة والمجاعة. وبعد هجمات 11 سبتمبر أوكلت إليه مهمة التدخل الوقائي لمكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الإنسانية المهدّدة للسلم والأمن الدوليين.
انتقلنا من عبارة “ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم”، إلى مبدأ “المسؤولية الدولية لحماية المدنيين”، مفردات ناعمة لا تثير الاشمئزاز بالرغم من “البرمجة” المسبقة لسلسلة حروب آتية أعلن عنها خافيير سولانا، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (1995 ـ 1999)، قبل أن يصبح الممثل السامي للسياسة والأمن الأوروبي: “تجربتنا المكتسبة في البوسنة يمكن أن تشكل نموذجا نحتذي به في حروبنا القادمة”
كانت آخر مرة ينطق فيها “شرطي العالم” كلمة “حروب”.
من هؤلاء وما مدي خطورتهم؟
كانت “أطباء بلا حدود” الرافعة التي أطلقت برنارد كوشنير على المسرح السياسي الفرنسي والعالمي. أدت فكرة إنشاء الممرات الإنسانية وتشكيل المناطق العازلة إلى تقسيم يوغوسلافيا وسقوط الضحايا المدنيين، وتخريب الصومال، وفي جورجيا تم تفتيتها إلى: أبخازيا وأراجيا وإستونيا. وكوشنير الآن من أكثر الناس تحمسا للتدخل في العراق وتشكيل مناطق عازلة لحماية الأكراد في سوريا: “لطالما تم تدخلنا بإذن من الأمم المتحدة، ونحن نطمح لتخليص المسلمين من الصورة البشعة التي يعطيها الجهاديون عن الإسلام الحق”.
إلى جانب كوشنير (الاشتراكي الذي عمل في حكومات اليمين وكانت زوجته مسؤولة عن فرانس 24)، يظهر برنارد هنري ليفي “سيد ومعلم المزيفين” كما يلقبه بونيفاس. أسس ليفي عام 1976 مع أندريه جلوكسمان وماريو بيتاني أستاذ القانون بجامعة باريس حركة (الفلاسفة الجدد) القائمة على فكرة التدخل العسكري الإنساني لنشر الحرية والديمقراطية. وصف البعض هذه الحركة التي انضم اليها كوشنير وهو ليس فيلسوفا بأنها “الجناح الثقافي لشمال حلف الأطلسي”؛ فقد أصدرت بيانا عام 2011 نشرته “لوموند” توبخ فيه دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة على عدم تدخلها في سوريا ودعمها للمعارضة بالسلاح.
يروي برنارد هنري ليفي، في كتابه “الحرب دون أن نحبها”، كيف استأجر طائرة من أمواله الخاصة لينقل أعضاء المجلس الليبي المعارض إلى قصر الاليزيه لمقابلة الرئيس ساركوزي، وكيف تجاوز السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية الفرنسية لدفع فرنسا للانخراط في القصف الجوي على ليبيا.
اشتهر ليفي بصفته وريثا للفيلسوف جان بول سارتر، لكن سرعان ما عرفه الناس مراسلا حربيا في أفغانستان في الثمانينيات، ثم عاد للظهور فيها بصفته مبعوثا خاصا للرئيس شيراك و”صديقا حميما” لأحمد شاه مسعود، ثم ظهر في جورجيا حيث حرض رئيسها لإعلان الحرب على روسيا. وهو صاحب قرار استقلال إقليم كوسوفو (حيث عين برنارد كوشنير ممثلا خاصا للأمانة العامة للأمم المتحدة فيه)، وتكرر ظهوره في الجزائر إلى جانب الجنرالات، أثناء العشرية السوداء التي راح ضحيتها 200 ألف جزائري، أما في شتاء 2014 فدعا لإلغاء الألعاب الأولمبية بسوتشي بعد مظاهرات أوكرانيا، للضغط على روسيا؛ كما رأيناه في ساحة الميدان بأوكرانيا يصرخ بإنجليزية ركيكة: “كلنا أوكرانيون”.
فمن يكون الرجل ومن أين يستمد جبروته؟ لقد فاقت سلطته تأثير رؤساء البلدان الأوروبية ويخشاه الجميع، ولا يتورع عن اتهام معارضيه بمعاداة السامية، وتلك جنحة يعاقب عليها القانون.
أما أندريه جلوكسمان (المنتمي للتيار الشيوعي الماوي)، رفيق درب ليفي في ساحات المعارك “الإنسانية” وعلى الفضائيات، فهو أستاذ للفلسفة بجامعة السوربون، وشارك في انتفاضة مايو 68؛ وكان مدافعا شرسا عن الثورة الثقافية في الصين، ومعارضا لأنظمة فرنسا “الدكتاتورية الفاشية”. ولكنه واصل أنشطته في دعم انفصال الشيشان، وتوقيف المسار الديمقراطي بالجزائر، والتحريض على التدخل في سوريا، والمناداة بضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وشرعنة العدوان الصهيوني على غزة، وهو في صحة جيدة، ويمكن أن يلحق أذاه أحفادنا.
الإعلام ومنطق تبرير الحروب
تصنع الأكاذيب بعد مرحلة تمهيدية من الشيطنة، شيطنة بعض الدول وبعض الزعماء، تديرها جوقة من الإعلام وصناع الرأي؛ فيصبح من السهل تقبل فكرة قصف بلدان لا يربطنا بها شيء، وتدمير منشآت اقتصادية بدون سبب. تصبح الحرب مجرد فرجة، وتتحول إلى مشهد استعراضي ضخم يسرح فيه الطيب والشرير، تماما مثل أفلام رعاة البقر. مشهد الهدف منه تهييج المشاعر، ولأن مجتمعات الفرجة تخضع بسرعة للانفعالات، فإنها ترتاح لفكرة الدور الجميل الذي تلعبه إزاء هذه الشعوب المتخلفة، وتصبح هي المنقذ من الديكتاتورية، والحامي من قيم التخلف. الآمن من خوف والمطعم من جوع.
حسب نعوم تشومسكي؛ فإن وسائل الإعلام تحولت إلى أداة بيد السلطة لحظة اندرجت فيها ضمن راية اقتصاد السوق. أصبحت المؤسسات الإعلامية حكرا لأفراد ومؤسسات غايتها الأساسية الربح، فهي من ناحية اقتصادية، قد رسخت تبعيتها لزبائنها من أصحاب الإعلانات الدعائية، ومن ناحية المصداقية والاستقلالية، سلمت رقبتها للمؤسسات العمومية والمجموعات الاقتصادية الكبرى التي تستقي منها الخبر.
ألم نشهد، خلال السنوات الأخيرة، تحول ملكية وسائل الإعلام لرجال الأعمال؟ ففي فرنسا وحدها، تمتلك خمس عائلات جميع وسائل الإعلام ودور النشر، وتحتكر التأثير على الرأي العام وتوجيهه (من الخمس عائلتان تمتلكان شركات طيران حربي وتصنعان طائرات مقاتلة من نوع “الرافال” و”الميراج”).
فأين الديمقراطية التي يحاربوننا من أجلها؟
……………………..
* كاتبة جزائرية مقيمة في باريس