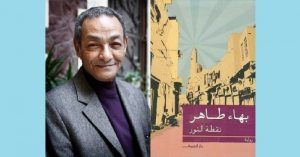د. عزة مازن
في روايتها “أقفاص فارغة: ما لم تكتبه فاطمة قنديل” (2021) للشاعرة الدكتورة فاطمة قنديل، تخرج الذكريات وتنهمر على الساردة/الكاتبة، التي تعترف بأن لها “ذاكرة مثقوبة” لم تعد تعبأ “بترميمها”. لكن دافع خفي دفعها لتأمل علبة الشوكولاتة المعدنية القديمة، التي أتت بها من بيتها القديم ضمن أشيائها الثمينة. كانت العلبة تحوي بضع قصائد كتبتها في صباها، أملا أن تتأملها في شيخوختها. بينما كانت تغير كيس العلبة القديم المتسخ بآخر بلاستيكي جديد، وجدت نفسها تتأمل العلبة الصفيح نفسها. لم تعد العلبة تنغلق، فحاولت إصلاحها حتى صارت تنغلق “نصف إنغلاقة، ليست محكمة. “وضعتها أمامي على المكتب هذه المرة، وجلست أتأملها، ربما للمرة الأولى في حياتي”. تقرر أن تتركها غير محكمة الإغلاق خشية ألا تتمكن من فتحها أبدًا: “سأتركها غير محكمة الإغلاق، لكنني سأحرص، أشد الحرص، على ألا تسقط، ويبعثر ما فيها على الأرض”. لا تسقط العلبة ولا تتبعثر محتوياتها، ولكنها تجبر الساردة على محاولة ترميم ذكرياتها، ولا تتركها تسقط على الأرض وتضيع، بل تحدق فيها حتى تتلاشى بعيون “كعيون الميدوزا، لا أريد سوى أن أمسخ كل الذكريات إلى أصنام، ثم أكسرها، ثم أكنس التراب المتبقي منها، حتى ولو كنت، أنا نفسي، صنما من بين كل تلك الأصنام” (18).
ينقسم السرد إلى أربعة أجزاء، يضم كل منها فقرات سردية تتشظى فيها الذكريات متقافزة بين الأحداث والتواريخ، في محاولة لتجاوز فجوات الذاكرة. بيد أن كل جزء يجمعه خيط شعوري واحد.يمثل الجزء الأول “علبة شوكولاتة.. صدأت للأسف!” عتبة السرد، حيث تنهمر الذكريات. أمام سيل الذكريات التي تخرج من العلبة،كمارد صغير يمسك بتلابيبها ولا يطلقها، تتوقف الكاتبة لتتسائل عن جدوى كتابة الماضي بتفاصيله الموجعة: “فكرة وجود “قارئ” لهذه الأوراق” ترعبني.. أكثر من الرعب، كأنه العجز الكامل عن أن أواصل، القارئ الذي طالما سعيت إليه، وكان يجلس على حافة مكتبي وأنا أكتب، أزيحه الآن بعنف، لا أريد أن يقرأ هذه الأوراق، لا أريد أن يتلصص على حياتي، لكنني أكذب أيضًا، لا يمكن أن يكتب أحد دون أحد، دون أن يشاركه شخص هذا الضجيج الساري في روحه، أقول لنفسي؛ ليس انتحارًا، أنا أريد أن أكشط قشرة جرح، كي يندمل في الهواء، أو لا يندمل، ويظل ينز دما، وأرقبه، وأمسح الدم “بقطنة مبللة” (18). تتوالى مخاوف الكاتبة من الحكي، تخشى أن يتخذ الآخرون مما تكتبه “درسًا، أو عبرة”، تراه “الجحيم ذاته، أحاول أن أتجنب هذا المصير وأنا أكتب، بلغة عارية تمامًا، لا ترتدي ما يستر عورتها من المجازات” (61). المخاوف نفسها تسيطر على الكاتبة في مجموعتها الشعرية “بيتي له بابان”: “…. وفور أن يموت الكاتب/ ستنبثق منه كل الحكايا/ كل ما أفضى لأصدقائه به/ كل ما لمسته أيدي عشاقه/ كل ما تحاشى تمامًا أن يكتبه/ سيحكونه/ ليثبتوا أنهم أحبوه أكثر/ ويصير عاريًا تمامًا/ كما كل الموتى” (42).
في الجزء الثاني “البداية.. حب، وشجن أوتار كمان”، تواصل الساردة/الكاتبة استحضار تلك الشذرات المتناثرة في الذاكرة، لا يهم أن تأتي الذكريات متشظية على فقرات سردية متناثرة. ومرة أخرى تحاول الإجابة عن جدوى الكتابة، رغم ما ينتابها من مخاوف. كانت الأم تدون آلامها ومعاناتها لفراق الأخ الأكبر، الذي رحل إلى ألمانيا، في كراسات أخفتها، وتظاهرت بالمرح. تعثر الإبنة على إحداها فيما بعد. في العثور على تلك الكراسة الصغيرة تجد الإجابة: “كانت تلوذ بالكتابة، تمامًا كما أفعل أنا منذ سنين، وكما أفعل الآن” (86). تحاول أن تحسم الأمر بأنها تكتب لكي تنهي المعركة، حتى بعد رحل الجميع: “حتى بعد أن يموتوا، يظلون “كمعركة” قائمة بينك، وبين العالم، معركة، تمنحك الحياة، أو تمنحك الرغبة، والقوة، في الاستمرار فيها، كي تكون واحدًا من اثنين: منتصرًا، أو مهزومًا، ضحية أو جلادًا، ليس هناك فرق، لقد منحوك الحياة، وأنت أخذتها منهم، بسذاجة من يقضم حبة من التين الشوكي، كي يقشرها! أولئك الوحيدون، العراة، الذين اختاروا، أول مرة، أن يكونوا مشاجب، ولم يكن في إمكانهم، أبدًا، بعدها، أن يختاروا تلك الملابس التي عُلقت فوقهم” (117-118).
في الجزء الثالث “غرباء.. يلعبون معًا: “البنج بونج” تعود الكاتبة لتأمل فعل الكتابة المتشظية لحياتها الماضية: “كل ما كتبته على هذه الأوراق، كان مؤلمًا، لكنني كنت أتعافى منه في اليوم التالي، أشعر أنني تحررت من ذاكرة، وأحاول أن أتذكرها مرة أخرى، فتتلاشى، كأنها تبخرت فور أن كتبتها” (163). ومرة أخرى تعود الساردة/الكاتبة لتبرير فعل الكتابة عن ذلك الماضي البعيد، فهي تكتب “عن هذا الجذر البعيد لتطيره أوراقًا في الهواء، كي لا يظل (يخادعها)بأنه شجرة! تكتب عن هذا الجذر “المعطوب”، فقط لتتخلص من “عفنه”، حتى لا يصير إلى نهاية (حياتها) ممتزجًا (بأنفاسها)! حتى لا تعتاد رائحته، ولا تستطيع أن تميز بين رائحته، ورائحة (حياتها)” (227)! قرب نهاية الجزء الرابع “الغائب يعود في موعده.. قبل بدء العرض!” تجد الساردة/الكاتبة نفسها وقد أنهت المعركة القديمة: “لم تعد هناك معركة، هذا يؤرقني الآن، ولا أدري لماذا تخايلني كلما صحوت أكياس الجلوكوز الفارغة، التي كنت أهرع لملئها في غيبوبة أمي؟! لا أحد يمكنه أن يحيا دون معركة، معركة تنمو إلى جواره، وتسير خلفه، كظله، كلما تحرك…” (253). تأتي هذه الكتابة ضمن محاولة التخلص من الماضي الذي تركته وراءها في المنزل القديم: “كنت كمن يرتكب جريمة قتل، ويحرص ألا يترك بصماته، في أي مكان، قررت، كذلك، ألا آخذ معي شيئًا، الأثاث القديم فتحت الأبواب، ومنحته لمن أراد، سيصلحونه، بعد أن اهترأ، بعيدًا عني، وربما سكبوا فيه شيئًا من أفراحهم، فلا أعرفه، إذا زرتهم، قطعت كل صور أخوىَّ وخطاباتهما، بعنف، أسميته ساعتها: “الكراهية حين تتفجر”، محوت أثارهما، فعليًا، من البيت القديم، كي لا تلاحقني، كي لا تراوغني في بيتي الجديد، وتختبئ في أي شق، وتهاجمني في الليل، ولم أبق إلا صورة وحيدة لأبي، وصور عديدة لي مع أمي، حملت ملابسي الصالحة، وكتبي، سلمت للمالك الجديد المفتاح، وأغلقت الباب إلى الأبد” (249). في البيت القديم أغلقت الكاتبة/الساردة الباب على الماضي إلى الأبد: “انتهى الأمر، دون ندم، دون ذاكرة، دون حتى مرور عابر أمام شارع البيت القديم، أثناء زياراتي لأصدقائي، في مصر الجديدة، لم يعد البيت موجودًا، هدمه مالكه الجديد، وأقام عمارة شاهقة مكانه، مرة وحيدة، حاولت أن أمر من الشارع، فارتبكت، ولم أستطع تحديد مكانه، فعرفت أنني لن أذهب مرة أخرى، وعرفت أنني ضللت الطريق إلى هناك، إلى الأبد” (251). في البيت الجديد تبدأ الحياة جديدة طازجة تقطع كل جذور الماضي: “خمس عشرة سنة مرت، كأن الحياة كلها بدأت هنا، في هذا البيت الذي أعيش فيه الآن، كأن الزمن هناك، أيضًا، قد تهدم، وسقطت صخرته الأخيرة” (251). في البيت الجديد اختفى الماضي، كما اختفت من فوق سطوح البيت القديم الأقفاص الفارغة، التي حملتها إلى هناك لتخبئها ممن كان يزحم بها فناء البيت في غفلة منها، تلك الأقفاص الفارغة التي منحت اسمها للرواية/السيرة.
أرادت الشاعرة الدكتورة فاطمة قنديل أن يكون كتابها نثرًا عاريًا من المجاز، فجاء نثرًا محمولا على أجنحة الشعر ورهافته وعمق تصويره.