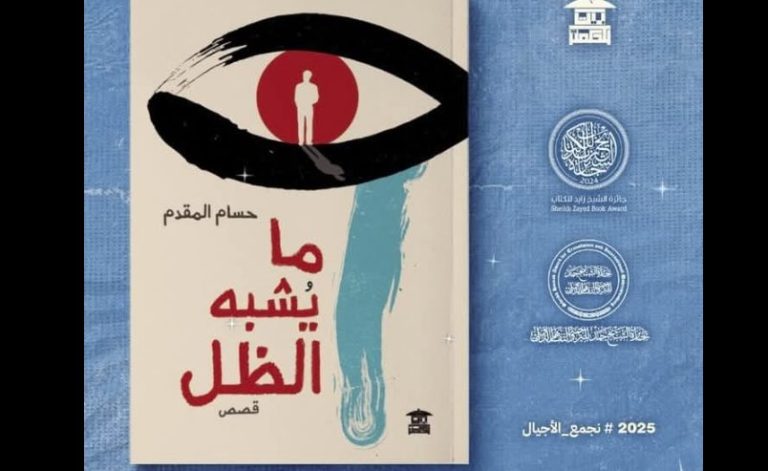سماح رشاد
تحتل لمبة صغيرة زرقاء غرفة النوم، تبعث ضوءًا أزرقًا باهتًا. لم تكن حمراء كما هو متبع في غرف الأزواج، بل كانت خيار الزوج، مثل كل شيء في البيت، يعكس ذوقه الرمادي وخياراته الباهتة. يدخل الغرفة، يضغط بإصبعه مفتاح اللمبة الزرقاء، ثم يستلقي على ظهره في سريره، وذراعاه إلى جانبيه، مغمض العينين. خلفه زوجته التي تعرف ملامح وجهه منذ عقدين، تمر بأصابعها اليمنى على جبينه لتلملم تجاعيده الصغيرة، تعيدها كما كانت. تمر على أنفه وخديه، ثم تتابع إلى ذقنه، تدلك عظامه بلطف من أعلى لأسفل، ثم بقوة أكبر لتطير الأرق من أطراف شعيرات لحيته الكثة.
هكذا كان الطقس منذ أولى ليالي زواجهما، ليغفو ذو اللحية هانئًا غير عابئ بما تركه لمفاصل أصابعها من ألم طفيف مزمن. تغمض عينيها هي الأخرى، وتطوف في أرض الخيال، بين أحلام لا يعكرها اللون الأحمر أو الأزرق، وكل طيوف ألوان الإغماض أثناء اليقظة، ثم تستسلم لنوم عميق بعد أن تنزلق يدها المجهدة عن وجهه.
كانت تعلم أن الحياة ليست عادلة، لكنها أقرت أنها لم تكن ضحية لا له ولا لأبيها ولا لأحد. علمت أنها طقس آخر للحياة سينتهي يومًا ما. سيأتي يوم سيجد فيه الجسد المسجى على ظهره، فراغ المكان بجانب ذراعه، خاليًا من جسدها، ومن تلك الأصابع، ومن ذلك الانحناء لظهرها عليه، ثم سيصبح وحيدًا، وحيدًا تمامًا، كما كانت هي وحيدة بين ملامح وجهه المغمض العينين. كانت تردد دائمًا ببهجة: سأموت يومًا ما وسأعزف حينها نوتات لا نهائية بأصابعي النحيلة، لموسيقى أختارها بنفسي.
في صباح يوم آخر، لملمت الستائر من النوافذ لتدخل الشمس إلى الغرفة، أعدت الفطور كما هو الروتين، صنعت كوب شاي وآخر من القهوة، اقتربت من أذنه لتوقظه بتلك اللمسة اللطيفة على وجهه التي يعرفها جيدًا: استيقظ، لقد صنعت لك قهوتك. لم يجبها رغم تكرار الجملة وتكرار اللمسات، حتى أدركت أن أنفاسه لم تعد تدفئ أصابعها.
علمت أنه حضّر لها مفاجأة وسبقها للأعلى، إلى السماء، ليتركها وحيدة بأصابعها على وسادة خالية من أي جوار آمن، كل ما يُسمع هناك، هو صوت أرقها وعينيها المفتوحتين، فهي بعد رحيله لا تنام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاصة مصرية