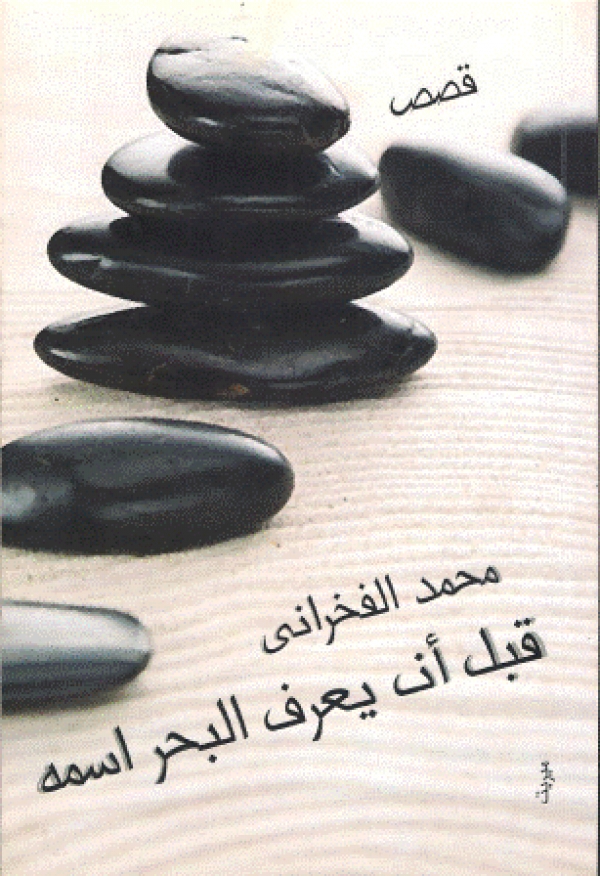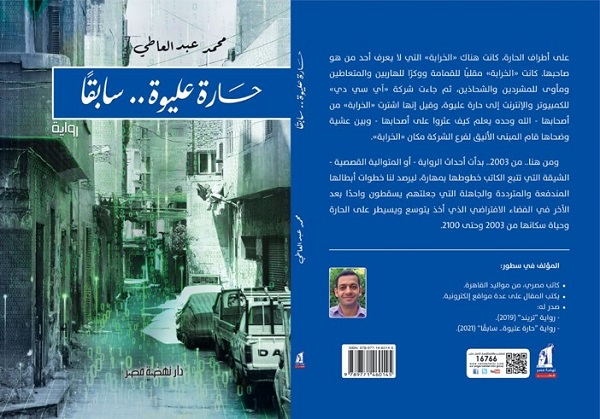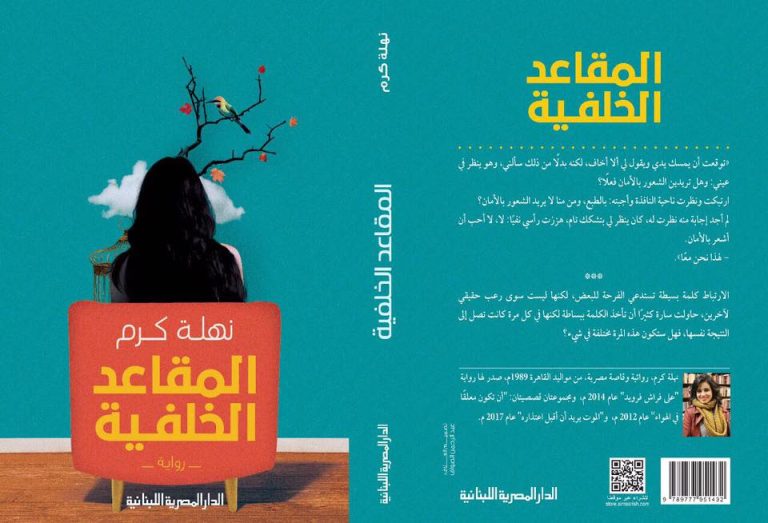محمد وليد
“رواية يخيل للقارئ أن ظاهرها قاتم، غير أن باطنها مضيء متألق، يكفي أن نحرك الرماد حتى يتأجج لهيب الجمر الكامن تحته.”
من جلسة عن الرواية خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 2025.
في اللحظة التي يضيق فيها العالم بما رحب، وتتحول الساحات العامة إلى مسارح للزيف والضجيج الممنهج، يبرز واحد من الأسئلة الوجودية العميقة: هل الانسحاب هزيمة أم هو استراتيجية للبقاء؟ تأتي رواية «ترف الانكفاء» للكاتب وائل هادي الحفظي، والصادرة عن دار الآداب، لتقدم إجابة أدبية وفلسفية شديدة الجمال والألم في نفس الوقت، وهي التجربة التي لم تمر مرور الكرام في المشهد الثقافي، بل توجت بحصولها على “جائزة أسماء صديق للرواية الأولى”. إن هذا العمل لا يقدم مجرد قصة، بل يطرح معضلة معقدة أو لنقل إنها إحدى أزمات الإنسان بعد الحداثة، وفيها يعيد الاعتبار لفعل التراجع، وتطرح لها رؤية مغايرة، محولًا إياه من حالة انكسار إلى ترف لا يملكه إلا الذين قرروا حماية جوهرهم من التآكل، وتماسكوا بينما تتداعى الأشياء حولهم.
عندما يكون التراجع بذخًا
إن اختيار الكاتب لعنوان «ترف الانكفاء» يعد في حد ذاته عتبة نصية تفيض بالدلالات. فالانكفاء في المعجم الوجداني يرتبط بالانطواء والحزن، لكن اقترانه بكلمة ترف يقلب المعادلة تمامًا. ويحولها إلى شيء يستحق الاهتمام، فالترف هنا ليس ترف المادة، بل هو ترف السيادة على الذات، وامتلاك ترف القول لا للعالم الصاخب الذي يوسع الفجوة ويزيد من المآسي التي تنتهي، ويراكم الضباب حول الروح وأمام العين. يدرك الحفظي أن العزلة الاختيارية هي أعلى درجات الارتقاء الروحي؛ فهي اللحظة التي يغلق فيها الإنسان الباب خلفه، لا هربًا من المواجهة، بل مواجهةً لأصعب خصم على الإطلاق، الأنا في مرآتها العارية، والنفس التي تدمن الندم حين تصاب بجروحٍ لا تندمل.
تظهر صورة الغلاف تجسيدًا بصريًا لهذا المعنى؛ رجل يجلس في عزلة تامة، يرتدي معطفًا يداري ملامحه، وأمامه علبة سجائر، وخلفه باب أبيض موصد. هذا المشهد ليس كئيبًا كما قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى، بل هو مشهد ترميم لتصدع عميق في روح العصر، فالشخصية الروائية هنا في حالة تقوقع استراتيجي، تجمع شتات الروح الذي بعثره الآخرون، وتعيد صياغة فعل الحضور من خلال الغياب عن العالم. حتى الباب الذي يظهر بجانب البطل ليس مجرد قطعة خشب، بل هو فاصل زمني ومكاني بين عالمين. عالم الخارج حيث القلق المستمر، وعالم الداخل حيث امتلاك حقٍ في الاختيار. هذا الباب هو الحصن الذي يمنح الشخصية الروائية القدرة على أن تكون ذاتها دون أقنعة، والتحرر من عبء التظاهر الذي بعثر الجوهر، وزرع الهشاشة الكامنة داخل الشخصية؛ صارت مقيدة لا ترغب من الأساس في التحليق.
العمل حين يُشكل الهوية
لم تعد العزلة في زمننا المعاصر حالة استثنائية تخص أفرادًا بعينهم، بل صارت عرضًا عامًا لعالم أنهك الإنسان حتى أقصى حدوده. في هذا السياق، لا يمكن قراءة «ترف الانكفاء» بوصفها رواية عن مزاج فردي أو انطواء نفسي، بل بوصفه نصًا أدبيًا يضع إصبعه على جرح جماعي، الاحتراق الوجودي الناتج عن عالم جعل العمل مركز الحياة، لا أحد مكوناتها.
العمل لم يستهلك وقت الشخصية فحسب، بل أعاد تشكيل وعيها بذاتها. الانسحاب هنا لا يحرر فحسب، بل يفتح أزمة أعمق: أزمة فقدان الهوية.
من نكون حين لا نعمل؟ وهل ما نفقده هو وظيفتنا، أم صورة أنفسنا التي بُنيت حولها؟
الرواية لا تقدم إجابات جاهزة؛ ثمن التحرر النفسي واضح، العمل المفرط يسلب الإنسان القدرة على أن يكون شيئًا آخر، وزواله يترك فراغًا أعمق من مجرد فراغ الوقت. أيضًا لا ترفع شعارًا مباشرًا ضد العمل، ولا تدخل في خطاب وعظي أو احتجاجي، لكنها تفعل ما هو أخطر وأكثر عمقًا، أنها تُظهر أثر العمل حين يفيض عن حده، ويتحول من وسيلة للعيش إلى هوية كاملة، إن نزعت سقط الإنسان في هوة الاغتراب، ومن مجال لتحقيق الذات إلى أداة تآكله بشكل بطيء تشبه التعذيب وأنت حي.
هنا، يصبح الانكفاء ليس خيارًا رومانسيًا له بعد درامي، ولا حتى منفذ وحيد حين تضيق السبل، أو تنفد المخارج، بل رد فعل إنساني أخير أمام الاستنزاف الصامت.
تعريف مقلق للحرية
منذ البداية وأنت تشعر أنك واقف على حافة المأساة أو تجاوزت عتبة الألم. قوة الرواية تظهر في طرحها تعريفًا صادمًا للحرية، لا يقوم على التوسع والانخراط، بل على الانسحاب الواعي بتداعيات اتخاذ القرار، وحجم التأثير الهائل على تفاصيل الحياة الدقيقة..
يقول بطل الرواية وهو في طريقه إلى سيارة الشرطة:
“فلا شيء يضاهي أن تسجن العالم دونك؛ لا يهم في أي جهةٍ تكون، ما دامت بينك وبين العالم القضبان فأنت حر.”
السجن هنا لا يقع على الذات، بل على العالم؛ والقضبان لا تحاصر الجسد، بل تحمي الداخل من فائض الخارج، وقبح الوسط، هنا الحرية لا تُستعاد بالظهور المستمر، بل بالقدرة على الاختفاء حين يصبح الحضور عبئًا، والتواجد عبثًا لا يُحتمل.
من الركض إلى التوقف.. وعي متأخر وتحول صامت
البعد في الرواية ليس لحظة عابرة، بل حصيلة تراكم طويل: التوقف يصبح شكلًا من أشكال الشجاعة بعد إدراك فشل الامتثال الكامل لإيقاع العالم.
يقول بطل الرواية:
“في المدرسة، كنت أركض، وأركض وأركض كمن نام الليل كله. أما اليوم، فكففت عن الركض.”
الركض هنا ليس حركة جسدية، بل استعارة عن التناغم مع إيقاع الواقع حين كانت براءة الطفولة تسكن داخلنا، لكن مع السرعة، الإنتاج، التقدم المستمر دون سؤال. والحق بأشياء لا ندركها جيدًا أو حتى نقترب وتمعن فيها لنعرف ماهيتها، حتى التوقف هنا ليس كسلًا، بل وعيًا متأخرًا، إلى أين نركض؟ ولماذا؟ وهل نعرف وجهتنا؟
أما التوقف، فليس كسلًا ولا عجزًا، بل اختيار واعٍ لإبطاء الزمن، والوقوف خارج السباق.
فالرواية لا تمجد البطء على حساب الحركة، لكنها تسائل فكرة الركض الدائم: إلى أين؟ ولماذا؟ وهل كل من يركض يعرف وجهته حقًا؟ الانكفاء، في هذا السياق، يصبح رفضًا ضمنيًا لفكرة أن القيمة الإنسانية تُقاس بالسرعة والإنجاز المتواصل.
الأسئلة التي لا تُجاب.. نضج أم إنهاك؟
يتأمل بطل الرواية:
“كنت فيما مضى أحسب أن التساؤلات الكبرى والوجودية صعبة الحل، والحال أن كثيرًا من الأمور السخيفة يجدر بالمرء أن يؤمن بها كما هي، لأن لا إجابات كافية عنها.”
الرواية تقول بوضوح: ليست كل الأسئلة قابلة للحل، والبحث المحموم عن المعنى قد يكون شكلًا آخر من الإنهاك. القبول بعدم الاكتمال ليس استسلامًا، بل إدراك حدود العقل الإنساني الغارق في الكثير من الأمور، وتقديرًا للطاقة التي نفدت في زحام الأيام، وتوتر اللحظات.
وتتخلى أيضًا عن النزعة الفلسفية المتعالية، وتستبدلها بحكمة هادئة في عالم يطالبنا دائمًا بالإجابات السريعة والمواقف الواضحة، تقترح الرواية خيارًا مغايرًا، أن نعيش بعض الأمور دون تفسير، وأن نسمح للغموض بأن يكون جزءًا من التجربة، لا عيبًا فيها.
الحزن في عالم مزدحم
يقول بطل الرواية بعد وفاة والدته:
“اكتظ البيت بالناس، ونسيت أن أبكي. اكتظ العالم بالناس، ونسيت أن أبكي.”
الاكتظاظ هنا يرمز إلى فقدان الخصوصية الداخلية للحزن؛ الانكفاء ليس عزلة باردة، بل حماية المشاعر، وهذا ما ميز أسلوب الكاتب قدرة مذهلة على تطويع الكلمات لتكون مرآة للأحاسيس غير المرئية. الرواية ليست سردًا للأحداث بقدر ما هي سرد للمشاعر النفسية. إن كل جملة تشبه طرقة خفيفة على باب القلب المنسي. والكاتب هنا لا يصف الحزن، بل يجعلك تتنفسه كرائحة قديمة علقت في أنفك، ولا يصف العزلة، بل يجعلك تلمس ملمس جدرانها المتصدعة،
هذه الشاعرية هي التي جعلت من الرواية عملًا مؤثرًا إنسانيًا؛ فهي تخاطب ذلك الجزء الخفي في كل واحد منا. فمن منا لم يحلم يومًا بأن يترك كل شيء خلفه وينسحب؟ من منا لم يشعر بأن في البعد ربما تكمن الحقيقة.
ولعل أبرز ما تقوله الرواية أن الانكفاء ربما يكون رد الفعل الأخير، عندما ينهار حد المقاومة، حيث التظاهر بالتماسك لن يجدي مهما حاولنا.
رغم القوة الفكرية والحميمية العالية والنزعة الفلسفية التي شُكلت بها «ترف الانكفاء» في إعادة الاعتبار للعزلة بوصفها فعل نجاة، فإن الرواية تسير على حافة دقيقة بين التبصير والتبرير. فتمجيد الانكفاء، وإن كان مبررًا وجوديًا في سياق الاحتراق والاستنزاف، يحمل في طياته خطر تحويل الانسحاب إلى ملاذ دائم، لا إلى مرحلة مؤقتة لإعادة الترميم. هنا تحديدًا، تكمن المعضلة التي لا تحسمها الرواية بقدر ما تتركها مفتوحة: متى يكون الانكفاء وعيًا، ومتى يتحول إلى قطيعة مع العالم لا تقل قسوة عن استسلامه له؟ هذا التوتر غير المحسوم لا يُحسب ضد العمل، بل يمنحه صدقه الإنساني؛ إذ يرفض تقديم العزلة كخلاص مطلق، ويُبقي القارئ في مساحة قلق منتج للأفكار والخطط، وتنشئ حيرة تنهش الذات لتُذكره بأن النجاة الحقيقية لا تكمن في الهرب ولا في الامتثال، بل في القدرة على التمييز بين ما يجب الانسحاب منه، وما لا يجوز التخلي عنه حين يكون العالم غير معقول. وهذا ما يحدث دائمًا.