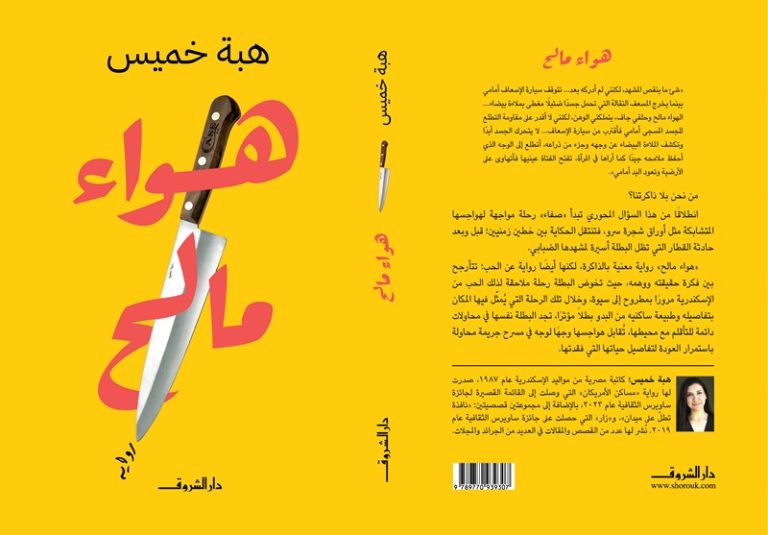آسر أيمن ناجح حبيب
انهمر المطر غزيرًا ليلتها، بدا كأن السُحُبَ في حالةِ حدادٍ على إسكندريتها، التي فقدت هويتها رويدًا رويدًا. صَكَّت الرياح الأسماع، وهي تُقيم وتُقعِد مياه البحر المُرَّة، وتعبث بسكون أشجار النخيل العالية، لتجعلها تتمايل على وقع لحنها المُنتحِب.. ثارت الرياح كما لو أنها معترضةٌ على ما يجري بموطن راحتها من عبثٍ بتاريخه، الذي أصبح بمرور الزمن أشلاءَ هويةٍ مبعثرة.
لم يكُن صوت الطبيعة الصارخ أكثر ما يتسلل إلى أذن صفاء يومها، بل كان صوت نحيبها الذي يملأ صدرها. كانت تسير وحيدةً، وكانت وحدتها تلك -للمرةٍ الأولَى طوال حياتها- مُحبَّبة لها؛ فلم تود أن يراها أحدٌ وهي تبكي بهذه الطريقة وهي في هذا العمر. شعرت أنها لا تقوَى على التنفس جيدًا، وأنها على وشك السقوط أرضًا. لم تعرف هل السبب في آلامها تلك، جسدها المُنهك، أم نفسيتها المُهشَّمة، بعدما امتعضت منها الدنيا، وأبت أن تمنَّ عليها بمعروفٍ، بعدما عاشت فيها لعقودٍ، كان سادسها قد تمَّ منذ عامين.
أعظم ما تتمناه الآن صفاء وظيفةً تستطيع من خلالها تسديد بعض مصروفات واحتياجات ابنتها داليا وأخيها الأصغر؛ فمعاشها من وزارة التربية والتعليم لا يكفيها، وابنتها على وشك الزواج من شابٍ معها في الكُليَّة، يعمل على فترتين يوميًا، اسمه نادر. هي تحبُّه، وهو مجتهدٌ ويحبها أيضًا، وهذا يكفي داليا ووالدتها.
تدرك صفاء أن لا أحد سيقبل بأن تعمل معه بعمرها ذلك. كما تشعر أن الإسكندرية -على وِسْعها- ضيقةٌ، لا تتسع لما تتمنى، على الرغم من بساطته. أحسّت أنها ضئيلةٌ أمام المباني الشاهقة التي تحيط بها، فلم تجد أمامها مهربًا سوى البكاء.. فقط البكاء.
خُيِّل لنادر أن حماته صفاء هي تلك السيدة المُحطَّمة الباكية أمام الأبنية المواجهة للبحر، التي يقود نادر دراجته البخارية أمامها الآن، لكنه نفض الفكرة عن رأسه ونظر لطريقه المزدحم؛ فهو يعلم أن حماته كانت سيدةً ذات مكانةٍ مقبولةٍ في عملها، قبل أن يُحيلوها إلى المعاشِ منذ عامين أو ثلاثة تقريبًا، فمن غير المعقول أن تكون هي تلك السيدة البائسة المُنكَسِرة.
فكَّر حينها أن يتّصل بداليا ليطمئن على والدتها، قبل أن يتذكر أنه على الخط مع خيريَّة والدته، فأخذ يتمتم لها بكلماتٍ غير مفهومة، في محاولة للإشارة إلى أنه لا يستطيع التركيز معها ومع طلباتها المستمرة أن يتوقف عن عمله الآن في توصيل الطعام، حتى لو وصل الأمر إلى أن يخسر هذه الوظيفة!
– حاضر يا ماما. أخلَّص بس الطلب دة وآجي على طول. مش هتأخر النهاردة.. أنتِ عارفة أنا محتاج الشغل دة قد إيه! مش عشاني حتى؛ عشانك وعشان داليا.
لم تشعر أن هذا الرد كافٍ، ولكنها كتمت ذلك في نفسها، وهمست له أن يفعل ما يريد، قبل أن تُغلِق الخط معه، وتذهب للدعاء له، مستغلةً وقت المطرِ.
تذكَّر نادر عندما التقى بداليا في الكلية في عامها الأول، وعندما تعارفا، وكذب عليها وأقنعها حينها أنه ميسور الحال، وأنه لن يعمل سوى بشهادته من الهندسة، حتى صارحها بعمله مع مطعمٍ لتوصيل الطلبات؛ لشدة احتياجه، قبل خطبتها منه.
شعر نادر لحظتها أنه ضعيفٌ جدًا، أضعف من هذه الدنيا التي حطمته وسحقته؛ فقد جعلته يتخلّى عن أحلامه صغيرًا، ويقبل بنصفِ حياةٍ كبيرًا، مجاهدًا لئلا يفقدها!
شعر نادر بالشفقة الشديدة على حاله، وكم كان هذا الشعور مُرًّا في نفسه! فانحدرت من عينيه دمعةٌ ساخنة، ليتجاهلها ويزيد من سرعة دراجته، متخطيًا بعض السيارات، مُتلقيًا العديد من السباب من أحد السائقين الذي تخطاهم.
لم يشعر نادر بتلك الدمعة، لكن والدته فعلت، فأغمضت عينيها جدًا، كأنها تريد أن تراه، ولو في مُخيِّلتها؛ لتطمئن عليه؛ فهي تشعر بحزنه، فدَعَت له من أعمقِ أعماق قلبها، كما دعت لجارتهما الأرملة الحاجَّة هدى بالخير والشفاء، ولولدها بالرحمة.
وقعت عينا هدى على نافذة منزل نادر وخيرية، التي لم تلمح هدى، وإنما استمرت في دعائها، مغمضةً عينيها.
نظرت هدى حولها دون أن تستقر على منظرٍ محددٍ؛ فعيناها زائغتان، كأنهما انعكاس مُخفِّف لاضطرابها الداخلي. شعرت هدى أنها في كابوسٍ، تمنَّت لو أنها تستطيع أن تستيقظ منه فجأةً، ولكنها عاشت في الحياة ما يكفيها لتعلم أن الحقيقة أحيانًا تكون أمرَّ من الكوابيس!.. فقد مات ولدها اليوم!
أخذت تهمس باسم ابنها همساتٍ مُضطربة، كأنها تتمنى أن يحتضنها بغتةً، ويأخذها من يديها لمنزلهما؛ لأنها تشبه المجاذيب في حالتها تلك، فاليوم يومٌ ممطرٌ، وهي خسرت ابنها في يومٍ كهذا منذ أعوام لا تعرف عددها، وهذا يعني بالنسبة لها أنها فقدته اليوم.
أصابها مرض “ألزهايمر” منذ عامين، ولكن كل ما تذكره منذ ذلك الوقت شيئين: ابنها التي فقدته حين خرج يومها ولم يعد، وتحسب كل يومٍ ممطر أنها فقدته فيه، وعنوان منزلها عندما يهلكها التعب، بعد رحلةٍ نواحٍ طويلة في شوارع الإسكندرية.
شعرت أنها خسرت كل شيءٍ، ولم يعد لديها ما تحيا لأجله؛ فقد رحل منها الأمل برحيل ابنها. لا تعرف إلى أين تقودها قدماها، ولكنها تعلم أنها خسرت ابنها، فأطلقت العنان لدموعها، فكانت دموعها تسبق قدميها في شوارع الإسكندرية المليئة بأمثالها من الباكين، قبل أن يراها سائق أجرة صدفةً وهي في إحدى الشوارع الخالية من المارة. رأى دموعها رغم ظلمة الليل، وشعر بمرارتها، على الرغم من عدم معرفته الشخصية بها، فقال في قرارة نفسه، مُشفِقًا عليها:
– ابكي يا حاجَّة، ابكي كتير، بس لحد إمتى؟ حتى لو بكينا الدهر كله، مش هنرتوي ولا هنرتاح.
ثم شعر بالإشفاق عليها، فقال، وهو يفتح باب سيارته:
– اركبي يا أمي. رايحة فين؟
دخلت في خنوعٍ، وأجابته بعنوان منزلها، فسمعه، ثم بدأ يقود سيارته، قبل أن يسرح في حاله وهو في طريقه… وهدى تنظر له بطرف عينها، بعدما هدأت قليلًا.
لم تفهم فيما يفكر ذلك السائق. كان يبدو لحظتها ساهمًا مُفكِّرًا في شيءٍ مجهول، لم تعلم أن كل ما كان يشغله سؤالٌ واحدٌ: هل هناك ما هو أعمق من الحزن؟ وفي كل مرةٍ يفكر في هذا السؤال، يجيبه صوتٌ داخليٌ صارخ: نعم، الخوف.
فؤاد -السائق- لم يكن حزينًا، بل كان خائفًا مما هو آتٍ؛ فهو يعلم أنه مريضٌ بسرطان الدمِ، وأن أيامه على الأرض معدودةٌ. هل يخاف فؤاد إذَنْ من الموت؟ لا يظن ذلك؛ فهو لا يملك ما يعيش لأجله؛ فقد وُلِدَ يتيمًا، وظل حتى هذه اللحظة غير متزوجٍ، ولم يُصادِق أحدًا طوال حياته سوى صديقًا وحيدًا اسمه شفيق.
كان شفيق صديقَ عمره، لم يجد ونيسًا سواه؛ ليلقي عليه همومه ومتاعب حياته. لم تكن حياتهما سويًا وردية خالية من المشقات، وإنما كان وجودهما في حياة بعضهما البعض يجعلهما يتقبلان أيامهما، رغم ثقلها الشديد وسخافتها. لكن مات شفيق منذ عامٍ وأربعة أشهر بالتمام والكمال في حادث سيرٍ، ليترك فؤاد وحيدًا، لا يرغب حتى في مقاومة مرضه.
ولهذا لا يخاف فؤاد من الموت، بل يخاف أن يكون حُرِم من الحياةِ الحقيقية.
– بس! نزِّلني على إيدك هنا يا حبيبي. كام حسابك؟
أفاقه صوت هدى من شروده، فهمس لها قائلًا أنه لا يريد المال، وأنه سيتحمل ثمن هذه الرحلة. أصرّت هدى على الدفع، ثم شكرته عندما تمسَّك بموقفه. ابتسمت له رغم دموعها التي جفّت على خديها، قبل أن يرحل ويقود سيارته بعيدًا. لأول مرةٍ يشعر أنه لا يريد أن يذهب لمكانٍ بعينه، بل يريد الاختفاء، كأنه لم يكن.
حتى الإسكندرية التي كان يشعر أنها تحتضنه، أصبحت الآن مصدرَ رعبٍ بالنسبة له. المدينة التي كانت تجدد روحه، وتشعل في عقله وعقل شفيق نيران الحنين والسعادة والإلهام، جعلته أثرٌ عتيقٌ من آثارها… المدينة التي جعتله يتنسّم نسيم الحياة، دفنته حيًا بعدما أمرضته بحبها، ودفنته مع خليله في أرضها.
عاد سؤاله المُحزِن يعصر عقله: هل عاش فؤاد حقًا؟ لا يظن ذلك؛ فقد قرأ ذات مرة ورقةً نساها شفيق في منزله، كُتب فيها:
“معنى أن تحيا هو أن تصنع ذكرياتًا خالدة، وأن تجد أناسًا يحبوك حبًا حقيقيًا، ويشعرون بالقلق عليك عند غيابك.”
وها هو فؤاد غارقًا في دموعه الصامتة؛ فهو لم يصنع هذا، ولا يجد ذاك الآن!
سار فؤاد بسيارته في شوارعٍ لم يدخلها من قبلٍ، بلا سببٍ حقيقيٍ، كأنه طفلٌ مفقودٌ يبحث عن ذويه. وبينما هو في طريقه، رأى شابًا غزير الشَعر أشقره، جميل القسمات، جالسًا في إحدى شوارع الإسكندرية العتيقة المُطلّة على البحر، بمحطة الرملِ، وبجواره لافتةٌ، كُتِب عليه بخطِ اليدِ: “المُلحِّن الكبير سعيد السمَّان”.
دقق النظر فوجد الشاب يعزف على عوده تحت الأمطار، فوقف بسيارته بجواره، وارتكن برأسه على وسادة الكرسي، قبل أن ينظر له الشاب متعجبًا من اهتمام هذا السائق الغريب بألحانه، لكن فؤاد لم يكترث، وإنما أخذ يسمع ألحان سعيد الشجيَّة، الصارخة بكل هدوءٍ.
كان ما يعزفه سعيد بأنامله من ألحانٍ عظيمةٍ ليس وليد الصدفة، وإنما نتيجة موهبة فذة، طورها منذ نعومة أظافره، بعدما جاء هذا العود -الذي يحمله الآن- على سبيل الهدية لوالده منذ أعوامٍ لم يعُد يعرف عددها.
بدا هذا العود بالنسبة له ساحرًا عندما وقعت عيناه عليه لأول مرةٍ، وهو يرى اسم والده عليه مكتوبٌ بخطٍ عربي جميلٍ، فقرر أن يجرب شد أوتاره دون ترتيبٍ أو تنظيم، فوجد الأمر ممتعًا… قرر أن يتعلم العزف عليه. ساعدته والدته في ذلك، حتى أتقنه سريعًا، وأخذ يبدع إبداعًا منقطع النظير في عزف الألحان البسيطة وهو صغيرٌ، وتلحين الأشعار البليغة بعدما كبر.
كان أكثر ما حطَّم سعيد وفاة والدته، ربما كان ذلك هو سبب حزن ألحانه وبكاء أوتاره؛ فقد كانت هي الوحيدة التي آمنت بموهبته ووثقت به وبها. أما والده، فقد قسى عليه بعد رحيلها، حتى اضطر سعيد أن يترك له المنزل الجديد الذي اشتراه، وأن يجلس في شوارع الإسكندرية حتى المساء، ثم يذهب إلى منزلهم المهجور لينام به حتى اليوم التالي؛ فهو يعلم أن والده ترك هذا المنزل تركًا نهائيًا من عدة سنين؛ لسببّ لا يعلمه سعيد.
لم يكن عدم إيمان والد سعيد به أكثر ما يجرحه، وإنما كان مجرد حلقة في سلسلة الألم التي أرّقته كثيرًا؛ فهو يريد أن يحبه الناس، وأن يؤمنوا بإبداعه وموهبته، كان يريد أن يسمع كلمة إعجاب عابرة من طفلٍ، أو أن يرى عجوزًا ذكّرته ألحانه بحبيبٍ قديم، أو أن يجد فاتنةً تتغزل في ألحانه. لكنه لم يلقَ الإعجاب الذي توقعه، ووُئِدت أحلامه في مهدها عندما وجد أن الناس لم تهتم بهذه الموهبة الفذة، رغم محاولاته العديدة في أن يُظهر للعالم إبداعه.
فها هو سعيد عاطلًا عن العمل، بعدما رفض الالتحاق بأي كليةٍ، واكتفى بتعليمه الثانوي؛ عندًا في والده. وهذا لا يؤلمه على الإطلاق، فهذا هو الطريق الذي اختاره، كما أنه يستلم من والده مبلغًا مجزيًا كل شهر، وإنما ما يبكيه حقًا رفض الناس له، وإعراضها عنه وعن فنه، كأن الناس قد أحبوا مرارة حيواتهم واعتادوا عليها، ولم يعودوا يريدون أن يروا ويسمعوا فنًا حقيقيًا، حتى انتهى به الحال يفترش الأرض عارضًا خدماته في التلحين بمبالغٍ زهيدة.
لم يكن سعيد يبكي عادةً، ولكن أوتار عوده هي التي كانت تنتحب نيابةً عنه، لكن اليوم لم يحتمل، فترك عوده وبكى، وذاق طعم البكاء مُرًا.
رحل فؤاد عن هذا الشارع قبل أن يتوقف العازف عن شدوه.. رحل بعدما شعر أن الموسيقى جمّعت أشلاء روحه. حاول فؤاد أن يذهب لشارعٍ أكثر ازدحامًا، آملًا أن يحتمي بالناس من وحدته. أراح رأسه على مقوده، وهو يشعر أن هذه الحياة قاتمة اللون لدرجةٍ مرعبة! وانسابت من عينيه الدموع خفيفةً مُريحة.
كان وَضع رأسه على المقود يمنعه من رؤية ما يحدث في الشارع الذي يقف فيه. ذهبت صفاء -بعدما أنهكها التعب- إلى بقالة عم طه، أشهر بقالات الإسكندرية حاليًا وأكبرها. دخلت وطلبت ما تريد. وما إن خرجت، رأت سيارة فؤاد. فكّرت قليلًا، لكن أبت أن تستقلها إلى المنزل؛ توفيرًا لثمن الرحلة، حتى لو بدا زهيدًا.
جلس طه على مكتبه بالبقالة، بعد يومٍ طويلٍ شاق، ثم شرع يغلق محله؛ حتى يأخذ قدرًا مقبولًا من الراحة؛ ليفتح أبوابه للمُشترين باليوم التالي. أغلق باب بقالته، وسار وسط الشوارع الباردة، وهو يرتجف قليلًا بين الفينة والأخرى، ويسمع صوت صفير الهواء، قبل أن يمر بجوار إحدى المحال التي كان يُشغِّل صاحبها أغنيةً على المذياع، بدأ صوت الأزيز يختفي تدريجيًا؛ ليُحِل محله صوت السيدة أم كلثوم القادم من بعيد، في أغنيةٍ سمع فيها طه صدى العود والكمان بوضوح.
– بعيد عنك، حياتي عذاب
ما تبعدنيش.. بعيد عنك
ما ليش غير الدموع أحباب
معاها بعيش.. بعيد عنك.
أكمل طه سيره، لكن تلك الكلمات، وذلك اللحن الذي سمعه، ذكَّراه بما لم يُرِد أن يتذكر.
هل كان ظالمًا أم مظلومًا؟ جانيًا أم مجني عليه؟ لا يعرف طه على الإطلاق إجابةً لهذين السؤالين، كانا يعتصران ذهنه لليالٍ منذ شهورٍ، حتى ظن أنه نسى، لكنه لم ينسَ على الإطلاق. يتذكر ابنه كلما سمع موسيقى حوله، يتذكر حلمه وطموحه، يتذكر احتضانه لعُوده، ويتذكر ابتسامته، وحتى دموعه يتذكرها! يتذكر خوفه على مستقبل ابنه سعيد، الذي أسماه هو قتلٌ لطموحه. هل ظلمه حقًّا؟ ربما، لكن سعيد ظلم نفسه بقدرٍ أكبر، عندما صدَّق أن هذه الدنيا ستفسح مجالًا لمثله من الموهومين!
ربما ظلم طه سعيد فعلًا، لكن طه يعلم أنه ظلم سُعاد بقدرٍ أكبر، عندما قرر ذات يومٍ أن يرحل عن المنزل، ويأخذ معه سعيد، ليتمشيا قليلًا في يوم إجازته، قبل أن يعودا إلى المنزل، ليجدا سُعاد ساقطةً على الأرض، وقلبها قد توقف عن النبضِ، ليعرفا بعد ذلك أنها توفيت بأزمةٍ قلبية مفاجئة كانَ من الممكن تفاديها لو وُجِد أحدٌ بالمنزل!
طه يعلم أن سعيد ولده يبغضه، وطه نفسه يكره شيئين لا ثالث لهما: موهبة سعيد التي عطّلته عن الدراسة والعمل مع والده، وشقته التي كانت تمتلئ بالحب الذي اختنق بوفاةِ سعاد!
لعل تأثره بموت زوجته في هذه الشقة كان هو الدافع الرئيسي لطه ليشتري شقةً جديدة؛ هروبًا من الذكريات.
على الرغم من أن قرار الهجر جاء من طرف سعيد ابنه، إلا أن طه لم ينسَه يومًا، بل كان دائم السؤال والاطمئنان عليه، لكنه كان دائمًا ما يُقابَل بالرفض من طرف ابنه.
شعر طه أنه يرى جميع زبائنه ابنه، ويجد في جميع الأبرار ملمحًا من وداعته، ويتمنى في كل وجهٍ يقع بصره عليه أن يكون وجه سعيد.. ابنه الضال!
دخل طه إلى الزقاق الذي يضم منزله، وقبل أن يفتح باب عمارته بسرعة؛ هروبًا من المطر، شعر بأن هناك دمعةً حارة أطارها الريحُ من مقلتيه، واختلطت مع المطر البارد خارجًا، فلم تفلح وحدها في تدفئته.
وهكذا مرَّ ليله: حربًا مع الذكريات، ينتصر فيها لدقائقٍ بالنسيان، ويخسر فيها لساعاتٍ بالندم.
أخذت شمس الصباح تولَد مرةً أخرى على الحافة البعيدة، فأشرقت الوجوه، وزال أثر المطر، وأخذ الندى يلامس الطرقات والأشجار، فيُحييها من سبات الليل. عادت الطبيعة لسكونها، كأنها تنبض بالحياة، وابتسمت المدينة مجددًا، وتلوّنت كلها بلوني البحر والسماء، حتى أصبحت كلوحةٍ ملأها الأزرق الرائق ودرجاته فقط.
– وبعد الليل، يجينا النور
وبعد الغيم، ربيع وزهور.
كان صوت كوكب الشرق، المُشوَّش قليلًا، وهي تشدو بأغنية “الحب كدة”، من كلمات الشاعر الإسكندري بيرم التونسي، يخرج من مذياع سيارة فؤاد، وهو يقطع طريق البحر بهدوءٍ بعد بزوغ الفجر بدقائقٍ عدة.
جال بخاطره سؤالٌ حزينٌ رغم انبهاره بالكلمات كعادته: كيف ستزهر الورود من الأمطار التي قد تملّحت بفعل الدموع. ولو أن النور قد أتى حقًا، فهل سيدوم رغم حلول الليل؟
كان مذياع شقة السيدة هدى يُصدر نفس الأغنية، وكان هذا الصوت الهادئ الذي يريحها، من الأسباب التي جعلت نادر يستيقظ صباحًا، بعد نومٍ طويلٍ.
قام من سريره، فوجد والدته تبتسم له بإشراقٍ، وقد أعدت له فطاره الذي تناوله سريعًا، وملابسه التي سيزور بها داليا ووالدتها السيدة صفاء. قبَّلها، وارتدى ملابسه، وأخذها ونزل إلى الطابق الأرضي، قبل أن يطرق باب هدى ليلقي عليها السلامِ، ليجدها بشوشة، ترد السلام بأفضل منه، رغم أنها لا تتذكره جيدًا، فقط صورًا مُشوَّشة عنه.
– ربنا يكتب لك في كل خطوة سلام وتوفيق يا ابني.
ابتسم لها وودعها، وخرج خارج العمارة؛ لينتظر سيارة أجرة، قبل أن يظهر فؤاد بسيارته، فيقرر نادر ووالدته أن يركبا معه.
– صباح الخير يا باشا. على فين إن شاء الله؟
بادله نادر التحية، وقال له أنه سيذهب لمشوارين، فوافق فؤاد. وفي الطريق، قال فؤاد بلا مقدمات:
– إسكندرية دي ما بتقْدِمش أبدًا. ولو قِدْمت، بتحلو أكتر. يا ترى إيه سر السحر اللي فيها؟ سيبك أنت. تسمع حاجة؟ ولَّا أقول لك؟ هشغّل أنا.
استنئق فؤاد بعضًا من النسيم الذي يملأ الطريق، ثم تنهد وهو يحاول سماع الأغنية المشغّلة بالمذياع، قبل أن يُغيّرها، ليستمعوا جميعهم في صمتٍ إلى صوت سيدة الغناء العربي، الذي يخرج كأمواج البحر التي تحيط بهم. بدأ الصوت يتصاعد رويدًا رويدًا ليحل محل صوت الهواء العالي.
– والموجة تِجري ورَا الموجة
عايزة تطُولها
تضُمها وتشتِكي حالها
مِن بعد ما طَال السَفَر.
شعر فؤاد أنه يرى مدينة الإلهام الحقيقي، الذي أشعل إبداع شفيق وجعله يتقبّل حياته، وأحسّت خيرية أن إسكندريتها العتيقة لم تفقد بريقها بعد وتندثر، كما حسبت، وتأكد نادر أن المدينة المبتسمة التي يتجول بها الآن غير تلك التي تُدميه ليلًا بين شوارعها.
تأملوا ثلاثتهم -نادر وفؤاد وخيرية- مدينة الجمال، مهد الحضارة، نور الفن، على أنغام الأغنية. شعروا جميعهم بالحنين لشيءٍ لا يعرفونه، وشعروا أن الابتسامة قد علت وجوههم دون أن يشعروا، ملأوا رئتيهم بنسيم الصباح المشرق، كما لو أنهم لم يذُوقوا البكاء يومًا، ولم تعرف الدموع طريقًا إليهم.
حوّل نادر نظرَه ليسارِه. نظر نحو بعض المباني التي يرى جمالها يوميًا دون أن تسترعي اهتمامه، كأن الألفة حجبت عنه الدهشة. وقال لفؤاد -مُجيبًا- أن سر السحر الكامن في الإسكندرية ليس فقط في البحر كما يظنون، وإنما في البشر الذين استمدوا بريق روحهم من روح البحر، فأضاءوا كل ما يحيط بهم وميّزوه وجعلوه ذا بهاءٍ خاص.
وقف نادر عند محطته الأولى: بقالة عم طه. نزل من السيارة، وطلب علبةٍ من الحلوى الشرقية التي تتميز بها بقالته على مستوى المحافظة كلها، قبل أن يحضرها له طه بشوشًا مُتبسِّمًا، وهو يقول:
– فيك شبه من ابني على فكرة.
دعا نادر لابن طه بالحفظ والبركة، قبل أن يبتسم طه دون ردٍ، وهو يشعر نحو نادر بامتنانٍ شديد؛ لأنه حثَّه -دون أن يقصد- على فعل شيءٍ لم يفعله منذ عشرة أعوام على أقل تقديرٍ؛ فعلى ما يبدو أن التفاؤل مُعدٍ، تمامًا كاليأسِ!
تذكر فؤاد هذا الشارع الذي زاره أمس، بعدما أقلَّ السيدة الحزينة إلى منزلها، فتذكَّر شيئًا آخر قد عزم على فعله. وما إن ركب نادر، أعطاه ورقةً، وقال له:
– حلو الكلام المكتوب دة؟
هز نادر رأسه موافقًا، قبل أن يثني ثناءً مُجامِلًا على كاتب هذه الكلمات، دون أن يخبره فؤاد أنه صاحبها بالاشتراك مع شفيق، كما كانت عادتهما في نظم الشعر سويًا، وإنما قال له كذبًا أنها لصديقٍ له يُسمَّى شفيق المليجي فقط، دون أن يذكر اسمه.
لم يركز فؤاد في طريقه، وإنما تذكر الوعد الذي قطعه بالدموع أمام قبر شفيق، بعد وفاته بيومين، عندما رأى الطيور تجتمع حوله، كأنها تشاطر فؤاد الأحزان، وحينما أقسم باكيًا أنه سيعمل جاهدًا حتى يُخلِّد ذكراه على الأرض، وأنه سينسب كل الأعمال الشعرية التي اشتركا في نظمها لشفيقٍ فقط، عسى أن تنجح ويتردد صداها في كل الإسكندرية، التي كان يعشقها شفيق.
وصل نادر لمنزل خطيبته، وما إن شرع يخرج من السيارة، أخرج فؤاد من جيبه صورة، وأعطاها لنادر مبتسمًا، وهو يقول:
– إمبارح، ركبت معايا ست شكلها طيبة من العمارة اللي أنت ووالدتك ركبتوا من قُدامها، نسيِت الصورة دي. ابقى اديها لها؛ شكلها ست غلبانة وما لهاش حد.
أمسكها نادر وابتسم، وهو يرى وجه المرحوم ابن هدى البشوش في الصورة، وهز رأسه موافقًا في وداعةٍ.
أخرج نادر المال ليعطيه لفؤاد، فرفضه، كأنه بدأ يزهد في كل شيء قبل رحيله عن الدنيا، فابتسم نادر دون اعتراضٍ، وصعد إلى منزل خطيبته.
لم تعرف والدة نادر لِمَ كانت تفكر في هدى كثيرًا، خاصةً بعدما علمت أن صورة ابنها الفقيد قد ضاعت منها. أخذت تتمتم لها بالدُعاء قبل أن يُفتَح لها وابنها باب منزل خطيبته.
كانت والدة نادر على حقٍ في قلقها على جارتهما العجوز.
فهدى أخذت تمشي بمنزلها ذهابًا وإيابًا دون توقفٍ. كانت تشعر بعدم الأمان، وكأنها فقدت شيئًا هامًا، لكنها لا تعرفه ولا تتذكره! فقررت أن تُصلِّي؛ لكي تصل للطمأنينة المفقودة، فقالت، طالبةً من أعماقِ قلبها التائه:
– يا رب، ما تسيبش حد حاسس إنه وحيد وتايه. رُدّ له اللي ضايع منه.
اطمأنت هدى جدًا، وشعرت أن الحياة تبتسم لها ببشاشةٍ، كأنها وجدت ضالتها. ابتسمت وجلست تحاول تذكر ملامح ابنها الغائب، قبل أن تشعر أنها تراه أمامها يحاول عناقها، فعانقته، وبكت فرحًا عندما رأت ابتسامته تملأ بيتها.
ما لم تعلمه هدى أنها بفضل دعوتها تلك للتائهين، شعر طه بالأمل مرةً أخرى. وأنه بعدما كان تائهًا عن قلبه، قد عاد!
وضع طه مفاتيحه في قفل شقته التي لم يقربها لسنينٍ. وما إن انفتح الباب، هرول طه ليجلس على أحد الكراسي أمام النافذة الواسعة التي تطل على البحر، ثم رفع عينيه للسماء وهو يصلّي لكي لا يتأخر سعيد عليه؛ فهو يفتقد حضن ابنه كثيرًا.
نظر إلى يساره، فتذكّر المذياع المُحاط بالأتربةِ، الذي اشتراه طمعًا في رضا زوجته، التي كانت تعشق السيدة أم كلثوم، وتذكر ابتسامتها الرقيقة الخجولة، وعناقها له، وهي تُغنّي -بالاشتراك مع سعيد الصغير- المقطع الأقرب لقلبها.
– مِن كُتْر شُوقي، سبَقت عُمري
وشُفت بُكرة والوَقت بَدري
وإيه يفِيد الزمَن مَع اللِي عاش فِي الخيَال؟
واللي في قلبه سكن، أنعَم عليه بالوصَال.
شعر طه أنه كان غبيًا طوال عمره الذي مضى؛ فهو لم يكن يهرب من الحزن عندما هجر شقته، بل كان يهرب من حياته الحقيقية وذكرياته. كان غريبًا، وها هو يشعر أن الدنيا عادت تبتسم له، ولا يعرف لماذا، ولا يعرف حتى هل هذه الابتسامة دائمة، أم أنها مجرد فاصلٍ لذيذٍ كافأته به الحياة؛ ليتحمل حياته الباقية!
لم ينجرف وراء تفكيره هذه المرة، وإنما اكتفى بأن يبتسم ابتسامةً واسعة هو الآخر، وأن يغمض عينيه مستمتعًا، كأنه يريد أن يرى بحقٍ، بعدما أصابه العمى وفقد بصره وبصيرته طويلًا؛ يريد أن يرى الحياة بألوانٍ أكثر إشراقًا مما هي عليه الآن… ربما ألوانها الحقيقية، وربما ألوانًا مُصطنَعة أضافها طه إشفاقًا على حاله.
بدا طه في هذه اللحظة -بجلسته المسترخية تلك على الكرسي المواجه للنافذة المطلّة على البحر، وابتسامته الصافية، وعينيه المغلقتين- كأنه بطلُ لوحةٍ عتيقة رُسِمت بريشةِ فنانٍ حالمٍ، بألوانٍ دافئةٍ من جنس الأصفر والبرتقالي، في أكثر مناطق العالم سكينةً!
لم يكن طه وحده مَن يحلق في سماء السعادة الآن، بل كان أيضًا نادر يشاركه في رؤية أكثر ألوان الدنيا إشراقًا، بعدما رأى البدر مرُتسِمًا على وجه خطيبته الخجولة وهي تفتح له الباب.
جلس نادر ووالدته مع داليا خطيبته ووالدتها صفاء، والبسمات ترتسم على ثغورهم المشرقة، والدعابات تنتقل بينهم في سلاسة، قبل أن تقرر صفاء -بالاتفاق مع والدة نادر- أن يتركاه مع خطيبته قليلًا، فذهبتا إلى الشرفة.
شعر نادر -عندما رأى ابتسامة داليا وسمع صوتها- أنه نسى كل أتعابِه، وأنه مستعدٌ لتحمل مشقاتٍ إضافية فوق مشقاته فداءً لها.
أخذت والدة نادر تتحدث كثيرًا عن كل شيءٍ خطر ببالها لصفاء، وتنتقل من موضوعٍ إلى آخرٍ في سلاسة كموج البحر: نادر وأحلامه، والإسكندرية وتاريخها الذي كانت تسمعه من والدها عندما كانت صغيرة، وصفاء تتظاهر بالاستماع، وهي تنظر بوجهٍ جامدٍ إلى الطريق والناس، وهي تعلم أنها ستجد مصاريف تجهيز ابنتها من حيث لا تحتسب. كان هذا الأمل وحده ما يرسم على وجه صفاء ابتسامةً تواجه بها الحياة.
رغم تأملها الناس، لم ترَ صفاء السيارة التي كان يقودها فؤاد، قبل أن يختفى من تحت عمارتها، بعدما أقلَّ نادر وخيرية لهذا الشارع.
تحرك فؤاد بسيارته كثيرًا، حتى وصل لشارعٍ جانبي كلاسيكي يطل على البحر، وركن سيارته بجوار سعيد السمان. ابتسم له، ثم أخرج ورقةً تحمل سطورًا شعرية عامية، كتبها مع شفيقٍ منذ أعوامٍ، وهو يهمس:
– ممكن تلحَّن الكلمات دي؟
وافق سعيد دون أن يقرأها حتى، فقط رأى بطرف عينه أن كان هناك اسمين أسفل الأبيات، شُطِب أحدهما وبقى الآخر. أمسك عوده الذي خُطَْ عليه بخطٍ ديواني جميل: “طه السمَّان”. نظر للاسم وابتسم ابتسامةً واسعة، وأحس أنه -لأول مرةٍ- لا يبغض اسم والده وعائلته بقدر ما ظنَّ، وشعر أيضًا أنه ناجحٌ ومطلوبٌ، وأن هناك من يؤمن بموهبته، حتى لو كان سائق أجرةٍ غريب الأطوار.
دعا سعيد فؤاد للجلوس أرضًا بجواره، ففعل الرجل. نظر فؤاد لسعيد وهو يرى فيه شيئًا من روحه، ومن حبه للفن والسير ورائه حتى لو كلّفه الأمر أن يتوه وسط كل الدروب والوجوه. شعر فؤاد أنه وجد صديقًا مرةً أخرى!… لقد وجد مَن سيتقبّل معه أيامه قبل أن تنتهي، ومَن سيتذكره بعد موته!
أسعدته هذه الخاطرة، فأغمض عينيه مبتسمًا، مُنتظرًا أن يسمع كلماته مُلحَّنة، حتى أخذت الأفكار تتدافع برأسه كما الأمواج العاتية في البحر الثائر.
كل الوجوه شاحبةٌ، حتى لو بدت نضرة. كل الوجوه تستر أنهارًا من الدموع، حتى لو تضاحكت آلاف المرات. ربما ابتسمت المدينة، وربما ضَحَكَ ساكنوها، لكن آثار البكاء والنحيب، التي عكَّرت الأمطار العذبة، لم تُمحى آثارها بعد من قلوب أصحابها. كانت ابتسامتهم هدنةٌ ومصالحةٌ مؤقتة مع الحياة فقط! فقلوب صفاء ونادر وخيرية وهدى وفؤاد وطه وسعيد وغيرهم الكثير، عَطشى للطمأنينة والسكينة والراحة. لم تروِ قلوبهم الأمطار، ولم تمحِ الدموع من على وجوههم آثار العطش!
لم يَفِق فؤاد من شروده سوى على صوت صديقه الجديد الشجي، وهو يقول شاديًا بكلمات فؤاد وشفيق:
– اِبكِي كتير… اِبكِي لحدّ ما ترتاح
وخلِّي المطر يِكْوِي جرحك الحزين
اِنزف دمع ودم، واِملا لِيلَك نواح
وسيب المواجع تِرسى على شط الحنين
واِشكِي للبحر حزنك… وغنِّي آهاتك للرياح
لكن يا ترَى… هيمسح دموعك مين؟
ومين هيرجَّع الضحكة تاني للعين؟
وإزاي هيرجَع اللي راح؟
وإمتَى هتنسَى الشجن والأنين؟
وإمتَى هتسكن قلبك الأفراح؟
يمكن محتاج شهور وسنين
ويمكن… يكفيك نور الصباح.
كان لحن العود وحده حزينًا مُبْكيًا، كعادة ألحان سعيد، لكن بامتزاجه مع شدو موج البحر الرقيق المتراقص، أصبح صداه مشرقًا.
ارتسمت على وجه فؤاد ابتسامةٌ راضية، مصحوبةً بدمعةٍ سريعة لم يحاول تجفيفها، ظنّ سعيد أنهما نتاج تأثره بلحنِه. لم يعلم أنهما تكوَّنا عندما رأى الطيور المُغرّدة فوقه -بعدما امتلأت برحيق الكلمات، وارتوت حتى الثمالة من سحر المدينة- تطير حوله، على شاطئ البحر، كأطيافٍ منيرة انبثقت من وهمه.
رأى بعضها يمضي إلى قبر شفيق.. والبعض الآخر يذهب ليُواصِل رحلته إلى قلب المدينة، حيث يمكنهم بثّ ما كتمته صدورهم من أغانٍ وحكاياتٍ عاينوها ولم ينطقوا بها بعد، كشهادةٍ حية على حيواتٍ متفرّقة لم يجمعها سوى الإسكندرية، وعن صِدق دموعهم المُرَّة كبحرِها، وإخلاص ابتساماتهم الواسعة كشمسِها… أو هكذا خُيِّل لفؤاد.