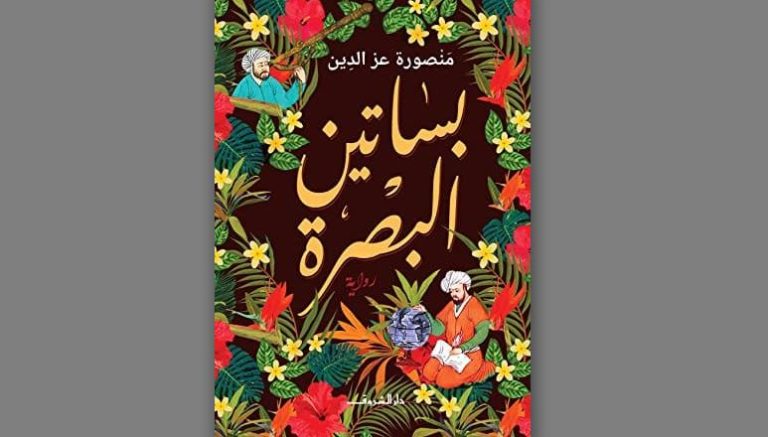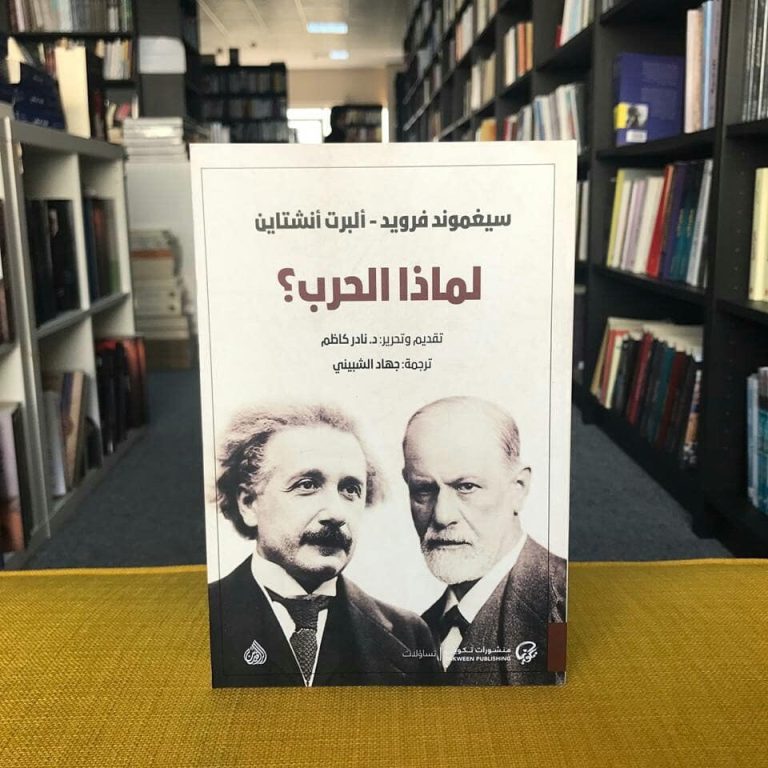محرر الكتابة
في روايتها “انخدعنا” الصادرة أخيراً عن دار الشروق، تصف الروائية دينا شحاته بطلها المأزوم طارق العايق بأنه أحرز هدفاً في نفسه، وهو وصف يمكن اعتباره مفتاحاً تأويلياً للنص بأكمله، واستعارة مركزية كثيفة الدلالة لبنية الرواية كلها، فالهزيمة هنا هي منطق حياة، وقدر يتسلل بهدوء من السطور الأولى حتى “قفلة الدومينو”.
طارق العايق ليس بطلا ملحمياً أو أسطورياً، وإن كان يشبه سيزيف الذي يكرر الفعل العبثي بوعي مأساوي متعال، فيحمل الصخرة إلى أعلى الجبل، ثم يعود لرفعها مجدداً في اليوم التالي. بطل الرواية شخص شديد العادية، يعيش داخل شبكة من التوقعات الاجتماعية والاختيارات المؤجلة، خسر لأنه اختار أن يلعب في الوقت الخطأ مع الفرق الخطأ وفي أرض تميد تحت قدميه، تصفه المؤلفة بأنه مدرب مهزوم بعد المباراة، وبأنه “كان يريد أن يُهزم ليبرر يأسه، ليجد شيئاً يلعنه، شيئاً يتعلق به حتى في الهزيمة”، يفهم الخدعة في النهاية، لكنه لا يثور عليها، يستوعبها ويستسلم، فهكذا يفعل ملايين العاديين من الذين لا يملكون رفاهية التمرد كل يوم، بل إنه عندما يأخذ قراراً واحداً متمرداً وهو الطلاق من زوجته، يتراجع عنه لأنه لا يملك “رفاهية الطلاق”، ومن هنا تتأسس فرادة الرواية، في اعتياديتها، في أنها تشبه آلاف الحكايات التي نسمعها كل يوم على المقهى، أو في العمل لأشخاص مثلنا، حكاية تشبهنا، تشبه أوجاعنا وآلامنا وهمومنا اليومية المعتادة.
تقدم دينا شحاته حكايتها عبر أكثر من لعبة فنية ولغوية لافتة، اللعبة الأولى هي أنها استعارت آليات لعبة الدومينو، كتابة ورسماً وتقسيماً، كبنية فنية تنظم الحكي وتتحكم في إيقاعه عبر أربع جولات وخاتمة تمثل “قفلة الدومينو”، وكأنها بهذه البنية تمنح البطل وهم السيطرة، فيظن أنه يمتلك حرية الاختيار في كل حركة، لكي يهرب من مصيره، لكنه يدرك في النهاية أن الدائرة تضيق عليه، لأن تتابع القطع يكشف حتمية كامنة، وهي أن كل نقلة تقود إلى الأخرى وفق منطق مغلق، فيستسلم في “القفلة”. وهكذا تتحول اللعبة إلى تمثيل رمزي لفلسفة النص، وهو أن صيرورة الأحداث سابقة على إرادة اللاعب، والخسارة نتيجة مؤجلة لكنها مؤكدة.
لعبة دينا شحاته الثانية، أنها تقدم الرواية عبر ثلاثة مستويات من السرد، وثلاثة طرق لمعرفة تفاصيل الحكاية ورؤية اللوحة الكاملة، عبر ثلاثة أصوات، تتبادل الحكي والشد والجذب في لعبة الدومينو، وهي كالتالي:
1 ـ صوت البطل طارق العايق، الذي يروي مأساته كاشفاً هشاشته وارتباكه وضعفه.
2ـ صوت الراوي العليم الذي يدعي الحياد لأنه يعرف مصائر الأمور، لكنه يمارس سخرية خفية تقوض ادعاءه الموضوعية، فيتحول إلى سلطة عليا باردة تراقب دون تعاطف، فنراه يسخر من طارق، حين يتحدث عن ذكر أمه لمميزات ابنها متسائلاً “لا أعرف كيف وجدت له ميزة وقتها”، بل يسخر من موقف كان سبباً في مأساة في حياة طارق قائلاً: “هههههه، حدث كوميدي، ضحك حي العرب كله يومها”، فصوت الضحكة هنا، هو سخرية من طارق ومن قدره المرسوم مسبقاً.
3ـ صوت المدينة، أي بورسعيد، التي تقدمها المؤلفة بوصفها كياناً حياً واعياً، تدرك خديعة الراوي العليم ولا إنسانيته تجاه طارق، فتصفه بأنه “الراوي غير العليم بالمرة”، وتخاطبه غاضبة: “لا ترفع حاجبك أيها الراوي ناقص المعرفة”.
هذا التوزيع الصوتي بين الرواة الثلاثة يهدف إلى مساءلة مفهوم “العلم” السردي ذاته، وكأن استسلام طارق لمأساته مردها “الجهل” بمصائر الأمور رغم عاديتها، كما أن الراوي الذي يفترض امتلاكه الحقيقة المطلقة يتعرض للتشكيك من قبل المدينة، التي تكشف جهله عبر تقديمها سرداً تاريخياً يستند إلى الذاكرة بوصفها فعل مقاومة، وهنا تبرز تقنية إدراج قصاصات صحفية تاريخية لتأصيل “الخديعة” وربط المأساة الفردية بالتحولات الجماعية عبر الأزمنة المختلفة.
وإلى جانب الأصوات الثلاثة المعلنة، يمكن استنباط صوت رابع خافت وغير مرئي، يتخذ موقعاً مراوغاً بين الحضور والغياب. يبدو كأنه صاحب المقهى الذي جلس فيه الرواة الثلاثة حول طاولة الدومينو، فهو الذي ينظم اللعبة دون أن يشارك فيها مباشرة، ويراقب حركات القطع، ويتدخل أحياناً عبر إشارات عابرة أو توصيفات دالة. هذا الصوت أقرب إلى وعي الراوية نفسها، بوصفه عيناً تنظم المشهد وتعيد توزيع زوايا النظر. فهو يرصد غضب المدينة، وينحاز إلى حساسيتها، ولا يخفي سخريته من الراوي العليم، إذ يصوره في هيئة ساخرة، جالساً فوق كرسيه الخشبي العالي، يرتدي قميصا أبيض مكرمشا من رطوبة الجو، ويدخن الجوزة.
بهذا التوصيف، تقوض صورة الراوي العليم بوصفه كياناً متعالياً؛ فتعيد تجسيده في هيئة بشرية عادية، قابلة للسخرية، ومحكومة بظروف المكان. ومن ثم، يتحول الصوت الرابع إلى أداة ميتاسردية تفكك سلطة السرد من الداخل، وتؤكد أن “العلم” ذاته موضع مساءلة، وأن اللعبة ـ حتى في مستواها الحكائي ـ ليست بريئة من الخديعة.
ومن المهم التوقف هنا قليلاً عند المدينة، فدينا شحاته تقدمها باعتبارها الأم الرؤوم التي تتعاطف مع ابنها بعد خسارته، فهي الأكثر حباً له، والأكثر تبريراً لهزائمه، ربما لأنها تظن أنه يُعاقب بسببها، وأن مأساته جزء من مأساتها، وأن ما وصل إليه كان بسبب ما حدث لها، ولأنها تعرف أن “الأكثر فجاجة في تلك الخدعة أنها متكررة”، تؤكد إن حكاية طارق حقيقية، لكن البداية لم تكن هنا، بل كانت مع تأسيسها، تخاطب طارق بحنو يائس أنها مثله، نتاج الأمل والألم، واللذين سينتجان بالضرورة خدعة كبيرة.
تتجاوز بورسعيد إذن كونها مسرحاً للأحداث لتصبح ذاتاً جمعية تشارك في إنتاج المعنى، فهي أم تعتذر لابنها عن العجز، لا عن قلة المحبة، ويتماهى مصير طارق مع مصير المدينة، لأن كلاهما ضحية تحولات تاريخية متراكمة. وفي هذا السياق، تستحضر الرواية أحداث بورسعيد 2012 بوصفه لحظة مفصلية في وعي البطل، حين غدا الانكسار فردياً وجماعياً في آن.
من الفائز في هذه اللعبة إذن؟ ظاهرياً، ثمة مهزومان واضحان هما طارق والمدينة، فكلاهما خرج من لعبة الزمن مثقلاً بإحساس الخسارة المتكررة والخيانة، في المقابل، يبدو الراوي العليم، الذي لا يهتم بما يضعه طارق العيسوي على الطاولة الخشبية، كأنه الفائز الوحيد، غير أن هذا التفوق الظاهري يطرح إشكالية جوهرية: ما جدوى اللعبة إذا كان الراوي العليم يملك المعرفة المسبقة بمآلاتها؟ تكشف دينا شحاته الإجابة في تقديمها للنص، بإشارتها إلى أن طارق الذي يعرف قلة حظه وخسارته، لا يهتم سوى بإثبات أن لعبته صائبة، أي أن الدافع تبرير المسار وليس تحقيق الانتصار، أو كما تقول المؤلفة “طارق لم يكن يبحث عن الشفاء، بل عن عزاء يليق بأوهامه”.
فكل القطع الجيدة التي تمثله ويلعب بها، والتي تتمثل في خدعة الحب، وصورة الأب الغائب المثالية وتشجيعه للنادي المصري، وسماع أغاني حسن الأسمر، والوجبة اليومية من سمك البوري أو الشبار، يخسرها واحدة تلو الآخر، يخسرها مع اكتشافه أنه لم يحب لميرفت بل أرادوا له ذلك، يخسرها في مثالية الأب لا غيابه، يخسرها عندما تقع أحداث مباراة الأهلي والمصري فيتحول النادي ومشجعيه إلى منصة تصويب من الجميع، يخسرها وهو يرى جثث المشجعين تخرج من بورسعيد، تقول الكاتبة “في ذلك اليوم لم تمت كرة القدم فحسب داخلك، بل دفنتَ معها طارق الذي كان”، يخسرها عندما يموت حسن الأسمر، يخسرها عندما يخسر تجارته ، ويخسر صديقه الوحيد أسامة المحلاوي بعد صفقة فاشلة، يخسرها عندما يقف على مسافة صدمة من مدينته/ أمه، بورسعيد.
لا يتعلم طارق من دروس الخسارة المتتالية، لكنه يعرف أن “الخسارة تبدأ في أكثر لحظة تتخيل أنها قد تمدك بالسعادة”، ما يحوله إلى شخص يخاف من الفرحة ومن السعادة ومن الحياة، لأنه يدرك أن اللحظة التالية هي لحظة الخسارة، اللحظة التي يحرق فيها ورقة جوكر في لعبة كوتشينة لأنه أبقاها في يده أكثر من اللازم.
هل الخدعة إذن أن كل شيء كان يؤدي إلى الخسارة لكنه لم يدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان؟ يدرك طارق دائماً أنه يخسر بعد انتهاء اللعبة، يظن أنه كان أقرب إلى الفوز، لكن ربما كانت الخسارة هي الأساس في حياته، يقول “كأنك تريد قلب الترابيزة، وإلقاء الزهر بعيدا، فالزهر خصمك تقرص عليه، فيصمم على خسارتك”، يقول في موضع آخر: “تصدق، أنا انخدعت، أمي والست سميحة والريس حسين خدعوني، قاموا بتمثيل مسرحية وأنا كنت المتفرج الوحيد، أخبروني ميرفت كذا وكذا وكذا، وضعوني في قالب وألبسوني بدلة عريس من عمر أربع سنوات”.
ومن ثم، يتبدل السؤال من “من فاز؟” إلى “هل كان ثمة خيار حقيقي أصلاً؟”. هل كانت تحركات طارق قرارات ذاتية، أم أنه كان مدفوعا إليها ضمن منظومة اجتماعية وثقافية سابقة على وعيه؟ يتجلى هذا بوضوح في مسار زواجه، الذي بدا وكأنه مخطط له منذ طفولته، وبهذا المعنى، تقدم الرواية الخديعة كبنية ذهنية واجتماعية تتشكل منذ البداية، وليس كحدث مفاجئ.
هكذا تتحول لعبة الدومينو من تمثيل للخسارة الفردية إلى استعارة للحتمية الاجتماعية، فالقطع التي يظن اللاعب أنه يختارها قد تكون محددة سلفاً ضمن ترتيب أكبر منه. وفي هذا السياق، لا يكون الراوي العليم فائزاً بقدر ما يكون تجسيداً لبنية قدرية تتحكم في المشهد، بينما يظل طارق عالقاً بين وهم الإرادة وواقع التوجيه الخفي.
اللعبة الثالثة التي تقدمها دينا شحاته في هذه الرواية، هي تعدد المستوى اللغوي، عبر الأصوات الثلاثة المتباينة الساردة، ما يعزز إحساس القارئ بأن الخديعة تتكشف عبر طبقات لغوية متفاوتة، لكل منها زاوية نظرها وإيقاعها الخاص. حيث يتباين الحكي عبر صوت طارق العايق شديد الواقعية، ثم تقدم في الفصول الأخيرة على لسانه بعض المقاطع بالعامية المصرية، بينما يأتي صوت الراوي العليم في معظمه بلغة تقريرية تميل إلى الوضوح والمباشرة، وتؤسس مسافة سردية باردة تتسق مع ادعائه الحياد والمعرفة الشاملة. وهناك صوت المدينة الأبرز، الذي يستند إلى خلفية دينا شحاته الشعرية، حيث تتكثف اللغة وتغدو مشحونة بالصور والاستعارات، في هذا الصوت تتراجع الواقعية لصالح نبرة غنائية، تمتزج فيها الشكوى بالحنين، والذاكرة بالتأمل، وهو ما يمنح البناء السردي بعداً رمزياً، فتتحول اللغة إلى أداة مقاومة للنسيان، وإلى مساحة لإعادة تأويل التاريخ الشخصي والجماعي.
ومن التشبيهات شديدة الفرادة في النص وصف الكاتبة لميرفت بأن لديها بشرة “كالجبن القريش وشعر كسواد رئة أبيها من شرب الشيشة القص والدخان”، أو تصف شخصاً نحيلاً بأنه يشبه حبل غسيل، بالإضافة إلى استخدامها تشبيهات من بيئة بورسعيد نفسها، فعندما تصف زغرودة أم طارق تقول إنها “رنت كصوت الفنار”، أو “تخبطهم في بعضهم كطيور نورس ضالة”، أو “ركضت كعم حسونة المجنون”، فالقارئ لا يعرف من هو عم حسونة المجنون لكنه يدرك أن هذا وعي البطل الذي يعرفه، أو قولها في مزج جميل بين طارق وبورسعيد “كأن المدينة تتنفس من صدره”.
اللعبة الفنية الرابعة في هذه الرواية، أنه لا يمكن مقاربتها بمعزل عن التجربة الغنائية المصاحبة، بدءاً من عنوانها “انخدعنا” الذي يحيل مباشرة إلى إحدى أشهر أغنيات المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر، والتي تشكل مفتاحاً قرائياً للنص، يستدعي حمولة وجدانية سابقة في الذاكرة الجمعية، ويضع القارئ منذ البداية داخل أفق من الحزن الشعبي والخذلان المتكرر كان المطرب الشعبي يمثله بأغانيه ومواويله الحزينة.
ومن ثم، يتجاوز حضور الغناء مستوى الإشارة العارضة ليغدو مكوناً بنيوياً في السرد، فصوت حسن الأسمر، بوصفه “المطرب الرسمي” للرواية والمفضل لدى طارق العايق، يتحول إلى خلفية صوتية دائمة لمشاهد الانكسار تؤدي وظيفة موازية للسرد، من هنا يمكنني القول إن هذه الرواية تشبه صوت حسن الأسمر، تشبه الحزن في صوته، تشبه حشرجته، تشبه مواويله ومآسيه وأحزانه.
كذلك تستدعي الرواية تراث بورسعيد الغنائي، خاصة أغاني السمسمية والضمة، بما تحمله من تاريخ مقاوم مرتبط بالحرب والذاكرة الشعبية، هنا يغدو الغناء فعل مقاومة بالمعنى الثقافي، فهو يحفظ الذاكرة من التآكل، ويمنح الجماعة وسيلة لمواجهة السرديات الرسمية أو الاتهامية، ويرسخ التوازي بين مأساة الفرد ومأساة المدينة، رغم إدراك طارق العايق أن ذلك جزءاً من الخديعة الأكبر “أن تبدو الضمة مأوى”.
هل هذه رواية عن مأساة طارق العايق أم مأساة بورسعيد، أم أن كلاهما انعكاس للآخر؟، تجيب دينا باعتذار تقدمه المدينة لابنها، حين تخاطبه قائلة: “أنا آسفة يا طارق.. اسمح لي أن أعتذر، لا عن قلة المحبة، بل عن العجز، فالمدن لا تخون أهلها لكنها تتعب أحيانا مثلك، وأنا يا طارق تعبت” هذه لهجة أم معذبة، يعاندها القدر والزمن وأبناؤها، فتحنو عليهم وتخبرهم أنها ليست خصماً لهم، بل هي أمهم التي لا تملك شيئا لتقدمه لهم بسبب القيود التي تكبل قدميها.
وكأن دينا شحاته هنا تطرح علينا سؤالا أخلاقياً، إذا كانت المدينة اعتذرت لابنها ولأبنائها جميعاً عن عجزها، عن الغضب والخذلان الذي يحملونه على أكتافهم، فمن إذن عليه أن يعتذر للمدينة، التي دفعت الكثير في تحولاتها الدرامتيكية عبر عشرات السنوات سواء في سنوات تأسيسها أو الحروب التي خاضتها، انتهاء بوضعها في خانة الاتهام ومعاملة أبنائها كالخونة بعد أحداث استاد بورسعيد سنة 2012، ومن يعتذر للأفراد الذين عاشوا وقاسوا داخل حدودها؟
خدعة دينا شحاته في نصها المدهش، أنها تقدم لنا خديعتنا التي ألفناها، والتي سمعناها مئات بل آلاف المرات، فلم نعد نشعر أنها كذلك من فرط تعودنا عليها، لتأتي هذه الرواية، لتصدمنا بهزائمنا اليومية، وانكساراتنا المعتادة، فتجبرنا على الاعتراف، وأن نصرخ مع بطل الرواية طارق العايق، وبصوت مطربه المفضل، أننا “انخدعنا”.
محمد أبو زيد