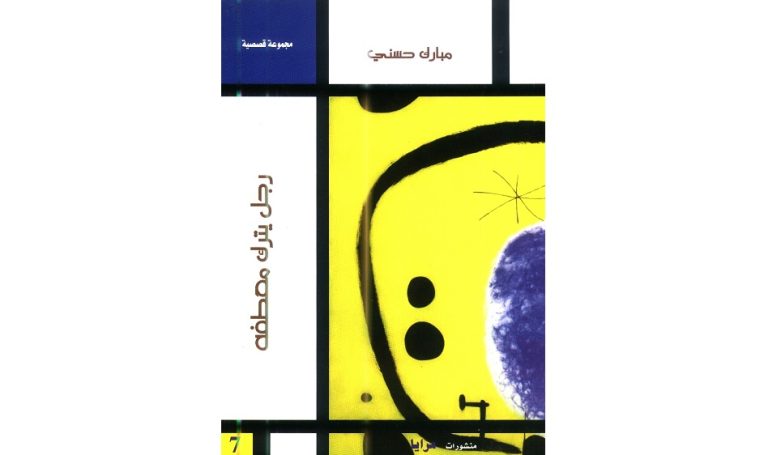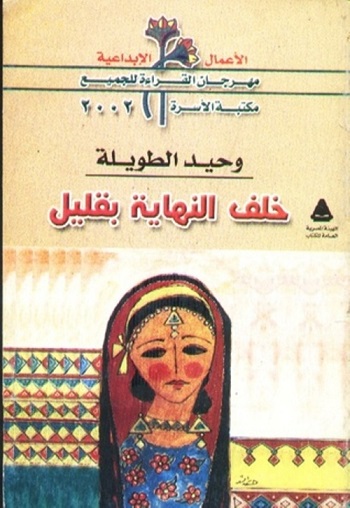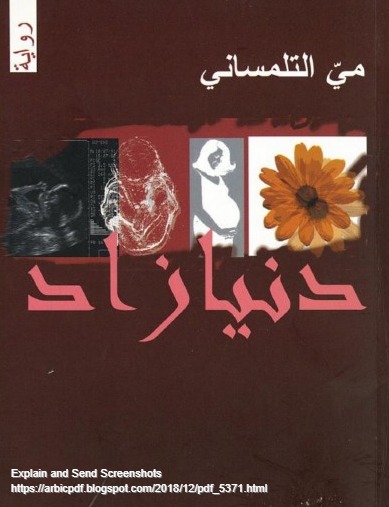مدحت صفوت
مع إعلان القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، فرع القصة القصيرة تحديدًا، كان اللافت حضور أربع مجموعات، جميعها لكاتبات، والمثير للإعجاب كمّ الحفاوة التي قوبلت بها “القائمة النسائية”، انتسابًا إلى جنس المؤلفات، لا انحيازات النصوص، وهو أمر جيد، فكان السؤال: لماذا 4 مجموعات وليست 5 أو 6 أسوة بالقوائم الأخرى أو بالسنوات الماضية؟
رُحتُ أقرأ المجموعات المتنافسة والمتجاورة أيضًا، هنا أسجل إعجابي باللجنة -غير المعلنة حتى الآن- واختياراتها التي لم تكن خبط عشواء من جهة، أو معبرة عن جماليات متنافرة ومختلفة، جراء اختلاف المحكمين أنفسهم وميولهم، كما هي العادة في كثير من الجوائز، لكنها بدت اختيارات واعية، وبناءً على معايير، أظنها تواجدت جميعها في المجموعات كافة، فحسنًا فعلت اللجنة في اختياراتها.
بقراءة متفحصة، تبدو المجموعات خطابات متقاطعة، لا نقول متشابهة، بقدر ما تشكل خطابًا أدبيًا واحدًا “عابرًا للأغلفة”، على الرغم من تباين المنطلقات الفنية، فإنها تتخذ من الجسد والمدينة والموت واللغة أدوات لتفكيك مركزية القهر والبحث عن خلاص ذاتي، في زمن يوصف بأنه زمن “تداعي المؤسسات” والانهيارات الصامتة.
وتُشكل القصص في مجموعها ما يمكن تسميته بـ “فعل المقاومة الجمالية”، لتطرح رؤية فنية تتجاوز مجرد الحكي التقليدي، وتدخل في اشتباك معرفي وأنطولوجي مع السلطتين: السلطة الأبوية المتجذرة في البنى الاجتماعية، والسلطة الأدبية التي حاولت لزمن طويل قولبة السرد النسائي أو حصره في أطر ضيقة.
كذلك تطرح قصص المجموعات رؤية “فينومينولوجية” شاملة للإنسان وهو يواجه تفتت جسده وضيق مكانه وتوحش لغته، خطاب قصصي وسردي يعيد إنتاج الألم جماليًا بوصفه أداة للمعرفة، ومحولًا الوجع اليومي من حالة بيولوجية صامتة إلى نص سيميائي ناطق بالاحتجاج والتمرد الفني ضد القهر بكافة أشكاله، بدءًا من قهر المؤسسة وصولًا إلى قهر الذاكرة والجسد.
نعود إلى “عبور الأغلفة” -أي وضع الخطابات كافة على خط واحد- والرقم 4، ولأنني أهوى اللعب النقدي، وسبق أن كتبت عن خمسة أشباح في خمس مجموعات قصصية، في كتابي “5X5.. أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر”، الذي حصد جائزة الدولة منذ عامين، فإنني افترضت لعبة جديدة، أن أدخل -مثلًا- في عقل لجنة التحكيم، وأن أفكر في الملامح المشتركة فنيًا وخطابيًا بين المجموعات، ولمَ لا؟ وهذه المرة نتحدث عن ملامح أربعة في مجموعات أربعة، ولنقل 4X4.. فهيا نلعب.
بداية سنتفق على أن المنجز السردي لكل من هدى عمران ونهى الشاذلي ونسمة عودة وإيمان أبو غزالة، عبر مجموعاتهن “حب عنيف”، و”مسافة تصلح للخيانة”، و”فئران أليفة”، و”للموت طرقات ثلاث”، يمثل حالة من الاشتباك العنيف مع المسلمات الاجتماعية والجمالية السائدة، كأنها – أي المجموعات- مشروع “جيولوجي” ينقب في نفوس القاهرين والمقهورين، ويشرح تجليات الانهيار الوجودي للذات المعاصرة.
الجسد المفتت
تتجلى أولى ملامح هذا الخطاب الموحد فيما يمكن تسميته بـ “أنطولوجيا الجسد المفتت”، إذ لم يعد الجسد وعاءً كليًا متصالحًا مع ذاته، بقدر ما صار ساحة “تشريحية” Anatomical وليست تفكيكية Deconstruction، مستحيلًا أعضاءً وحواسًا تمتلك ذاكرتها المستقلة وأحزانها الخاصة.
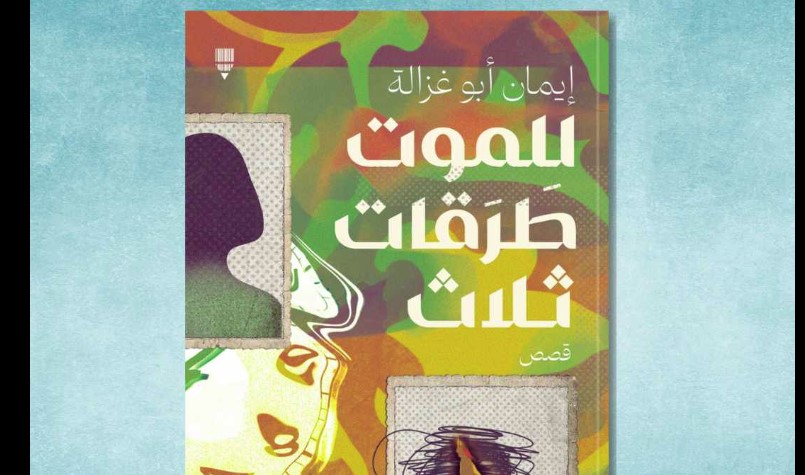
ففي نصوص إيمان أبو غزالة تجسيد بين لهذا الملمح، من خلال الساق المبتورة التي لا تعاني فقدًا فيزيائيًا، إنما تدخل في أجواء “شبه فنتازية” حين تلمس الساق السليمة فراغ أختها وتبكيها بدموع حقيقية، في استعارة حية لتمزق الهوية وتآكل الذات في مواجهة الفناء، “رأيت في كابوسي، أن ساقي اليسرى قد علقت بين إصبعيها السبابة والإبهام قلمًا، وانغمست في الكتابة!”.
هنا، تشريح سردي يتقاطع بعمق مع ما تقدمه نسمة عودة في “فئران أليفة”، بانتهاك قدسية الجسد عبر ممارسات القهر الاجتماعي، من الزوج أو الأب، كما في مشهد “المقص الصدئ” الذي ينتهك حرمة الجثث أثناء الغسل، وكأن الجسد في حياة المرأة وموتها ليس ملكًا لها، بل مادة خام للتجريب والانتهاك، وهي عملية متوارثة من امرأة لأخرى، “بالتدريج لاحظت تحول لون حلمتيّ من الوردي إلى البني.. لقد أصبحتا بالكامل نهدي خالتي”.
الجسد الذي “يتجنب التجربة” أحيانًا ويُحمل كعبء أو كجثة أداة للتنقل، يبدأ في اكتشاف نفسه كعالم من اللذات والأوجاع في آن واحد، محولًا “الأيقونة الجسدية” إلى أداة تغيير حقيقية، كما في “يوم عادي في حياة امرأة متزوجة” عند هدى عمران، جسد الزوجة يتمتع به الرجل بعد أن صفعها.
ويمتد التفتت الجسدي ليشمل “الكيمياء الحيوية” للنفس كما نجدها عند نهى الشاذلي في “مسافة تصلح للخيانة”. هنا، يظهر الجسد خزانًا للسموم الروحية والأفكار السوداء، حيث تشعر البطلة أن تحررها مرتبط بتبدل “خلاياها السامة” إلى “خلايا حية صحية” بمجرد خروجها من ضيق الغرفة إلى رحابة البحر.
“أشعر أن كل خليَّة سامَّة في جسدي تتحول إلى خليَّة حيَّة صحيَّة. كل فكرة سوداء سكنت عقلي تتبدَّل كلَّ يوم بفكرة نورانيَّة”، تصور يقلب مفهوم الصحة والمرض؛ فالمرض هنا هو “الواقع القاهر”، والشفاء هو “الانفصال السردي” عنه.
بينما تضع هدى لمستها على الجسد المفتت في مجموعتها “حب عنيف”، عبر تصوير “الثقب الحقيقي” الذي يسكن القلب، بئر عميقة تسحب كل شيء بداخلها، محولة الحب إلى فعل عنيف يملأ الذات بيأس يجعل الإنسان “يصير مثل الحيوان” ويخرج عن نطاق نفسه البشرية.
جدلية “الغرفة الضيقة”
أمّا الملمح الثاني الذي يضفر هذه المجموعات في خطاب واحد، فهو تفكيك مركزية القهر عبر سيميوطيقا “المسافة” وجدلية “الغرفة الضيقة”. المكان في هذه النصوص فاعل درامي يمارس سلطته على الشخصيات، وأبرز هذه الأماكن، الغرفة الضيقة التي ترمز إلى “الرحم الاجتماعي” الذي استحال زنزانة.

فالمنزل في “فئران أليفة” مكان تُقيد فيه حرية الابنة بـ “مسامير يدوية” يدقها الأب القاسي، وهو المكان الذي تشهد فيه الأم القطة تأكل صغيرها لأنها “أم جائعة لا تعرف الشبع”، في مشهد صادم يلخص تحول المكان من مأوى إلى محرقة.
تفكيك يشمل المدينة بوصفها “غرفة ضيقة كبرى”، كما يتجلى في القاهرة عند هدى، المدينة التي تتداعى فيها المؤسسات “بالتصوير البطيء”، وتتحرك فيها النساء “على حافة الانهيار العصبي”، وحيدات دون مظلات اجتماعية. القهر هنا ليس صوتًا عاليًا، بل هو “بيروقراطية عبثية” و”علاقات مجهضة” تجعل من المكان فخًا يوميًا، حيث تتحول الشخصيات إلى “موظفين” في آلة صراعات ونفاق لا تنتهي.
غير بشري
وينتقل الخطاب في ملمحه الثالث إلى استخدام استعارة “الكائن غير البشري” (الفئران، الكلاب، والقطط) كأداة لشرح حالة الاستلاب التي يعيشها الفرد. إن اختيار نسمة لعنوان “فئران أليفة” رؤية تضع النساء في مرتبة “فئران التجارب” التي مورس عليها القهر حتى أَلِفت التجريب. وهي النساء في المجتمعات المحافظة، النساء اللاتي يرين أن الأب “طيب جدًا، مشكلته الوحيدة أنه حين يضربنا لا يحضننا”.
إنها الفئران التي خلقت بالأساس للتجارب أو هكذا نتخيل إجابة على سؤال “لماذا خلق الله الفئران”؟ اللحظة التي تأكل فيها القطة الأم صغيرها ليست فعلًا وحشيًا، بل هي “رحمة وحشية” من عالم لا يطعم أبناءه، وهو ما يولد الرغبة الصادمة لدى بطلة القصة في أن تكون قد نالت المصير نفسه لترتاح من عناء الوجود.
يتقاطع التوحش في فضاء المدينة مع حضور ‘الكلاب’ في نصوص أبو غزالة، حيث تطل الاستعارة للدلالة على مدن الأشباح التي خلفها وباء ‘كوفيد’. هنا، لا يحضر الوباء بوصفه تقريرًا طبيًا، بل كأزمة وجودية كبرى حولت البيوت إلى سجون اختيارية والنوافذ إلى شباك للعناكب.
واستدعاء هذه العزلة في السرد يمثل استجابة فنية لما يسميه العالم الألماني أولريش بيك ‘مجتمع المخاطر’، حيث تفرض الحداثة على الإنسان مواجهة كوارث من صنع يده. لكن الكاتبة هنا لا تكتفي برصد المخاطر، بل تحول ‘العزلة الإجبارية’ إلى ‘فضاء فني’، وتصبح المدينة الفارغة مرآة لتفتت الذات، وتغدو حركة الكلاب في المنازل المهجورة استردادًا للطبيعة في مواجهة حداثة منهارة، مما يجعل فعل الكتابة في هذا السياق هو الأداة الوحيدة لترميم معنى الحياة وسط أنقاض ‘الواقع الوبائي’.

وعند هدى يتحول الإنسان تحت وطأة اليأس إلى “حيوان” خارج عن نفسه، يفقد القدرة على التواصل البشري الراقي ليعود إلى الغريزة الصافية في صراع البقاء، “ضحكت الصورة وقالت: مينفعش، كان هذا الكلب إنسانًا، ولأنه لم يجد رفيقًا رموه في البحر؛ فصار حيوانًا”. كذلك بفعل الحنان يستحيل الكلب طفلًا، خاصة وإن كانت اللمسة أنثوية “شعرت المرأة بالشفقة عليه، وطبطبت على فروته برفق فبدأ تحوُّله من حيوان إلى طفلٍ صغير”.
الكتابة “خيانة مشروعة”
ينتقل الخطاب الأدبي في هذه “الرباعية” في ملمحه الرابع إلى “الميتا-سرد”، إذ تصبح الكتابة ذاتها موضوعًا للتأمل وفعل “خيانة” مشروع. فتتبنى نهى الشاذلي الكتابة فعلَ “خيانة” ضروريًا للواقع، لأن الصدق مع واقع زائف وقاهر هو الخيانة الكبرى للذات؟ كأنه انفصال سردي يسمح بالنجاة؛ فالكتابة هي “النجاة من هلاك آتٍ” وخلاص من ظلام داخلي لا يعلم بوجوده أحد.
وتلتقي هذه الرؤية مع هدى عمران التي تجعل بطلاتها يتحايلن على القبح عبر تأليف كتب تراثية مزيفة أو خلق ذاكرة بديلة، مما يحول السرد إلى تدرج ينقل الشخصية من طور إلى آخر.

وعند إيمان أبو غزالة، فالكتابة “مرثية للحياة” وفعل ترويض للغياب، إذ يتحول الجسد الذي يكتب مذكراته الأخيرة إلى شاهد على الوجود، ما يعني أن الكتابة ليست ترفًا، بقدر ما هي “ضرورة بيولوجية” للبقاء، وفعل تطهير يغسل ما علق بالروح من خيبات.
السلطة والمصلحة
ختامًا، يبرز هذا الخطاب الأدبي الموحد فعل مقاومة مزدوج وجسور ضد السلطتين الأبوية والأدبية. فإذا كانت الأولى تتمثل في صورة الأب الذي يدق المسامير في حرية ابنته أو في الرجل الذي يمارس عنفه بصفعة تنقلب عليه في “عدالة كونية”، فإن السرد يقوم بفك هذه المسامير لغويًا وتقويض أركانها.
وعلى الجانب الآخر، فإن هؤلاء الكاتبات يكسرن سلطة “الأديب الأب المؤدب” الذي يضع معايير الجودة الأدبية بناءً على القومية والامتثال اللغوي والأعراف الثابتة. إنهن يخترن سرديات الهامش، والتشريح الجسدي، والركاكة المتعمدة أحيانًا، والصور الخادشة للحياء الاجتماعي كأداة لتقويض المركز، معلنات أن الأدب هو الذي يخرج من المواقع الهامشية والمنافي اللغوية والجغرافية ليصوب سهامه نحو تناقضات السلطة.
هل يمكننا أن نعتبر “حب عنيف”، و”مسافة تصلح للخيانة”، و”فئران أليفة”، و”للموت طرقات ثلاث”، مانيفستو سرديًا يخبرنا أن النجاة ممكنة فقط عبر امتلاك الشجاعة لقول “لا” صريحة، واتخاذ تلك المسافة التي تسمح لنا بإعادة خلق العالم، وتحويل “الجرح” إلى نص باقٍ يقاوم النسيان والفناء؟ أظن يمكننا ذلك بشيء من الاطمئنان.
…………………..
*ناقد مصري