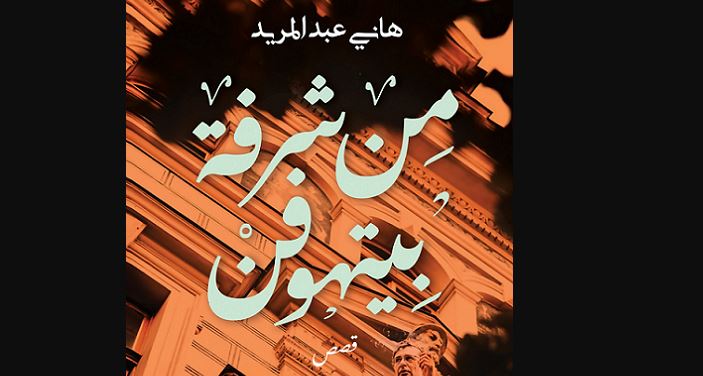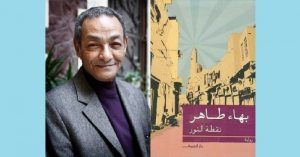د. عــزة مازن
في كثير من أعماله الروائية والقصصية يركز الروائي والقاص هاني عبد المريد على تيمة الكتابة وعودة الروح وخلودها بالحكايات، فبها تمتد الجسور وتنتعش الأرواح وتتوارى أشباح الوحدة ويطمئن الإنسان إلى خلود الذكرى.
في روايته “أنا العالم” (2016) استخدم هاني عبد المريد تيمة الكتابة لمقاومة الوحدة وتجمد الروح. يقول الراوي، المصاب باضطراب عصبي: “لم أكن أشعر سوى بأنني وحيد، في قاع القدر العملاق، كان القاع رطبًا باردًا، وكانت شفتا الطبيب تتحركان بلا صوت…. عندما تلاشى الطبيب، وتلاشت عيادته، كنت في القاع لأول مرة بلا خوف…. قاع القدر العملاق بدا لي كعالم طبيعي، زالت منه البرودة والوحشة، نبتت به الأشجار بثمارها المختلفة، نبتت أزهار ورياحين، وأحجار جيرية مختلفة الأحجام، لم تكن صلبة، أتاحت لي تسجيل كل مشاعري، على قشرتها الخارجية، متقبلة ذلك بكل ود، بقيت أكتب وأكتب، وفي روعي أنه عندما يسألني أحد لماذا تكتب؟ سأجيب على الفور، أنني أكتب كي أبدد مخاوفي وشعوري بالوحدة، أكتب حتى لا ينتهي العالم”.
وفي روايته “محاولة الإيقاع بشبح” (2018) يعزف هاني عبد المريد على أوتار الفانتازيا لحنًا جديدًا، يمتزج فيه الواقع بالخيال ويستوحي أجواء “ألف ليلة وليلة”. يثقل الواقع على نفوس البشر، تشتتهم المسئوليات ويغيب التواصل وتتوارى الحكايات، فتتصلب الأجساد وتتجمد الأرواح. يأتي الحكي بديلا للكتابة، فتتبدد مشاعر الوحدة فوق جسر الحكايات الممتد بين البشر. في مستهل السرد يحكي الراوي – يامن – كيف جاءت الحكايات جسرا يربط بينه وبين الخال يونس، فتتشتت على جوانبه مشاعر الوحدة وامتدت وشائج الألفة والتواصل: “”شبح”. هكذا نطق الخال بلا داع، وبمفاجأة كعادته…. حين نطق بدا كأنه حرك المياه الراكدة بيننا، بطريقته صنع صخبًا دبت معه الروح بين جنبات المكان، جعلني أفكر هل نحن نقترب من الناس أكثر حين يكون بيننا وبينهم لعب، أم حكايات. بيني وبين الخال حكايات، أنبتت أسرارًا ولعبًا، الحكايات تشمل كل شىء، أتخيل أنه لا لعب بلا حكايات تسبقه…” .
يتبادل يامن دفة السرد مع الأم – هانم – بأسلوب استرجاعي – فلاش باك. تستخدم الأم الحكي لتعيد الحياة لزوجها وابنتها وولديها الآخرين الذين تحولوا إلى دمي مطاطية، بلا حياة. اتخذت الأم من الحكايات وسيلة للتواصل مع المتحولين، وعندما غابت في رحلتها مع ابنها الأكبر إلى بيت خاله، عادت لتجد الأجساد المطاطية وقد أصابتها التشققات. راحت تحكي لابنتها عن حبها لها، عن مكانتها وأهميتها لديها. ولدهشتها أخذت التشققات تتوارى. تقول الأم: “ظللت أحكي حتى حدث ما لم أتوقعه…. كنت أحكي وكانت التشققات تتوارى، اقتربت من جسدها مدققة، اكتشفت أنني عندما أتوقف عن الحكي تثبت التشققات على وضعها، أكمل فتبدأ تدريجيًا في الاختفاء؛ أكملت حكاياتي حول أبيها وكيف تعرفت عليه، كيف اعترف لي بحبه، تفاصيل زواجنا، حتى اختفت كل التشققات من جسدها”.
كررت الأم الأمر مع زوجها وولديها، فاختفت التشققات من أجسادهم المطاطية، ومن ثم أدركت أنهم يشعرون بها، وأنها عندما غابت عنهم وانقطعت الحكايات أصابهم التصدع والتشقق. وهنا أدركت أنهم “سيبقون ما بقيت بيننا الحكايات”. وجدت الأم في الحكايات الملاذ والدواء: “طوال الوقت أجلس بجوارهم الواحد تلو الآخر، أحكي كل تفاصيل اليوم، كل مشاعري وتصوراتي عما يدور من حولي… صرت أقضي جل يومي بجانبهم، أقص الحكايات لأجلهم كأنها زادهم، وكأنني ألقمهم حكايات ليستمر الوجود”. تنتابها الحيرة في البحث عن أسباب تحولهم إلى دمي، وتبدو كمن “يحاول الإيقاع بشبح”. بعد لقائها بالسيدة العجوز، الوحيدة غريبة الأطوار، تتحول الأم إلى “شهرزاد” تحكي لهم الحكاية تلو الحكاية، كما تلقنها لها العجوز، وبعد كل حكاية تستعيد الدمي جزءا من بشريتها، ولكن تبقى الروح غائبة. لا تخبر العجوز الأم بالحكاية التي تستعيد الروح: “… أكدت لي العجوز … أن ما تبقى هو دوري أنا، فهي لا تملك حكاية لتعيد الروح، حكاياتها للجسد بحواسه فقط، أوضحت لي حين لمحت الحزن باديًا في عيني أن أرواحهم ستعود من حكاية أحكيها أنا… حكاية لا أعلم عنها شيئًا…. لا أعرف ولم يعد أمامي بد من أن أقص عليهم كل الحكايات واحدة تلو الأخرى، حتى تأتي الحكاية التي ننتظرها جميعًا بكل شغف”. ينتهي سرد الأم وهي لم تزل تطارد شبح الحكاية الغائبة وتحاول الإيقاع به. وهكذا تستمر الحياة مادام هناك ذلك التواصل الإنساني ومادام الناس تجمعهم الحكايات.
لا تخلو مجموعته القصصية “من شرفة بيتهوفن” (2019) من قصص تطارد شبح الحكاية، أملا في بعث الأرواح المجهدة والإنطلاق إلى عوالم أكثر رحابة وإنسانية. تأتي عتبة السرد في ذلك الإقتباس من الروائي الإنجليزي “جورج أورويل”: “هل خطر ببالكم يومًا أن داخل كل رجل بدين رجل نحيف؟” لتشي بذلك التناقض المتصارع داخل نفوس البشر، كأن يغلف الخير الشر، وينطوي الشر على الخير. وتأتي الحكايات لتحرر النفوس المعذبة. في قصته “قراءة حرة”، يتسلل لص إلى أحد المنازل بحثا عن النقود والذهب، ولكنه “لا يجد سوى الكتب، كتب لها حجرة كبيرة رئيسية، تتسرب مجموعات كثيرة منها متناثرة في كل مكان”. يعثر على كتاب “السلطان الحائر” لتوفيق الحكيم، مفتوحًا على سطح المكتب. ينجذب إلى عوالم الكتاب وتأخذه القراءة حتى النهاية. أخذ رواية لنجيب محفوظ وخرج من المنزل متسلقا ماسورة الصرف، كما دخل. في الصباح بقى في فراشه حتى أنهى الرواية، “لم يتخيل أن الكتب تحوي كل هذه المتعة، حين استبد به الجوع، ذهب لمكانه الأثير، صعد سلم العمارة حتى السطح، انزلق على ماسورة الصرف، أعاد الكتاب لمكانه، استخرج قطعة جبن من الثلاجة، أكل حتى شبع، أخذ كوب الشاي، اختار كتابًا، جلس إلى المكتب، انتابته مشاعر لم يكن يفهمها، لم يكن يتخيل أنه يفكر فيها أو يحتاجها لهذا الحد، الشعور أنه مثل أبطال المسلسلات الذين يظهرون في بيوتهم بالروب، جالسون إلى مكاتبهم بشعر مصفف لامع”. ذهب إلى الحمام ووقف يصفف شعره أمام المرآة، فانتابه شهور بأن لديه ما يود كتابته: “استخرج بعض الأوراق البيضاء، فتح قلمًا أسود كان موضوعًا أمامه على المكتب، بدأ يسطر أولى حكاياته، صار في كل يوم يأتي للمكتبة، يقرأ ويكتب، يشرب الشاي، يأكل القليل حين يشعر بالجوع، صار معه الكثير من الأوراق التي يحتفظ بها، تحوي العديد من حكاياته”. وسرعان ما يكتشف أن صاحب المكتبة عجوز تجاوز السبعين يستلقي ممدداً في سريره، يستمع إلى موسيقى ناعمة. أدهشه ذلك الشبه بينه وبين العجوز. شعر بالطمأنينة وانتظم في زياراته اليومية إلى المكتبة “يقضي اليوم كاملًا مع الكتب والكتابة، يجد في كل مرة كتابًا جديدًا ينتظره على سطح المكتب، يقرأه ويتركه في مكانه ليعود في اليوم التالي فيجد كتابًا آخر، يقضي يومه معه، ينتظر حتى يأتي العجوز، يطل عليه يطمئن أنه خلد للنوم، يدخل على أطراف أصابعه، يتأمل ملامحه التي صارت أكثر هدوءًا، وكانت في كل يوم تتشابه معه عن سابقه”.
في قصته “زوجات الكهنة” من نفس المجموعة يدور السرد بضمير المتكلم، الذي ينتمي إلى جزيرة يعيش عليها مجتمع بدائي، وبينما هو معلق على حبل المشنقة يتذكر سبب إدانته، وهو ترديده لأفكار أخيه المناصرة للمرأة وضرورة مساواتها للرجل، مما أثار أهل الجزيرة ضده. وتم العثور عليه “يطفو على سطح بحيرة فاقدًا للحياة، في ظهره أثر طعنة، وعلى وجهه ابتسامة استهانة، كأنه يقول “ليكن” . ولكن موته كان بمثابة الشرارة التي أيقظت كثيرًا من النساء على ضرورة المطالبة بحقوقهن. حاول إحياء أفكاره وترديد كلماته، وهو على يقين بأنه “رحل وترك خلفه حكاية، من يترك خلفه حكاية لا يموت أبدًا”.
في قصته “أوهام كهف الشيخ” يجد الشاب نفسه في كهف بالصحراء، وقد أنقذه من الموت شيخ عجوز يقطن الكهف. لاحظ الشاب معجزات يأتي بها الشيخ لتوفير طعامه وشرابه. يعرف الشاب من الشيخ أنه يعيش في الكهف منذ خمسين عامًا، بعد أن ترك مكانه العريق وأسرته الكبيرة بعد أن ساد القهر وانتشر الظلم على يد “الوريث” الذي صار إليه حكم المكان: “الشيخ كان يعلم أن الوريث بذلك صار كاكائن شرس مسعور، فعل ما يريد بالناس، وسيتحول بعد ذلك للمقربين، سيترك الجميع يتقاتل ويراقبهم كما يراقب عقاربه”. كان الشيخ يخشى “من فقد البصيرة لو بقى لوقت أكثر تحت هذه الظروف”. ترك زوجته ووولده في أحشائها، وكل شىء خلفه “ظل يمشي لشهور حتى دخل شق في بطن الجبل”. بدا الشيخ كأنما ينتظر الشاب ليروي حكايته ويأتمنه عليها مسطورة على لفافات من جلود الغزلان ليحملها لولده، ثم يفارق الحياة: “الشيخ ظل يحكي، كأنه كان ينتظر مجيئي، كأنه يدخر حكي خمسين سنة حتى يراني…. بقيت طوال الليل أنعم بصوته، يحكي عن الكثير مما قابل، كأنه استعرض أمامي سريعًا رحلته كاملة، عند شروق الشمس شعرت أنني تعافيت تمامًا، ووجدت صوته يخفت كشمعة تنطفئ، ظننته يود الدخول للنوم، لكنه كان ينتهي، حاول التحدث بسرعة، كمن يود الانتهاء سريعًا من أمر ما، أشار أن أدخله إلى فراشه، رفع جوال الشيح، استخرج لفافات من جلود الغزلان، قال إنه سطر كل ما يود أن يقوله لولده هنا، قال إن هذا هو طلبه… أن أسلم خلاصة عمره وحكمته هذه لولده… قال إنه قاوم وبقى في انتظاري حتى لا تضيع كلماته وعمره سدى…”. يعود الشاب إلى المكان الذي عاش فيه الشيخ ليجد الأمور قد تغيرت وقذف الجميع “بالماضي وراء ظهورهم والتفتوا فقط لمستقبلهم”. رفضت زوجة الشيخ لقاءه، وتركه الإبن وهو يسرع لعمله مؤكدًا “أن ليس لديه وقت لقراءة تجربة لا يهتم بها، ولن تفيده كثيرًا”. قرر إلقاء اللفافات في البحر، حتى لا يطلع عليها أحد، كما أمره الشيخ، والعودة إلى حياته.
بيد أن الليل داهمه ففضل البقاء حتى الصباح، واستأجر إحدى عشش البامبو المقامة على الشاطىء. وهناك تأتيه فتاة لترحب به وفي يدها جلباب ومشروب بارد، فقد لاحظت أن لا حقيبة معه. ينجذب الشاب لصوت الفتاة الذي بدا قريب الشبه بصوت الشيخ. تسير معه على شاطئ ويكون هو من يحكي: “قالت الكلام الكثير، لم أكن أسمعها، كان فقط يجذبني صوتها، شعرت كأنني سمعته من قبل، إنني لا أود سوى أن أظل أسمعه، كانت البداية أن ظللت معها حتى الصباح نسير على شاطىء البحر، لم أكن أستمع هذه المرة للحكايات، كنت من يحكي، وبدت كأنها تنتظر حكاياتي من قديم الأزل”.
في روايته الأحدث “عزيزتي سافو” (2021) يدور السرد حول الكاتب والكتابة والبحث عن الحكاية. تأتي عتبة السرد في اقتباس من “نقش على ابريق من أثينا” يقول: “إلى ذلك من بين جميع الراقصين يصنع أعذب المتعة”. كيف يصنع الكاتب أو الفنان “أعذب المتعة” إذا لم يكتب/يرسم حكايته/لوحته الأصيلة التي تستنطق روحه وتكتب له الخلود. يلتزم السارد/ الكاتب بعقد مع إحدى دور النشر يكفل له مرتب شهري على أن يقدم لها رواية كل عام. يوشك العام أن ينقضي وخالد/الكاتب يعاني من حبسة الكتابة: “يخاف أن يأتي يوم لا يستطيع فيه أن يكتب، لا يجد حكاية يحكيها، لعله يعيش أتعس أيامه؛ لأنه بالفعل يشعر لأول مرة بعجزه عن الكتابة، خالد اعترف بأنه خائف بالفعل”.
تحاول الناشرة أن تستغل العقد بينهما لتجعله يكتب حكاية جدها الذي نفذ بنفسه حكم الإعدام في سليمان الحلبي، حكاية تبرأ ساحته أمام التاريخ. تشتد حيرة الكاتب، الذي يرفض أن يكتب حكاية تزيف التاريخ مقابل المال. فيكتب حكاية حب بسيطة ليخدع الناشرة، ويحتفظ بالعقد، ورغم أنها حققت أعلى المبيعات يظل الكاتب يبحث عن حكايته الأصيلة التي تنبع من روحه.
على النقيض من خالد يأتي صديقه الفنان بولا يحمل لوحاته التي تتدثر خلفها حكايات أصيلة. يعلق خالد على لوحات صديقه: “وجدتني أبتسم وهو يحكي، قلت إن علاقتي اختلفت باللوحات بعدما حكى عنها، قلت إنني مازلت أؤمن أن الحكايات أصل الفنون، هى المادة الخام لأي فن، لو لم يكن خلف لوحاتك حكايات ما صار لها مثل هذا التأثير لدىّ، قال في الحقيقة لو لم يكن خلف اللوحة حكاية ما رسمتها أصلا”.
ظل خالد يتأمل لوحات صديقه، ذات الحكايات الأصيلة التي تكمن وراءها. وفي الحلم تزوره “سافو” الشاعرة اليونانية، التي اخترقت كلماتها حجب الزمان وعاشت آلاف الأعوام. يمتزج الواقع بالخيال في حياة خالد/الكاتب، فبينما يبحث عن حكايته الأصيلة في الواقع تأتيه سافو في الحلم لتأخذ بيده نحو الكتابة الأصيلة التي تستقطر روحه وتنبعث منها، تدفعه لكتابة حكايته التي تلتصق بجذوره. تقول له سافو: “أنت تقول “زنقة كتابة”، وأنا أقول لعلك لم تجد الموضوع الذي يشبهك، أنت بالتأكيد تعلم أننا نكتب ما يشبه أرواحنا، هناك أفكار عظيمة تصلح لكتابة عظيمة، لكنها في الحقيقة قد تحتاج لروح غير روحك، ولا أدعي أننا نعلم ما يشبه أرواحنا، أنت في الكثير من الأحيان تفاجأ بالأمر مثل الآخرين تمامًا، هناك مفاجآت طول الوقت…”. وتواصل: “نحن – معشر الكتاب – نصطاد من الفضاء المحيط ما يتوافق مع أرواحنا… في كثير من الأحيان يُخيل لي أن الكتابة موجودة من حولنا تسبح في الهواء، نتنفسها جميعًا دون أن ندري، لكن عند لحظة ما، أو لنقل في ظروف ما يلتقط كل كاتب منها ما يليق بتجربته وروحه ووعيه.” يجد خالد نفحة روحه في حكاية يلتقطها من جذوره البعيدة، قرر أن يكتب حكاية أسلافه “فرد مساحة للكاذب الأعظم جليل، مساحة لصوت عاشور الكبير حتى يظهر ويؤثر ويسحر، مساحة لعاشور الصغير ابن مليحة، ليرقص ويحلق ويرتقي، بل ومساحة لأحجيات جد بولا الذي مات حين فقد سطوته عليه، دون أن يدرك أنها التي كانت تفرض سطوتها عليه طوال حياته، مساحة لنفسه ولبولا ولأشجان، لتمتزج أصواتهم وضحكاتهم بضحكات وعرق ورائحة الأسلاف…”. ينشر الكثير من الروايات وتبقى الرواية التي تحمل صوته الخاص وحكايته الأبدية وكأنها سره الخاص: “اكتشف أن سنوات مرت على وجود النسخة داخل جهازه، كل حين قد يضيف كلمة أو يحذف أخرى، لم يشعر بكونها رواية قدر شعوره بأنها سره الخاص، أنها جزء منه لا يمكن لغيره الاطلاع عليه…”.
يمر الزمن ويبقى “ما بينه وبين هذه الرواية تحديدًا… أكبر من كونها رواية، ما بينه وبين سافو أكبر من كونها ملهمة، كأنه استبدل سور الروف الذي كان يسير عليه بخيط رفيع، تمسك به روايته هذه من جهة، ومن الناحية الأخرى تمسك به سافو، يشدانه كوتر آلة موسيقية، لا بد أن يسير عليه بدقة مرهفًا السمع لما يصدر من أصوات”.
ينشغل الروائي والقاص هاني عبد المريد في كثير من أعماله بالبحث عن الحكاية التي يتردد فيها صدى الروح، وتحمل صوت الكاتب الخاص الذي ينفخ الحياة وروح الخلود في كلماته وأعماله.