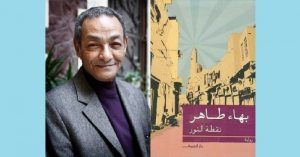د. عزة مازن
تدهشني وتستوقفني نظرة كثير من الشباب إلى اللغة العربية، ينظرون إليها بإستعلاء ويرونها مقصورة عن مواكبة ثقافة العصر وتقنياته. أستنكر موقفهم وأراه نابعًا من جهل وعدم إنتماء، ينفون أنفسهم خارج لغتهم، فيحيون غرباء عن لغتهم وثقافتهم، ومن ثم يغتربون عن الوطن وهم يعيشون فوق أرضه. أتذكر عظماء أتقنوا لغات أجنبية واطلعوا على ثقافاتها وامتلكوا ناصيتها بطلاقة منقطعة النظير، ولكنهم اختاروا لغتهم العربية وطنا يحتضن فكرهم وإبداعاتهم يتواصلون بها ومن خلالها. ومن منهم حرمته ظروف إحتلال بلاده من إتقان لغته العربية، فاضطر إلى إستخدام لغة المحتل، شعر بنفسه منفيًا خارج وطنه وتراثه وحضارته، وإن تمحور إبداعه حول هموم الوطن وقضاياه.
“اللغة وطن”، هكذا تراها الأديبة والناقدة وأستاذة الأدب الإنجليزي الدكتورة رضوى عاشور (1946 – 2014). أثرت صاحبة “غرناطة” و”الطنطورية” و”أثقل من رضوى” والدراسات النقدية المتعددة الإبداع الأدبي والنقدي العربي والعالمي في لغة عربية جزلة مرهفة آسرة، عشقتها وانتمت إليها. في شهادة لها حول الكتابة في القيراوان 2002 (جاءت ضمن كتابها “لكل المقهورين أجنحة” (2019) الذي ضم مقالات لها غير منشورة) تقول: “أعترف أنني أتشبث باللغة تشبث الغريق. وأي لغة؟ لغة قوم معجزتهم كتاب، ومن بعد الكتاب خمسة عشر قرنًا شهدت المدهش من التجارب. إن استمرارية هذه اللغة العربية وصلابتها ومرونتها وتنوعها وثراءها وعامياتها المتفرعة منها بما قدمته للعالم من نصوص مكتوبة وشفهية، لها رسوخ المعابد المصرية القديمة وعنفوان فاعل لم يعد لهذه المعابد. هل يبدو غريبًا لو قلت الآن إن هذه اللغة تمنحني قدرًا لا يستهان به من الأمان؟ أكتب بالعربية وأنتمي إلى تراثها الحي فينتفي اليتم، تتبدد الوحشة، وأيضًا يهدأ بعض الإضطراب”. وتضيف: “أرى في العربية وطنًا يمتد من قرآن العرب إلى نداء البائع المتجول (…). أرى في العربية وطنًا متراميًا، واضحًا وغامضًا، أليفًا ومدهشًا، وفي بعض الأحيان مربكًا. أعرفه ولا أحيط به. أسكنه وأعرف أنه يسكنني، وأنني في كل فعل وقول أحمل خاتمه وعلامته. العربية أداتي ولكن الصحيح أيضًا أنني أداة من أدواتها، هي كتابي الذي تضم صفحاته إرثي وحكايتي مع الزمن، وطموحي أن أضيف سطرًا جديدًا إلى سطوره”. وتؤكد: “ثراء العربية، في يقيني، لا يقتصر على إنتاج كبار كتابها القدماء والمحدثين، ولا على ما أنتجته المخيلة الشعبية من ملاحم وحكايات بل يتسع لذلك التنوع الهائل في حياة البشر يتشكلون بها وتتشكل بهم. هي موروث ومعيش، قديم جليل مكنون في بطون الكتب وتلافيف الذاكرة، ويومي متجدد يتفاعل مع شعر الواقع ونثره ويعيد إنتاجه. باختصار هي لغة حياة وتحيا، رغم استلاب الإرادة والقهر، تحيا لأننا نحييها ونحيا بها. تملؤنا وجلًا بسلطتها الأبوية الصارمة وتحيط بنا بردائها الأمومي الضافي ثم تنقلب الآية في غمضة عين فنجد أنفسنا أهلها نلاعبها وهي طفلة تفاجئنا، على طريقة الأطفال، بالجديد المدهش من تراكيب الكلام”.
أما الكاتبة اللبنانية هدى بركات، صاحبة الإبداعات الأدبية العالمية، والفائزة بجائزة البوكر العربية 2019 عن روايتها “بريد الليل”، والتي تعيش في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة عقود، فتقول في حوار لها بجريدة المدن الإليكترونية: “فرنسا، التي لم أختر الهجرة إليها، وفّرت لي الحريّة في انعزالي عن ضرورة التأقلم مع الواجب الإجتماعي ومراعاة فولكلور العلاقات المفروضة علينا. وهي كرّمتني في أوجه كثيرة. لكني لست فرنسية أصلية ولن أكون. ولست فرانكوفونيّة رغم مساهمات لي عديدة وباتت مهمّة باللغة الفرنسية التي أحبّها وأقدّرها أيضا طبعا. لكن لي لغة وهي العربية، لأني ببساطة عربية، وأكتب عن مكان عربي وعن أناس، شخصيات، لغتهم هي العربية. كنت ربّما سأكتب بالفرنسية لو أني أجهل اللغة العربيّة، أو لو أن لكتابتي طموحات “عالميّة” سريعة لا تحب التأني أو الإنتظار. الترجمة إلى الفرنسية التي تتبع رواياتي تأتي أحيانا بالتزامن مع النشر بالعربية”. وتضيف إنها رغم ذلك ليست بعيدة عن الواقع الفرنسي: ” لست بعيدة من الواقع الفرنسي أبدا، لكنّه حتى الآن ليس “منطقتي” السرديّة، ربما لأني حملت معي ما يكفي لعمرين أو أكثر. وربما لأن أسئلتي الأكثر إلحاحا تأتي باللغة العربية ومنها. على أي حال أصبح العالم أوعية متصلة بحق. واهتمام الغرب بكتاباتنا، كما يحصل حاليا مع “بريد الليل” منذ صدورها، ووصول التعبيرات السرديّة العربية إلى مستويات عالية، يؤكد أن الرواية العربية تركت الهامش إلى المتن. وأكرر أنه ليس بالنسبة إلىَ وحدي طبعا”.
وفي حوار آخر لها مع جريدة الشرق الأوسط تقول: ” فأنا معجبة إلى حد بعيد بطواعية اللغة العربية وأجدها حديثة جداً. هذا لم يكن تلقائياً ولا عفوياً. قرأت القديم ولا أزال. كان يجب أن أعلّم نفسي ما لم أتعلمه في المدرسة. كنت حينها أكره العربية، ثم بعد ذلك، في لحظات الوعي، وفي الجامعة، تعرفت على الأدب. كتابتي باللغة العربية جاءت بفعل خيار شخصي، فقد كنت عند تخرجي وبحكم طبيعة دراستي أقرب إلى الكتابة بالفرنسية، ولا أزال أكتب نصوصاً بالفرنسية، حين يطلب مني المشاركة في عمل ما أو كتاب مشترك أو مقالة. ولا داعي للحديث عن كمّ المغريات للكتابة بلغة أجنبية، من تسويق وغيره. لكن قلبي ليس ثنائي اللغة، فتكويني اللغوي عربي. وعندي احترام عميق جداً للعربية، أعمق من أن أستطيع وصفه”.
وعلى الجانب الآخر عاش الكاتب الجزائري أمين حداد (1927– 1979) مرارة الصمت والنفي خارج اللغة. وكان حداد يأمل في أن تتحقق أمنية حياته بأن يقرأه العرب بلغتهم، بعد أن عاش سجينًا في الفرنسية محرومًا من الكتابة بالعربية. سكن الشعر أعمال حداد الروائية، بكثافته وإيحاءاته، فكتب روايته “التلميذ والدرس” عام 1960، سبقتها روايته “الانطباع الأخير” (1958 )، التي كتبها تحية للثورة الجزائرية، ثم “سأهبك غزالة” (1959 )، وتلتها روايته “رصيف الأزهار لا يجيب” وهي آخر ما كتب، قبل أن يقتله الصمت لعجزه عن التواصل مع أبناء وطنه باللغة العربية الأم، وشعوره بأنه منفي في اللغة الفرنسية. وهو أيضا الشاعر صاحب ديوان “الشقاء في خطر” (1956 ). جاءت الترجمة العربية لروايته “التلميذ والدرس”، وترجمها عن الفرنسية الروائي والمترجم الجزائري “شرف الدين شكري”، وأعادت نشرها دار الهلال 2014، لتحقق له أمنية وصوله إلى قراء العربية.
في رواية “التلميذ والدرس” يدور السرد في مدينة فرنسية صغيرة، وهو تأملات طبيب جزائري عجوز مهاجر إلى فرنسا، يسترسل في مونولوج طويل يستبطن فيه مشاعره وأفكاره. تتشابك الأصوات ويعود الحكي إلى عام 1945، وأجواء الحرب العالمية الثانية، والشعور بمرارة الإحتلال الفرنسي لبلاده. يقارب السرد تخوم الشعر وتتحول الرواية إلى مونولوج شعري طويل، يلقيه الطبيب المسن، المهاجر إلى فرنسا، إلى بلد يحتل بلاده بعد الحرب العالمية الثانية في النصف الثاني من الأربعينيات. يفجر مجئ الإبنة براكين الذاكرة في عقل الأب ويفتح جراح الضمير. يتماهى الكاتب مع الشخصية المحورية في روايته، فتجمعهما وخزات الضمير لعيش كل منهما منفيًا في بلد يحتل وطنه، وفي لغة تطمس لغته الأم. هاجر الراوي إلى المدينة الفرنسية الصغيرة أثناء الحرب العالمية الثانية. في المونولوج السردي الطويل تتشكل الخطوط الرئيسية للشخوص في ذهن الراوي، فيتعرف القارئ على الإبنة وصديقها، وعلى الزوجة الراحلة والحبيبة الفرنسية. ويعود السرد إلى ذكريات بداية الحرب، قبل الرحيل، وأجوائها العبثية، وقت أن كان طبيب كتيبة، صيف عام 1940 . ويتكاثف الشعور بالمرارة الذي يخلفه المنفى، ويتضافر مع شعور متكاثف بالوحدة، يتماهى مع الصمت الذي يثقل على روحه. وفي النهاية يسير الراوي في جنازة صديقه الحميم، الطبيب الفرنسي دكتور “كوست”، فتشتد وطأة المرارة على نفسه وتتكاثف أستار الصمت، وتختلط الرؤى، ويدرك أن روحه قد فارقت الحياة منذ هجر وطنه. وبذلك يتماهى الراوي مع الكاتب الذي عانى مرارة النفي وراء أسوار لغة المحتل وحضارته، وقتله الصمت العاجز عن التواصل بلغة بلاده العربية.
أما الكاتبة الجزائرية الأصل والمولد فرنسية الحياة واللغة “آسيا جبار” (1936 – 2015)، فعاشت يسكنها التاريخ وتنفيها اللغة. ولدت آسيا جبار في مدينة “شرشال” الجزائرية عام 1936، وكانت تحمل اسم “فاطمة زهرة”، ولكنها اتخذت الاسم القلمي “آسيا جبار” بعد صدور روايتها الأولى “العطش” بالفرنسية عام 1957. يراها النقاد واحدة من أهم أساطين الإبداع الروائي في شمال إفريقيا. فعلى مدى ما يزيد على خمسين عاما كرست آسيا جبار إبداعها الأدبي، في الرواية والقصة والمسرحية والشعر، لطرح هموم وطن مزقته الحروب وقضايا نساء عربيات يعانين القهر والتهميش. وكانت الأديبة العربية الوحيدة التي رُشحت لنيل جائزة نوبل في الآداب، كما صارت أول عربية تعتلي مقعد الخالدين في الأكاديمية الفرنسية. على مدى أكثر من عشرين عمل إبداعي، في الرواية والمسرح والشعر، تمحور مشروعها الإبداعي حول الهم القومي، ومقاومة المستعمر، وقضايا المرأة العربية. فرغم لغتها الفرنسية التي كانت أداة تواصلها الإبداعي، كانت آسيا جبار مسكونة بالتاريخ منفية خارج لغتها العربية. ففي العشرين من عمرها انضمت إلى إضرابات الطلاب الجزائريين في فرنسا، تضامنا مع كفاح الجزائر من أجل الإستقلال.
واصلت آسيا جبار المشاركة في إضرابات الطلبة خلال عام 1958. وفي العام نفسه، وبينما كانت في الثانية والعشرين، تزوجت رفيق المقاومة “أحمد عولد رويس”. بعدها انتقل الزوجان إلى سويسرا، ثم إلى تونس. وهناك امتهنت الصحافة وعملت في قسم التحقيقات الصحفية، فسلطت الضوء على مآساة اللاجئين القادمين من مدينة “ساقية سيدي يوسف” التي قٌذفت بالقنابل عام 1958. وجاءت تجاربها في هذه الفترة محورا لروايتها “القبرات الساذجة” عام 1967، وهو نفس العام الذي حصلت فيه الجزائر على إستقلالها، ومن ثم توجهت سهام النقد لآسيا جبار لمواصلتها الكتابة بالفرنسية، وليس بلغتها العربية الأم. وفي حديث لاحق لها علقت الكاتبة على ذلك بقولها: “كنت قد بلغت الأربعين آنذاك، وتملكني شعور بأن الفرنسية لغتي للكتابة، بينما أنا جزائرية حتى النخاع في أعماقي”.
ظلت آسيا جبار مشغولة بوطنها الجزائر في أعمالها الإبداعية. وفي الثمانينيات والتسعينيات نشرت أكثر من عشر روايات، بالإضافة إلى أعمالها السينمائية. تمحورت معظم أعمالها الإبداعية حول كفاح الجزائرين والقيود المفروضة على المرأة العربية. كما جذبت الإنتباه إلى تأثير سنوات الحروب في الجزائر على حياة الناس، وما أسفرت عنه من إضطرابات في شتى مناحي الحياة.
وفي عام 1985 تأتي روايتها “فانتازيا”، ويراها كثير من النقاد أجمل إبداعاتها. تدور الرواية حول مجموعة من النساء الجزائريات ودورهن في المجتمع. يتماوج السرد بين تاريخ الجزائر وبين لقطات من حياة فتاة شابة، في فضاء سردي يمتد من الغزو الفرنسي عام 1830 إلى حرب التحرير في الخمسينيات. تنشأ الفتاة في مدينة جزائرية، وتقارن حياتها بحياة أسرة فرنسية مجاورة، وتتطلع إلى تجاوز ما تفرضه عليها التقاليد والأعراف. فتتمكن من الهروب من جو الأسرة المغلق لتلتحق بأخيها في مقاومة الإحتلال الفرنسي. تبعث الرواية الحياة في تجارب فتيات ونساء خضن الصراع من أجل تحقيق الإستقلال المزدوج – إستقلال الجزائر وإستقلالهن الشخصي.
في روايتها “كم هو واسع السجن” (1995) تتعرض آسيا جبار لعالم من المتناقضات على المستويين، الشخصي والعام. يدور السرد حول امرأة جزائرية عصرية متعلمة تعيش في مجتمع ذكوري، ومن ثم تتسم حياتها بكثير من المتناقضات. وتطرح الكاتبة أيضًا قضية التناقض الثقافي، وهو ما يتجلى في الكتابة بالفرنسية عن مجتمع عربي، فهنا يتعارض فعل الكتابة ذاته مع التقاليد الشفهية القوية للحضارة الأصلية، كما يتجلى في كونها امرأة شهدت الثورة في بلد تحرر من الإستعمار، وجزائرية تعيش في المنفى.
بإبداعاتها المتعددة والمتميزة انتزعت “آسيا جبار” احترام العالم واعترافه، فكانت الأديبة العربية الوحيدة التي رُشحت لجائزة نوبل في الآداب، كما نالت العديد من الجوائز، منها جائزة “نيو شتات العالمية” من جامعة أوكلوهاما عام 1996، لإسهاماتها في مجال الأدب، وأصبحت أول عضو في الأكاديمية الفرنسية ينتمي إلى شمال أفريقيا. وفي سنواتها الأخيرة تبوأت “آسيا جبار” منصب أستاذ الكرسي الفضي للدراسات الفرنسية والفرانكوفونية في جامعة نيويورك. تُرجمت أعمالها إلى كثير من لغات العالم، ولكنها ظلت بعيدة عن قارئ العربية، ومنفية داخل اللغة الفرنسية التي تكتب بها.
اللغة العربية وطن يجمع المتحدثين بها، ومن يتخلى عنها طواعية يتخلى عن وطنه ويتنكر لتراثه وحضارته، ويرتضي لنفسه النفي خارج الوطن وخصوصية الثقافة والتراث.