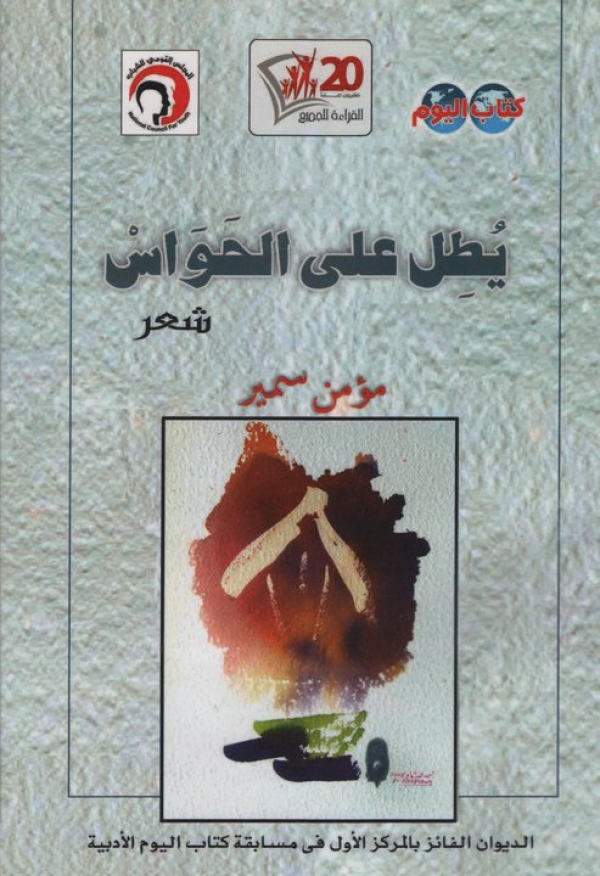أكرم محمد
يمثل كتاب “النقد الثقافي.. نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب”، للكاتب والناقد محمد إبراهيم عبد العال، الصادر عن “بيت الحكمة”، والحاصل على جائزة “أفضل كتاب نقد أدبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤”، منفذًا لاستقراء العلاقة الفنية الأدبية بين النقد الثقافي، باعتباره تأويلا للنص وتحليلا له بتفكيك معنى عام الترميز واستقراء لقيمة المجتمع والتاريخ وأيدولوجيتهم فيه، وبين النقد الجمالي متناولًا اللغة وجمالياتها، كركيزة أساسية لبنية فن الكتابة، وبذلك يطرح تعريفًا للنظريات النقدية الحديثة..
لا يتناول الكتاب المنهجين النقديين كثنائية، كتضادين يتصارعان لانتصار منهج نقدي ما، سواء بنهج مثل “الماركسي” والمهتم بقيمة المجتمع والتاريخ، أو بنهج مثل “البنيوي” الموصوفة باللا تاريخانية واللا اجتماعية؛ فتعتبر تلك الدراسة النقد الثقافي جزءًا من النقد الأدبي والبحث عن جماليات النص، فتتجلى تلك القضية المحض جدلية، خاصة مع طرح تأريخ لسيرة وأيدولوجية ومنجز “مدرسة فرانكفورت” في الفصل الأول من الكتاب، حول علاقة النهج الماركسي، واهتمامه بانعكاسية المجتمع وذاتيته على النص والاستعانة به؛ لإهمال نظريات الحداثة وما بعد الحداثة لدور المجتمع وانعكاسه.
بعد استقراء القضية المشكلة بنية الدراسة، واستنطاق جوانبها وما أحاط بها من جدلية، يبدأ الفصل الأول من الكتاب بتقديم نص مواز لتلك الدراسة، نص يقدم محاكاة للقضية المطروحة، بتقديمه تأريخا ل”مدرسة فرانكفورت” الشهيرة، بما قدمه أجيالها من منجز فكري ونقدي وفلسفي، تنضح تجربة تلك الأجيال وإنتاجها في موضوع الكتاب الجدلي، كذلك في القضية المطروحة بين أبناء “فرانكفورت” وبين جيليها، حيث الجيل الأول راديكالي ماركسي ثوري أما الثاني فإصلاحي نزعت من أيدولوجيته تلك النزعة الثورية، حيث قضية بين جدل رابض في ثنائية جزءها الأول انفصال الباحث عن بحثه، وهو ما تصدى له هوركهايمر ليقدم أطروحته، الممثلة الجزء الثاني من الثنائية، فيرى أن الباحث هو صنيعة أيدولوجية ثقافته ومجتمعه، فالإنسان والباحث نتاج تلك الذاتية المنعكسة من مجتمعه، كما ذكر الراحل جيمس جويس في “صورة الفنان في شبابه”: “أنا ابن هذه البيئة وهذا المجتمع، وسوف أعبر عن نفسي كما أنا”.. فعل التأريخ ل”مدرسة فرانكفورت” يطرح أهمية خاصة لبنية الكتاب وموضوعه؛ فهي الرافد الأول للنظرية النقدية، وبالتالي ل”النقد الثقافي”، كذلك بالتأريخ لها، استنادا للبحث الصحفي والنبش عن التاريخ النقدي، يطرح إعادة بناء لمفهوم الفن، ككل، متخذًا من تأثير منتجهم على النظرية النقدية والنقد الثقافي سبيلًا للتعبير عن جدوى الفن..
كذلك يطرح الكاتب في الجزء الثاني من الفصل الأول سيرة شخصية ونقدية وفكرية لرايموند وليليامز، الناقد والمفكر البريطاني، وبتقديمه لفعل التسجيل والتأريخ الشخصي والفكري يبحث عن المفهوم المجرد للثقافة، وهو ما قدمه ويليامز، ما يؤدي لتناول منجزه في “النقد الثقافي”، ورؤيته لتأثير البنية المجتمعية وثقافتها، كمفهوم مجرد عن كل ممارسات الحياة، وبالتالي رؤيته ل”بنية المشاعر” في النص الأدبي، تلك التي قدمها ويليامز بمؤاخاتها مع ممارسة اكتشاف الثقافة في المجتمع وتشييد “النقد الثقافي”، كامتداد لإنتاج ل”مدرسة فرانكفورت”.
ويتناول الكاتب محمد إبراهيم عبد العال للتأريخ الفكري والشخصي لويليامز، ومن قبله سيرة الإنتاج والتأريخ ل”مدرسة فرانكفورت” تتجلى أساسات بنية هذا الكتاب، حيث تربضه ثلاثة أساسات أولهم التأريخ الموازي، وهو حتمًا تأريخ يطرح فضاءً دلاليًا، حيث يمهد لفضاء تناول الموضوع النقدي والفكري الشائك، وثاني الأساسات هو المرجعية البحثية والتلقي الثقافي الجاد، وهو ما يتجلى على طول الكتاب، وثالثهم طرح قضاياه بين ثنائية الخاص/ العام، فيظهر الخاص في النقد والبحث في النظريات النقدية، أما العام فيظهر في التأريخ السياسي والاجتماعي، واستنطاق الثقافة الجماهيرية على مر التاريخ، وفهم الأطروحات السياسية والفلسفية المرتبطة بالأطروحات النقدية، تلك التي يقدم لها النص مقاربة نقدية وفكرية وعرض صحفي في نهاية الفصل الأول بعد تقديم ل”مدرسة برمنجهام” ومنجزها ونظرياتها، فيقدم الكتاب عرض صحفي المقاربة بينهم وبين “فرانكفورت*، واتباعًا للفضاء الزمني وتسلسله يستكمل الكتاب طرح تأريخه المنجزات والنظريات المتعلقة والمؤثرة في الموضوع، فينتقل ل”بارت”، الناقد في ما بعد البنيوية، والذي اتبع البنية الدلالية، واهتم بالسيمائية و”السوميطيقيا”، علم العلامات والرموز، متخذًا منها أطروحة ستأثر في النقد الثقافي، خاصة السيمو-ثقافة، وهي السيمائية المتعلقة بالنقد الثقافي، فلا تنفي أطروحة بارت أهمية البنيوية وجماليات النص، وبطرح منجز بارت، أيضًا، يتناول الكتاب ثنائيو الخاص والعام، بين ما يتعلق بالنقد الثقافي، وبين ما يتعلق بالمجتمعات، ككل، وعلاقتها بالأساطير، كمفهوم أكثر تعميمًا بتفكيك وتحليل فضاءه الدلالي، ومن بارت ينبثق تتبع وعرض صحفي لإنتاج الفرنسي ميشيل فوكو الثقافي، ورؤيته المؤثرة في مفهوم النقد الثقافي والأدب ومفهوم الفن، ككل، متخذًا من التاريخ عنونًا لبناء فكره، حيث يرى أنه عنصر أساسي في البناء، ويكشف المجتمعات بتعريتها في فترة ما من حياتها، وبذلك ينفي أحادية رؤية المجتمعات والفترات التاريخية، ويبعثر الأحكام العامة والمعتادة، ويقترب من السيمو-ثقافي والسيمولوجي واهبًا النص بعد تأريخي ربما يكون دلالي، وربما يربض الكاتب الضمني، ودائمًا يكشف المجتمعات، كذلك يقدم مشروع نقدي أكثر شمولًا ممن سبقه، فيشمل خطاب النص، ككل، ولا ينتمي لأحادية أيديولوجية دوجماتية، جامدة، وعند ميشيل فوكو تتجلى الجدلية ثانية عند قالب الثنائية بين النقد الثقافي والبنية المتهم بالنص كعمل جمالي بالأساس لا يخضع لقولبة الأيدولوجيات والبنية الدلالية، لكن ميشيل فوكو لا ينفي بنظريته البنيوية، ولا يتنصل منها، فلا ينفي دور الرؤية الجمالية والبنيوية، ومن طرح سيرة شخصية وفكرية لفوكو تنبثق بنية شخصيته ورؤيته للفكر، ككل، سواء الأدبي والنقدي أو السياسي والفلسفي؛ فهو لا يربض تحت أحادية فكرة ويقطن دوجمائية، كقراءته المغايرة للماركسية، وبالتي لطرحه أطروحة نقدية مؤثرة، تلك الأطروحة التي أثرت في مثقفي اليسار الأمريكي، الذين تناولهم النص في الجزء الثاني من الفصل، قبل الولوج لقراءة تطبيقية، وتناول الجزء الثاني من ثنائية الشرق/الغرب، بتناول النقد الثقافي عند المتلقي العربي باتخاذ كتاب الغذامي نموذج، وبطرح تعريف عام للنظرية المشيدة “النقد الثقافي”، وهي السيمائية، فيه الكاتب محمد عبد العال إبراهيم المتلقي تعريفًا لمصطلحات السيميائية، بعد طرح نص تسجيلي موازي لأصحاب الأثر في “السيموطيقيا” والسيمائية والنقد الثقافي بهروب من دوجماتية التلقي وأحادية العرض.
بتقديم الكاتب لكتابه، ولتقديم الناشر لمشروع “أفق جديد للثقافة العربية” يتضح اهتمام الناشر بإصدار هذا الكتاب في محورين، أولهما تقديم هذا المشروع المعني بتقديم المنجز الثقافي والفكري للواقعين في ثنائية الجيل الجديد والجيل القديم، ذلك الذي همش إنتاجه، والمحور الثاني هو أنه بداية لمشروع نقدي وفكري للمؤلف يتناول تلك العلاقة بين النقد الأدبي والثقافي، كذلك يتناول مفهوما عاما ومجردا للأدب والنقد، ويمارس فعل التناول الخاص له بعد التناول المجرد للمفهومين.