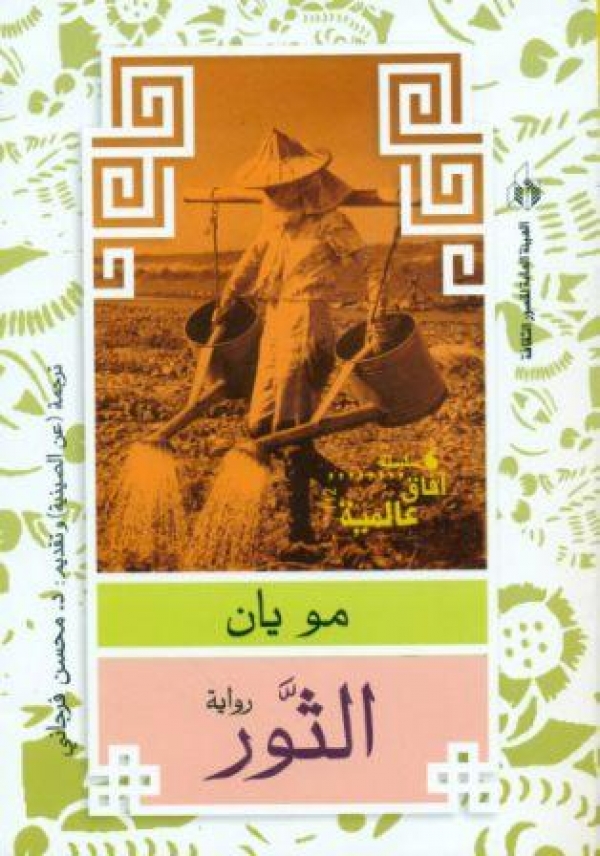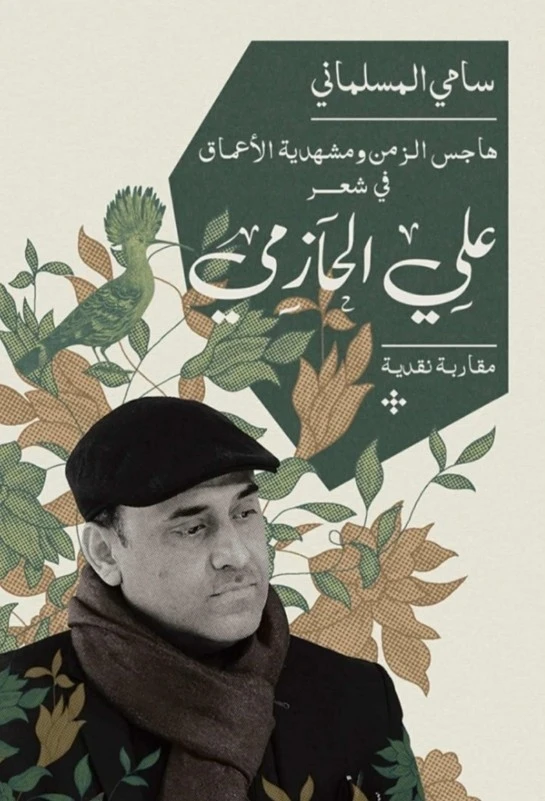أعلنت منصة “ستاند شعر” نتيجة مسابقتها الشعرية الأولى التي أعلنتها أخيراً، وفيها فيها خمسة أصوات شعرية شابة، تؤكد أن بستان الشعر في مصر لا ينضب أبداً.
وفيما يلي تقرير لجنة التحكيم التي تكونت من الشاعرين عاطف عبد العزيز، وجمال فتحي، وتليه القصائد الفائزة في المسابقة، التي تم توزيع جوائزها أخيراً في القاهرة، بالإضافة إلى الإشارة إلى أسماء لم تفز ولكنها جديرة بالتنويه والإشادة.
تقرير الشاعر عاطف عبد العزيز
اثنتان وأربعون زهرة يانعة أُهديتها مؤخرًا، كان لكل منها لون ورحيق يخصها، فوجدتني أقول: الحياة حلوة، أعني لم تزل الحياة حلوة، لعلهم قليلون أولئك الذين يدركون أن حلاوة الحياة تقاس بحياة الشعر، صحيح أن أغلب تلك الزهور كانت في طور التكوين أي أنها بحاجة إلى المزيد من الرعاية حتى يكتمل نضجها ولكنها لم تفقد خصائصها وقدرتها على الإبهاج ومنحنا الأمل في غد أجمل.
تقرير الشاعر جمال فتحي
أثمن بصدق كل النصوص التي قرأتها علي سبيل التحكيم في مسابقة “ستاند شعر” سواء فصحي أو عامية وهي في مجملها نصوص جيدة ومبشرة ومحاولات يغلب عليها الصدق مع التسليم بأن الكثير منها يحتاج إلى الاقتراب أكثر من روح الشعر والاجتهاد في القراءة والاطلاع على نتاج السابقين مع الحذر من فخ التأثر والتقليد كما يحتاج بعضها للمزيد من الإحاطة والفهم للسمات الفارقة للقصيدة الشعرية مقارنة بغيرها من فنون الكتابة الأدبية الأخرى أو الخواطر العابرة مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بقواعد اللغة العربية لاسيما قواعد الإملاء باعتبار أن الشعر هو فن لغوي بالأساس وليس كلمات وجملا وتعبيرات مبعثرة في الفراغ، وهذا لا يمنع أن عددا من النصوص المقدمة وهي النصوص التي رشحت للفوز قد توفر لها دون غيرها قدر أكبر- نسبيا – من الوعي بطبيعة الشعر ولغته واقتربت بدرجة ما من روحه وجوهره وحضرت فيها المفارقة الشعرية وأنتجت في النفس الدهشة التي هي دائما قرينة الشعر الجيد كما وظفت فيها الكثير من الصور الشعرية الطازجة وهي قصائد في معظمها مكثفة و متماسكة وقدمت رؤية خاصة وكشفت عن روح شعرائها وأشارت إلى أصوات شعرية حقيقية ومواهب جادة تحتاج فقط إلى الدعم والتوجيه.
اقرأ أيضاً:
النصوص الفائزة
عالم ضئيل جدًا
نجلاء مجدي
راحة الكبار
شيرين فتحي
رقصتنا التالية
تامر الهلالي
الموعد الأول
سيد أحمد
محمود مجدي قدري
“ستاند شعر” توزع جوائز مسابقتها الأولى لقصيدة النثر