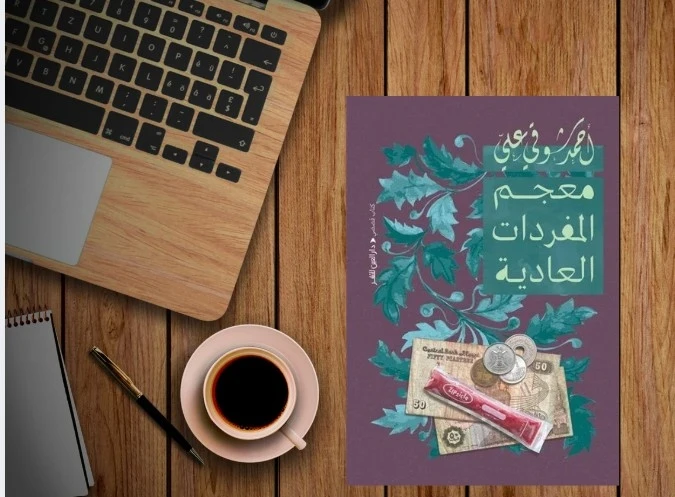في ديوانه الجديد، الصادر عن سلسلة ( الكتاب الأول ) بالمجلس الأعلى للثقافة، والمعنون بـ (غرفة في سحابة) للشاعر إبراهيم محمد إبراهيم، يأخذنا إلى تجربته المتفردة الطازجة بشكل تدريجي، خفي وبأسلوب عميق ولغة مكتنزة الدلالة طيعة على المستوى الشخصي، عرفتُ إبراهيم محمد إبراهيم، كشاعرٍ حالمٍ، يمتلأ شعره بالرومانسية الظاهرة، ويقترب من الإيقاع الجلي حد الغناء، كنا زملاء في كلية التجارة، جامعة عين شمس، آوائل التسعينيات، و كان حينها شاباً ممتلئاً بالحيوية والخجل، يُلقي شعره كحبات الكرم على من يقابله، يتغنى بالحبيبة / الأمل، في كل قصائده، وكانت أشعاره حينها واضحة وضوح الطريق، حزينة حزن الموت، طيبة طيبة القلوب الغضة، ومرت الأيام، ولا أقول مر العمر لأن تكرار الأيام لا يعني العمر، مرت الأيام وأعطتنا من التجارب والخبرات، ما انطبع على ذواتنا وبالتالي على كتاباتنا .
مرت سنوات، وفاجأني إبراهيم بهذا الديوان، وكان جُلّ ما أردت أن أعرفه، كيف صار شعره الحالم ؟
(أريد أن تحطَ حنانك على سريري
يا أبي
و أن أسألك
فيم كبرت هكذا بلا اكتراث)(2)
“ غرفةٌ في سحابة “ هو الديوان الأول لإبراهيم، ولكنه ليس أول الشعر، وحسناً فعل إذ تمهل على تجربته الشعرية، فأنتجت هذا الديوان العميق والذي يمكننا رصد عدة خصائص مميزة له :
أولاً: السُخرية :
تتغلغلُ السُخرية داخل قصائد الديوان، ونجدها مرة متسائلة، ومرة مريرة ، وفي
الأغلب هي للتهكم من الواقع، حيث يسخرُ الشاعر من كل ما هو سلطوي :
(كل شيء هالكٌ كالحكومات )(3)
أو في قوله :
(والجرائد عادتْ مسامير منتصبة
كالحكومة)(4)
و أحياناً تكون السخرية من الشاعر نفسه :
( نسيتُ أن أموتَ فجأة
لا تلمني
مشاغلي كثيرة )(5)
أو يتغنى بسخرية شجية ، فيقول :
( كان يجلس في المقهى
ذلك الحزن
سأخرج خلسة
ربما للمرة الأولى
وحيداً
لكنه ذلك الوغد يحفظ رقم هاتفي )(6)
ثانياً : الذاتي / العام :
في هذا الديوان لا يمكن الفصل بين الهم الذاتي/ الشخصي، والهم العام/ الوطني، ولا عجب أن الشاعر ذكر الوطن في أول قصائد الديوان، و وصفه بالوطن الزائر ومن شأن الوطن أن يكون الموطن والآمان المستديم، ولكن كيف؟!
فالشاعر وجيله تقريباً يشعرون أن الوطن تركهم في الطرقات من دون سند، ولهذا يقف الوطن عند حدود الزائر في وجدان الشاعر، فالجيل الذي عاش التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة، التي اجتاحت الوطن العربي حتى زلزلته، وانطبع هذا الزلزال على كتابات الجيل فأصابها بالتساؤل الدائم حول كل شيء، حتى الرواسخ المقدسة في الوجدان، ولهذا يمزج الشاعر بين همه الشخصي والهم الوطني ، ويجعل كلاً منهما نتيجة للآخر ، فهو ابن الطبقة المتوسطة التي سعتْ إلى تعليم أبنائها كطوق نجاة سيصعدون به بعيداً عن الطوفان، فإذا بطوفان التحوّلات يقسم الطبقة المتوسطة ويغرقها، ولا تبقى سوى نداءات الاستغاثة المترددة لإثبات فعل الوجود.
يقول الشاعر :
( القاهرة هي آخر ما لدي بعد صراع )(7)
و في موضع آخر ، يصرخ :
( هزيمتك الأخيرة مُلوّنة بالسحاب
كأنك منخلع يلتحفُ بالمجلس العسكري و أمسيات المقاهي )(8)
و يجسد تأثير المأزق السياسي ، فيقول :
( القاهرة
كهيئة البرد ، و مؤخرة المتوسط
تنامين تحت سرير الملك الضليل ، و تنبعثين من بالوعةٍ
في مؤتمر المانحين )(9)
ثالثاً : الرمز و الدلالة :
الديوان يمتليء بالرموز التي تؤدي إلى دلالات معينة واضحة، وتتكرر الرموز، وتتكرر معها الدلالات، فالشاعر مخلص لعالمه، يصنعُ رموزه من شخصياتٍ حيّة في المجتمع، شخصياتٍ يمكن أن نعدها مُعبّرة عن قطاع من المجتمع يقع تحت وطأةِ الأمل والرجاء .
فالأم تلك الحاضرة الغائبة المُعطية المُضحية، دلالة على الشخصية المكافحة، ويتجسّدُ من خلال حضورها في القصائد أزمة الشاعر، وبالتالي الشعر :
( كأن كل حسرة وتد
كأن كل دمعة إله )(10)
و يتجلى رمز الكفاح المتواصل مع الحياة ، في قوله :
( لم يعد زخمٌ ما يعجُ بالحجرة
كأنه مهرجان من الانكسار )(11)
الأب رمزٌ كبير في هذا الديوان، ذلك الذي يورثُ ولده هيئته وضعفه، مما يجعل الشاعر يعطف عليه مرة، ويحمل عليه مرة، فالأب دلالة على قسوة الحياة، والقسوة هنا ليست بمعنى الفقد و الفقر فقط، بل أيضاً تتجلى القسوة في الآمال المتلألئة الغائبة، مما أضفى رمزاً كبيراً آخر، وهو الرجاء الدائم، رجاء لم يقترب من تحقيق الأمل فصار سعادة، ولا اقترب من ضياع الأمل فصار يأساً، رجاء مُعلّقٌ دائم، يتأرجح الشاعر معه :
( و حبل الغسيل الذي مالَ
ليته يظلُ هكذا
طائراً
ينفضُ وحدته بين شُرفتي
و شُرفة الجيران
ليتها لا تصدأُ
في حوائط الغرفة
سيدةٌ
غائبة )(12)
ويمتدُ الرجاء :
(ليته اللهُ
يُشعلها رُقيتي على سلالم
البيت )(13)
رابعاً : الشاعر/ الراوي :
آثر الشاعر أن يجعل من نفسه الراوي الوحيد في الديوان، أن يكون هو المتكلم، هو المسيطرُ على روح القصائد، ورغم أن هذا أعطى للديوان خصوصية على مستوى التجربة، وعلى مستوى طزاجة الإحساس، والقدرة المتفردة لدى الشاعر على تمثل الحالة الشعورية، التي ما تلبث أن تتسرب إلى وجدان القاريء، حتى يجد نفسه، داخل خندق الشاعر، إلا أنني كنتُ أُفضل أن يخرج الشاعر من أسر ذاته، كي يرى العالم من حوله، وهذا ما أنتظره في الدواوين القادمة .
(لغتي حصى تحت جمر
تؤكد أن ورداً سينبتُ في عتمة البيت)(14)
تساءلتُ في البداية، كيف صار شعر إبراهيم محمد إبراهيم، وبعد هذه القراءة أرى أنه صار أعمق عمق السؤال، غاضباً غضب العوز المكتوم، ليِّناً لين الرضا والرجاء، ساخراً سخرية الأيام .
________________________________
هامش :
*( غرفة في سحابة ) ، شعر : إبراهيم محمد إبراهيم ، الكتاب الأول ، المجلس الأعلى للثقافة ،
ط1 ، 2014 .
1- قصيدة ( جهاد ) ص7
2- قصيدة ( مراهقة ) ص9
3- قصيدة ( طوق الحمامة ) ص14
4- قصيدة ( الغائب ) ص31
5- قصيدة ( الرومانسي ) ص43
6- قصيدة ( أيام الأسبوع ) ص49
7- قصيدة ( جهاد ) ص8
8- قصيدة ( المرأة العجوز ) ص59
9- قصيدة ( الغزاة ) ص 57
10- قصيدة ( جهاد ) ص8
11- قصيدة ( غرفة في سحابة ) ص41
12- قصيدة ( شاي الجيران ) ص70
13- قصيدة ( هالات ) ص72
14- قصيدة ( لهاث الروح ) ص11