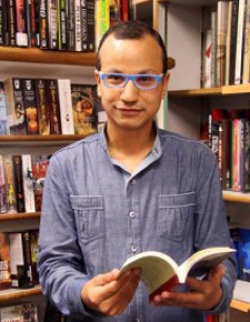تتبدى الروح المتهكمة، وربما المتشائمة كذلك، من العنوان وأبيات الشعر الحلمنتيشي التي تتصدر صفحات الرواية، ومن ثم الإهداء:
أيها الزائر ليّا قف على قبري شوية
واقرأ السبع المثاني وأهدهم منك إليّا
في زماني كنتُ مثلك بين طوب الأرض حيّا
بعد حينٍ أنت مثلي لستَ بعد الدود شيّا
(أهدي هذه الرواية إلى فقيد الشباب الذي لا أعرفه، وقرأت على شاهد قبره الأبيات السابقة.)
الأبيات السابقة لا تعول على الحياة، بقدر ما تؤكد هشاشتها وزوالها وزيف زينتها وزخرفها، في مقال حقيقة الموت، والقبر والدود. غير أنها لا تفعل ذلك بنبرة الوعظ والإرشاد المباشرة، بقدر ما تؤكد هذا المعنى بخفة روح وسذاجة وربما شيء من عدم الاكتراث. استلهام عنوان الرواية من هذه الأبيات يضع الرواية الكابوسية بالفعل ككل بين قوسي ابتسامة هازئة ومتهكمة كبيرة، ابتسامة فيها من الشفقة والتأسي بقدر ما فيها من التسليم والانصياع بواقع الحال. المزج بين الصفحى والعامية، وهو من طبائع الشعر الحلمنتيشي على ما أظن، يؤكد الإحساس بانعدام الرصانة والفخامة، وهو من الملامح التي لا يصعب تتبعها على مدى روايتنا هذه.
الوقوف على القبر، في العنوان وفي الأبيات، يتخذ في الرواية بُعدا آخر، كأنه وقوفاً على قبر الحياة نفسها، على أطلال ما كان يمكن أن يكون ولم يكن، أطلال المتخيل الساحر، أطلال الأحلام والطموحات الخاصة بأسرة فقيرة، عائلها فراش في مدرسة متزوج من ربة بيت، وله عدد من الأبناء أغلبهم من الذكور، في مراحل مختلفة من التعليم. الآمال المعقودة على تعليم وتخرج وعمل هؤلاء الذكور تصير مصدر مفارقة وكوميديا سوداء عند وضعها في إطار شروط الواقع المرير، وانكسارها المدوي على صخور ظروف مجتمعنا الراهن، والتي لسنا بحاجة للإشارة إلى مقدار كآبتها وسودوايتها.
على عكس ما اعتدناه، الأب والأم هنا ليسا بأي قدر هما الربان الممسك بالدفة، المطاع والمرهوب الجانب. يتحول الأبناء، وعلى الخصوص باسم في الثانوية العامة، إلى سلطة على الأبوين، بحجة المذاكرة والمستقبل والمجموع. أوامر باسم تطاع، حتى يذاكر وينجح، ولا تكون له حجة عليهم إذا أصاب مجموعاً ضعيفاً أو رسب. لن تكون هذه أولى أو آخر المفارقات المثيرة في تكوين هذه الأسرة وعلاقات أفرادها ببعضهم البعض، إلى جانب علاقتهم بمن يحيطون بهم من شخصيات، في إطار مدينة المحلة أو المدن الصغيرة المحيطة بها.
نتسرب مع السطور تدريجياً إلى بقية شخيات الأسرة، فانطلاقاً من باسم وجبروته في التعامل مع الآخرين، اعتماداً على حجة الثانوية العامة، ننتقل إلى الأبوين في صراعهما مع الحياة كل لحظة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات هذا الباسم والآخرين من فريق الذكور متفاوتي الأعمار. ثم ننتقل منهم إلى الكبير جمال، أكثر شخصيات الرواية مأساوية الهائم في عالم كامل من الخيالات التي يحقق فيها كل ما يتمناه ويعجز عن لمسه في عالم الحقيقة والمادة، وينتهي به الأمر معلقاً مشنوقاً مع آخر صفحات الرواية. لعبت خيالات جمال دور المهدئ أو المسكن لعجزه أمام الواقع على مدى الرواية، في مونولج كان من الممكن تطويره واستغلاله ليصير هو فقط الهدنة المريحة بين مشاهد الرواية المتتابعة المتلاحقة بالمآزق والمشكلات، غير أن حتى هذه الخيالات والشطحات الحلمية، سواء أتت خلال النوم أو في صورة أحلام يقظة، وردت بالإيقاع المتوتر نفسه في صياغة الجمل والعبارات الذي وسم الرواية من أولها لآخرها، ولم تفلح في الابتعاد عن دق الشواكيش التي تتواتر على أدمغة الشخصيات، وكأن الواقع – أو الروائي – قد استفرد بهم في ركن وراح يكيل لهم الضربات، نظرة الرعب التي ترتسم على وجوه هذه الشخصيات مقصود بها أن تعكس فظاظة وفظاعة هذا الواقع الذي لا يرحم. ولكن لا ننسى ابتسامة التهكم والتسليم، فكل شيء يقدم من خلال إحساس عالٍ بالمفارقات والكوميديا السوداء لا تكاد تغيب عن صفحات النص حتى تطل برأسها من جديد.
نستطيع من خلال هذه الرواية الأولى للروائي محمد داود أن نلمس بعض خصاله الكتابية وميزاته الأسلوبية التي سوف تبقى معه، متخذة هذا البعد أو ذاك، خلال رواياته التالية، وخاصة في عمليه الأخيرين فؤاد فؤاد وأمنا الغولة. وإذا كنا قد أشرنا قبل سطور إلى لغة متوترة في السرد، قصيرة العبارات، تعتمد الجملة الاسمية في الوصف والسرد على السواء، نضيف أيضاً اعتماد تقنيات السرد المشهدي، أو ما يسمى بالسرد السينمائي، على أن تتبع المشهد بجميع الحواس الممكنة والمستحيلة لا يمنع من استكناه لدواخل الشخصيات وما يستقر في ضمائرها، بعين راوي عليم لا تخفى عليه خافية مما قد يدور بخلد شخصياته. فالمشهدية الخاصة بمحمد داود إذن ليست المشهدية المحايدة التي يلعب فيها الرواي دور الشاهد الصامت أو المحايد، مما قد نجده في قصص هيمنجواي وأغلب كتابات إبراهيم أصلان، بل هي مشهدية إطار، مشهدية أقرب إلى العتبة للدخول في نفسيات وعقول وأرواح الشخصيات.وهي مشهدية لا تحتفي بالعنصر الإنساني وحده، بقدر ما تحيط أيضاً بكل العناصر المجاورة له من جمادات وكائنات حية أخرى، وقد نلمس أحياناً روحاً وجودية (هل نقول عدمية؟) عابرة عند وصفه لبعض تلك العناصر، سواء الآدمية أو غير الآدمية. ويتبدي هذا خصوصاً، في روايته الأولى هذه: “في إحدى يدي دعاء حقيبة سوداء، وفي الأخرى بقايا منديل، وثمة أربعة أرجل، كل رجلين تحملان حوضاً فوقه بطن، تقيمه فقرات الظهر، إلى صدر ملفوف بالضلوع…) وكأن الجسد الإنساني تجرد في هذه الصورة الوصفية المقتضبة إلى شيء، علامات شكلية يمكن تسميتها بأسماء غير إنسانية بالمرة، بما أن كل ما يحيط به، بهذا الجسد، في المشهد الروائي، يجرده من إنسانيته تماماً، الإنسانية وفقاً لمفهومنا الرومانسي والنبيل عنها، لا كما كتبها وشرحها محمد داود بمبضع جراح لا تأخذه شفقة ولا رحمة بشخصياته.
نلمح في الرواية الأولى أيضاً لمحمد داود رغبة عارمة في التجريب واللعب والشطح، هذه الرغبة يتم قمعها وكبتها أحياناً لصالح المشي على الخط السردي المستقيم، ثم يُطلق لها العنان في لحظات أخرى فنراه يرسم جدولاً مثلاً في ص 54، للموازاة بين دعاء أمس ودعاء قبل الأمس وحال والدها دائماً وأبداً. الجدول أيضاً شكل رياضي أو على الأقل وسيلة توضيحية غير أدبية لإيضاح الشخصية، ولنتذكر هنا السطور الأولى من روايته الداهية فؤاد فؤاد، وكيف جرد حياة بطله فيها إلى مراحل مختلفة، على طريقة عالم الإحصاء أو عالم الرياضيات. وهناك محاولات داود لكتابة الأصوات، فالعطس يتحول عنده إلى “هتسي” على طول الرواية، وأصوات نول والد دعاء إلى “ضمضمات، ومفردها ضم”، وإلى هذا من محاولات شجاعة في انتزاع لغة السرد من أرضها المطمئنة وإكليشاتها الجاهزة. يضع محمد دواد عناوين لبعض فقرات السرد، باسم الشخصية الأساسية التي يدور حول الفصل، أو كعنوان جانبي مثل البكاء بعين واحدة، وهو ما كان في غنى عنه تماماً في هذه الرواية، إلى جانب الهوامش التي حاول من خلال تفسير بعض النقاط، كان يمكن أن يجد لها مكاناً داخل تيار السرد نفسه. من نوع: الكبنيه* الاسم الذي تستعمله أم دعاء للمرحاض.
سمة أخرى للكتابة الروائية الداودية هي البطولة الجماعية إن صح التعبير المقتبس عن السينما، فباستثناء رواية فؤاد فؤاد، والتي وإن كان فيها العديد من الشخصيات الروائية المثيرة والمرسومة ببراعة شديدة فقد تمحورت جميعها حول فؤاد نفسه، أما في “قف..” وأمنا الغولة، فلا وجود لبطل واحد أو مركزي للعمل ككل، هناك شخصيات تتناثر في فضاء واحد، غالباً ما يكون قرية صغيرة أو مدينة هي المحلة الكبرى، قد تجمع هؤلاء الشخصيات صلة قرابة أو زمالة أو غير ذلك، إلا أن الذي يجمعهم فوق هذا وقبله هو محنة ما، كبيرة ونهائية ولا حل لها في الغالب. مشهد بيع البطاطين الاستثنائي قرب نهاية رواية أمنا الغولة يقابله في عمله الأول هذا مشهد ملء بيانات باسم للتقدم إلى كلية الشرطة، يتم تزوير البيانات تزويراً فاضحاً، في حالة من التواطؤ أو الجهل أو عدم الاكتراث المضحك، والأسرة كلها مجتمعة حول شخص مجهول، بلا اسم، كل ميزته أنه جميل الخط، ليملأ الاستمارات والبيانات التي ستمهد الطريق لباسم ولهذه الأسرة معه إلى النجوم النحاسية اللامعة على الكتفين. المفارقة الكبيرة تجد ذورتها في هذا المشهد، الكوميديا السوداء تشتد وتتفوق على نفسها، وكأنني بمحمد داود نفسه هذا الشخص جميل الخط الذي اختارته الظروف لأن يكون شاهداً على المأساة الكوميدية، أو الكوميديا السوداء، لهؤلاء الناس، وكان كل ذنبه هو أن وجد بالمصادفة بينهم، بين أهله وناسه، الذين تطحنهم الحياة بلا رحمة، ومع ذلك لا يتوقفون عن الضحك والتمرد ودق الطبول. كل ذنب محمد داود أنه جميل الخط وجميل الكلمة، وكل ذنبه أبطاله أنهم وقعوا تحت مطرقته التي لا ترحم.