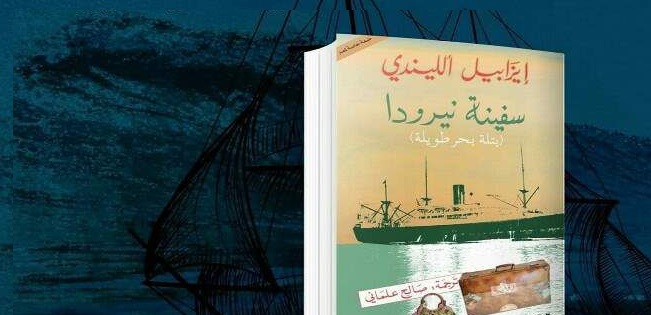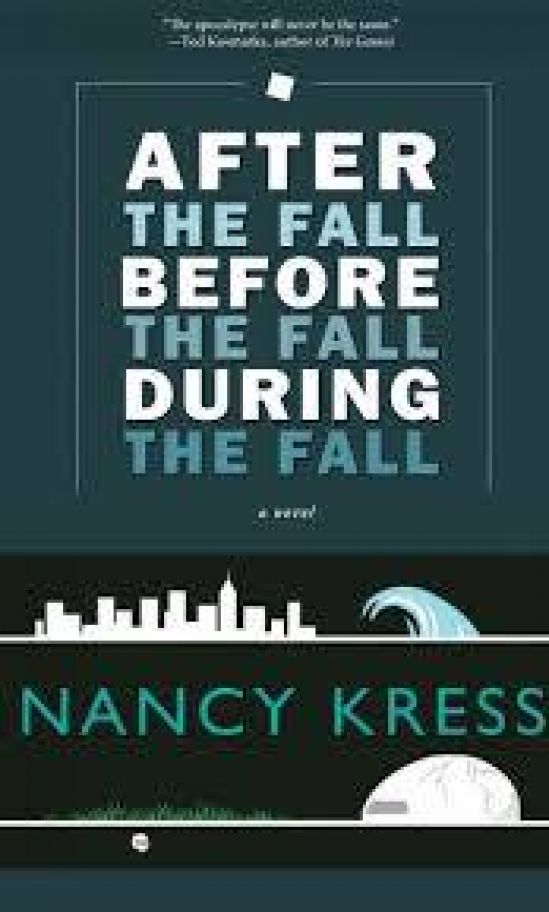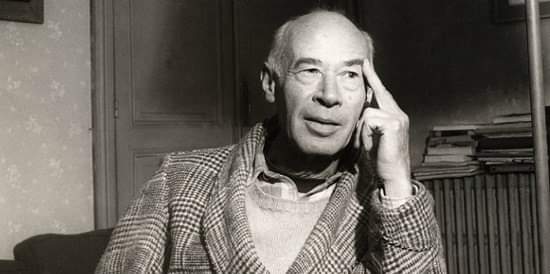بالنسبة لي كان تجربة قراءة مربكة ومختلفة، لا أجد بين يديّ حكاية يمكن تلمسها، لا احتفاء مبالغ فيه بالمشهدية ولا بالسرد الإخباري المطرد على طريقة ليالي ألف ليلة، بل ربما مزيج ذكي من التوثيق والانطباعات الشخصية، يضمر السخرية واحتقار العالم، كما يضمر أيضاً شفقة وحناناً، لا سيما عندما يستدعي شخصيات من فروع العائلة. وبمناسبة العائلة، فكأن ياسر لا يرى الذات في روايته هذه شيئاً مقطوعاً ومبتوت الصلة بالعالم، بل على العكس يصر على أن يتلمس حدود هذه الذات تاريخياً من أيام الجد البارمان النوبي، وجغرافياً حتى حدود النوبة وأسوان، وهو في تلمسه لهذه الحدود يتبنى نبرة تقريرية أقرب إلى نبرة المؤرخين المحايدين والتي تبدو مضحكة رغم هذا، لكن تبقى الذات هي البؤرة المشعة التي تنطلق منها كل الأسهم النارية، وحين يعمل السرد على تلمس هذه الذات فهو يصطادها في لحظاتها الفارقة، المشحونة بالدلالة، مثل جلسات المخدرات الليلية، التي تنتهي بنهار مأساوي على البحر عند تعاطي الشلة للباركينول أو الصراصير حسب اسم شهرته. وكانت سعادة إضافية لي في تجربة قراءتي الأولى للرواية أن أقرأ في رواية عن مخدرات المهمشين الرخيصة البشعة وهي الأدوية مثل التوسيفان إن، أو الكميا بأنواعها، وحتى هنا لا يمر ياسر على الأشياء والتجارب مرور الكرام، أو يخطو وئيداً على أطراف أصابع قدميه مترفعاً عن التجربة أو مكافحاً ليحولها إلى شيءٍ أكبر، شيء شعري مثلاً أو شيء له مغزى سياسي كبير، بل هو يمسح التجربة مثل مسّاحي الطرقات، يحتك بجسده بأرض هذا الواقع مثل الزواحف التي تختبر في سعيها الأرض شبراً شبراً.
والآن، ماذا؟ بالنسبة لي، تبقى قراءة قانون الوراثة تجربة ممتعة، لمجموعة من اللقطات السردية التي تعكس بأمانة لحظةً وذاتاً ووعياً بالعالم. والآن، ماذا؟ لم يمتد . لا أدري للأسف أم لحسن الحظ . كثيراً هذا الفرع الكتابي السردي بخصوصيته، والحقيقة أن المنتوج الجيد تحت مظلة هذه الكتابة هزيل للغاية، فكأنها بحاجة إلى ذات إنسانية خاصة لها تجارب وقدرات ووعي على قدر كبير من الخصوصية لتنتج تجربة كتلك، لهذا قرأنا العديد من التجارب التي تزعم التمحور حول الذات ولا تعدو كونها استنساخ من ملايين الذوات الإنسانية التي تمتلئ بها الشوارع والكتب، دون رؤيا مفارقة أو نظرة بزاوية جديدة. والآن، ماذا؟ نما وامتد واشتد عود فرع الكتابة المضاد لفرع ياسر . ومن جديد لا أدري للأسف أم لحسن الحظ . وهو فرع التأليف والتوليف، كتابة الحكاية الكبيرة، التي تستدعي التاريخ، وتتناول مسائل الهوية، وتنبش عن شخصيات أسطورية، ولا بدّ بالتالي أن يكون للرواية كعب محترم يملأ العين. لماذا مال أغلب شباب الكتاب في الوقت الراهن إلى هذا الفرع؟ ألانه أسهل ماداموا بلا تجربة حقيقية في الحياة؟ أهي الجوائز ودور النشر وتوجيهاتها غير المعلنة؟ أهو الطموح المشروع في محاكاة النماذج الروائية الغربية الكبرى التي تبهرنا وتثبتنا في مواضعنا لأكثر من أربعمائة صفحة في حكاية عشق تاريخية مكتوبة بأناقة وكما قال الكتاب؟ كل هذه أسباب محتملة، وأنا ليس معي الخبر اليقين، ولم آت إلى هنا إلا لأقول إنني استمعت بإعادة قراءة رواية قانون الوراثة للصديق ياسر عبد اللطيف ربما أكثر من المرة الأولى، ورحتُ أرقب كيف ينسج التوثيق المحض بالتعليقات الذكية بالحكايات العائلية المريرة، فيذوب على سطوره الخاص بالعام والذات المشتعلة بالفضاء البارد الذي تضطر للتحرك فيه، فشكراً له.