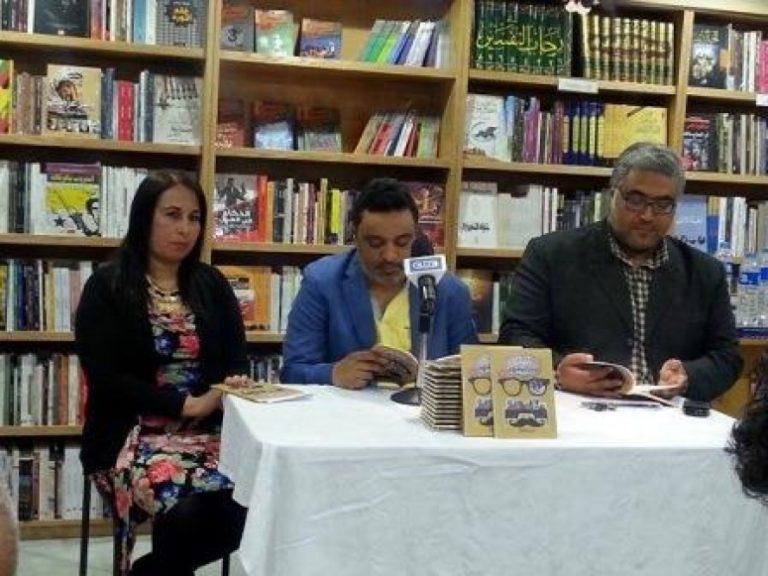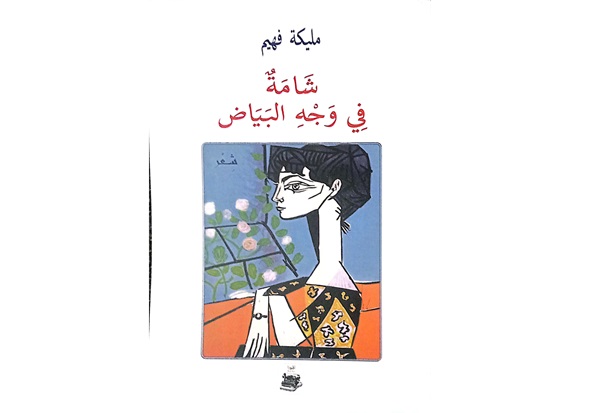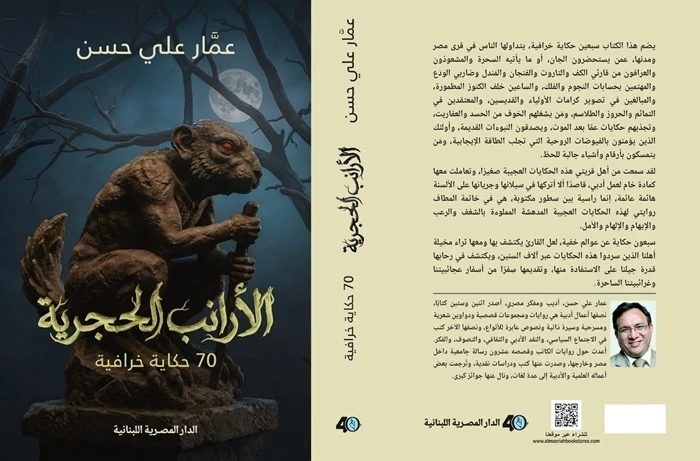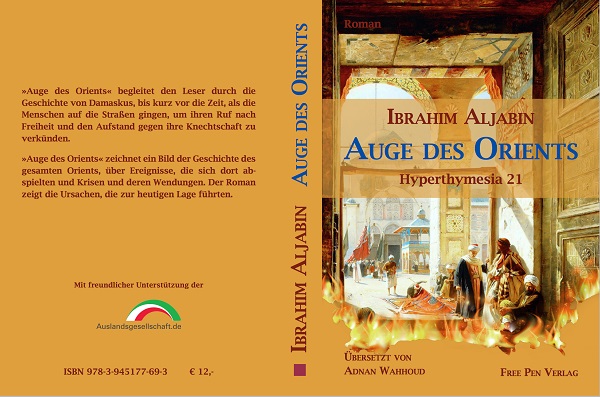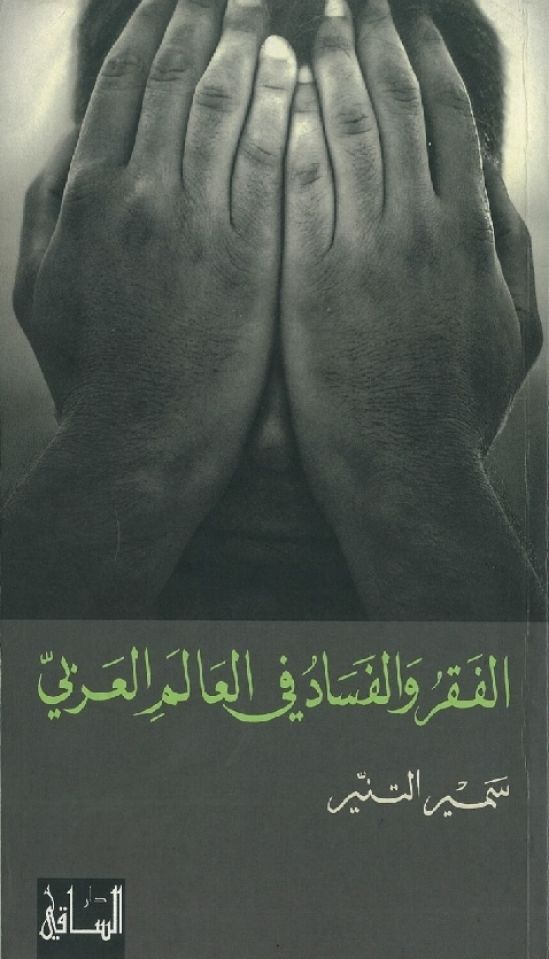ويتم عرض اللوحة حاليا في المعرض المقام للفنان “فرانكو إنجيلي” والذي يستمر حتى 4 سبتمبر القادم، وقد ظل الغموض يحيط بهذه اللوحة التي تم العثور عليها في إحدى الشقق الإيطالية، بعد حوالي 45 عاما من رسمها.
“ستاند شعر” تطلق مسابقتها الأولى لشعراء قصيدة النثر
احتفاءً بيوم الشِعر العالمي، أعلنت...