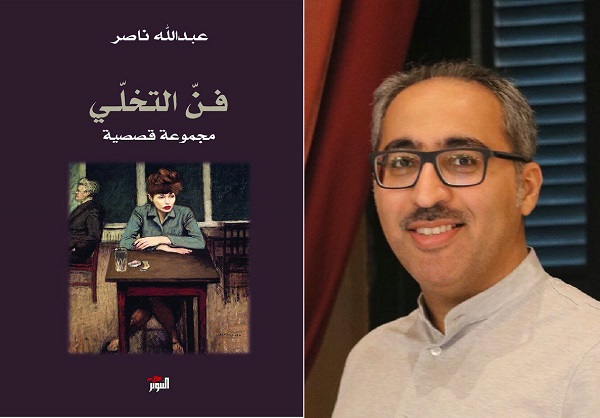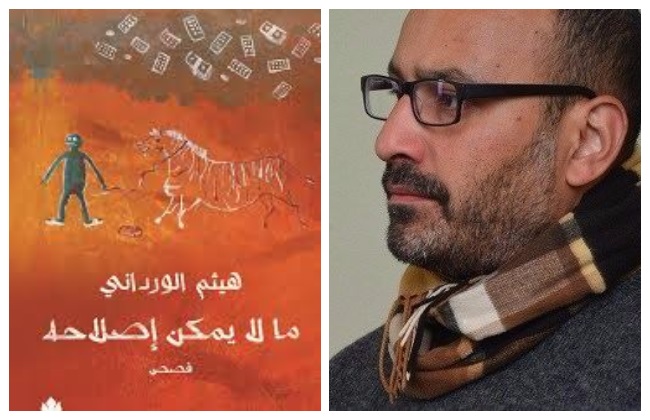إيمان حميدان روائية وصحافية، صدر لها الروايتان باء مثل بيت مثل بيروت، وتوت بري، وتعمل بمجال التنمية والبيئة، وأنجزت بحث الماجيستير الخاص بها عن تجربة أهالي المفقودين خلال الحرب الأهلية. وفي مقدمتها القصيرة لهذا الكتاب أشارت إيمان حميدان إلى النقص الفادح في مكتبتنا العربية لهذا النوع من الكتب، في مقابل المكتبة الإنجليزية والأمريكية بالطبع، كما ألمحت إلى أن دراسة الأدب الذي يُكتب الآن وهنا تكاد تكون لا وجود لها في مناهجنا التعليمية وجامعاتنا الأكثر انشغالاً بتاريخ الأدب، أما كيف يمكن كتابة هذا الأدب؟ فهو السؤال الذي نادراً ما نجد إجابة شافية عليه، فيما كتب في العربية، ولهذا السبب يمكننا اعتبار هذا الكتاب خطوة أولى على هذا الطريق.
لم يجتمع المساهمون في الكتاب على وصفة، أو طريقة لتقديم تجربتهم للقاريء المفترض، ولعلهم لم يحددوا – معاً أو كلٌ منهم على حدة – ملامح واضحة لهذا القاريء المستهدف. فتنوعت نبرة كل كاتب، وذهب في تركيزه إلى حيث يشاء، وبقدر ما في هذه الحرية من إيجابية، تتيح له اللعب والاكتشاف والنبش داخل معمله أو مطبخه الخاص، فقد جاءت على حساب الغرض الأساسي من الكتاب، وهو نقل الخبرات، وتعليم مباديء الكتابة الإبداعية، الروائية على الخصوص. تحديد هدف كتاب من هذا النوع مسألة لا علاقة لها بالمرة بتحديد سن الأطفال على أغلفة الكتب الموجهة لهم، ولكن بتركيز العدسة وتكثيف أكبر قدر ممكن من المادة المفيدة للقاريء – الكاتب المبتديء. جاءت بعض الدروس أقرب إلى شهادات الكُتاب التي يتلونها في المؤتمرات أو ينشرونها في المطبوعات الثقافية، ذات الرطانة والغموض الساحر، واستدعاء الذكريات الخاصة المرتبطة بهذا العمل أو ذاك.
قلنا إنها خطوة أولى على هذا الطريق، ومثل جميع الخطوات الأولى من الطبيعي أن تكون مرتبكة قليلاً، وعلى الرغم من هذا، فإن قارئاً مدرباً – ولو قليلاً – على قراءة الأدب والنقد، سوف يستفيد للغاية من تجارب هؤلاء الكتاب السبعة، وما طرحوه من أفكار وخبرات غاية في الأهمية على وجه العموم، ولا شك أنه سيجد واحداً منهم يجيب عن بعض تساؤلاته الخاصة، أو يسّهل عليه مهمة كتابية أرقّته، أو يشير له نحو الاتجاه الصحيح.
ركز الروائي محمد أبي سمرا (من رواياته: بولين وأطيافها، والرجل السابق، وسكان الصور) على الانتقال من السيرة الشفاهية لشخصيات من الواقع، كان يلتقي بهم ويسجل لهم حكاياتهم وتواريخهم الشخصية، إلى التدوين السردي، الذي ينطلق فيه متحرراً من أسر المادة الوثائقية، وإن انطلق منها، نحو التخييل والاكتشاف. كما أشار إلى ميله الخاص في “وكيف تكون الرواية رواية، إذا كان دأبها رواية الثبات؟” لا يدري إجابة، لكنه يحيل إلى المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل الذي جعل دأبه في كتابته التاريخية التأريخ للبنى شبه الثابتة في الحضارات الإنسانية. ومن جانبه يسعى في عمله أن يقبض على البنى التحتية للشخصية الروائية، ما لا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة.
ذهبت نجوى بركات (صاحبة روايات المحوّل ، حياة وآلام حمد بن سيلانة، باص الأدوام، وأخيراً لغة السر) مذهب كونديرا واستشهدت به بوضوح، وذلك في مسألتين؛ الأولى أن الرواية لا يجب أن تنطلق من اليقين، وأنها أرض الشك والحيرة والأسئلة، دون أي أحكام أخلاقية من قبل كاتبها على ساكنيها، أو شخصياتها. وحرية الشخصية واستقلالها – النسبي – عن كاتبها، فهي ليست ابنة للكاتب، بل هي تولد من رائحة أو صورة أو استعارة، حسب كونديرا. وختمت باعترافها أن لعبة الرواية تستمر عصية على السبر، لأن فيها ما يتجاوز محاولات أسرها في أفكار ونظريات، تبقى – على أهميتها – نزيلة الهامش لا المتن. إن جمال النموذج السردي المقتطف من رواية لغة السر، بعد شهادة نجوى بركات، أدل ما يمكن على رأيها هذا، ومنه قد يتعلم القاريء الذكي أكثر كثيراً من شهادتها الكونديرية.
جاءت “شهادة” الشاعر والصحافي يوسف بزي (صاحب دواوين المرقط، ورغبات قوية كأسنانا) أقرب إلى التأملات الذاتية، ومع هذا فلن نعدم فيها الأفكار المهمة للكتابة الإبداعية عموماً، وخصوصاً في علاقته المركبة باللغة، وكيف يتصيد الكلام الدارج في الإعلام أو على ألسنة الناس ليضعه في سياقٍ آخر، يحوله وينحرف به عن دلالاته المبدئية. كما أشار على أهمية “كيف” نكتب في مقابل “ماذا” نكتب، وضرورة البحث دائماً عن حيلٍ جديدة في قول أي شيء، سواء كان قديماً أو مستهلكاً أو مستجداً.
الشاعر الكبير عباس بيضون، (وصاحب رواية وحيدة منشورة هي تحليل دم) حاول أن يرصد الجسور الخفية بين الشعر والنثر، والرحلة التي قطعها على تلك الجسور ذهاباً وإياباً، حتى استقر في النهاية، وكما أشار في أول كلمة بشهادته: “أنا شاعر”. على الجسر الواصل بين الشعر والنثر، استعرض بيضون سريعاً العناصر النثرية، وربما السردية في تجربته الشعرية الخاصة، ثم ركز على تجربته في روايته تحليل دم، كما أشار لرواية سابقة حالت الظروف دون نشرها، كانت مشروعاً أقرب إلى السيرة، لكنه اكتشف في أثنائه أن التذكر نفسه هو عمل تخييلي، وشق عليه خيانة الذكرى في البداية، حيث لم يتبق منها سوى نكهتها ووقعها ولم يعد من سبيل إلى استعادتها إلا باختراعها وإعادة تأليفها، لكنه في نهاية الأمر انتفع بهذا التخييل والتأليف وهو يغزله بما تبقى من الوقائع.
آثر الروائي حسن داوود ( كاتب بناية ماتيلدا، أيام زائدة، وغناء البطريق وغيرها من الأعمال المتميزة) في شهادته الخاصة أن يبدأ بالحكي وروى واقعة ضياع مخطوطة رواية له ظل يبحث عنها لسنوات – عبر أصدقاء له في باريس، إذ فقدها في تاكسي بمدينة النور – وظل لسنوات أيضاً يحاول إعادة كتابتها دون جدوى. يظهر في شهادته الوعي المرهف بتقنيات اللعبة السردية، وبخصوصية الطريقة التي يتبعها، الطريقة “غير الدراماتيكية” والتي تنأى تماماً عن مشهيات الإثارة والتشويق، وتتبع إيقاعاً يكاد يكون رتيباً في نبشها للشخصيات والعوالم التي تتكشفها. ويرجع هذا إلى تأثيره بالشعر، الذي لم يفتقد وجوده في روايات لكتاب كبار عالميين كثيرين، أي عدم الانشغال بما حدث وما سيحدث، وعدم الانتظار حتى نهاية الرواية حتى يكتمل معناها، وبعبارته الجميلة: “أي أن لا يكون التحقق بالوصول، بل في كل ما يسبقه موصلاً إليه.” احتشدت شهادة حسن داوود بالأفكار الثرية الدقيقة، إلى جانب الحكي الشخصي البسيط والحميم.
في نهاية الكتاب نقرأ شهادة علوية صبح، (صاحبة الروايات مريم الحكايا ، اسمه الغرام، ودنيا) التي أكدت على عدم الانطلاق من خطة مسبقة في الكتابة، وإصرارها على عدم حكي الحكاية بترتيبها الزمني المنطقي، وميلها – بالتالي – إلى الكتابة، في مقابل الحكي، حيث مع الكتابة تبدأ من حيث تطاوعها الكتابة، على عكس الحكي. خصت الجزء الأكبر من شهادتها بالحديث حول شخصياتها النسائية، وكيف يتلبسنها أو تتلبسهن، وتحديداً بطلتها مريم، وكيف استطاعت بحكاياتها حتى أن تخرس الروائية وتزيحها لتنفرد بالسرد.
أشارت إيمان حميدان، في شهادتها التي توسطت الكتاب تقريباً، إلى صعوبة الوصول إلى الجملة الأولى التي يكتبها روائي مثل أورهان باموك من 50 إلى 100 مرة. وأشارت أنها تكتب رواياتها نتفاً وقصاصات هنا وهناك، على الفوط الورقية وقوائم الطعام وظهر فواتير الكهرباء، ثم تقوم بعملية مونتاج لهذه المقطاع المتفرقة، وتعيد طباعتها، وهكذا ثم تضيف إليها فقرات جديدة، في لعبة دائرية تستمر طويلاً خلال رحلة اكتشاف، تكون فيها لحظة الكتابة هي لحظة اليقين الوحيدة للكاتب!
استمتعت واستفدت بقراءة نصوص هذا الكتاب حول الكتابة، وأظن أن جميع المهتمين بالكتابة – ممارسةً أو استهلاكاً أو نقداً – سوف يعيشون التجربة المثرية نفسها عند قراءته. هذه التجربة تستحق التحية لأنها فتحت باباً جديداً نحو التعامل مع عملية الكتابة الإبداعية بقدرٍ أقل من الغيبية وقدر أكبر من الوعي والنضج. ولعله من الدال والطريف أن تعترف إيمان حميدان في شهادتها، وهي محررة الكتاب وصاحبة فكرته، أنه لا توجد وصفة جاهزة أو “خالدة” وفق تعبيرها للكتابة.