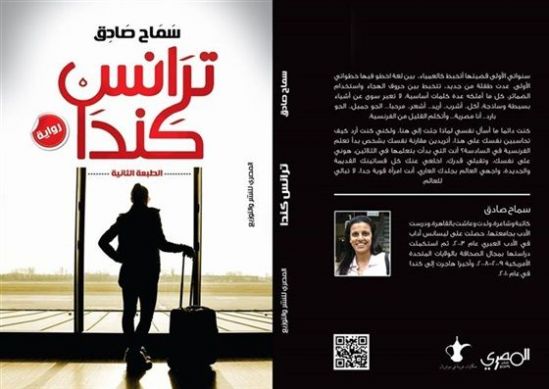هاجر مصطفى جبر
حمّلتني أمي الحقيبة، وأرسلتني لمصر لألحق بالجامعة، وودّعتُ أبي وأخي الأصغر بالرياض، وعدتُ لأتقاسم الوحدة والغربة مع أخي الأكبر. سنتقاسمها؛ ففي أيام إجازته من الكلية العسكرية سأكون في المخيم، وقبيل عودتي تنتهي إجازته. نتقاسم الأيام لتسلية الشقة.
وحيد بالمنزل. وخارجه.
الحيّ مقتسم؛ نصفٌ لنا نحن سكان الأبراج، ونصفٌ بعد الشارع المنقسم لاتجاهين به المنازل القديمة والسكن الشعبي. سكان الأبراج يقبعون في أمتارهم المحدودة، وسكان المنازل يبغضوننا.
العطل الصيفية التي نقضيها بالإسكندرية تجعلني أكره الشقة أكثر، ويضيع معظمها في تفسير الكلمات.
يقول أبي: «متى نبقى ولا نرحل عن الوطن يا سلوى؟»
وأقول: متى أعود للوطن يا أمي؟
يقول أخي: وأنتِ في الغربة يا أبي.
أقول: أنا في غربتي.
تقول أمي: اشتقت لطفولتي وذكرياتي.
أقول، وأنا في شقة أجهلها وشارع ينكرني: يا لذكرياتي وطفولتي.
لكن أنتظر تلك العطل.
انتهى التخييم العلمي مساء الخميس، صممتُ على السفر ليلًا وحدي لأصل البيت صباح الجمعة؛ يومًا كاملًا أقتنصه من الغربة والوحدة، وأقضيه مع أخي بالضحك والكلام، وننسى الطعام؛ جوعنا لن تشبعه اللقيمات.
دققتُ جرس الشقة، طالعني وجهها؛ سمراء صافية، نعم، ذاك السمار الذي يشبه الخمر التي لم أكن أدرك لونها أو مذاقها. كيف أحسستها كالخمر وأنا ما ذقت المشبَّه ولا المشبَّه به؟ جهلي بسحرهما قد يكون وجه الشبه!!
هل هذا التشبيه فاسد؟
لا أعلم، لست من معلمي البلاغة، فأنا جغرافي لعين.
مدّت يدها، سلّمت. تسمّرت مكاني حتى جاء أخي. ظنّ أني غاضب، قاطعت تبريراته العبثية بسؤالي الأهم: يدها طرية، أليس لدى الفتيات عظام؟
ابتسم: نعم. اكتشفتُ ذلك
تعمدتُ كبت فضولي، منعتُني من التفكير في سمراء أخي، لكن شهوة اللحم الطري لم تغادرني. بعد سفره بحثتُ عن يد تعوّض يدي ما فقدت. بعد أسبوعين التقيت «نهيل»، تشبهني؛ والدتها وطفولتها، ووالدها في ليبيا. ومعها علمت عن الكائنات الجميلة أكثر من كونهن خاليات من العظام؛ إنهن دافئات في الشتاء، جسدهن بارد في الصيف. نسيت بهن الأيام، وتعدّلت بهن الفصول، وكثيرًا ما عثرت على المعاني التائهة بهن.
لماذا أتذكر كل هذا الآن؟ هل موت زوجتي أعاد لي ذاكرتي النسائية؟ هل قرار الرجوع لمصر أعاد لي أبي والوطن؟ هل ذاك الحزن الدفين بعيني أخي ما يذكرني دومًا بيد أبحث عنها وجسد أشتهيه؟