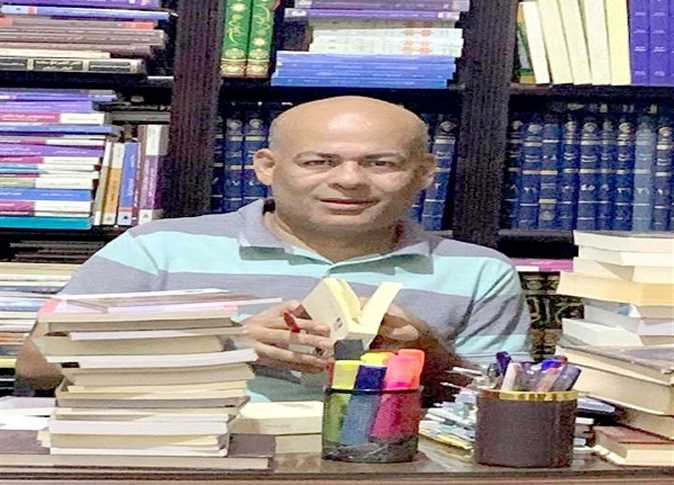رحاب إبراهيم
دخلت أم قدرية بيتنا قبل أن أدخل المدرسة.
قبلها أذكر فتاة ريفية صغيرة كانت تعتني بي وبأختي، ولم أكن أحبها، أما أم محمد فلا أذكرها إطلاقا، ولولا الصورة التي تقف فيها خلف عربة أختي الرضيعة في المصيف ما عرفت اسمها أبدا.
استمرت أم قدرية في زياراتها المنتظمة لبيتنا طوال فترة طفولتي وصباي، حتى بعد زواجي ظللت أسمع أخبار زياراتها بين فترة وأخرى، وكيف لم تعد تقوى على العمل الشاق لكنها لا تحب أن تغيب طويلا عن “حبايبها”.
ما اعتادت القيام به كان شاقا بالفعل، وكنت أكره يوم زيارتها – بيني وبين نفسي طبعا –
وأسميها العاصفة – مع نفسي أيضا –
تأتي مبكرة، فتفتح كل الأبواب والشبابيك والشرفة الكبيرة المتصلة بغرفة الجلوس وكذلك الشرفة الصغيرة المتصلة بالمطبخ، تفتحها كلها في وقت واحد بينما لا أزال تحت الأغطية الدافئة، يهاجمني النور والهواء، ثم لا تكتفي بذلك، تسحب السجادة من تحت الأثاث كما يسحب الفطاطري فطيرة، وتقذف بها لسور البلكونة حيث تبدأ عملية التنفيض غير ملتفتة للكسالى النائمين حتى الظهر – الذين هم أنا وأخوتي – رغم الثلاث ساعات المتبقية على ظُهرها المزعوم.
على مدى سنوات عملها مارست التنفيض بنفس الحماسة والإخلاص، بدأتها باستعمال منفضة خشبية يدوية الصناعة، ثم انتشرت المنافض البلاستيكية الصغيرة صينية الصنع والتي رفضت استخدامها في البداية، حتى فعلت ذلك مضطرة حين لم يعد هناك بديلا.. تمسكها وتقلبها بين يديها في شك مختلط بالقرف وتقول: “الدنيا اتقلّ خيرها”
أضطر للقيام، لأن خطوتها التالية هي تشميس المراتب والفرش، دقائق قليلة ثم لا يبقى في البيت مأوى لي فأتجه للمطبخ.
غالبا ما يقتصر دوري على تحضير الفطور والغداء، فهي لا تقوم سوى بأعمال التنظيف.
شهدت أم قدرية تطورات مهاراتي المطبخية بدءا من الخبز محترق الأطراف والرز المعجن، وصولا لوجبات مقبولة متكاملة الأركان، دون أن تُبدي أبدا أي انتقاد ولو بتعليق عابر أو لوم مستتر كما تفعل النساء في مثل عمرها عادة.
عاصرت أيضا تطور شخصيتي بكل ارتباكات المراهقة الحادة، وكل القسوة الواثقة في الشباب بحياد تام وبلا أدنى لوم.
رغم تقلباتي المزاجية كنت أكنّ لها إحساسا خاصا قد يخبو قليلا لكنه لا يختفي.. إحساس عميق بالحب والتقدير سببه موقف صغير بالتأكيد هي لا تذكره، حتى أنا أحيانا احتفظت بمشاعري تجاهها بلا تفسير واضح..
كنت قد بدأت للتوّ أيامي الأولى في المدرسة حين عدت بثياب متسخة..
لم أستطع تفادي بركة الماء الصغيرة أمام بوابة المدرسة والتي أخذ التلاميذ يدورون حولها بمهارة لاعبي السيرك، أما أنا فقد غصت فيها مع أول تدافع خلفي.
استقبلت أم قدرية وجهي المحتقن بلهفة أم، تركت ما في يدها وأدخلتني برفق للحمّام
وسط بكائي الشديد خجلا من شكلي وخوفا من عقاب أمي.
ساعدتني على الاغتسال واستبدال ملابسي دون أن يكون هذا العمل من مهماتها وعادت لتكمل عملها بعد أن مرّ الأمر في سلام.
لا أذكر أنها أشارت لهذا الموقف أبدا بعدها لا من قريب ولا من بعيد وربما اتفقنا ضمنيا على أنه شيء لا يستحق الذكر.. أنا لرغبتي في تجاوز مأساتي الصغيرة، وهي لاعتقادها أنه شيء بسيط ومعتاد.
مرت سنوات الطفولة، وبدأت أخطو نحو الصبا بثبات، وكما يود المراهق التخلص من طفولته كنت أتخلص من النظام الذي يفرضه وجودها في يوم التنظيف الأسبوعي.
فمرة أطلب منها أن تغلق الشرفة ومرة أخبرها أن تعيد تنظيف شيئا لا تعجبني نظافته، أو أن ترتب الأحذية بطريقة معينة، لا ترتيبا عشوائيا كما اعتادت.
لا أذكر سبب غضبي الذي جعلني أقول لأبي مرة: هي تؤدي لنا خدمة مقابل أجر..هذا كل ما في الأمر
أجاب نافيا بشكل حاسم : لا طبعا…ليس هكذا
تركني بعد النفي القاطع وصمت كعادته دون أن يقدم تصحيحا واضحا لما قلت أو وصفا بديلا.
أظن أنه اكتفى بما سوف تعلمني الأيام إياه على مهل.
بدأت أم قدرية تناديني بلقب “الدكتورة “فور ظهور نتيجة الثانوية العامة، الأمر الذي أثار دهشتي.. كيف تحولت بين يوم وليلة من البنت التي كانت تناديها بأسماء الدلع المختلفة لـ “الضاكتورة” كما تنطقها!
بالنسبة لي لم يكن شيء قد تغير بعد ولا حتى عرفت شكل الكتب فضلا عن فكرة كتابة علاج لشخص ما، لكنها منحتني اللقب بلا تردد بل وبكل فخر.. ربما لم تصرح أبدا أن لها في هذا اللقب نصيبا لكنني الآن أعلم هذا جيدا.
رغم حكاياتها العديدة عن بناتها وأزواجهن ثم عن أحفادها فإنها لم تكن تحكي الكثير عن زوجها حتى شككت في وجوده أصلا، لولا المرة الوحيدة التي ذكرته فيها وهي تحكي عن زيارة أحد لمشايخ المعروفين لقريتها، إذ سألت الشيخ عن حكم الأكل معه وهو لا يصلي، فأخبرها بجواز أن تشاركه الطعام بشرط أن تضع حدّا فاصلا بين طعامها وطعامه.
كانت الفتوى لا تقل غرابة في نظري عن السؤال..
ولم أربط ذلك الحرص على معرفة الحلال والحرام حتى في تفاصيل بسيطة بحرصها على الصلاة مهما كان العمل الذي في يدها.
لم أعدّ أيا من ذلك دليلا على تدينها، فمظهرها لم يكن يختلف عن أي سيدة ريفية ترتدي الجلباب الملون وتبدو أحيانا خصلات شعرها الفضية من تحت الطرحة التي تربط بها رأسها.
لم تكن تشبه الأخوات الملتزمات التي تعرفت عليهن وعلى عائلاتهن في المدرسة واللاتي نجحن في إقناعي وقتها بالنسخة الموحدة للتدين المقبول.
لذا احتفظت بها في ذهني مجرد امرأة عادية لسنوات طويلة كان يجب أن تمرّ قبل أن أدرك الفرق بين العادي والثمين..
شاركتنا أم قدرية كل المناسبات الاجتماعية من خطوبة وزواج ووفاة وسفر وإياب
قبل أن تخف زياراتها تدريجيا.. ربما بسبب مرض وربما لأنها أكملت رسالتها في تعليم وتزويج أولادها
عادة ما تخطر في بالي يوم الجمعة – يوم زيارتها المعتاد لبيت أهلي في مدينتي الصغيرة البعيدة.
وحين أدير محطات المذياع بحثا عن إذاعة تنقل لي شعائر الصلاة، أتذكرها وهي تمسح زجاج النوافذ بهمّة، مستغرقة في الاستماع لتلاوة الشيخ في المسجد المقابل
أذكر الحسرة في صوتها حين تنتهي التلاوة فتتنهد قائلة: خلصت ليه يا عم الشيخ!
……………
يناير/فبراير 2021