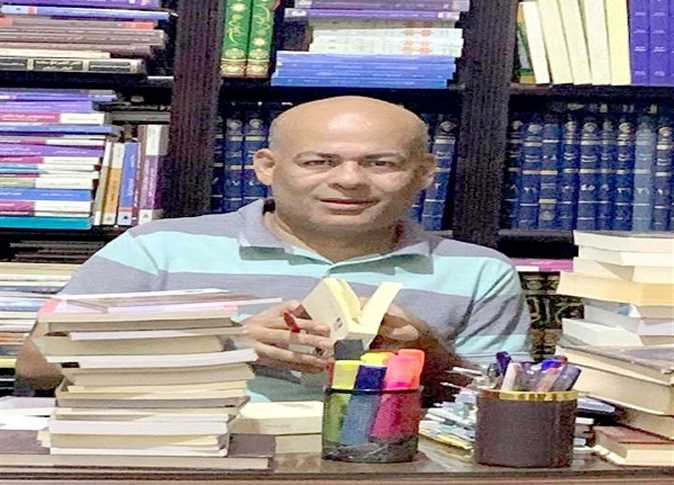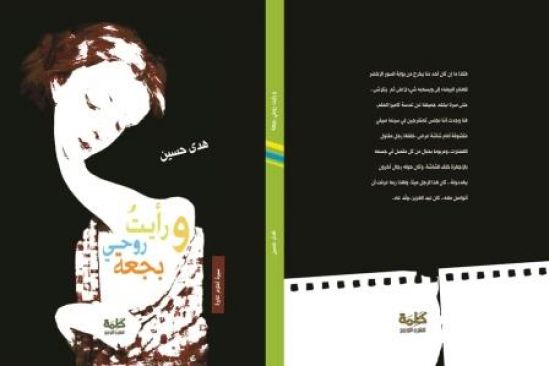محمد مصطفى الخياط
“سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش / (ستينَ) حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ”، نظرت نحو صاحبنا من خلف الطاولة التي تفصل بيننا تعلوها أكواب المياه وفناجين القهوة، وابتسمت وقلت له بصوت كله دعابة، (أتُلحن في أحد أشهر أبيات العرب، حسبك أن يسمعك زُهير بن أبي سُلمى)، رسم ابتسامة باهتة عكست مِزاجًا مُعكرًا، تجلى في كَدَرِ قسماته وجهه ورقرقة دموع من تُفلح عدسات نظارته السميكة في إخفائها، ثم أمسك بفنجان القهوة بين كفيه وقال وهو ينظر بداخله، كأنما يقرأ ما سُطر في قَاعِهِ، (صعبٌ جدًا أن ننتظر عشرين عامًا إضافية حتى نقتنع بصواب رأي زُهير)، ثم رفع وجهه وأردف (كفانا تلك العقود الست، وما هي بقليل).
أجبته قاصدًا إخراجه من حالته المزاجية السيئة، (يبدو أنك نسيت ترديدك لمقولة “العمر مجرد رقم”..)، ثم أكملت وأنا أكذب (انظر في المرآة وستجد شابًا دون الأربعين). طوح ذراعه في الهواء كأنما يبعد به ذباب كلماتي عن أذنيه، وقال بصوت ظهر فيه أثر كي السنين (كلام…)
(ما رأيك لو تمشينا قليلاً.. ربما تحسن مِزاجك)، سألته وأنا أُشير للنادل ليأتي بالفاتورة، تنهد بحرقة وقال (وهل تعتقد أن ذلك يُخرجني من تلك الشرنقة اللعينة؟)، قلت (نأخذ بالأسباب على الأقل!)، قال (لك هذا!)، ثم نهض معي متثاقلاً.
تمشينا بحذاء الكورنيش، فلفحتنا ريح يناير الباردة، أحكمت الكوفية حول رقبتي، وكبست الطاقية الصوف على رأسي، فيما بدا شعره الناعم الطويل مهوشًا في غير نظام، ترسله الريح يمينًا تارة، ويسارًا تارة أخرى، وهو غير عابئ، مكتفيًا بدس كفيه في جيبي البنطلون، والريح حولنا تعوي وتزوم.
(ما رأيك في صورة؟)، قلت وأنا استوقفه بيسراي، وأشير لشاب يقف –غير بعيد- وسط أقرانه بيمناي، رسم على وجهه نصف ابتسامة ووقف إلى جواري، دون أن يُخرج كفيه من جيوبه، التقط الشاب عدة صور ظهرت فيها صفحة النيل خلفنا، التففنا بكاملنا واتكئ كل منا بمرفقيه على السور المعدني البارد.
كانت المراكب في إبحارها الهادئ وأضوائها الملونة تبدو كحوريات ترقص على سطح الماء، تضج بصخب ركابها، طبول، وتصفيق، وأغاني، بدا في واحدة منها عروس تراقص عريسها على إيقاع طبلة ودف، ومن حولهما تحلق الأهل والأصحاب بوجوه تضج سعادة وسرور.
نظرت نحوه نظرة مشاغبة وقلت له وأنا أشير بنصف وجهي نحو النيل (ما رأيك؟)، أخرج صوتًا بين الضحك والرثاء، وقال (تبقى كملت!)، ولم أدر بنفسي إلا وأنا اسحبه من ذراعه رغم أنفه وانزل به نحو مدرج النهر، وهو يحاول الفكاك عبثًا، قبضت على ذراعه بقوة لا أعرف من أين جاءتني، ربما من إصراري على إخراجه من حالته تلك.
(وسع للباشا.. وسع للبيه)، قال مساعد المراكبي وهو يفسح لنا الطريق لنعبر إلى المركب من فوق سقالة خشبية، خطوتان وصرنا على سطحها، وعبثًا فشل صاحبي في نزع ذراعه من كفي.
(يا خويا أقعد كده.. حد طايل)، صاحت سيدة ممتلئة الجسم وهي تشيح بذراعها في وجهه وسط دهشتنا لجرأتها، ثم أردفت دون أن تأبه بما ارتسم على وجهه في ملامح استنكار (ومالك شايل طاجن ستك.. اضربها صرمة تترمي تحت رجليك وتقولك يا سِيِدْ)، سألها مبهوتًا (مين دي؟)، فردت مجموعة من البنات والشباب مع السيدة في صوت واحد وبصوت ممطوط وبإيقاع أشبه لمن يغني (الدنيا)، ثم أطلقوا ضحكات هستيرية، ضحك لها صديقي رغم أنفه.
كانوا في حدود الاثني عشر فردًا، متفاوتي الطول ولون البشرة، يحملون في أيديهم آلات إيقاع؛ طبول، ودفوف، وصاجات، لا يكفون عن اللعب عليها في إيقاعات صاخبة، وإن بدت متناغمة مع رقصهم، وصيحتهم التي يطلقونها في رتابة كل أربع طرقات، (دنيا.. دنيا).
(أيوه كده بلا نكد)، قالت السيدة البدينة عندما شاهدت صديقي يضحك بكل ما فيه من قوة حتى دمعت عيناه، ثم أردفت (لو عايز نكد على أصوله، تعالى وأنا أنكد عليك)، فأطلق الشباب المصاحبين لها ضحكات مجلجلة، أجبرت صديقي على المزيد من الضحك، وما هي إلا لحظات حتى توسطت السيدة المركب وراحت تهتز مع الإيقاع وتطلق سيل زغاريد لا تنقطع، والشباب من أولاد وبنات متحلقين حولها، وفي حركة مباغتة جذبت السيدة صاحبنا وأدخلته في الدائرة فراح بعفوية يحاكي حركتها مسترجعًا إيقاعات السمسمية التي تربى عليها في شوارع الإسماعيلية، قبل قدومه للقاهرة واستقراره فيها.
مضى بنا الوقت، والمراكبي يقطع النيل شمالاً حتى ظننا أنه لن يرجع، ثم يوغل جنوبًا كأنه لن يعود، والجميع من حوله يرقص ويغني، بينما تضوي أضواء اللمبات الملونة في ظلام المحروسة فتُغري الهاموش والفَرَاشْ على ترك مكامنه في دغل البوص على جانبي النيل والطيران حولها.
نظرت إلى صديقي، فوجدته مندمجًا مع السيدة البدينة والشباب وقد سربل العرق وجهه ورقبته وألقى سترته جانبًا. اتجهت نحوه عندما أشار لي، ففرج الشباب فتحة فصرت إلى جواره في قلب الدائرة، تتعالى من حولنا أصوات الإيقاعات، وزغاريد السيدة البدينة، والمركب في رواحها ومجيئها لا تهدأ ولا تتوقف، وفوقنا يُطل البدر راسمًا ابتسامة خرافية.. اقترب صاحبي من أذُني قدر استطاعته ورفع صوته مُنشدًا “سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن (لم) يَعِش / ثمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ”.. ثم ضحك وقال (وليسامحني زُهير)، وضحكًنا..