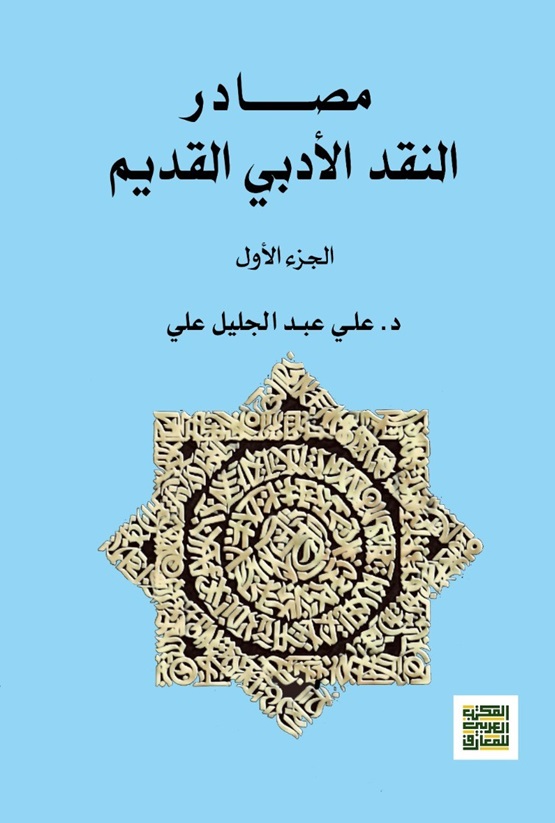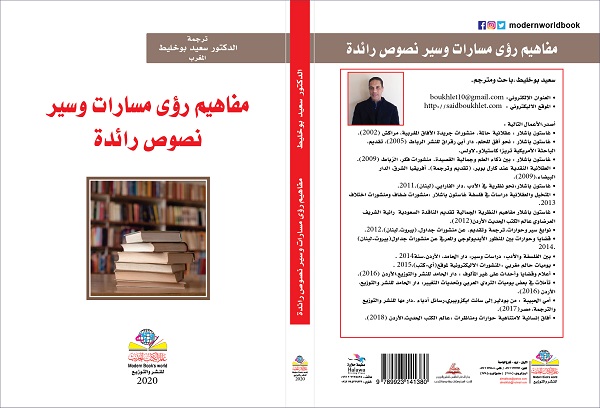وتقدم أدهم نجل الراحل مصطفى محمود، والفنان جلال الشرقاوى موكباً بسيطاً شيع الجنازة إلى مدافن الأسرة فى أكتوبر، وغالبت ابنته «أمل»، التى تولت رعايته طوال فترة مرضه، دموعها فى وداعه، فى اللحظة التى تعالت فيها هتافات الوداع من الممرضات والمترددين على مستشفى مصطفى محمود.
وغاب عدد كبير من أصدقاء وتلاميذ الفيلسوف، فيما نعى الدكتور عمرو حلمى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الفقيد، وقال الدكتور محمد عادل نورالدين، الرئيس السابق للجنة الخدمات فى الجمعية، إن غياب التمثيل الرسمى للحكومة لا يعنى الفقيد لأنها لم تكن تشغله فى حياته، وكان متوجهاً لعامة الناس بماله وعلمه وعمله.
وانتقد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، الغياب الرسمى للدولة فى وداع العالم الجليل، وقال «الفقراء وحدهم هم من يودعون المرحوم لأنه كان بطلاً للفقراء لا للحكومة»، وأضاف أن نقابة الصحفيين تنعى الفقيد الذى كان نموذجاً للمثقف المصرى المستنير، خدم الشعب المصرى، ومزج العلم بالإيمان.
قال صلاح عبدالمقصود، وكيل النقابة، إن الراحل يودع البسطاء الذين جاءوا خلفه بمشاعرهم الصادقة وقلوبهم الصافية، دونما ضجة رسمية، واعتبر وفاته خسارة كبيرة لنموذج رائد فى العمل الدعوى والخيرى والأهلى فى مصر، مثلما هى خسارة للدعوة الإسلامية بما قدمه من مؤلفات وعلم ينتفع به الجميع.
يذكر أن الراحل أجرى عدة عمليات جراحية منذ أواخر التسعينيات منها تغيير بعض شرايين القلب وإصابته بجلطات متوالية ألزمته الفراش وهو ما اضطر أسرته إلى منع الزيارة عنه، خاصة أنه كان يرفض لقاء الغرباء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بروفايل : مصطفى محمود.. المؤمن بالعلم.. والعالم بالإيمان
فى أواخر عام 1921 ولد بمدينة شبين الكوم بالمنوفية مصطفى كمال محمود حسين الشهير بـ«مصطفى محمود» فاتحاً عينيه على الدنيا للمرة الأولى بعدما أعطته الحياة فرصة أخرى بعد وفاة توأمه عقب ولادته مباشرة، تلك الولادة التى جاءت بعد سبعة أشهر فقط من بداية الحمل لتعطى الطفل الصغير وصفاً اعتاد الناس فى مصر أن يطلقوه على المولودين بعد هذه الشهور.. «ابن سبعة».
لعب الصبى مصطفى محمود دور الطفل المدلل من قبل والده «محمود حسين» المحضر بمديرية الديوان العام بالغربية، وساعده على هذا التدليل ضعفه العام الذى جعل منه طفلاً مريضاً على الدوام ولم يمض وقت طويل حتى التحق بالكتاب ثم المدرسة الابتدائية..
ويحكى بنفسه عن تلك الفترة فيقول: «عندما كانت الأمطار تهطل وتحول حوش المدرسة إلى بركة ماء كنت أقوم بصنع زوارق من ورق وأتخيل أنها ستأتى محملة بالعطور من الهند.. أراقبها وأنا جالس فى حالة شاعرية، وأجوب الدنيا بخيالى»، لم يكن مصطفى محمود تلميذاً متفوقاً كما يروى فقد رسب ثلاث سنوات فى الصف الأول الابتدائى غير أنه استطاع أن يستأنف الدراسة بعد ذلك دون رسوب واستهوته بشكل خاص مواد الكيمياء والطبيعة،
ويقال إنه أنشأ معملاً صغيراً وبدأ يصنع مبيدات يقتل بها الصراصير، ويقوم بتشريحها بعد ذلك، قبل أن يلتحق فى النهاية بكلية الطب فى نهاية الأربعينيات، حيث لاحظ أقرانه شغفه بالتأمل، إذ كان يقضى أوقاتاً طويلة داخل المشرحة، إلى أن تخرج عام 1953 ليعمل طبيباً للأمراض الصدرية بمستشفى أم المصريين.
الشك كان رفيق دربه، عرف منذ صباه بموهبته فى الأدب، فكان يكتب وينشر أعماله فى روزاليوسف، وفور تخرجه فى كلية الطب عمل بها حتى منع الرئيس عبدالناصر الجمع بين وظيفتين، فتخلى مكرهاً عن الطب وتفرغ راضياً للأدب والصحافة، ثم أصدر مجموعته القصصية الأولى التى حملت عنوان «أكل عيش» عام 1954 ثم أتبعها بكتاب «الله والإنسان» الذى فتح عليه النيران من اتجاهات عديدة اتهمته جميعها بالإلحاد والكفر وهى التهمة التى ستلاحقه طوال حياته، رغم محاولاته إثبات عكس ذلك حتى يأتى عام 1960 ويقرر التفرغ للكتابة مستقيلاً من وظيفته.
استطاع محمود من خلال برنامجه التليفزيونى المشهور «العلم والإيمان» أن يجمع عدداً كبيراً من المشاهدين.. منهم الملكة فريدة، والرئيس الراحل أنور السادات، ففى أعلى مسجده كان يضع أجهزة للرصد الفلكى، فهو حبه الأول، وفى أسفل المسجد كان متحفه البحرى.
بعد هذا المشوار الطويل تقف أمامه وتسأله: هل أنت الأديب القاص، أم المسرحى الفنان، أم الطبيب؟ فتأتيك الإجابة: كل ما أريد هو أن أكون خادماً لكلمة لا إله إلا الله.
خلال الأعوام الأخيرة بدأت تعتل صحته وأجرى عدة عمليات جراحية فى المخ والقلب فى أوروبا بعد تكرار إصابته بجلطات ألزمته الفراش وفرضت عليه قيوداً للظهور فى وسائل الإعلام، اختار الفيلسوف أن تكون «المصرى اليوم» هى الوسيلة الوحيدة التى تنقل أخباره وتطمئن محبيه عليه، وفى الساعة العاشرة إلا الربع غابت شمس الفيلسوف بعدما أرسل العقل آخر رسائله لأبنائه الذين التفوا حول فراشه مساء أمس الأول، مودعاً إياهم بضغطة حانية على يد أدهم وقبلة على جبينه ردها إلى «أمل» على وجنتها قبل أن يروح فى غيبوبة أنهاها الموت.