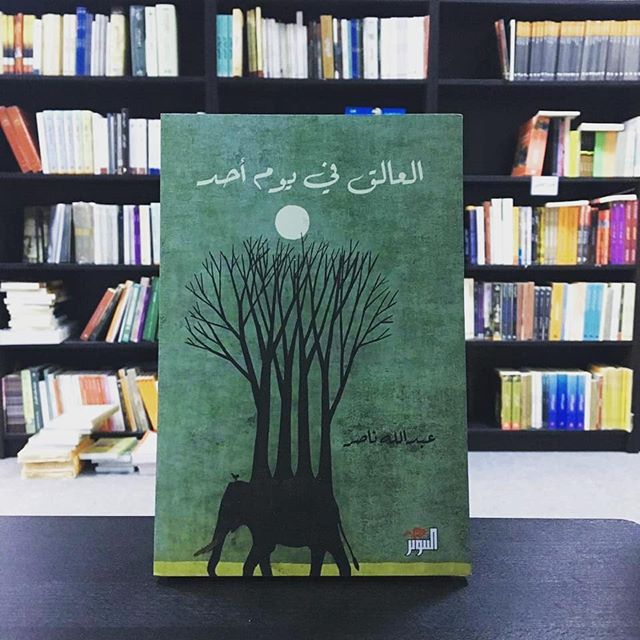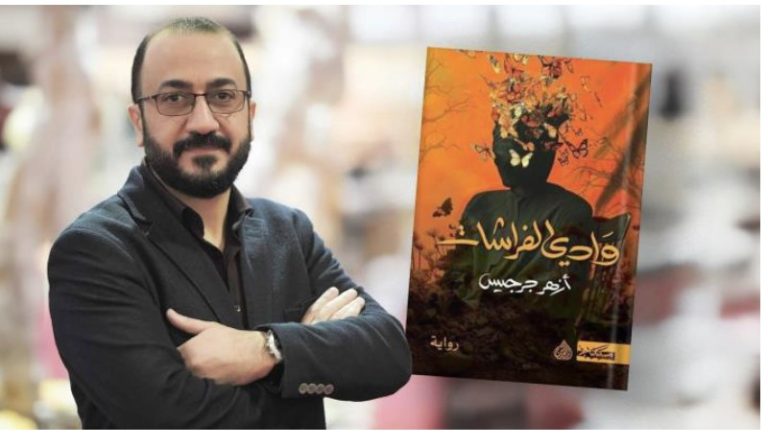خالد البقالي القاسمي
استهل المبدع نصه الروائي قبل بدايته ببيت دقيق لأبي العلاء المعري:
تحدث هذه الأيام جهرا ويحسب أن ما نطقت هسيس
عاش أبو العلاء المعري بين القرنين العاشر، والحادي عشر الميلاديين. وقد كان فخورا. معتزا بنفسه. بيد أنه كان شاعرا متوترا، تنازعته رغبتان، واحدة رغبة في الكلام، ورغبة أخرى في الصمت.
لماذا آثر المبدع المغربي عبد الحميد البجوقي استهلال روايته ببيت ملهم من قصيدة المعري الدالة إذا رفعوا كلامهم بمدح ذات الستة أبيات؟ لا يمكن أن يكون الأمر عبثا، إذ إن إثبات بيت شعري للمعري في عمق أديم الصفحة دليل على أن هناك تقاطعا حتميا لقول هذا الشاعر مع النص الروائي، لا يمكننا أن نلهو مع المعري ، صرامته تحول بيننا وبين ذلك.
ولا أخال إلا أن المعري سوف يطل معنا داخل جنبات النص الروائي، الذي سوف يشكل صدمة بالنسبة إليه، فهو لم يعرف بتاتا أن ما يسمى الرواية جزء من الأدب، ولذلك فإن المعري عبر بيته الشعري هذا، تحدث بصوت مرتفع وحاسم، ردا على الذين يعتبرون قوله مجرد هسيس بصوت خافت هامس. والمعنى أن الشاعر يوجه سهام نقده لسلوك مستمعيه الذين لا يتوفقون في إدراك مراده العميق وفلسفته الرفيعة. وربما رموه حتى بالجنون، وخرق العادة. ولذلك نقول هل يمكن أن نتحدث عن وظيفة للأدب في محاربة جنون العالم…؟ ألا يكون الأدب هو نفسه جنونا…؟ وعلى هذا الأساس فإن كان ما صدر عن أبي العلاء من ذخائر معرفية وأدبية جنونا، فإن هذا النوع من الجنون يغذو محببا، ومرغوبا، ومطلوبا…
نفس الشيء تقريبا حدث بالنسبة لأنطونيو ، لقد كاد أن يصاب بالجنون تبعا للضغط النفسي الرهيب الذي عانى من أعراضه بسبب الصدام الهوياتي الذي نكأ جراحه العميقة، ولذلك أصبح يرفض وسائل وآليات الاشتغال لدى الحرس المدني الإسباني، خصوصا أثناء التعامل مع المهاجرين المكلومين. وقد ظل إحساسه هسيسا إلى أن احتج، وتمرد، وارتفع صوته، وانسحب تماما من صفوف الحرس المدني الإسباني. فقط لكي يعبر بحرية، وبصدق.
يفتتح المبدع في روايته أفقا زمنيا ضاجا بالحياة، مفتوحا على الاحتمالات الواعدة للنص الذي يقبع بين جوانح أنطونيو ، والذي راق كثيرا للكاتب الصحافي أنخيل غارسيا . بمعنى أن هذه الرواية التي انبثقت من رحم المأساة المتخمة بالعاطفة، والمفتقرة إلى الحيوية، كتبت بتوظيف تقنية الإسناد . بيد أن المبدع سوف يكسر هذه التقنية مباشرة في المقطع الثاني، إذ كان من المفترض أن تتم عملية السرد بواسطة تشغيل ضمير المتكلم، حيث يقوم الراوي منتج الأحداث أنطونيو ، بقول حكايته للكاتب الصحافي أنخيل غارسيا .
ويخبر أنطونيو اللقيط الصحافي الإسباني عن أمه خديجة ومن سميت خالته التي سلمته صغيرا لمن رباه بمدينة سبتة المغربية… ويدفع هذا الحديث أنطونيو إلى الإحساس بأنه مثل أمير السوداني، مهاجر، ولاجئ، وتائه، وضائع، وحائر… ولكن المبدع انطلق في فرش روايته بتوظيف سارد يشتغل بواسطة ضمير المفرد الغائب. منطقيا فإن المبدع هنا يحترم تماما السياق الزمني الذي يمتح من الذاكرة، ولكن النقلة التي قام بها تستحق الانتباه… إذ يبدو وكأن المبدع لم يكن يثق تماما في حكي أنطونيو رغم أنه الوحيد الذي كان يعتقد بأنه يمتلك حقيقة محكياته.
جميع مقاطع الرواية الستة عشر تنطلق بتوظيف الوصف ضمن سياق زمني محدد ومسمى. ثم إن كل مقطع يحتوي على تيمة معينة لا يتعداها، وهذا جميل كونه يكسر الرتابة والملل، فنلاحظ بأن المواضيع الجزئية المشكلة لمقاطع الرواية والتي هي تقنية اعتمدها المبدع في بسط مجريات نصه الروائي، تتهادى فيما بينها، وتسير وفق متوالية توافقية تفسيرية، بحيث كلما تابعنا القراءة كلما اكتشفنا ارتباط المقاطع، وبيان المعنى المضمر خلف اللغة والسطور.
يعمل المبدع على تشغيل الصدف واستحضارها بكثرة، لأنها كما يبدو في النص تسعفه في إقصاء مساحات زمنية وفيرة، كانت سوف تكلفه كثيرا من الحكي. وهذه الصدف تمكنه من تقليص عدد من الإمكانات السردية التي ربما كان يعتقد المبدع بأنها لن تكون مفيدة للقارئ. بمعنى أن الروائي أصبح قارئا لعمله من منظور خلفي، فأدرك بأن التفاصيل التي اختزلها بواسطة تقنية الصدف هي فعلا غير ضرورية، وحذفها لن يغير من معمار الرواية في شيء. يبقى السؤال المفتوح هنا هو هل فعلا يحق للمبدع أن يتدخل مسبقا في اختيارات القارئ؟ ألا تشكل هذه الصيغة نوعا من توجيه القارئ وتنميط توجهاته؟
توظيف تقنية الصدف دفعت المبدع إلى الاستعانة بتقنية أخرى هي تقنية بلاغة الحذف. وهذا أمر طبيعي، إذ إن الصدف تستدعي تشغيل بلاغة الحذف، مع ترك كامل الحرية والصلاحية للقارئ لكي يملأ الفراغات التي برزت بوضوح في ثنايا النص الروائي… حيث نلاحظ بأنه انتقل بأنطونيو مباشرة من التوقف عن العمل في صفوف الحرس المدني الإسباني إلى الانخراط في منظمة أطباء بلا حدود بالعاصمة الإسبانية مدريد … فكيف نتصور إذا قبول أن أنطونيو يبتعد عن محل ومصدر وجوده بسرعة متوجها إلى مدينة مليلية المغربية، فمدينة مدريد ، مع أنه كان في حاجة ماسة لكي يشركنا في قضيته المصيرية؟… ( ص.76 ). وهل فعلا مرت سنوات على الحدث المأساوي الذي التقى خلاله بالشاب الإفريقي المهاجر اللاجئ أمير السوداني الذي جرح جرحا بليغا في عملية محاولة اقتحام المهاجرين الأفارقة للحدود الفاصلة شمالا بين تراب المملكة المغربية وبين مدينة مليلية ؟… بينما كان من الضروري فرش المزيد من المعطيات بين مدينة سبتة والقرى المغربية القريبة منها، لأن الأمر يتعلق بمصير كان مجهولا، وبقضية تحتاج إلى نفض الغبار عنها.
كما يوظف المبدع الخطاب الإعلامي، مثل: …سوف يتناول فطوره في الحسيمة… وشرع في الحديث عنها. نفس الشيء كرره أثناء الحديث عن مدينة شفشاون المغربية. إذ إن التكرار عبارة عن تقنية بارزة آثارها في مجريات أحداث الرواية. ويورد الروائي تفاصيل تاريخية كثيرة بواسطة توظيف رمزي، مع تركيز على إبراز نوع من التلاقح الملاحظ بين الحضارتين الإسبانية والمغربية. كما يورد المبدع كثيرا من المعلومات المتنوعة التي تزيد في تحقيق ألق الرواية.
يحضر المكان في الرواية بشكل بارز وكثيف. ويبدو هنا أن المكان هو اللغة التي تفكك الهوامش والزوايا. وكل لغة تملك قيمتها بوصفها خطابا. والمكان الذي يشكل حدودا رسمية بين مدينة مليلية وأرض المملكة المغربية شهد على ميلاد الرواية من قلب رحم مأساة إنسانية مريرة، حيث اتخذ أنطونيو من لحظة خاطفة يحفها الموت والفناء فرصة لبناء موقف، وتشييد قضية إنسانية، توجها بزيارة السودان بحثا عن أم أمير المصاب في الأحداث المأساوية.
ونجد أن الحديث عن أمير يتكرر في كل مرة، كما تتكرر في نفس الوقت الصدف التي تشتغل بغرابة بينه وبين أنطونيو . ولذلك يكاد يكون أمير سيدا في القيافة، خصوصا عندما يتحرى عن أنطونيو في كل مكان، وكأنه يستعجل حتفه. حيث يبدو الأمر صعب التصديق، ولكنه يطرح نفسه بقوة وعنف، إذ تكاد تكون صدفة لقائهما في مدريد موحية بحدث جلل تتردد ملامحه المرعبة بين المكان والزمن. إن وصول أنطونيو مع أمير إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان يشهد على توالي عدة طقوس، فيكون وصولهما عبارة عن عبور من طقس الهجرة إلى طقس الفناء. ويظل لقاء أمير بأمه خديجة بعد طول غياب بمثابة طقس لإعداد الفتى بعد ثلاثة أيام للقاء مصيره المحتوم. لقد آمنت خديجة بعمق ويقين بأن أنطونيو عندما عاد بأمير إلى مدينة جوبا فإنما جاء به لكي يقتل بطريقة مجانية رخيصة، ويوارى التراب بدون مخلفات. فقط احتراق فؤاد خديجة عليه، موازاة مع احتراق الزمن وانسيابه بسرعة.
هل كان أنطونيو يستعجل الزمن لكي يستعيد أمه من جديد ولو من بين أحضان المهاجر الشاب أمير ؟ لقد كان إصراره مطلقا في اختزال خديجة أم أمير أما رمزية بديلة له عن خديجة التي قضت ضحية ظلم قرية الهيادر الواقعة شمال المملكة المغربية، وكأنه يستعير من أمير أمه الثكلى. وقد ترك المبدع قدرا كبيرا من الأحداث التي عرفها أنطونيو في جوبا تذوب مع الزمن، وآثر بلاغة الحذف، مع العلم أن جزءا وفيرا من الحكي ضاع في صيغة اختزال الوقائع. كما أنه لم يشر إلى نوعية اللغة التي كان يتواصل بها أنطونيو مع أمه الرمزية، واكتفى ببناء نوع من التقابل، والتوازي، والتقاطع في الحكي والمصير بين ما حدث في قرية الهيادر ، وبين ما حصل هناك بعيدا في أقاصي السودان. يظل فقط بالنسبة للمبدع أن المهاجرين اللاجئين هم مفتاح اكتشاف أنطونيو الوجه الآخر للعالم، حتى أصبح مؤمنا بأن ما نتخيله كنا نجهله، ومن ثمة فإنه يصبح ما نعرفه…
نستطيع أن نستنتج ضمن مسار الرواية أن أنطونيو كان يعتقد بأنه يبحث عن التشابه، فإذا به يسقط في تمجيد اللاتشابه، بحيث لا يمكن بتاتا أن تكون خديجة السودان هي خديجة قرية الهيادر . إنها فن من اللاتشابه الذي يعطي نوعا من اليقين المؤقت الذي سرعان ما يتلاشى بريقه ويظل وهمه ساريا… لقد حصل أنطونيو على واقع يشبه الحقيقة، ولكنه بالتأكيد ليس بالحقيقة… إنه واقع مغموس في الاستثناءات، والاختلافات التي تلغي الهوية، ولا يعود للبروز بصيغة عفوية إلا حيثما توجد التطابقات… التي لم يكن أنطونيو المتسرع والمتحمس يدركها جيدا… لقد كان أنطونيو وهو مغمور بفكر التشابه لا يسعى فقط لإيجاد نوع من القرابة، أو الجاذبية، أو الطبيعة المشتركة مع أهل السودان، ومع أهل قرية الهيادر أيضا، بل كان يسعى للوصول إلى تحصيل نوع من الاندماج الكلي معهم. لأن الحقيقة لا تجد صداها في الإدراك الجلي، والواضح، والبدهي، إلا بواسطة المعرفة التي هي التمييز.
وهذا بالضبط ما لم يدركه أنطونيو ، لأنه ظل حتى في اللحظة التي اعتقد فيها بأنه أمسك باليقين موغلا تماما في ظلمات اللايقين، وذلك بسبب أنه آمن بصفة مطلقة في مسألة البحث عن أصله، وإثبات هويته بالحدس، دون غيره من القوى الأخرى. وبما أنه كان يؤمن بأن عمله هو واجبه أكثر مما هو وجوده، فقد أصبحت كينونته هي آلامه وأحزانه، وأضحت هويته تنساب منفلتة من بين يديه.
لقد كان أنطونيو قلقا، نزقا، شديد الحساسية، وكان حدسه الذي يتوسده يشير عليه باستمرار بأن واقعه ليس ما يحياه، بل هو ما سوف ينتظره. وبمجرد ما تلقف الإيحاء بعلاقة الأمومة التي تربطه بخديجة الهيادر، حتى بادر إلى الانسحاب من صفوف الحرس المدني الإسباني والالتحاق بصفوف منظمة أطباء بلا حدود. وكأنه يخلع عنه هوية، ويستعد للتنقيب عن أخرى.
إن انسحابه من صفوف الحرس المدني الإسباني هو توقفه عن تمثيل البطولة للغير، وعزمه على تلبس البطولة لذاته هو دون غيره. ولكن قراره هذا لم يكن ناجعا، لأن عمله مع منظمة أطباء بلا حدود ليس ببعيد عن حدود معاناته الضيقة القديمة. لقد كان يسعى إلى البحث عن الحقيقة بعد أن انفصل عن القوات الأمنية التي كان عضوا عاملا بها، واعتقد أنه تحرر من ازدحام العالم في الحدود الترابية، ولكن الصواب هو أنه غادر الحيز الضيق لكي يلتحق طائعا بحيز أضيق منه.
لقد كان الزمن يخترق أنطونيو ويستنفذ قواه كلية، سواء في استرجاع الماضي، أو في تركيب وصفة الحاضر، واستشراف المستقبل. ومن ثمة أضحى الزمن يقبع داخل السرد. بمعنى أن الزمن سكن اللغة، وأصبح هو الموجه لطبيعة الكلمات والألفاظ الموظفة في صنع خطاب الرواية. وبما أن الزمن يتغير فكذلك تفعل اللغة، إذ إن لغة الرواية في الهيادر أو تطوان أو سبتة ليست هي نفسها في السودان… لأن المكان يستوطن اللغة ويقوم بتكييفها حسب تعاقب الزمن… وبالتالي فإن كلا من الزمن والمكان أصبحا يستوطنان أنطونيو ، فظل خطابه مبعثرا، لأنه لم يستطع تجميع أجزائه، حيث كيف يمكن الجمع بين الهنا والهناك؟…
وبسبب هذا التداخل عرف أنطونيو لحظة من الفوضى الفكرية، والتشابه الغامض المضطرب بين حالة سابقة وحالة لاحقة، ما قبل خديجة ، وما بعد خديجة . وهو الأمر الذي صاغ تاريخيته ومصيره المتقلب… فهو كان يعتقد أن خديجة الهيادر هي أمه المفترضة، و خديجة السودان هي أم أمير . وكل واحدة منهما تماثل الأخرى، وتشبهها، ومن ثمة تطابقها، ولذلك فلا بأس بإمكانية تبادلهما الأدوار بينهما، وكأن إحداهما حلت في الأخرى، فأصبحتا بدنا واحدا، وروحا واحدة، وتم اختزال الإثنتين في عامل استدعاء العاطفة والاستقرار النفسي… وهكذا أصبح ما وجده في خديجة السودان بديلا عن الذي فقده في خديجة الهيادر . ولذلك ركب أهوال ومخاطر المغامرة. وأصبح يؤمن بكل ثقة بأن جوهر الأشياء لا يتغير، ووجودها وحده يظهر ويختفي. يختفي في الهيادر ، ويظهر في السودان.
ثم… انتهت الرواية كما بدأت، بلقاء أنطونيو مع أنخيل الصحافي الذي وعد بتحويل محكيات صديقه إلى رواية مكتوبة… وبناء على هذا لم يكن على أنطونيو أن يخبر الصحافي الإسباني أنخيل بأنه شاهد حكايته وممثلها الأوحد فقط، بل كان عليه كذلك أن يقنعه بأنها تقول الحق، وبأنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم الذي يحياه، وبأنه كان بصدد العمل من أجل فك رموزه المستعصية… ونحن نفترض بأنه اختار أن يقدم مروياته لصديقه أنخيل وفق واحدة من الفرضيات الخمس الآتية:
1- يقدم مروياته كما كانت…
2- يقدم مروياته كما تكون، أي كما هي…
3- يقدم مروياته كما يحكى عنها (= من طرف رواة ثقة )…
4- يقدم مروياته كما يجب أن تكون…
5- يقدم مروياته كما اعتقد الناس بأنها كانت كذلك…
وطمعا في الحصول على نموذج متميز، فإن الصحافي الإسباني أنخيل كان يتصور بأن أنطونيو سوف يروي الأحداث الحاضرة والماضية بطريقة مثالية… وعندما استنتج بأن أنطونيو قد أخفى عنه بعض الأحداث، والوقائع، اكتشف بأنه كان ساذجا للغاية، خصوصا عندما لمس ذلك من خلال المقارنة بين الأحداث والتفاصيل. لقد وضع أنخيل حرفيته الأدبية والإعلامية موضع شك، وتساؤل، واستغراب، حيث كان بدهيا أن يجزم بذلك منذ البداية عوض أن يفترضه أمام الراوي…
وعلى هذا الأساس يبدو بأن أنخيل لم يكتب الرواية الحقيقية التي عاشها أنطونيو ، وإنما كتب النموذج المفترض الذي يسكن، ويكمن، ويربض في وعيه الصحفي… حيث إن ملاحظاته على النقص الحاصل في مرويات أنطونيو كانت دافعا له لكي يدرج في النص المنشور هوامشا، واستنتاجات من تأليفه الخاص. ويتأكد هذا الطرح عندما نكتشف بأن النص أصبح هجينا، فاقدا لأصالته الأولى… ولهذا السبب لم يتح أنخيل أي فرصة لأنطونيو لكي يراجع النص الأخير، ويضيف إليه التفاصيل المنسية التي ربما سوف تدعم حقيقته، لأن هذا النص كان قد أصبح ملكا تاما للصحافي الذي تصرف فيه بالطريقة المناسبة لعرضه، والتي تروق جمهور قرائه، ومن ثمة أضفى عليه حقيقة روائية، لغوية، مناسبة لأهدافه… والذي يبدو واضحا للمتتبع هو أننا تحدثنا كثيرا عن الحقيقة التي يعكسها هذا النص كما لو أن طبيعته الروائية تفتقر كليا إلى التخييل والتصور، في مقابل الواقع والتمثيل…
لقد كان أنطونيو بسبب من الحماسة الزائدة التي كانت تلف طبعه ونفسيته، وبسبب من العجلة المفرطة التي كانت تحيط بأفعاله وقراراته، يصور شخصياته أسمى مما هم عليه في الأصل. وهذا فعلا هو منحى أرسطو في التراجيديا بما هي محكي الأفعال. بينما في الكوميديا فإن منحى أرسطو هو أنها تصور الناس في أسوأ وضع لهم في الواقع بما هي محكي الأقوال… لأن أنطونيو حتى في عمله في القوات الأمنية الإسبانية عندما كان يذوذ عن الحدود، كان يستحضر مصداقية الأعذار ذات البعد الوجودي للمهاجرين المقتحمين… ويبدو هذا واضحا في عمل المبدع الذي بنى نصه الروائي استنادا إلى التراجيديا المركبة كما حددها أرسطو ، والمعتمدة على التحول والتعرف… ولذلك ولكي يكون أكثر إقناعا عمد إلى توظيف التأثيرات التي تنتج عن تشغيل اللغة مثل البرهنة، والتفنيد، وتضخيم الأمور، أو التهوين من شأنها. وإثارة الانفعالات كالشفقة، والخوف، والغضب، وتوظيف التكرار، والإيهام الساخر، وبلاغة الحذف…
لقد كان أبو العلاء يسعى جادا لإخراس الأفواه التي تتقول عليه ما ليس فيه، ولذلك آمن ببلاغة الصمت والترفع عن الهسيس الآثم. بينما كان أنطونيو يسعى جادا لإقصاء عوامل النسيان. والاحتفاء بإنعاش الذاكرة عن طريق الجهر بالمخفي والمستور، ولذلك آمن بعدم تحويل الهسيس إلى عامل عادي أو عابر، بل ينبغي امتطاؤه باعتباره جسرا للوصول إلى تحقيق الأمن والأمان…