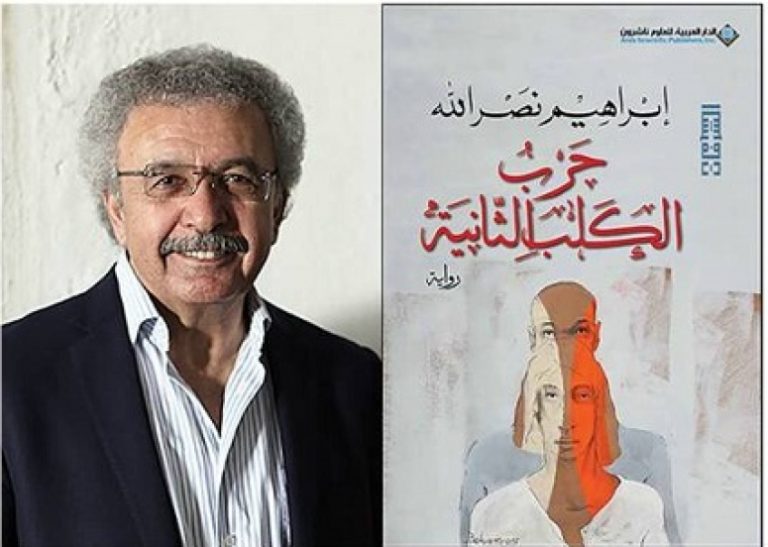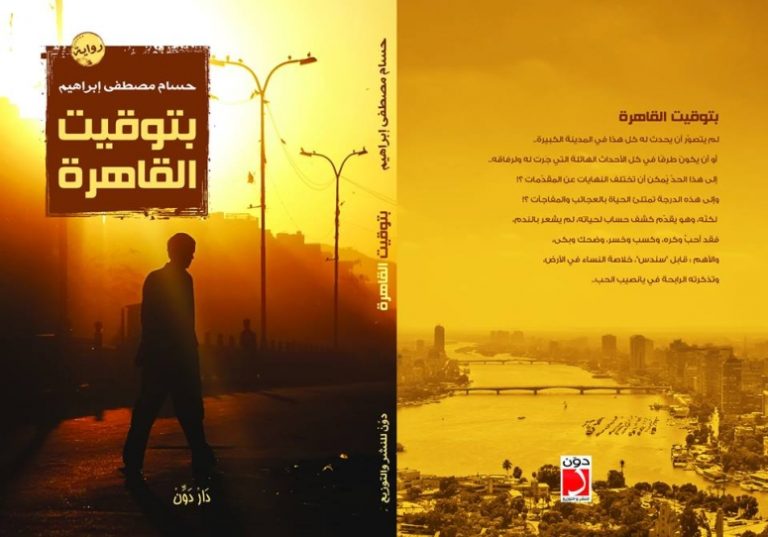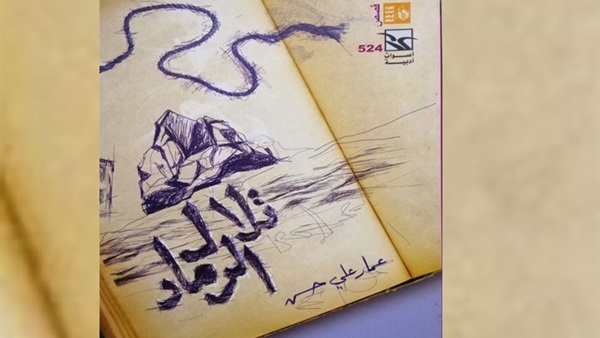رغم تفرد كل عمل من أعمال “منصورة عز الدين” بكيانه وحياته الخاصة، إلا أنها جميعا تنطلق من قناعة راسخة، تؤكدها الكاتبة في شهادة سابقة لها عن الكتابة، بأن: (الغرائبي… لا ينفصل عن الواقع، والواقع ليس فقط مجرد ما نراه بأعيننا ونعيشه بوعينا…. فالأحلام لا تنفصل عن الواقع، بل هي جزء أساسي منه، هي لغة اللاوعي، ووسيلته للتعبير عن نفسه…. عندما نقوم بتفكيك عالم الأحلام والكوابيس سوف نتمكن من إعادة بناء الواقع بمعناه الأوسع. الوقوف على الحافة بين الوهم والحقيقة، بين الواقع والخيال، بين العقل والجنون ربما يمنحنا فهمًا أعمق للعالم الذي نعيش فيه).
ومن ثم تأتي تلك المجموعة القصصية الأحدث لبنة جديدة في مشروعها الإبداعي. تقف الشخصيات المحورية، في معظم قصص المجموعة الإحدى عشر، على تلك “الحافة بين الوهم والحقيقة، بين الواقع والخيال، بين العقل والجنون”، وتتوه في متاهة إنسان العصر الحديث. فتتكشف طبقات النفس المتوارية وراء المظهر المتزن العاقل لكثير من البشر. في قصتها “مطر خفيف” تتخذ الكاتبة من قصة للكاتب الأرجنتيني “خوليو كورتاثر” إطارًا عاما للسرد. تصل الشخصية المحورية إلى مطار فخم لمدينة في دولة أجنبية، وتجد نفسها مضطرة للذهاب إلى مدينة فيسبادن الألمانية؛ تلك المدينة التي لا تعرف عنها شيئًا (سوى أنها تقع في ألمانيا، وفي قصة تحبها لخوليو كورتاثر عن “خاكوبو”، الذي حاول شبح امرأة انجليزية تشبه خلد الماء، أن يحذره من المصير المحتوم داخل المطعم البلقاني الخاوي في ليل فيسبادن الماطر، وانتهى بهما الأمر إلى أن يصيرا شبحين ينتظران في ليالي المطر). يتقافز السرد وتتداخل المشاهد، مثلما يحدث في حلم كابوسي، يختلط فيه الواقع بالخيال، ويغيب عنه منطق العقل. فتارة تظهر البطلة (بفستان ملون قصير، وحذاء بكعب عال مدبب) تسير فوق أرضية المطار بخطوات تتظاهر بالطمأنينة، ولها رنين مزعج، بينما تفكر في كيفية الوصول إلى “فيسبادن”. تدخل دهليزًا يقودها إلى مجموعة من الممرات المعدنية المتقاطعة؛ لا تعرف كيف وصلت إلى هناك، ويتعالى وقع خطواتها على الأرضية المعدنية؛ تتلاشى محطة القطارات والمطار برواده، لتبقى بمفردها (تفكر في أنها محتجزة في اللامكان). تلمح بابًا حديديًا يقودها إلى (مدينتها الأم وقد تحولت إلى فخ هائل يلونه دخان أبيض كثيف). كانت تركض فيتسع العالم وتنهار حوائط قديمة؛ شعرت (كأنها بطلة في لعبة كمبيوتر، راحت ترتقي من مرحلة للتي تليها، ومع كل خطوة للأعلى تزداد الخطورة). وفجأة ترى نفسها في (سروال جينز ضيق، سترة جلدية بنية اللون، حذاء رياضي، وكوفية حول رقبتها. المطار والمتاهة المعدنية صارا جزءًا من واقع آخر مراوغ). ومع مشاهد القصف والهجوم تتقاطع مشاهد من طفولتها، فترى نفسها (عادت من جديد، طفلة بعينين متسائلتين، وشعر بني طويل، تتسلق – حافية القدمين – تلا رمليًا ذات ظهيرة حارقة). وفي بنية دائرية يعود السرد إلى قصة “كورتاثر”، وترى البطلة نفسها وقد تحولت شبحًا (تسير تحت مطر خفيف في مدينة غريبة مع شخص لا تعرفه، وإن بدا ك”خاكوبو” كما تخيلته…. شعرت بأن خطوات ذات رنين معدني تتبعهما، استدارت فلم تجد إلا الفراغ). الشعور بالخوف والمطاردة والضياع في المتاهة، كلها طبقات متوارية خلف المظهر الأنيق والخطوات التي تدعي الثقة والطمأنينة لإنسان العصر الحديث. من مفردات الكابوس السريالية تقدم الكاتبة قراءة باطنية للواقع، أو ربما لواقع مواز يدخره اللاوعي مثلما يحدث في الأحلام.
تحرص الكاتبة على استخدام بنية السرد الدائرية في معظم نصوصها، مما يؤكد على الأزمة الوجودية لإنسان العصر الحديث، وإحساسه بلاجدوى السعي وعبثيته. ففي قصتها “ليل قوطي”، تعيد الكاتبة إنتاج أسطورة سيزيف المعروفة، وتتخذها إطارا رمزيا يغلف السرد. تدور القصة على لسان الراوية. تأتيها رسائل من صديق يحكي عن مدينة سافر إليها، لا تغيب عنها الشمس، شوارعها متشابهة و (عمارتها قوطية تبعث على الرهبة بأقواس بارزة وأبراج مستدقة، وزخارف ونقوش متماثلة لوجوه صارخة بعيون متسعة بفعل الفزع. ميادينها مربعة، وحدائقها أشبه بغابات ممتدة على أطراف المدينة). تحكي الرسائل عن عملاق خرج من مدينة الشمس بحثًا عن الليل. وبعد أن سار مئات الأميال ومرت الأيام والأعوام وجد نفسه في طريق العودة إلى مدينته الأولى! تتوالى الرسائل وتسيطر المدينة بأجوائها الغريبة على خيال الراوية. يتبادل الإثنان الرسائل؛ يحكي كل منهما، بلا كلل، عن مدينة تعيش في خياله. لا يقرأ أحدهما رسائل الآخر، إنما يكتب رسائل منمقة الخط مفعمة بالتفاصيل، وكأنما تحول كل منهما إلى سيزيف، يدحرج صخرته إلى أعلى، ثم يعود ليدحرجها من جديد بلا نهاية: (في البداية كنت أرسل له رسالة مقابل كل واحدة تصلني منه، لا أعلق على ما يكتبه ولا أسأل عنه، وهو كعادته، يبدو كأنما لا يقرأ رسائلي من الأصل. ثم بدأت أكتب بلا توقف، رسائل طويلة مكتوبة باهتمام ومشغولة بالتفاصيل، أرسل بعضها وأتغاضى عن إرسال معظمها. إلى أن كففت عن مراسلته تماما، منشغلة فقط بتسويد مئات الرسائل التي أكدسها هنا وهناك في أرجاء مسكني). ويدور السرد لتتماهى مدينة الراوية مع المدينة الأخرى التي يكتب عنها الصديق، وتتوحد خطواتها مع خطوات العملاق: (أراه يسير متفكرًا بشرود، وأسمع وقع صاخب لخطوات ثقيلة كأنما تصدر عني).
تتسم قصص المجموعة في معظمها بتشظي الأحداث وغياب المنطق العقلي ووقوع الشخصيات المحورية في متاهة دائرية، تتكشف خلالها طبقات اللاوعي المتوارية خلف المظهر الهادئ لكل شخصية. و يتجلى ذلك في قصة “نحو الجنون”، التي منحت اسمها للمجموعة. تحكي الراوية عن جارات لها غريبي الأطوار. ترتدي إحداهن العباءة والحجاب، ويصدر عن شقتها ضجيج أطفال لم يظهروا أبدا. وعندما تستدعيها الجارة إلى شقتها، تجدها نسخة منقولة من بيتها. وعندما تذهب إليها مرة أخرى، تخرج إليها امرأة في الخمسين تدعي أنها تعيش بمفردها في الشقة مع ابنتها الجامعية منذ عشر سنوات. وتحكي الراوية عن امرأة أخرى تسكن الشقة التي تعلو شقتها، وتصدر عن شقتها جلبة بشكل دائم: (ذات يوم كنت على وشك الصعود إليها كي أبدي لها انزعاجي وعدم استطاعتي النوم بسبب صخبها، إلا أنني وجدتها هي من يطرق بابي لتسألني عن امرأة ضئيلة الجسم ترتدي العباءة والحجاب مدعية أنها تسكن شقتي. تمالكت أعصابي واكتفيت بقول إني أسكن هنا مع ابنتي وحدنا منذ عشر سنوات ولا نعلم شيئا عن المرأة التي تسأل عنها). وبذلك يدور السرد دورته لتتماهى الشخصيات المروي عنها مع شخصية الراوية، وكأنها طبقات متوارية في اللاوعي لديها: (وجود عباءتها وملابس أطفالها في دولاب ملابسي لا يثبت أي شئ. يجب أن يصدقوني. يمكنهم أن يتصلوا بطليقها الذي انتزع أطفالها منها بحكم محكمة كي يؤكد لهم جنونها هي لا أنا).
بمجموعتها القصصية الأحدث “وراء الجنون”، تضع “منصورة عز الدين” لبنة جديدة في صرح مشروعها الإبداعي، الذي يطرح الأزمة الوجودية لإنسان العصر الحديث الغارق في متاهة واقع مأزوم، يحكم خيوط شرنقته حول روحه وعقله.