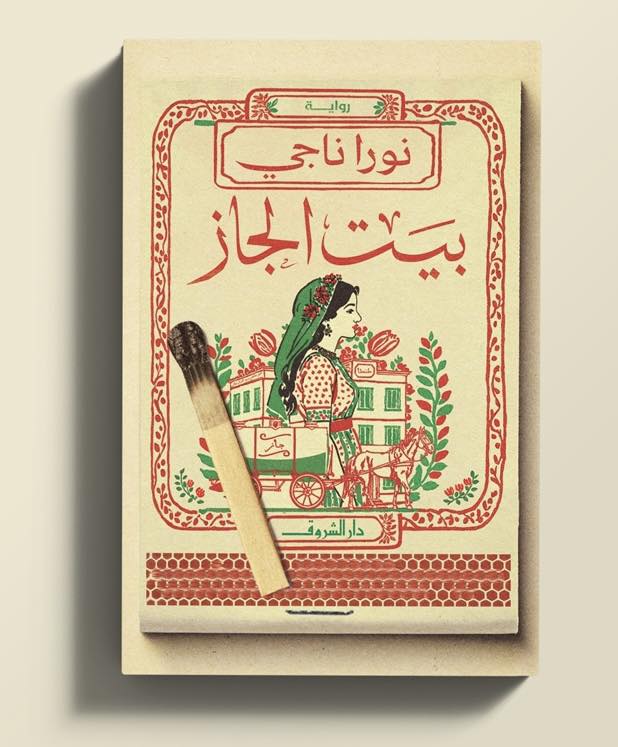فاروق عبدالقادر
قدر ما تتيسر سُبل المتابعة، يبدو لي حسني عبدالعليم من أكثر الكتاب الذين عرفت أعمالهم إصراراً علي الاستمرار، فقد أصدر – منذ بدأ النشر في ١٩٩٠ – أربع مجموعات من القصص القصيرة، وأربع روايات متتاليات، وحديثي هُنا عن الأعمال الثلاثة الأخيرة: «سعدية وعبدالحكم وآخرون، ٢٠٠٦» وبازل Puzzle، ٢٠٠٥ و«فصول من سيرة التراب والنمل، ٢٠٠٣”.
أول ما يلفت النظر في أعماله أنها «قصيرة»، بمعني أن أياً منها لا يكمل المائة صفحة من القطع الصغير، وليست هذه ملاحظة شكلية، وأنني أميل إلي تفسيرها بما يمكن أن ندعوه تراكم الخبرة المشتركة عند الكاتب والقارئ معاً، بعبارة ثانية: لا شك في اتساع قاعدة قراء الرواية العربية، ولا شك كذلك في ازدهارها الذي يتمثل في وفرتها وتنوعها، ولعل ما حققته خلال هذه العقود الأربعة الأخيرة يفوق – من حيث انجازاته الفكرية والفنية – كل ما تحقق لها منذ بداياتها أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، ومن ثم لم يعد الروائي – وهو يتوجه لقارئه – بحاجة للإسهاب والتفصيل قدر حاجته إلي توصيل ما يريد في أقل عدد من الكلمات (المنتقاة).
من الناحية الأخري فإن ازدهار التعبير بالصورة – في وسائطه المتعددة – قد ترك أثره في التعبير الأدبي الذي أفاد من مختلف تقنيات اللغة السينمائية وكتابة السيناريو، ولعل لنا عودة لهذه الملاحظة فيما يلي، ثم إن لجوء الروائي إلي هذا الشكل وراءه أنه يعرف قارئه معرفة جيدة: قارئ عجول، عزوف عن بذل الجهد لأنه مثقل بأعباء حياته اليومية، إنه – والاستثناءات قليلة – ليس قارئ «البحث عن الزمن الضائع» أو «أوليس» أو «كرامازوف» أو أي «ثلاثيات» أو «رباعيات» أو «خماسيات» في الأدب العربي أو سواه!
“سعدية وعبدالحكم” صياغة جديدة ومدهشة لحكاية فلكلورية عن «شفيقة ومتولي» (لعل أشهر من قدمها في الفن المصري الحديث هو شوقي عبدالحكيم: مسرحية في الستينيات، ثم فيلماً – بالاشتراك مع صلاح جاهين، أخرجه علي بدرخان ولعب بطولته النجمان أحمد زكي وسعاد حسني فيما بعد): أخت خاطئة وأخ تلزمه العائلة أو القبيلة بقتلها محواً للعار، وهي تدور في أربعينيات القرن الماضي، حين كان البغاء العلني مُباحاً قبل صدور الأمر العسكري رقم (٧٦) لسنة ١٩٤٩ بإلغائه، في عهد حكومة إبراهيم عبدالهادي عقب اغتيال سَلَفه النقراشي، ثم حل جماعة «الإخوان المسلمين» والتنكيل بأعضائها. لم تعش سعدية هذا الأمر بالإلغاء، فقد كانت سبقت إلي مصير آخر: نشأت في قرية قريبة من طنطا، وكانت فتاة طُلعة، تُريد أن تفهم العالم من حولها، تزوجت ومرض زوجها فجاءت معه للعلاج في القاهرة حيث عرفت بوجود حي للبغاء، وبعد أن مات زوجها جاءت وحدها للقاهرة وعرفت الطريق إليه بإرادتها هذه المرة (كأنها فتحية بطلة «نداهة» يوسف إدريس). ماذا دفعها لهذا الاختيار؟
كانت تجيب عن السؤال دائماً بأنه «عقلها» وأنها «عاوزة تجرب..»، في حوارها مع ضابط الشرطة الطيب الذي لجأ إليه أبوها وأخوها قالت – صادقة: «كل الموضوع إني أنا جاية هنا.. مش عارفة إزاي ومش عارفة أقول لك إيه.. دماغي كده..»، ولأن «دماغها كده» فقد رفضت أن تتقبل فكرة «الوعد والمكتوب» السائدة بين البغايا: «واجهت سعدية فكرة التبرير» الوعد والمكتوب، التي كانت أحد ملامح ثقافة البغاء، رفضتها بينها وبين نفسها لكنها لم تعترض عليها علانية. إن المومس في مجتمعها الجديد الذي تعيش فيه ليل نهار تجد في حكاية الوعد والمكتوب والنصيب والمقدر، التبرير الكافي لما تفعله كل يوم، وتجد في مجتمع البغاء البيئة نفسها التي تقبل هذا التبرير..».
هل كانت تحدس أنها سوف تُصاب بنوع خطير من أنواع الزهري العصبي الذي لا علاج له، والمؤدي، حتماً، للجنون؟ هذا ما حدث لها، وحين حجزت في مستشفي «الحوض المرصود» كانت تأتيها نوبات هياج، وفي واحدة من هذه النوبات حدث حادثان تافهان معاً: أحالها الطبيب إلي مستشفي الأمراض العقلية، وظهر أخوها عبدالحكم فطلب منه الطبيب أن يرافقها. علي هذا النحو تنتهي الرواية القصيرة: “دندنت أجراس عربة الإسعاف وهي تجوب شوارع القاهرة في اتجاه الخانكة – قليوبية. كانت سعدية نائمة والضماد يحيط برأسها المصابة، مقيدة اليدين والقدمين والجسد بسيور جلدية إلي السرير المثبت بالسيارة، وعلي جنب كان عبدالحكم يجلس، يمسك الأوراق في يديه وينظر إليها في بلادة..”
يلفت النظر في العمل أيضاً «المعلومات» التي يقدمها، وتتنوع هذه المعلومات تنوعاً هائلاً (يثبت الكاتب أهم مراجعه في البداية) فهي تدور حول البغاء العلني في مصر منذ ألغاه محمد علي وأعاده عباس الأول حتي ألغاه إبراهيم عبدالهادي كما سبقت الإشارة، وعن بعض نجوم هذا العالم، وعلي رأسهم إبراهيم العربي، ملك حي البغاء الذي كانت له «سلطة مذهلة في البلاد، ليس في عالم الدعارة فقط، ولكن أيضاً في محيط السياسة والمجتمع الراقي..»، وهو من كانت سعدية تهذي باسمه في نوبات لوثتها، ومعلومات عن الكلاب البوليسية وتاريخها في جهاز الشرطة، وعن «الكلب هول» أحب ضباط الشرطة الإنجليز عند المصريين، وعن محاولات العلماء المستمرة لاختراع المضادات الحيوية، وغير ذلك.
لكن هذا عمل روائي في نهاية الأمر، وليس ثبتاً بمعلومات عن هذا وذاك من الشؤون التي تعني الأبطال، ولا أريد الاستطراد في قضية استخدام «الوثائق» في العمل الأدبي، يكفي القول إنها يجب أن تذوب في نسيج العمل، ولا تقف خارجه، وأن تكون «موظفة» في سياقه العام، وهذا ما حاوله الروائي فأصاب أحياناً: (من أهمها شخصية ضابط البوليس القبطي أسعد بسادة)، وأخطأ أحياناً أخري (من أهمها المعلومات الواردة عن جهود العلماء في مجال المضادات الحيوية، فقد بقيت نتوءاً خارج العمل).