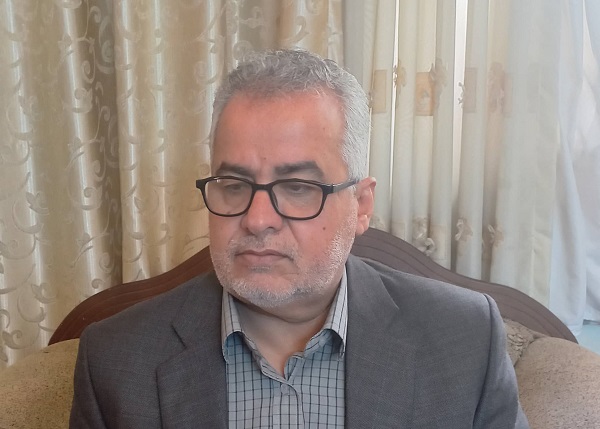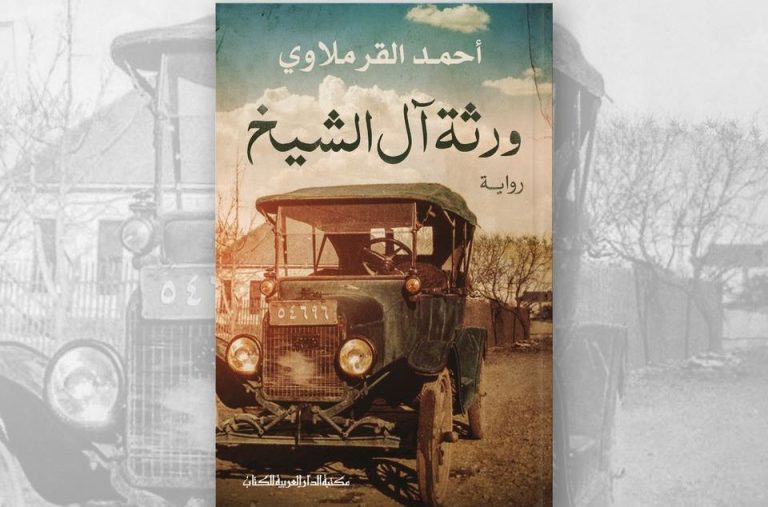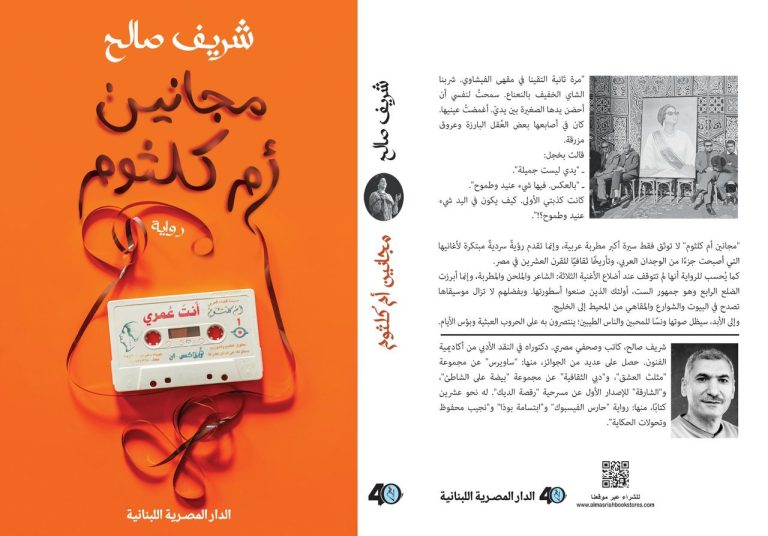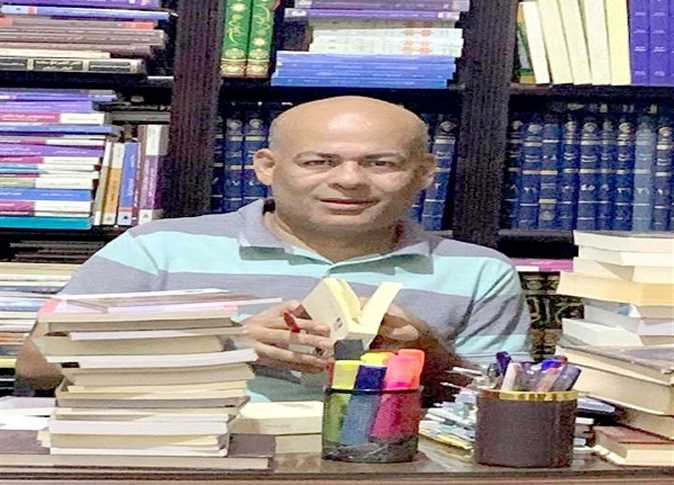لا أعرف ماذا يعني أن يكون وجهُ صديقِكَ كوجهِ القِطّ تماما! الولدُ ابنُ ناس، وهذا أمرٌ واضحٌ في طبيعة ملابسِهِ وفي تفوقِهِ الدراسيِّ وفي حرص والدِهِ على إلحاقه بالدروس الخصوصيةِ عند أشهر وأكفأ الأساتذة. كما أنه واضحٌ في ملامحه. هذه النعومةُ التي تتجه بها عيناهُ للداخل، نحو نقطةٍ في منتصف أسفلِ الجبهةِ، يبتدئُ منها الأنفُ الدقيقُ الذي ينتهي في خطٍّ عرضيٍّ، تفصلهُ عن الشفتين مساحةٌ لا يبدو فيها أثرٌ لجذورٍ محتملةٍ لشارب!
هذا الشَّعرُ الناعمُ الفاحمُ كشعرِ أحد نجوم السينما المصريةِ في أربعينياتِ القرنِ العشرين. كل ما يحتاجُهُ الولدُ ليصبحَ قِطَّ شيرازٍ أبيضَ هو تغيرٌ في لون شعرِهِ وامتدادٌ له ليغطي جسده بأكملِه. آه. وأن يحتدَّ صوتُهُ كثيرًا. أعني صوتَهُ الغليظَ الذي لا يُنبئُ عن ملامحِهِ إذا حادثتَهُ في الهاتف، ولا تنبئُ عنه ملامحُهُ إذا رأيتَهُ صامتا.
كان (هيثم) زميلي في فصل المتفوقين في المدرسة الإعدادية. تخرَّجنا سويًّا فيها منذ شهرين فقط، ليبدأ في زيارتي في المنزل ويصطَحِبَني في نزهةٍ أسبوعيةٍ في حي المعادي. ما الذي شدَّني بالضبطِ لصداقة (هيثم)؟
إذا كنتَ مؤمنًا بتجاذب الأضداد، فإني أخبرُكَ أن ملامحي غليظةٌ لا دخلَ لها بالقطط، وبأنَّ كِلَينا كان يقرأ القرآنَ في الفصل وفي إذاعة المدرسة، لكن كما نبَّهَني أحدُ زملائنا في الفصل، قراءتي فَرِحَةٌ جذِلَةٌ دائمًا، وقراءتُهُ حزينةٌ بما لا يدعُ ثقبًا لشعاعٍ من بهجة. (هيثم) بارعٌ في مفاوضةِ البائعينَ حين يُقدِمُ على شراء قميصٍ جديدٍ أو كيلوجرام من الكُمَّثرَى، وأنا لا أستطيعُ كتمانَ إعجابي بمناوشاتِهِ مع الباعة، ولا أستطيعُ أن أسمحَ لنفسي بهذه المفاوضات، فأدفع أولَ سعرٍ يطلبونه!
أما إذا كنتَ واثقًا من أنَّ الأرواحَ جنودٌ مجنَّدةٌ، وأنَّ ما تعارفَ منها ائتلفَ، فإني أطمئنُكَ إلى اتفاق لونَينا أنا و(هيثم)، فكلانا أبيضُ كالحليب، وكلانا يحبُّ أن يُباهِيَ بتفوُّقِهِ الدراسيِّ رغم حذر آبائنا من شرِّ العين، وكلانا ترتبطُ ذكرياتُه بأغنياتِ (عمرو دياب) في النهاية. ما يهمُّني الآن هو أن يَثبُتَ قلبُكَ على عقيدتِه في تفسير مسألة الصداقةِ، أيًّا كانت هذه العقيدة.
-“يعني إيه ان وِشّ صاحبك يبقى شبه وش القط بالظبط؟!”. هكذا سألتُ (هيثم) وهو يسيرُ إلى جِواري في أحد الشوارع الرئيسةِ بالمعادي. لم أسألهُ هذه السؤالَ إلا بعدَ أن كانت الفكرةُ قد تمَلَّكَتني تماما.
ابتسمَ في خبثٍ وهو ينظر في الأفق ثم قال:
-“يعني بيفترس وشوش الفيران اللي بتعدّي من جنبكو ف الشارع، يقتلها من غير ما ياكلها”.
في هذه اللحظةِ خرج ولدٌ في مثل سننا من شارعٍ جانبيٍّ ليسيرَ حاثًّا الخَطوَ محاذيًا للرصيف المقابل، وهو يديرُ وجهه الصغيرَ المثلثَ في المارةِ والبناياتِ، حتى نشبت عيناهُ في عيني (هيثم) وظلّتا هكذا حتى عبر بجانبنا وقد زاد سرعته.
-“أنا باتكلم بجد يا هيثم. هو انا ماقلتلكش على حكاية (قُطّة)”؟
-“أنهي قطة؟ انت ما قلتليش حاجة”. هنا كانت يد (هيثم) تقبضُ على ساعِدي الأيسر وتجذبني خلفه فجأةً لندخل من باب ڨيلاّ فخمةٍ في منتصف الشارع.
-“انت رايح فين يا هيثم وجاررني معاك؟ يالله يا عم نخرج من هنا قبل ما حد يشوفنا وندخّل نفسنا ف مشكلة من غير لزوم”
-“تعالى بس. عايزين. بس تعالى”!
كان يسيرُ أمامي في ثقةٍ بجوار نافورة البستان داخل أسوار الڨـيلاّ متجهًا إلى المربَّع المزروع بأبصال النرجس في آخر البستان.
سألته:
-“انت عارف اصحاب البيت دا يا (هيثم)؟”
-“لا ماعرفهمش، بس مش دا المهم. شكلهم مش موجودين زي ما انت شايف. جايز سافروا، والمفروض نطّمِن ان كل حاجة تمام لحد ما يرجعوا”!
-“نعم؟! انت بتهرّج معايا؟ أكيد بتهرّج! انت عايزنا نطّمّن على جنينة ناس مانعرفهمش؟”
ضحك ضحكةً مكتومةً ثم تناول الخرطوم المُلقَى فوق حشائش البستان وبدأ يتفحَّصُهُ وهو يقول لي دون اهتمام:
– ما تكمّل حكاية قُطّة يابني. ياه دا انت مابدأتهاش أساسًا. يالله يالله احكي وانا سامعك اهو”.
هززتُ رأسي في تسليمٍ بينما انطلقَ هو ليفتحَ الصنبورَ المتّصِل بالخرطوم ثم عاد ليباشِرَ ريَّ النرجس.
-“دي يا سيدي حكاية بجد، حصلت لجيران ابويا وامّي ف بيتهم القديم اللي كانوا عايشين فيه قبل ما يخلّفوني. بنت الجيران كان عندها حوالي عشرين سنة، وكانت مرحة إلى أبعد الحدود ورقيقة جدًّا بشهادة كل اللي حواليها. كان اسمها (قُطَّة)”.
هنا التفت إليَّ (هيثم) ولوى عنقه جهةَ اليسارِ وصَوَّبَ نحوي الخرطومَ بينما هو يقلد صوت قطة. ابتلَّ أسفلُ بنطالي تمامًا. صرختُ فيه:
-“إيه دا يا بني آدم؟ انت تافه فعلاً .. أنا مش عارف باحكي لك كل دا ليه!”
اهتزَّ الخرطومُ في يده وهو يضحكُ في خبثٍ وزهور النرجس تهتزُّ حين يصطدمُ بها الماء، ثم قال بين ضحكاته:
-“أنا آسف. ماتزعلش بجد. دانا كنت باهزّر معاك يا اهبل. كمّل الحكاية. إيه اللي حصل لـ(قطّة)؟”
ضربتٌ كفًّا بكفٍّ مفتعلاً الاندهاشَ من حماقته واستأنفتُ الحَكي:
-“(قطة) كانت مدللة بين اخواتها، كانت أصغرهم وأجملهم، وكانت لها علاقات بشباب الحيّ ماتتعدّاش اللهو البريء يعني، لكن أبوها وامّها كانوا بيزَعقوا لها ويمكن يضربوها لما يشوفوها مع حد م الولاد. المهم ان أمّها شافتها في بير السلم ف يوم بتهزّر بالإيدين مع شابّ من الجيران، فنادت لها وقعدت تزعق لها وتشتمها وهددتها بغضب ابوها لحد ما البنت بدأت تعيّط عياط مُرّ، ودخلت أوضتها وقفلت على نفسها الباب بالمفتاح. كان صوت عياطها مسموع طول الليل لامّها واخواتها اللي حاولوا يخبّطوا عليها عشان يهدّوها، وهيّ أبدًا، لحد ما الصوت هِدِي تمامًا على نُصّ الليل كده، وكانوا كلهم ناموا أصلاً. الصبح، امّها قعدت تخبّط ع الباب وتسترضيها بالكلام عشان تفتح وتقوم تفطر، بس لا حياةَ لمن تنادي، ماحدّش بيرُد. ماكانش فيه غير ان ابوها يكسر الباب”.
كان (هيثم) قد أتمَّ ما بدأه من الري وذهب ليغلق الصنبور، وحين وصلتُ إلى هذه النقطة التفتَ إليَّ، والارتباكُ بادٍ على ملامحه:
-“هاه. وطبعًا لقاها هربت من الشّباك وسابت لهم رسالة تقطّع القلب”.
لم يكن الردُّ سهلاً أبدًا، فقد عاودت قلبي تلك القبضة الباردةُ التي تعتصره كلما وصلتُ إلى نهاية الحكاية، وعاودت حلقي الغُصَّةُ الصديقة، وأحسستُ بذات الرِّعدة تسري في أطرافي، لكنني أجبتُهُ في النهاية بما أعرفه من الحكاية:
-“ماحدّش عارف إيه اللي حصل لـ(قطة) بالظبط. ماكانش في أوضتها شباك، بس همّا مالقيوهاش ف أوضتها، ولقيوا مكانها… لِقيوا قطة ف سريرها المرتَّب نايمة، بصّت لهم لما فتحوا الباب فجأة، ونونوِت مرة، وبعدين سكتت”.
كانت أماراتُ عدم التصديق باديةً على وجه (هيثم) الذي تسمَّرَ في مكانه في منتصف المسافة بيني وبين مربع النرجس. أحسستُ بوطأة اللحظة ثقيلةً على كِلَينا، فقفزتُ الأمتارَ التي تفصلني عنه وقبضتُ على ساعده الأيسر كما فعل معي، متصنِّعًا المرح وأنا أسأله:
-“قل لي يا أغلس خلق الله. انت ليه روّيت النرجس بالذات؟! وبعدين احنا ليه هنا أصلاً؟! ف أي وقت ممكن اصحاب البيت دا يظهروا وساعتها مش حيحصل طيّب”
ضحك في خبثه المعتاد ونحن خارجان من البوابة، ثم استدار ليغلقَ البوابةَ ووضع في رزَّتِها قُفلاً أخرجه من جيبه.
-“إيه دا؟! انت معاك قفل البوابة؟”
كنت مندهشًا إلى أقصى درجةٍ بينما هو يجيبني في برود:
-“دا بيت عمي يا اهبل .. هو مسافر اليومين دول، وقال لي ما اسيبش النرجس يدبل. أنا باجي اروّي الزرع هنا 4 مرات ف الأسبوع لحد ما يرجع. النرجس بالذات ما يتسابش من غير مَيّة”.
كنتُ مغتاظًا بشكلٍ يستحيلُ معه ألاّ يحتقنَ وجهي وألا تمتدَّ يُمنايَ لتلكزَ (هيثم) في خاصرته. التوى في رشاقةٍ متفاديًا لكزتي وضغط كتفي اليسرى في استرضاءٍ خبيث. أخذنا طريقَنا متجهَين إلى منزله في آخر الشارع. كنتُ أشعرُ بالإهانة لاستخفافِهِ بي على هذا النحو.
شرع هو يتكلمُ في أخبار نتائج زملائنا في الامتحانات، وكانت لهجته تقطُرُ ذلك الخُبثَ الذي لا أدركُ منبعه لكني لا أخطئُهُ أبدا، وكنتُ صامتًا فيما تبقى من الطريق حتى أوصلتُهُ إلى باب العمارة التي يسكن طابقَها الثاني، فصافحَني بيُمناهُ في وُدٍّ، ثُمَّ أسرعَ صافعًا قفايَ بيُسراهُ، وانطلقَ إلى داخل العمارةِ وضحكتُهُ تلتهمُ صبري.
قفزتُ خطوةً واحدةً وراءه قائلاً:
ــ “امشي يابن الـ….”!
لم أستطع أن أتزحزحَ قيدَ أنمُلَةٍ من مكاني، فقد وقف قُبالَتي قِطٌّ كبيرٌ على عتبة باب العمارة، وظلَّ محدِّقًا فِيَّ بعينيه المُدوَّرَتين.
قبضةٌ، وغُصَّةٌ، ورِعدةٌ، وسمعتُ صوتَ نافذةٍ تُفتَحُ بالطابَقِ الثاني. نظرتُ، فإذا (هيثم) مُطِلٌّ ضاحكًا. قال بصوته الغليظ:
ــ “انت لسة هنا يا ابو هبل؟!”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مجموعة “ما يحدث في هدوء” الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة 2021