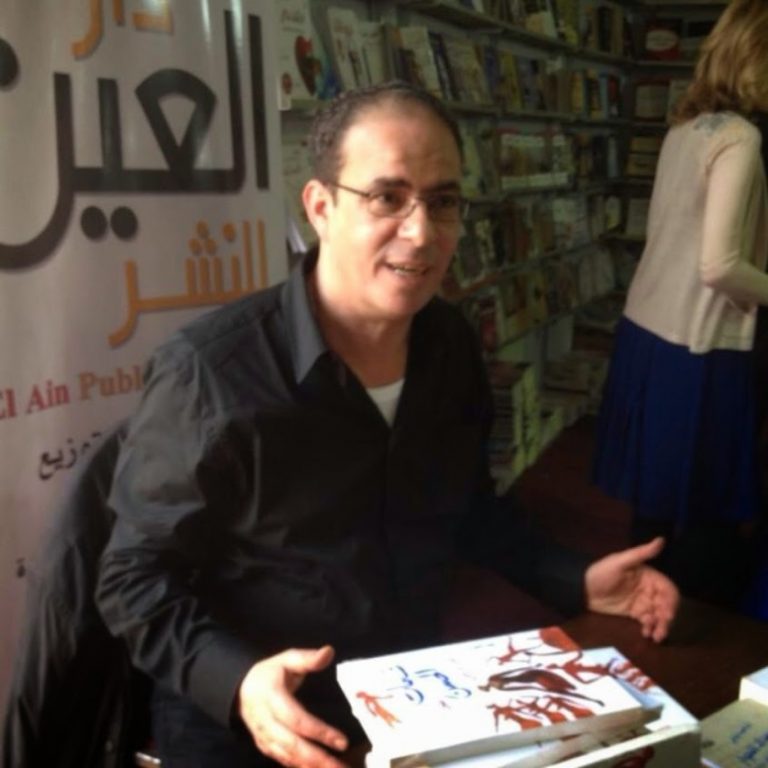حاورها: حسين عبد الرحيم
“أيّام الشمس المشرقة”… نصٌ جديدٌ للكاتبة ميرال الطحاوي، يصرخ بالكثير من رؤى التهشيم لمسميات الوطن والهجرة والترحال والعصف، في محاولاتٍ مستميتةٍ من أجل إخضاع كل هذه المسميات لماكينات السرد الرؤيوي الباحث عن جدوى الحياة.
نجحت الرواية في فضح زيف العيش والخروج الى جنانٍ موعودة عبر الهجرات المتعددة لعرب كان مصيرهم العصف والتشتت. تغوص “أيام الشمس المشرقة” في الكثير من جراح التلاقي مع الآخر بحضارته، ولتبقى العبودية والضياع والموت هم جدوى الخروج وحصاده.
ميرال الطحاوي كاتبة روائية وأكاديمية مصرية، تعمل أستاذة للأدب العربي في كلية اللغات العالمية والترجمة في جامعة أريزونا الاميركية، ومن أشهر رواياتها: “الخباء”،”الباذنجانة الزرقاء” (حازت جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 2002)، “نقرات الظباء”، “بروكلين هايتس” (ضمن القائمه القصيرة لجائزة البوكر العالمية سنه 2011 التي تمنحها الجامعة الاميركية في القاهرة، ترجمت رواياتها الى أكثر من عشرين لغة أجنبية حول العالم، ولها مجموعة قصصية عنوانها “ريم البرابري المستحيلة”. هنا حوار معها:
*في روايتك “أيام الشمس المشرقة”، ثمّة تداخل في آليات السرد والبناء وامتزاج ما بين اللغة الحسية/ البصرية مع فرادة البناء اللغوي، وكأنّه مزجٌ لا يعبِّر عن حدثٍ بقدر ما يعبّر عن رؤية وجودية لتفاصيل الإرتحال وتشظي الوجود… كيف تفسرين ذلك؟
لن أستطيع تفسير ذلك لكنّني سأعتبره شهادة جميلة منك تشرّفني وتفرح قلبي فأنت أيضًا من الأصوات الروائية التي أعتزّ بصداقتها وأعرف أنّ تجربتنا تستند إلى محاولة كتابة نصّ يوازي- ويوازن- بين النصّ الأدبي الحداثي مع الاحتفاظ بقواعد اللعبة الروائية الكلاسيكية، لا سيّما بعد طغيان البنى الكلاسيكية التي تعتمد على الحدوتة والدراما الموجهة ورواج الروايات البوليسية وروايات الرعب والجريمة، أي الروايات ذات الحبكة والغموض والأحداث المتلاحقة، التي يتمّ استهلاكها في شكل كبير.
لقد تغيّر المشهد الروائي تمامًا لأسباب عديدة، ويمكن أن أرصد- ككاتبة- النجاح المذهل لرواية “عمارة يعقوبيان” بعدما انخفض صوت جيل التسعينات الذي كان يغامر ويحاول خلق نصٍّ منعتق من البنية الكلاسيكية.
نجاح هذا النوع من الروايات التي بدأت تحتلّ لوائح أكثر المبيعات وحققت رواجًا كبيرًا عند القراء الشباب، أغرى الجميع بالعودة الى الحدوتة وهذا ليس عيبًا، لكنّ الحدوتة ليست الضلع الوحيد في المعمار الروائي. الرواية في نظري أكثر عمقًا وتعدّدًا من حدوتة، بل هي رؤية فلسفية للوجود، وهذا ما جعل كتابات نجيب محفوظ خالدة، لأنها تحمل رؤية وجودية لا تبلى.
نستطيع أن نسترجع “أفراح القبة” و”حديث الصباح والمساء”، ونعيد قراءتها واستلهامها لأنّها حبكة روائية عميقة وذات دلالة فلسفية. في روايتي وربما في أعمالي كلّها أحاول أن أخلق ذلك التوازن، أنني أكتب حكاية نعم الخباز وأحمد الوكيل وسليم النجّار وميمي دونج، لكنّهم مجرّد أبطال عابرين في تلك الأرض، إنّهم يمثلون تلك الشرائح التي تعيش صراعاتها في تلك البلدة التي تسمي الشمس المشرقة، ثمة تراجيديا، لكنّ الرواية لا تحتفل بالبنية التراجيدية. ثمة راوي عليم، لكنّه لا يعلم كل شيء. إنه ينقل فقط ما يدّعيه البشر عن أنفسهم، لذلك تأتي كل المرويات على سبيل الاحتمال وبعيدة بعدًا تامًا عن اليقين الذي عرف به هذا الراوي العليم.
*كيف كانت الدوافع لتلك التوليفة التى تفور وتنضح بتعدد الأصوات وحرفية استخدام المجاز؟ فمع العدم وظلامية الرؤية للبشر والأمكنة يتلمس القارئ أن ثمة قصدية في الطرح المجازي وكأنه نوع من الإحالة للواقع المعاش في الوجود وليس في الشمس المشرقة أو مكان الحدث فقط؟
لقد تركت مصر منذ نحو خمسة عشر عامًا، قضيت السنوات الخمس الأولى بحثًا عن وظيفة، أتنقل بين الولايات من نيويورك الي فرجينيا ومن فرجينيا الى واشنطن ثم نورث كارولينا، ثم حظيت باستقرار نسبي حين تمّ تثبيتي في وظيفة أستاذ مساعد للأدب الحديث في جامعة ولاية اريزونا. وهناك بدأت خبرتي في عالم الغرب الأميركي (الميد ويست) والبلدات الحدودية التي هي في الأساس مناطق للتهريب والدخول غير الشرعي للمهاجرين.
وصارت رؤية مناطق الاحتجاز وعربة الترحيلات حدثًا يوميًا يوازي رؤية مجموعات من المتسلّلين الذين يفترشون الأرصفة، لا يجمع بينهم سوى القلق وتلك الحقائب التي يحملونها فوق ظهورهم. مشهد عاملات النظافة وعاملات البيوت ممن يعرضن المساعدة أصبح مؤلمًا. كانت كل البلدات التي تجاور مدينتي تبدأ بكلمة شمس لأسباب متعلقة بالمناخ أو الجغرافية: (سن فالي)، (سن شاين )، (سن هيلز). وقد لا يجمع بين هذه البلدات سوى تلك الشمس المحرقة المسلطة على الرقاب بلطفٍ حينًا، و بقسوةٍ أحيانًا.
وحين بدأت في كتابة هذا النص اخترت هذا العنوان المؤقت لكنني لم أستطع الفكاك منه. سألت عددًا من الاصدقاء الذين قرأوا روايتي قبل النشر وكان معظمهم يقترح إضافة شيء له كأيام أو أوقات أو بلاد الشمس المشرقة. وضعت عناوين عدة للصديقة الناشرة فاطمة البودي ولكنها بعد مناقشات كان لها الرأي نفسه. ولمفارقة لم تكن فقط في العنوان وإنما تم توظيفها في عناوين الفصول والبلدات التي تغوي بأسمائها بالتلال والوديان والمزارع والجبال العالية، أي اليوتوبيا الأبدية. لكنها في النهاية تفقد معناها لأنها ربما تجسد نقيض تلك الحقيقة. إنها لا تمت للجنّة بصلة، إنها الجحيم الشمسي، جحيم الرأسمالية التي خلقت هذا التفاوت بين المنتجعات في قمم الجبال ومنخفضات البؤس الجغرافي والاجتماعي، تلك الجيوب العرقية التي لا يراها أحد
*مع تعدد الشخصيات النسائية وتعدد الأصوات الراوئية على وجه الدقة، مثل نعم الخباز وميمي وعلياء الدوري، تظهر نجوى كشاهدة على الاحداث… فمن هي إذًا أقرب الشخصيات لروح أو تطلعات الساردة/ الكاتبة؟
بطبيعة الحال، كنت أشعر بأنني قريبة من كل الشخصيات النسائية وربما كنت أقرب لشخصية “نجوى” مثلًا لأنني ابنة طبقة متوسطة كان لها أحلامها في الهروب والنجاة من الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لكنّ ذلك الهرب لم يؤمن لها حياة بديلة، كما لم يوفر لأمها وأبيها من قبل. لقد عشت تلك المشاعر الغاضبة وحاولت الخروج واستطعت أن أرصد تلك التناقضات بما في ذلك الخراب الروحي بين العالمين. عشت طويلا في الأروقة الجامعية في مصر وفي أميركا وتمنيت أن أكتب عن تلك الصراعات التي لا تنتهي، وعن الابتزاز وعن الفساد وعن الفقر وعن اللواتي استطعن تسلق الطبقة ونجحن في الوصول لأحلامهن الطبقية. لكنّ ذلك لم يمنع قربي من شخصيات أخرى مثل نعم الخباز وأم حنان وزينب، فأنا أيضًا تربيت في قرية وأعرف مرارة الريف وتطوراته، بل أستطيع أن أقول إن الشخصيات الذكورية أيضا كانت قريبة بشكل ما من خبراتي. لقد وجدت الكثير من صديقاتي يتحدثن معي عن أحمد الوكيل واحداهن قالت إنها تشعر بقرب شديد من شخصية أحمد الوكيل، الهارب دائمًا والمضطرب والباحث عن معنى لهذه الحياة.
*من يتتبع مسارك الكتابي، يشعر بشيء من خصوصية الإيقاع في اللغة والحكاية وحتى فيما يخص البنية البيولوجية والنفسية لأصوات المرأة الخافت/ الصارخ والمرئي/ المحجوب. فهل لعلاقتك العميقة بتدريس الآداب دورًا في تلك التقنية حيث المراهنة على متلقى الخارج قبل الداخل، أم أن ما يحدد الايقاع والشكل هي خريطة الحكاية وتقنياتها؟
بالطبع دراسة الأدب تجعل علاقتي بالنص علاقة مزدوجة، وعلاقتك بالكتابة علاقة شائكة، فأنت تعرف بالضبط أسرار تلك المهنة. ولكن رغم تدريس الكتابة الإبداعية ورغم قراءة كل ما يكتبه الكتّاب المشهورون عن تقنيات الكتابة وعوامل النجاح وحبكة الطبخة، لكنني مازلت أعتقد أن الكتابة تشبه خبرتك في الحياة، شخصيتك وتكوينك النفسي، قدراتك في قراءة الآخرين، وخبراتك في القراءة.
ورغم وضوح كل عناصر تلك التجربة الإبداعية، لكنها تظل متفردة. هناك تعبير في الأصالة. أن يحمل نصك جزءًا من تاريخك ولغتك وتطور قدراتك في الكتابة ويعكس تطور وعي الكاتب بعملية الكتابة، لذلك تصبح بعض التجارب متكررة، وبعضها محبوكة، ولكن ليس لها نكهة وبعضها بلا طعم.
أعجبني تحليل صديقي عزت القمحاوي لمفهوم الكتابة بأنها في النهاية مجرد طبخة، أحب أن أذكر نفسي بذلك، وأن أعرف أنه في الحقيقة ليست هناك نصوص عظيمة في المطلق ولكن هناك نصوص تثير الشهية وأخرى لا تستطيع اكمالها لأنها لا تتناسب مع ذوقك أو لا تنسجم مع اللحظة التي تعيشها.
*انطلاقُا من المكان كمتخيل وحقيقة… من أين يأتي كل هذا الحضور للذاكرة؟ ما هو الوقت المنقضي في التحضير لرواية ” أيام الشمس المشرقة”، وكيف استلهمت فكرتها؟
لا يبعث على الأحزان مثل العيش في المنفى. وكان الحكم بالنفي في العصور التي سبقت العصر الحديث عقوبة بالغة الشدة. فالنفي لا يقتصر معناه على قضاء سنوات هائمًا على وجهه بعيدًا عن أسرته وعن الديار التي ألفها، بل يعني إلى حد أن يصبح إلى الأبد محرومًا من الإحساس بأنه في وطنه”.
ربما لا ينطبق ذلك الحال الآن علي ظروف المنفى الاختياري في العصر الحديث، ذلك الخروج الذي سعي اليه الكثير من الكتاب العرب في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة كالحروب والنزوح القسري والتغيرات السياسية وغيرها. صحيح أن العالم أصبح أصغر، وأن وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح بتبادل التحيات ومتابعة الاحداث خففت قليلا من ثقل الغربة، ولكن بطريقة أو بأخرى انقسم العالم الواحد الى عالمين. جزء منك ذاكرتك وأصحابك وذكرياتك في مكان ما وجزء هناك في عالم آخر.
بالنسبة إليّ، لم أستطع ابدًا التخلص من الإحساس بأنني صرت أنتمي بشكل ما الى عالمين متناقضين، بخاصة وأن طفولتي ونصف عمري عشته كإبنة عرب، أي في ظل ثقافة قبلية شديدة التحفظ. ورغم التجربة فإن التحرر من كوابح العرف القبلي في الكتابة ظلت تلازمني.
في الشمس المشرقة تحررت نسبيًا من الخوف ورغم أنني حذفت الكثير من الجمل التي بدت لي غير لائقة، لكنني فعلت ذلك دون خوف، سمحت ليدي أن تكتب تلك الشخصيات التي لا تشبهني، وتلك الالفاظ التي كنت أسمعها ولم اجرؤ على استخدامها في الحياة. ثم تركت للراوي أن يتحرك داخل النص بلا حذر وبسخرية وفجاجة وعنف.
بدأت في كتابة هذه الرواية سنة ٢٠١٥، لكنني كنت أكتب ثم يطرأ ما يبعدني عن النص، انشغالات ومصاعب الحياة غير المتوقعة، الفقد والمرض والركض خلف مهام الحياة كأمّ وأستاذة جامعية، ثم في نهاية كل مرة أعود و وأواصل. وكان ذلك هو الهامش الوحيد الذي يعيدني للحياة ككاتبة مرة أخرى، إن ذلك ما أردت أن أكون وتمنيت أن أعيش له.
كانت الشخصيات تتحرك بماضيها وحاضرها حولي، تركض على أرصفة الشمس المشرقة طوال الوقت وكنت فقط أحاول أن استعيد لياقتي ككاتبة لأكتبها.
أما الفكرة فاستلهمتها من رحلتي الطويلة في التنقل بين الولايات الاميركية كأستاذة جامعية وبين كوني امرأه عربية أو من العالم الثالث. كنت اعرف بطبيعة الحال كيف مناطق المهاجرين وتجمعاتهم وحوانيتهم ومدارس أبنائهم، وكنت ابحث عن هذا العالم في تلك الرحلة، وتعرفت فيه على كثير من النماذج البشرية التي لا استطيع نسيانها.
*معظم شخصيات الرواية هم مطاردون ومنفيون ومسحوقون… فهل كان هناك قصدية بأنه لا أمل في هذه الحياة للتحرر من “العبودية”. ليتك تطرحين رؤيتك فيما يخص تلك الإشكالية الوجودية؟
أنا أعيش في بلد يعد أكبر مُستَقبِل للمهاجرين واللاجئين، وقارة تأسست على الهجرات وتعيش كل يوم أكبر حالات التسلل عبر حدودها، بل لا يمكن إحصاء عدد البشر الذين يموتون جوعًا وعطشاً على حدودها قبل أن يقضوا نحبهم في محاولة للعبور. وبما أنني أعيش في ولاية حدودية، أشاهد يوميًا القادمين الجدد وهم يتوسدون الأرصفة ويبحثون بلا كلل عن بقعة تظللهم من قسوة الشمس، تجت الجسور وفي الحدائق العامة وبين مخلفات البيوت. إن قضايا الهجرة والهجرة غير الشرعية وقوارب الموت قضايا يومية في تلك البلاد.
………….
عن النهار العربي