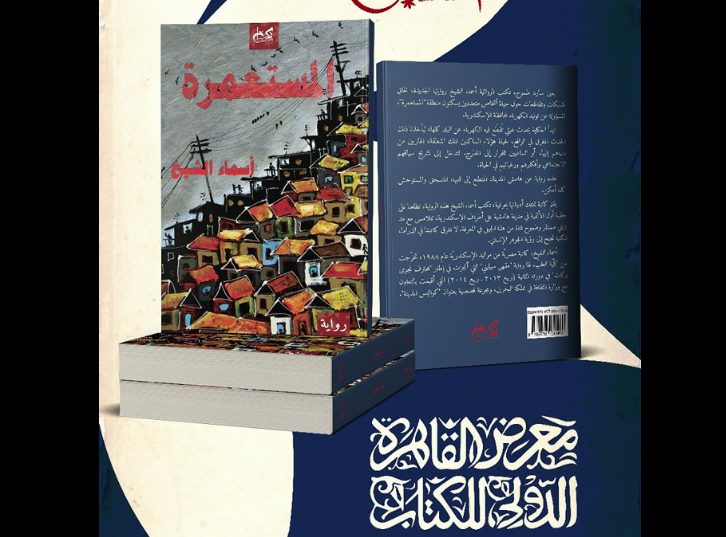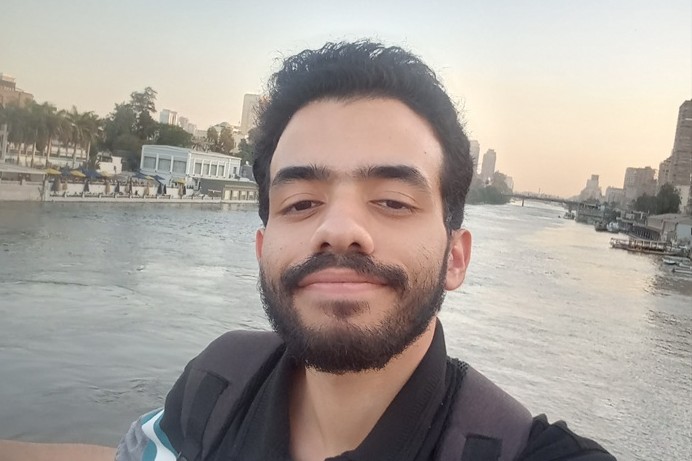هكذا أسمى المبنى الأنيق، القديم الذى نجا من القصف المتبادل خلال الحرب العالمية الثانية، لم أطلق عليه قط الاسم المعروف به، أى معهد الدراسات المتقدمة، حتى الآن لم أعرف بالضبط نوعية ما يدرس به، وأين أماكن الدراسة، بل.. أين الدارسون؟ صحيح أننى أقابل فى غرفة الإنترنت، فى الطابق السفلى، أستاذا فارسيا، وعجوزا، برازيليا تصحبه زوجته التى تقاربه سنا وترعاه أيضا مقعد، نتبادل التحية، عليه سمت العلماء المنغمسين، لكن لم نتجاوز الإيماءات، كذلك الفارسى الذى يتصادف وجوده أحيانا إلى
عندما أقصد الغرفة التى صفت بها الحواسيب الآلية وآلات اتصال مختلفة، من هاتف وفاكس وأخرى لم أتحقق منها، بل لم أتعرف عليها، كنا نتبادل بعض الألفاظ العربية ثم يستغرق كل منا فى التطلع إلى الشاشة المضيئة، كنت واثقا أنه يتحدث العربية يتقنها، خاصة بعد أن قابلنى من مدة ناطقا بيتا من الشعر.
إن بيتا أنت ساكنه لا يحتاج إلى سرج
لماذا أنشده؟ لماذا فى تلك اللحظة عند دخوله وخروجه؟ لماذا توجه إلى بالنطق؟ حتى الآن لا أعرف سببا، ابتسمت مجاملا، وصباح اليوم التالى وجدته محدقا إلى الشاشة، وعندما سألته عن بيت الشعر الجميل الذى سمعته منه أمس، أجابنى بالفارسية وكأنه لم يفهم ما قلت، عندئذ توجهت إلى الحاسوب ولم أنطق إلا رد التحية عندما غادر قبلى.
بعد عشرين يوما من وصولى بطلب المدير مقابلتى، ما تبقى نصف المدة، بعد ثلاثة أسابيع تقريبا أدخل، لم يتحدد اليوم على وجه الدقة، السكرتيرة أخبرتنى أنها ستبلغنى بتأكيد الحجز، سيتم الأمر كما طلبت، العودة مباشرة ودون محطة فى المنتصف، الخط موجود على الشركة الوطنية المصرية، ثلاث رحلات على مدار الأسبوع، بالطبع يمكن السفر فى أى دقيقة إن شاء، الرحلات متاحة عن طرق مختلفة، لكننى طلبت المباشر، وسيتم تحقيق ذلك، الحقيقة أن كل ما رغبته استجابوا له بدقة، لكن الشىء الوحيد الذى لم أعرفه، الهدف من قدومى إلى هنا، من تلك الدعوة التى تعتبر طويلة نسبيا بين ما تلقيت منذ شيوع أمرى فى ترميم المخطوطات القديمة، خاصة المصنوعة أوراقها من الكتان أو البردى، لكن..لماذا؟ أتعجب والأمر كله غامض منذ أن تلقيت الدعوة، منذ بدء الترتيب، تلك الليلة فى الفندق المطل على النيل، واللقاء مع الملحق فى السفارة، كلما لاقيت مثيرا للغوامض، للتساؤلات، لماذا جئت إذن؟ لكم نطقت تلك الجملة وأنا أتطلع إلى سقف الحجرة المستطيلة، والنافذة العريضة المطلة على الحديقة غزيرة النبات والأشجار، وأسطح القصور المجاورة والتى لا ألمح إلا أجزاء منها عبر الغصون والأوراق، إنها منطقة أثرى الأثرياء أصحاب القصر الأصليون باعوه بثمن بخس وهاجروا إلى الشاطىء الآخر من المحيط إلى الولايات المتحدة، لم أعرف السبب من السكرتيرة التى لم أتبادل معها إلا جملا محدودة، قصيرة، عند قدومى وخلال أيام إقامتى، المؤكد أن ذلك جرى قبل الحرب، رغم اهتمامى بالأماكن التى أقيم بها ولو لفترة قصيرة، فإننى لم أكن راغبا فى معرفة جميع التفاصيل حول أصل البناية ومن تعاقب عليها، ومن أدخل عليها تلك التعديلات التى حولتها إلى معهد داخله مكاتب وقاعة للمحاضرات ومطعم فى الطابق الذى يقع تحت مستوى الأرض، به موائد معدة، وجبات على منضدة معدنية، تحتها ثلاجة للمشروبات، وصوان لأنواع مختلفة من المخبز، وأخذ يضم زجاجات القهوة والشاى والنعناع ومشروبات أخرى لم أعرفها، كان الإفطار جاهزا باستمرار، كنت أعرف عدد المقيمين من الأطباق المتراصة والطعام الذى تحويه، تختلف الأعداد عند الغذاء والعشاء، غير أننى لم ألتق بواحد منهم قط، كذلك من بعد الطعام رغم أن الخضار والمرق واللحم كان باستمرار ساخنا فى الأوعية المستطيلة التى أغرف منها وأختار.
عندما وصلت بصحبة من انتظرنى فى المطار، تقدمنى إلى مكتبة السكرتيرة، طويلة، غير أن خللا فى معمارها، كتفاها العريضتان، أردافها المسطحة الخلو من أى استدارة، أما ما نفرنى من أى محاولة للتقرب فرائحة حادة منبعثة من تحت أبطيها فى الأغلب وليست عرقا، لكنها حمضية حادة، لكل جسد رائحته، والرائحة تحدد المسارات عندى، قبل صعودها بصحبتى إلى الطابق الثالث حيث أقيم، شرحت لى جميع ما يتصل، توقفت عند المفاتيح، خاصة ذلك المغناطيسى الذى يتم تقريبه من فتحة صغيرة فى الباب، عندئذ يمكن إدارة المقبض ودفع الباب هائل الحجم والوزن، لكنه يتحرك بيسر، كذلك مفتاحى الغرفة. عندما فرغت طلبت منها أن تضيف إلى الأرقام التى زودتنى بها، رقم أقرب مستشفى، ورقم الطوارئ الصحية التى يمكننى أن أستنجد بها، وشرح ما قد يدركنى بالإنجليزية، أعرف بعض المصريين هنا، لكننى لست حميما، قريبا إلى أحدهما بحيث يمكننى أن أوقظه ليلا لأطلب المعونة، طلبت خريطة للضاحية وأرقام الحافلات العامة التى يمكن أن تقلنى إلى وسط المدينة، الحق أنها أفاضت فى شرح ما يلزمنى، مكان الآن للغسيل، المطبخ فى نهاية الطابق إذا رغبت فى إعداد طعام يخصنى، غرفة التليفزيون والمكتبة الخاصة، وعندما قالت إن التدخين ممنوع، قلت إننى لا أسمح بالتدخين فى أى مكان أنزله أو أجلس به، أضفت مبتسما: ألم تلاحظى استفسارى عن مستشفى الطوارئ؟ إن أحوالى الصحية ليست على ما يرام، تلفت حولى، قلت إن كل ما أطلبه أجده فى الغرفة، خاصة جهاز الاستماع إلى الموسيقى، عدا شىء واحد أنا المسئول عنه، تطلعت مستفسرة، قلت إن الطابق الثالث مرتفع بالنسبة لى، لم أذكر أننى أجريت جراحة دقيقة بالقلب. قالت إن الأماكن الأخرى مشغولة للأسف، إنها الحجرة الرئيسية، المميزة، إذ تطلب مباشرة على الحديقة، بعد لحظة قالت: لا تقلق إن كل شىء محسوب، أومأت، أعرف هذا من الخطاب الأخير الموقع من المدير الذى سألتقى به أخيرا، أخطرتنى السكرتيرة ذات الصوت المحايد بالموعد، الواحدة بعد ظهر الغد.
عندما بدأت أسفارى، داخل مصر أو خارجها، كان أهم ما يشغلنى، الإناث، التعرف إلى إحداهن، التواصل معها، كنت بمجرد مفارقتى محل سكنى، خروجى من القاهرة أشعر بإقبال يولد، ونزوع إلى ما لا أقدر على تحديده، لكنه متصل بهن، متعلق بأمرهن، كنت مقبلا، متوثبا، بمجرد الخروج أبدا، حتى عند السفر إلى الصعيد، ظل ذلك متصلا بالترحال، إلى أن جرى ما جرى وتبدل ما تبدل، هأنذا أبدأ إقامتى بالاستفسار عن مصحة الطوارئ، بدلا من ملهى ليلى، أو مقهى يمكننى التعرف فيه إلى من أتعلق بها. هكذا جاد أمرى مع التقدم فى المسار، الوهن المصاحب، بل إننى أصغى متوقعا ولوج الأبدية ليلا، ما قبل النوم فى الغربة، الصادة، ربما منهم المصاحب لأنثاه، أو المستضيفة صديقها، لا أحد يتطلع إلى أحد هنا. ولا شروط للإقامة تحد من حدية النزيل، لكن من. وكيف التواصل مع من أجهل لغتهم، وبرنامجى يخلو من دخولى فى دوائرهم، التقاطع مع التفاصيل اليومية للآخرين، عند عودتى أتطلع إلى النوافذ المضاءة خلال الأشجار مدحية بالدفء، بالكنة والألفة، بالمجاورة، والمفاعلة، غير أن المبانى تلوح نائية جدا، تبدو الكواكب أقرب إذا ما تطلعت إليها فى السماء، بعدها منطقى، الأبعد ما يبدو فى المتناول ولكنه فى صميم الناى، عرفت مثل ذلك عندما أمضيت عاما فى الصعيد متنقلا بين مدنه الصغيرة، المنطوية على أمورها، الغلقة فى وجه الغريب، شرط بقائه الالتزام بكافة الشروط غير المرتبة، الخروج عنها يدفع الإنسان إلى الحافة، هنا كل شىء ممكن ومستحيل فى الوقت عينه، لماذا أثبت إذن؟، لماذا جئت؟ لماذا أضيع أياما من رصيد حاد محدود، أمرى عجيب!. بدأت التهيؤ للمواعيد، إنها المرة الأولى التى يطلب فيها أحد المسئولين رؤيتى، حتى من ينظف الغرفة ويرتبها يوميا. لا أعرف إن كان رجلا أم سيدة ــ يختار التوقيت الذى أفارق فيه، إما إلى الإنترنت، أو حجرة الغسيل. أو إلى مشوار أرتب له حتى أقنع نفسى أننى أقوم ــ بنشاط ما.
رغم إقامتى عشرين يوما، خلالها تفحصت الغرف والمكتبة، وصالات الاستقبال، غير أننى لم أتوقع قط أن هذا السلم يؤدى إلى الجزء الإدارى من القصر، طبعا أثار فضولى، ظننته يؤدى إلى حجرة أخرى، غير أننى ــ طبقا لوصف السكرتيرة ــ أعبر بابا صغيرا إلى شرفة داخلية مطلة على صالة فسيحة، قسم من المبنى لم أتعرف عليه، بل إننى لم أدرك وجوده حتى بالتخمين، تختلف ألوان الجدران، وسط بين الرمادية والبنى، لوحات أنيقة فى إطارات خشبية متساوية الأحجام، متشابهة التكوين، داخل بعضها رسائل أو صفحات مدون بها خطوط أشخاص قدامى، ربما مشاهير كتاب أو علماء. لم يتح لى الوقت للتفحص. يقف المدير أمام الباب المؤدى إلى مكتبه، لا أحد غيره رغم ثلاثة مكاتب متساوية على كل منها أوراق وملفات وكراسات متفاوتة الأحكام، ومصابيح إضاءة عتيقة الطراز.
يرتدى قميصا وبنطلونا رماديا، تتقدمه ابتسامة، يرحب بى باسطا يده إلى الداخل، أتقدمه إلى مقعد وثير فى ركن الغرفة، يواجهه مثله، يجلس إليه، تلك علامة إبداء الود، حميمة المقابلة.. تمنى أن تكون الإقامة مريحة. استفسر عن الوجبات، ثم قال إن بعض المشاهير أقاموا فى غرفتى، أحدهم عالم كيمياء أمريكى فاز بجائزة نوبل أثناء إقامته، بلغة الخبر من السكرتير.
شكرته على كل شىء، غير أننى أبديت ملاحظتى على خلو البرنامج من أى نشاط يخصنى.
يقول إن كل شىء كان واضحا خلال المراسلات مع المستشار الثقافى. قلت إن من قابلته كان الاقتصادى حتى إننى تعجبت.. أبدى أسفه، قا لإنه لم يعلم ذلك، هم لا يطلعوه على كل التفاصيل التى تجرى فى السفارات خلال الترتيبات التى تم لدعوة الباحثين.
قام ليتناول كتابا صغيرا من فوق الرف، سألنى عما إذا كان فى غرفتى نسخة منه، قلت أننى لم أره، قال إنه سيعطينى فكرة جيدة عن الذين أقاموا وما أنجزوه، أى تأثير مشاركتهم على أعمالهم التى تلذ ذلك، المعهد لا يوجد برنامج معين له، لكنه يوفر المناخ والمصادر والإمكانات لكل من يأتى بحيث ينعكس ذلك على اجتهاده وبحوثه، كدت أستفسر عن اسم المعهد وماذا تعنى الدراسات المتقدمة، لكننى لم أنطق، أطرقت محاولات استنتاج الغرض من المقابلة، مؤقتا أن ثمة شيئا آخر لم يفصح عنه، سألنى فجأة عما إذا زرت المتحف المصرى؟ رفعت إصبعين. مرتان، قلت إن الموجودة هنا خاصة وبها قطع نادرة.
قلت إن لدى خطة لزيارة كافة المتاحف، وترددت أكثر من مرة على المكتبة الوطنية، وعندما طلبت اطلاعى على بعض المخطوطات استجابوا بمجرد إبراز بطاقة المعهد.
بدا مسرورا، متوجها بنظرة إلى نقطة ما فى الأرض، متطلعا إلى بين جملة وأخرى، قال إن أى جهة، خاصة أو عامة ستقدم لى كافة ما أطلب، طبعا فى حدود القواعد المتبعة.
فجأة أتجه إلى مقطبا، كأن خاطرا طرا عليه فجأة.
أعرف أنك سافرت كثيرا..
أومأت. قال إن لديه اقتراحا يمكننى أن أفكر فيه، لقد بقى حوالى عشرين يوما، الآن نصف المدة انقضى والنصف الآخر متبقى، طبعا يمكن إنهاء الإقامة فى أى وقت أرغب، لكن إتمام المدة تترتب عليه فرص أخرى فى المستقبل، خلال الأيام التالية يقترح أن أخصص وقتا، فلنقل ساعتين أو ثلاثا يوميا، أدون فيها أى خاطرة أو واقعة مررت بها خلال ترحالى فى البلدان المختلفة.
قلت إننى لم أفكر قط فى كتابة أى شىء. لا مذكرات ولا خواطر. ولا يوميات، ربما لأننى أجد ما أرغب قوله مدونا بخطوط الأقدمين.
قام متجها إلى المكتب، فتح درجا تناول منه جهازا صغيرا فى حجم القلم الحبر، قال متسائلا: ومن طلب منك الكتابة؟ هذا الجهاز سيصفى إليك، كلما خطر لك أو تذكرت شيئا مل يمكنك أن تمليه عليه، هذا أحدث تسجيل رقمى، يستوعب ألفى ساعة متصلة، يمكنك الاحتفاظ به.
قلبته بين أصابعى، قرأت الإشارات المدونة عليه.
«استخدامه سهل»
«جدا..»
ثم قال مواصلا، إنه هدية شخصية منه إلى، لن يسأل ولن يستفسر ولن يلزمنى بأى شىء. لكن إذا تجمع شىء ورأيت إرساله إلى المعهد، سيتم إجراء الاتصالات لنشره.
أشار بإصبعه مؤكدا.
«إذا رغبت..»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفتر السابع من دفتر التدوين