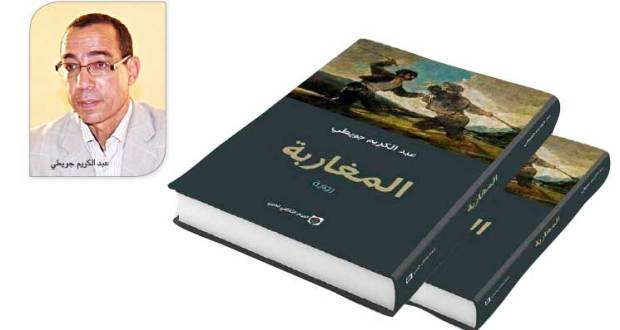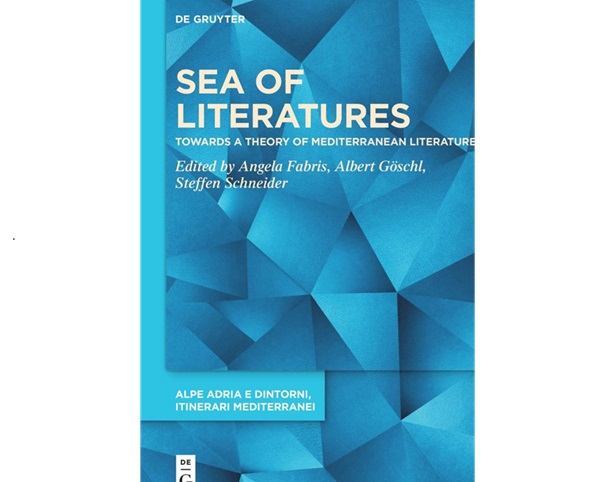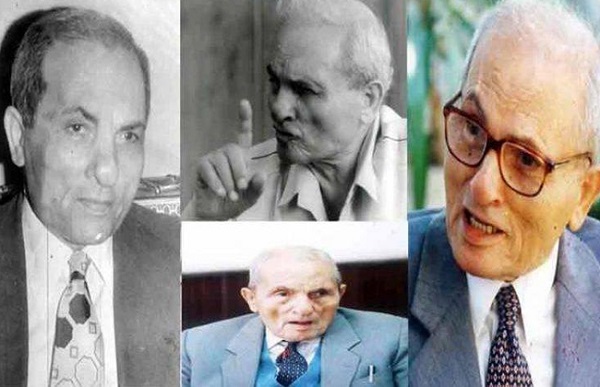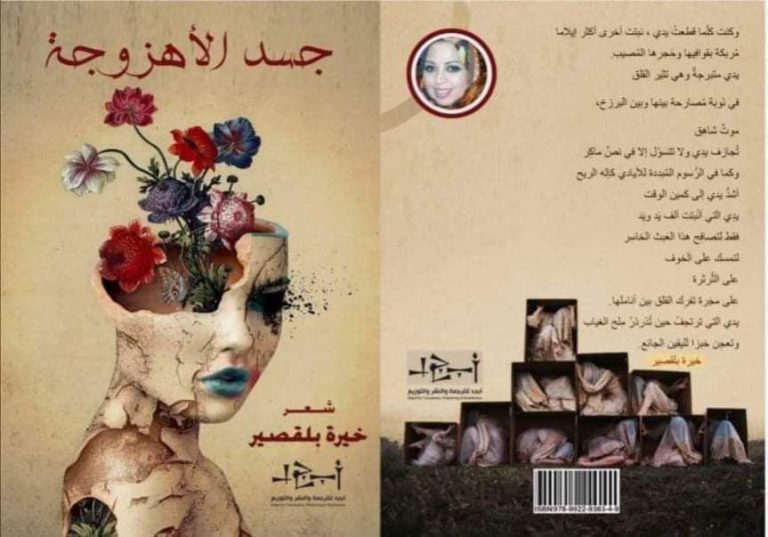نعيمة عبد الجواد
حياة الإنسان مفارقة كبرى، ومهما حاول البشر أو الفلاسفة سبر أغوارها، تكون النتيجة الحتمية هي الدخول في متاهات لا حصر ولا نهاية لها، وإذا كان أحدهم محظوظًا وتسنى له إيجاد مخرجًا، لسوف يجد نفسه يصل لنقطة البداية.
وفي غمار تلك الحلقات المفرغة والمفارقات التي تحيط حياتنا من كل جانب، كانت أفضل وسيلة لتعليم الأطفال كيفية التأقلم مع صعاب الحياة هي حكي الحواديت، والمفارقة الكبرى أن جميع تلك الحواديت المخصصة للأطقال، على اختلاف أنواعها والدول التي قيلت فيها، لا تخلو من عنصر الرعب “الشديد”، وكأن الكبار يعلِّمون الأطفال منذ نعومة أظافرهم أن الحياة ما هي إلَّا محنة كبيرى. وهذ الرعب الذي يصدم الأطفال ويكون معلِّمهم الأوَّل في باكورة مراحل عمرهم ، ينمو ويتكاثر عند الاصطدام بالحياة الواقعية، مما يخلق ثلاثة صنوف من البشر. أوَّلهم، هو ذاك الذي لا يزال يرتعد بداخله، فيلجأ طوال الوقت لمشاهدة أفلام الرعب، وكأنه يحاول البحث عن وسيلة للتعامل مع مصاعب الحياة بالطريقة التي تعوَّد عليها منذ الطفولة. والثاني هو ذاك الذي يدمن الأخطار والمصاعب ويشعر أن في كل خطر مغامرة ووسيلة تعليمية، وحتى ولو أسفر ركوب الأخطار عن إصابته أو حتى فقدانه لحياته، فتلك هي النتيجة المتوقعة لمجابهة الحياة.
لكن الصنف الثالث هو ذاك الأكثر تعقيدًا والذي يندرج تحته الغالبية العظمى من البشر. ويقع ذاك الصنف تحت فئتين أساسيتين، أولهما من يعيش على هامش الحياة ويحاول عدم الاشتباك معها قدر الإمكان، وثانيهما هو ذاك الذي يخوض التجارب الحياتية بصدق، ولا يكل من المحاولة أو الاجتهاد. بيد أنَّ كلاهما على إيمان عميق بأن الموت ينتظر الجميع في نهاية المطاف، مهما حاول الإنسان الهروب من تلك الحقيقة. وبما أن كلا الفئتين تعاني من مصاعب الحياة وتعيشها لأنها فرضت عليهما، نجدهما يعتقدان، غالبًا، أن في الموت راحة أبدية، وأن استكانة الأحوال في القبور، تنتظرهم عند الوصول لتلك النقطة. ولهذا يقول الكاتب الياباني “هاروكي موراكامي” Haruki Murakami : “الموت لا يعني نهاية الحياة، بل هو جزء أصيل منها.”
ولهذا السبب ينصح الحكماء أن نعيش حياتنا مهما كانت، دون الخوف من الموت، أو حتى انتظاره. ولقد نصح الفلاسفة الرواقيون الذي سيطر منهاجهم على الاتجاهات الفكرية السائدة في القرن الثالث الميلادي، أنه يجب يوميًا الاستفادة من الوجود على ظهر الأرض؛ لأنه لطالما لم نتواجد في الجنة أو النار بعد، فإن اليوم هو الوقت المناسب لإتقان فضائلنا وعيش الحياة على أكمل وجه، وفي غمار ذلك، يجب أيضًا أن نتأمل حياتنا الفانية، وهذا فقط لنذكِّر أنفسنا بأن الغد قد لا يأتي أبدًا.
ولغلق أبواب نقاش وجدال لا طائل منه في هذا الأمر، لخَّص الإمبراطور الروماني والفيلسوف الرواقي الشهير “ماركوس أوريليوس” Marcus Aurelius الأمر ببراعته المعهودة بأسلوب بسيط لا يمكن أن يختلف عليه أحد، قائلاً: “من الجائز أن تفارق الحياة الآن. ومن ثمَّ، دع تلك الفرضية تُحدد ما تفعله وتقوله وتفكر فيه”. وللتوضيح والتبسيط أكثر، أضاف “أوريليوس” مازحًا، “مات الإسكندر الأكبر وكذلك مات سائق بغله، كلاهما مرّ بنفس التجربة”. أي أن كليهما خاض تجربة الموت، لكن تم تخليد ذكرى “الإسكندر الأكبر” للأبد بسبب أعماله البطولية، بينما لا يعرف أي فرد من هو سائق بغله.
ولقد سبقه الفيلسوف اليوناني “أبيقور” Epicurus (341-270 ق.م.) في التوكيد على نفس المفهوم منذ ما يربو على الستة قرون، أي قبل الميلاد بثلاثة قرون، وبكل وضوح أكَّد للجميع أن للموت تعريف بسيط، وهو “توقُّف الإحساس”، ومن ثمَّ يضيف: “وبالتالي لا أهمية له ولا يعنينا، شكرًا جزيلًا.” وفي نفس السياق، صرَّح بأن “خوفنا من الموت هو العائق الوحيد أمامنا لعيش حياة مُرضية، وأننا مدينون لأنفسنا بالسعي وراء أكبر قدر ممكن من الإحساس”. مما يعني أن “أبيقور” كان أيضًا لا يعنيه الموت، فالأهم هو عمل الفرد طوال فترة الحياة الذي سوف يجعله يشعر بأن لا يزال على قيد الحياة، ونفس تلك الأعمال العظيمة هي التي سوف تخلِّد وجوده على ظهر الأرض، حتى ولو فنى الجسد.
لقد أجمع الفلاسفة والأديان على فكرة أنَّ الموت ممر لدخول حياة أخرى لا نعلم عنها شيئًا، ولكي لا تنتهي حياتنا على وجه الأرض، يجب وجود طريقة لنخلِّد بها ذكرانا. وفطن لتلك الحقيقة المكسيكيون، ولم يجعلوا من إحياء ذكرى الموتى يومًا للبكاء والعويل، بل كرنفالًا سنويًا يقام في اليومين الأول والثاني من شهر نوفمبر من كل عام. وخلال الاحتفال، يرقص ويغنِّي المشتركين بينما يرتدون ملابس نقش عليه هياكل عظمية أوموتى في طور التحلل. وفي ذاك اليوم أيضًا، يعود الأشخاص مقابر موتاهم ويكللونها بالزهور، ويقدّمون الطعام والحلوى لكل من يخالطونه أو يمرون به، وكأنهم يرسلون للموتى رسالة تجعلهم يطمئنون بأنهم لا يزالون أحياء على ظهر الأرض، ولم تنتهي ذكراهم.
وهذا التقليد الغريب الذي يتبعه المكسيكيون، لا يقل غرابة عن رواية “بيدرو بارامو”Pedro Páramo (1955) للكاتب المكسيكي “خوان رولفو” Juan Rulfo (1917-1986) التي سبر فيها أغوار عالم الموتى بمهارة تحضّ القارئ أن يحاول الاستفادة من فترة وجوده على ظهر الأرض بكل الوسائل. والرواية بعيدة كل البعد عن الوعظ الديني أو الاسقاطات الفلسفية، بل تصويرًا واقعيًا لعالم مثالي من وجهة نظر الكسول الذي يخشى لاشتباك مع معترك الحياة.
والرواية شديدة الاقناع والواقعية لأنها مكتوبة بلغة سهلة وأسلوب سلس، لكنها تنتمي لفئة الروايات ذات الأسلوب السهل الممتنع الذي يُقنع القارئ، وله القدرة على أن يؤثِّر بالإيجاب على أجيال من عظام الكتَّاب الذين خلَّدهم الزمان، بل أن أيضًا تلك الرواية عينها كانت البذرة التي نمى من بفضلها أجيال من عظام الكتّاب والمؤلفين في أمريكا اللاتينية. وعلى هذا، وصف الكاتب الأرجنيني “خورخي لويس بورخيس” Jorge Luis Borges (1899-1886) رواية “بيدرو بارامو”Pedro Páramo بأنها أعظم النصوص الأدبية على الإطلاق، مهما كانت لغتها.
وأمَّا الكاتب الكولومبي “جابريل جارسيا ماركيز” Gabriel García Márquez (1927-20214)، فلقد ذهب لأبعد من هذا عندما أكَّد أن رواية “بيدرو بارامو” كانت سببًا ودافعًا لكتابته أعظم أعماله على اإطلاق، وهي رواية “مائة عام من العُزلة” One Hundred Years of Solitude بعد أن كان يعاني من عدم القدرة على التأليف لمدة أربعة سنوات. بل أنه أيضًا يعترف أن السطور الافتتاحية لروايته قد اقتبسها من أسلوب “خوان رولفو” في رواية “بيدرو بارامو”. ولهذا يرى “ماركيز” أن جميع أعمال “خوان رولفو”، بالرغم من قلَّتها، خالدة وشديدة القيمة كأعمال الفيلسوف اليوناني “سفوكليس.”
وعنوان الرواية القصيرة التي لا تتعدى صفحاتها المائة والعشرين يشير إلى الدخول في عالم قفر مجهول من وجهة نظر الأحياء؛ فكلمة “بارامو” تعني أرض قفر. وبداية الرواية تدخل الرهبة في قلب القارئ الذي يشاطر “خوان بريثيادو” في رحلته إلى قرية “كومالا” كما وعد أمّه المتوفاه لكي يأخذ ميراثه من والده “بيدرو بارامو”، ذاك الرجل المهيمن الذي كان يسيطر على القرية بأكملها.
والقرية التي تقع في منطقة نائية، تمهد الطريق للعبور للعالم الآخر، فالذهاب إليها سهلًا كما هو الحال عند الانزلاق عبر منحدر، بينما الرجوع صعب وكأن الفرد يحاول الصعود على جبل لكي يصل للبوابة. والرواية يسيطر عليها الظلام والشعور بالضيق وكأن الفرد على وشك الدخول لعالم من الرعب، وهذا ما يحدث تمامًا. فالرواي عندما يصل للقرية يجدها قد استحالت لمدينة أشباح بعد ما كانت تعج بالحيوية والأحداث. وأمَّا والده، الرجل الأقوى في القرية، فلقد اقترف العديد من أعمال الظلم والقهر التي تقريبًا أبادت أهل القرية.
وتكون صدمة “خوان بريثيادو” في والده عظيمة لدرجة أنه لا يحتمل الوضع، وينتهي به الحال أن يموت هو نفسه من هول شناعات الوالد. وفي تلك اللحظة، يدخل “خوان بريثيادو”لعالم الموتى ويجدهم لا يزالون أحياء، وهنا تتعدد الأصوات، ويحل محل ضمير المفرد المتكلِّم ضمير المفرد الغائب. وأمَّا الأحداث، فهي تضاهي حياة الأشباح؛ فجميعها غير متسلسلة، وقد تأتي وتختفي، وعلى القارئ جمع المعلومات وتجميع القطع الناقصة. أمَّا الشيء الأكيد فهو أن الأشباح لا تزال تواصل نفس مسيرة حياتها على ظهر الأرض، ولا يزال الظلم والهوان يقتلع كل سعادة وإنجاز، والسبب هو الخوف من مجابهة “بيدرو بارامو” ووضع حدًا لظلمه.
وبعيدًا عن الاسقاطات السياسية للأحداث الدائرة في المكسيك في هذا الوقت حينما كانت تمزِّقها الحروب الدَّاخلية، فلقد اتفقت الرواية مع أراء الفلاسفة عن الموت، وشددت على أهمية الإنجاز. لكن الإسهام الأعظم ل”خوان رولفو” هو التوكيد على أن الموت ليس السبيل الأمثل للهروب من صعوبات الحياة، بل من الأحرى التمسُّك بالحياة ومجابهة كل المخاوف بشجاعة.
كانت العقيدة الشخصية للإمبراطور الفرنسي “نابوليون بونابرت” عن الحياة والموت هي السبيل لعظمته وخلوده، وأيضًا الدَّافع الذي مكنه من غزو العالم والسيطرة على مفاصله؛ فلقد كان يردد: “الموت لا قيمة له، لكن العيش في ظل الهزيمة والخزي بمثابة موتًا يوميًا.” فلا يوجد في الموت راحة، لكن الرَّاحة الحقيقية هي الإنجاز.