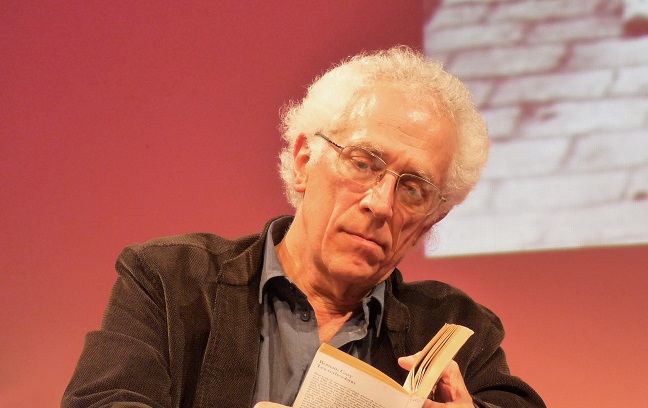حاروها : حسين بن حمزة
منذ مجموعتها القصصية الأولى “ضوء مهتز” (2001)، أبدت الكاتبة المصرية منصورة عز الدين نضجاً مبكراً، فخلت نصوصها من عثرات البواكير. قرأنا لها قصصاً مكتوبة وفق مخيلة تمزج الواقع بالحلم، وتتخلى عن الثرثرة الزائدة والسرد الوصفي لصالح قصة مكثفة ومتوترة يتحرك فيها أشخاص يعيشون لحظة زمنية ونفسية ووجودية. الأحلام والكوابيس والوقائع الغرائبية تسرّبت إلى روايتها الأولى “متاهة مريم” (2004) والثانية “وراء الفردوس” الصادرة حديثاً، وتحوّلت إلى جزء جوهري من نبرة الكتابة وحساسيتها، وإلى علامة شخصية داخل المشهد الروائي المصري الراهن.
في “وراء الفردوس”، تعود منصورة عز الدين إلى زمن طفولتها ومراهقتها، بدون أن يعني ذلك أنها تكتب سيرة ذاتية. الرواية تحفر في جانب من فترة السبعينات والثمانينات، وتعاين التقلبات التي عصفت بمصائر شخصيات عاشت أحلامها وانكساراتها.
مع منصورة عز الدين عن روايتها الجديدة وعن تجربتها الروائية عموماً، كان هذا الحوار:
* لنبدأ من مجموعتك القصصية الأولى “ضوء مهتز”. لماذا القصة وليس أي جنس أدبي آخر؟ ماذا عن المؤثرات والقراءات الأولى؟
– البداية الأولى كانت مع الشعر، عبر محاولات ساذجة وأنا فى المرحلة الإعدادية، وفى الجامعة كتبت قصائد نثرية لم أنشرها، ولم يقرأها إلا بعض الأصدقاء المقربين. أما القصة فبدأت كتابتها فى بداية المرحلة الجامعية، وكنت أيضا أرفض عرضها على أحد، كنت غير راضية عما أكتبه، لأننى كنت قارئة نهمة، وبالتالى كنت مدركة لسذاجة وبدائية ما أكتبه فى تلك المرحلة مقارنة بما أقرؤه من إبداع عالمى، لكن أحد زملائى فى كلية الإعلام وكان يكتب القصة أيضا صمم على قراءة قصصى فأعطيتها له، فقام بنسخها دون أن أعلم وقدمها فى مسابقة للقصة القصيرة فى الجامعة، وبعدها بمدة فوجئت بأننى فزت بالمركز الاول بالجائزة، وأن أعضاء لجنة التحكيم، وكانوا من الكتاب والصحفيين المعروفين، يبحثون عنى. كانت مفاجأة غريبة. شعرت ساعتها بالورطة، لكننى فرحت فيما بعد عندما فازت القصة نفسها بجائزة يحيى حقى التى كانت تمنح على مستوى جامعات مصر.
نشرت القصة فى أكثر من أربعة منابر مختلفة، وقرأ بعدها الروائى محمد البساطى قصصى وتحمس لها جدا، وقام بتعريفى على معظم كتاب جيل الستينيات باعتبارى موهبة جديدة يراهن عليها.
القصة كانت أكثر ملائمة لى وقتها، كانت أشبه بتمرينات على توسيع العالم والإمساك بتقنيات الكتابة وإجادتها، كنت متهيبة جدا من فكرة أن أكتب رواية، لأنها فى نظرى تحتاج إلى خبرة بالعالم ورؤية فلسفية وثقافة واسعة.
بالنسبة لقراءاتى الأولى، أتذكر أنى بدأت القراءة بنهم بمجرد معرفتى بالقراءة والكتابة، أى فى سن السادسة، بدأت بجريدة الأهرام، وتعرفت عبرها على أحمد بهاء الدين، لويس عوض، وتوفيق الحكيم فى سن مبكرة، وفى سن العاشرة وقع فى يدى كتاب “حول العالم فى 200 يوم” لأنيس منصور وبعده رواية لنجيب محفوظ قرأتها بنهم وشجعتنى على البحث عن باقى رواياته، إلا أن نقطة التحول فى قراءاتى حدثت وأنا فى الثالثة عشرة من عمرى حين قرأت بالصدفة ملفا عن الفيلسوف الفرنسى ألبير كامى منشورا فى إحدى المجلات، اتذكر أنى انبهرت بشخصيته وأفكاره، وجدته يطرح أسئلة خاصة بالموت والحياة والوجود كنت أطرحها على نفسى دون أن أفهمها كلية. من هنا تعرفت على الفلسفة الوجودية فى سن صغيرة وبدأت فى قراءات تفوق سنى بمراحل، وهو ما اختصر على الطريق كثيرا.
* روايتك الجديدة “وراء الفردوس” ترصد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقود الثلاثة الأخيرة في مصر. هل هناك مطابقة مستهدفة بين كونك مواطنة عاشت هذه الحقبة ورؤيتك ككاتبة للخلاصات والمصائر التي انتهت إليها؟ وهل الماضي بهذا المعنى هو دائماً فردوسنا الذي فقدناه؟
– عشت نصف هذه المدة كطفلة وصبية، وقتها لم أكن أفهم علاقة تلك الحقبة بما قبلها ولا تأثيرها على ما بعدها.. المعاصرة تفرض حجابا على الواقع، حين بدأت الكتابة عن حقبة الثمانينيات وبداية التسعينيات اكتشفت أنى عشتها كالمنومة، صحيح أن ذاكرتى خزنت الكثير من ملامحها، إلا أنى لم أفهمها بشكل أوضح إلا حين كبرت. الرواية ليست نقلا للواقع، هى محاولة لتفكيكه وإعادة تركيبه مرة أخرى. الواقع الاجتماعى والاقتصادى فيها هو تكئة لطرح أسئلة وجودية تخص الإنسان فى أى مكان. هى أيضا ليست سيرة شخصية، إنما يمكن اعتبارها سيرة عالم ومناخ، وإن بشكل يعمد إلى المحو والإبدال وطمس الآثار لأغراض فنية بالأساس، حيث حاولت فيها طرح العلاقة بين الفن وأصله الواقعى من خلال الرواية التى تكتبها سلمى داخل الرواية.
بالنسبة للشق الثانى فى سؤالك، فالرواية أبعد ما تكون عن رؤية الماضى كفردوسى مفقود أو الحنين له. على العكس من ذلك ثمة رغبة مستحيلة لدى البطلة فى القطيعة معه، والتمرد على موروثه. الماضى هنا يحمل بذرة الإنهيار والسقوط، كما أنه سبب أساسى من أسباب عطب الحاضر. أنا ككاتبة ضد الحنين لعصر مضى، فى رأيىّ أن الإيمان بوجود عهد ذهبى فى الماضى هو نوع من الرومانسية التى تقارب حد السذاجة.
* يُلاحظ القارئ وجود انضباط أسلوبي صارم في كتابة شخصيات الرواية والعلاقات المتشابكة بينها. هل تكتبين وفق مخطط عام مسبق أم تتركين الفرصة للارتجال والتغيرات المفاجئة أثناء الكتابة؟
– حين أكتب ألجأ للأمرين معاً، بمعنى أننى أجهز مايشبه المخطط العام لكل شخصية: صفاتها الشخصية، مواصفاتها الشكلية، كل ما يخصها تقريبا. ثم أبدأ الكتابة دون أن يكون لدى خطة عامة للعمل ككل، وحين أقطع شوطا فى الكتابة قد تقودنى عملية الكتابة نفسها لتغيير
خططى، بل وتغيير وجهة العمل نفسه، ساعتها قد أعيد الكتابة من جديد، أو أعدّل فيها وفقا لما وصلت إليه. ودائما ما يكون لدى عدد من الاحتمالات وكل منها قد يقود لرواية مختلفة. أى أن عملية الكتابة تكون خاضعة للتجريب والتبديل طوال الوقت. وبعد أن أكتب معظم العمل، أتركه بعض الوقت، ثم أعود إليه للعمل على البناء الذى يأتى عندى كآخر مراحل الكتابة، فى هذه المرحلة قد أحذف الكثير وقد أغير من سمات الشخصيات أو علاقاتها ببعضها البعض. واعتقد أن اشتغالى على بنية العمل كآخر مرحلة من مراحل كتابته هو ما يعطى الانطباع بالانضباط الأسلوبى الذى أشرت إليه.
* هناك تكرار لتقنية الأحلام والكوابيس في تجربتك. هل هي محاولة لتكريس هوية محلية وعربية للرواية التي تكتبينها أم أنها جزء من حساسية السرد الذي تفضلينه؟ ألا تخشين من تحول التكرار إلى عبء على الرواية؟
– الأحلام والأجواء الغرائبية بدأت منذ القصة الأولى التى كتبتها، خرج الأمر فطريا. من المؤكد أن له علاقة بتململى من الواقعية الصرفة التى كانت مسيطرة على الأدب المصرى إلا قليلا، غير أن هذا ليس كل شىء. يخيل لى أن الأمر له علاقة برؤيتى للواقع، ترى عيناى العالم من حولها على هذا النحو.. أبسط أمر واقعى يتطور فى ذهنى لخيالات غريبة وأحيانا مخيفة. فيما بعد ومع تزايد خبرتى نسبيا فى الكتابة بدأت أحفر فى هذا العالم، وأقرأ فى هذه المنطقة، أقرأ كثيرا عن الأحلام وتفسيراتها فى الثقافات المختلفة، كما أهتم بالميتافيزيقا والأساطير، أى أن المسألة بدأت تكون أكثر تعمقا.
قبل “وراء الفردوس” كانت الكتابة عندى تكاد تكون غرائبية بالكامل، وأثناء كتابة الرواية كنت أشعر أننى أكتب أحيانا فى منطقة بعيدة عنى، اختلفت منابع الغرائبية كثيرا، بعد أن كانت تنبع من هلاوس اللاوعى والإيهام بالجنون، والشك ما إذا كانت حقيقة أم حلم. أصبحت فى وراء الفردوس نابعة من الأسطورى والتراث الشعبى وحكايات الجان والأشباح، توقفت كثيرا لاحساسى بأن ما أكتبه بعيد عن تصورى للكتابة، بعد تفكير واعادة قراءة المخطوط أكثر من مرة أدركت أن المكان هو الذى يفرض الغرائبية الخاصة به. فيما يخص البحث عن هوية محلية وعربية، فالواقع أنى لم أنشغل بهذه المسألة كثيرا، الكاتب من وجهة نظرى بلا جنسية ولا وطن وكذلك الأدب، هو كإنسان يملك التراث العالمى كله.
التكرار هو الفزاعة التى تهدد كل من يكتبون، لكن من ناحية أخرى، الوعى والتعامل مع الكتابة بجدية قد يحميان الكاتب منها، أنا مشغولة بأسئلة أساسية كما يفترض بكل كاتب، قد أعيد طرحها لكن التناول يختلف من مرة لأخرى، لا أحب الكاتب الحرفى غير المهموم بأسئلة فنية ووجودية، محاولة فهم الوجود الإنسانى المحكوم بالفناء، والنفس البشرية الملغزة هما شرط الكتابة الجيدة من وجهة نظرى.
* لماذا تعاني شخصياتك دائماً من تمزقات وجودية؟
– الكتابة من وجهة نظرى هى رحلة فى المجهول، هى محاولة لفهم الوجود الإنسانى، والنفس البشرية. منذ طفولتى تشغلنى أسئلة عن المغزى وراء وجودنا، طالما أنه محكوم بالفناء فى النهاية. هذه الأسئلة تنتقل إلى شخصياتى على اختلافها وتنوعها.. الفن يكمن فى المخفى والخفى، فى المناطق الضبابية بين الضوء والظلمة. والشخصيات الأكثر تأثيرا على كقارئة هى المحكومة بضعفها وخيباتها. ثم ألسنا جميعا – على اختلاف ثقافتنا ووعينا- هذه الشخصيات الممزقة وجوديا حتى لو لم ندرك ذلك.
* المرأة هي البطلة الرئيسية في “متاهة مريم” وفي “وراء الفردوس”، ولكنك لا تهملين الشخصيات الذكورية. هل تهمك مسألة ألا تُقرأي ككاتبة نسوية؟
– هى مصادفة بحتة أن تكون المرأة هى البطلة الرئيسية فى متاهة مريم ، و “وراء الفردوس”. أنا لا أحب التقسيمات فيما يخص الأدب، وككاتبة لا اعتبر نفسى كاتبة نسوية على الإطلاق، رغم احترامى للتيارات الجديدة فى الحركة النسوية كحركة فكرية. الكاتب الجيد من وجهة نظرى هو الذى ينظر للعالم بعين إندروجينية تحمل الذكورة والأنوثة فى الوقت نفسه. أربأ بالإبداع عن أن يكون بوقا أو ناطقا رسميا باسم جنس أو دين، أو عرق، أو قبيلة أو حتى وطن بعينه. أحيانا يأخذنى الشطط للتفكير فى أن الروائى ليس من حقه حتى أن تعبر أعماله عن رأيه وحده. الرواية من وجهة نظرى هى عالمٌ موازٍ للعالم الذى نعيش فيه، تحتمل الآراء والرؤى المتصارعة، والأصوات المتعددة المتناقضة.
لذا حين أكتب دائما ما أضع أفكارى موضع المساءلة، أخونها أحيانا، وأتمرد عليها فى أحيان أخرى وفق منطق الشخصية التى أكتبها. أحيانا أقرأ أعمالا كل شخصياتها تقريبا تنطق بالأفكار نفسها وتتصرف وفق المنطق نفسه الذى هو فى الغالب منطق الكاتب نفسه. بعض الكاتبات يتصرفن كأنهن محاميات موكلات للدفاع عن المرأة ضد الرجل، وفى سبيل هذا يضحين بالقيم الجمالية والفنية فى العمل لصالح الأفكار التى يردن تمريرها. وبعضهن يرسمن الشخصيات النسائية بمهارة، فى حين تخرج الشخصيات الذكورية فى أعمالهن باهتة، وهو أمر أحاول تلافيه فى أعمالى، من هنا يأتى اهتمامى بالشخصيات النسائية والذكورية بالقدر نفسه.
* هل تحسين أنك تنتمين إلى جيل زمني وإبداعي معين؟ ما هي خصوصية هذا الجيل واقتراحاته؟
– لا أؤمن بفكرة الأجيال، والتقسيمات الصارمة التى تتم وفقها، هناك سمات عامة قد تجمع بين عدة كتاب ينتمون للفترة الزمنية نفسها، لكن التقسيم الجيلى المتعسف الذى يمارس فى مصر لا أوافق عليه. قد يجمعنى بكاتب تواجد قبلى بقرون أو عقود أكثر مما يجمعنى بآخر من سنى نفسه. يُخيّل لى أحيانا أن من يكثرون الكلام عن الجيل هم الباحثون عن غطاء للاحتماء به، أو قطيع يسيرون فى ظله. ألاحظ ميلا لوضع الجميع فى سلة واحدة كأنهم يكتبون نصا واحدا، وهو ما أرفضه. البعض يعيد طرح الأفكار نفسها حول الكتابة منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يكلف نفسه عناء مساءلتها أو التوقف عندها.
* كثر الحديث مؤخراً عن المغايرة والتجديد في الرواية العربية. ما رأيك في ذلك؟ هل صار محفوظ وجيل الستينات وراءنا أم أن هناك مبالغة من قبل الأصوات الجديدة؟
– التجديد والمغايرة هما طموح كل كاتب، إلا أنه الطموح الأصعب، فكما يقولون لا توجد فكرة عذراء، كل الأفكار تم طرحها، التجديد يكون عادة فى كيفية طرح فكرة ما ومقاربتها، غير أنه حتى وفق هذه النظرة فالمسألة نسبية. رواية كـ “دون كيخوته” مثلا تتجاوز من ناحية الجدة والأصالة معا معظم الأعمال التى تلتها. البعض يرى أن كونه يعيش فى الزمن الحالى يعنى بالضرورة أن كتابته أفضل من الكتاب القدامى، غير أن التجديد لا علاقة له بسن الكاتب أو العصر الذى يعيش فيه، هناك كتاب شباب أعادوا الكتابة أعواما بالسلب إلى الخلف، وهناك كتاب قدامى أكثر جدة ومغايرة.
فيما يخص نجيب محفوظ وجيل الستينيات أرفض الكلام عن أى كاتب ككل بما فى ذلك محفوظ، أى كاتب مهما كانت شهرته لديه أعمال جيدة وأخرى دون المستوى، من هنا أفضل الحديث عن روايات بعينها.