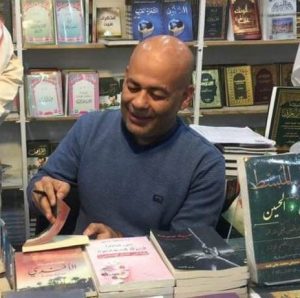حسني حسن
(1)
أدخلوه، من دون كلام، إلى الحجرة التي يجلس فيها الشيخ. كان جو المكان، كله، مشحوناً بصمت ثقيل الوطأة، فمنذ أن اجتاز عتبة الدار، أو فلنقل الفيلا كما يحلو لأهلها تسميتها، لم يسمع أحداً ينطق بكلام، وحين امتدت يده لترن جرس الباب، سمع رنينه، الخافت المكتوم، يخرج إلى باحة السلم، المغمورة بالظلال وبالغرابة، من طبقة الباس لأورغون كنسي عتيق. ولأنه، وكما يقولون عنه، ولد حساس قوي الملاحظة، لم يفته، بطبيعة الحال، تسجيل تلك المفارقة العجيبة التي صدمته قليلا؛ أن يكون صوت جرس باب دار خليفة المسجد الأحمدي الكبير لا يشبه إلا صليل الأجراس، المكتومة من طبقة الباس، لأبراج كنيسة مار جرجس، الشهيرة، بالمدينة التي يتربع الشيخ، بالميلاد وبالتسلسل الوراثي، على كرسي راعيها الديني والروحي الأكبر. ابتلع ملاحظته الأولية تلك، وتقدم والجاً الغرفة، الواسعة نصف المضاءة، إلى حيث يتكئ الشيخ فوق أريكة وثيرة بعمق المكان. جاهد كي يحافظ على ثباته وشجاعته، بحيث لا تصدر عنه أية إشارات تنم عن الضعف أو الخشية قد يستغلها العجوز ضده خلال جلستهما الأولى، وربما الأخيرة، معاً. وقف بمواجهة الرجل، ضامر الجسد، مشذب اللحية، منطفئ النظرات، بانتظار أن يدعوه للجلوس قبالته. راح يحدث نفسه بأنه ليس لديه ما يدعوه للخوف منه، ولا للضعف في حضرته التي بدت، وبالرغم من كل شئ ظل يفكر فيه طيلة الأسابيع الأخيرة، طيلة سنوات عمره التي لما تشارف العشرين بالكاد، مرهوبة ومربكة، لسبب أو لآخر.
– جئت للتفاوض، لا لتوقيع وثيقة الاستسلام. جئت للبيع، أمَا هو فينتظرني كي يشتري مني.
وكان يعرف في أعماقه، وبينما أخذ يطامن أعماقه، أن ما يهمس به لقلبه ليس الحقيقة، أو فلنقل إنه، على الأقل، ليس كل الحقيقة، بل جانباً واحداً منها، الجانب الذي تصطنعه الذات لذاتها كي تغدو، ربما، قادرة على مواصلة العيش، مواصلة استجلاء ممكنات العيش. نعم، كان يعرف أنه جنرال شاب هُزم جيشه في ساحة المعركة، وأنه يقدم على الماريشال العجوز المنتصر بتفويض من قائده الأعلى؛ ذلك الراقد مشلولاً محطماً ببيت العائلة، ساعياً للحصول على أفضل شروط ممكنة للتسليم، ولقبض أعلى ثمن يقدر على استخراجه من كيس الثعلب الأحمدي الداهية الذي أدار حربا ضروساً، لعشرين سنة أو أكثر، لم يتردد خلالها في استخدام كافة أسلحته، المالية والروحية والاجتماعية، كي يجرد خصمه من وكالته التجارية القابعة أسفل فيلته، ويطرده منها بغير عودة.
– اجلس يا بني. استرح.
أخيراً، همس له الرجل بنبرة واهنة محايدة، مشيراً للأريكة المجاورة لأريكته.
– ماذا تشرب؟
– لا شئ.
– أحضرت معك الأوراق والعقود؟
غامر برفع عينيه إلى عيني الشيخ، مفتشاً في نظراته، في حركاته، وفي سكناته، عن لهفة، عن فرحة بانتصار طال التخطيط والعمل على احتيازه، أو حتى عن ظلال لشماتة، لكن الغريب في الأمر أنه ما عثر على شئ من ذلك كله، بل صدمه حسٌ مريع بانطفاء، وبالذبول. استرجعت حافظته تلك الكلمات التي كان قد قرأها بكتاب ما، ثم نسيها؛ تلك الكلمات، الغامضة غير المفهومة، التي تحدث صاحبها فيها عن لزومية الانشغال بالناس وبالأشياء وبالأفكار، وبضرورة الاعتصام، في الأثناء، بالإمهال والإغفال والإهمال، ومن بعدها النسيان، فهل يعاني الماريشال المنتصر من أفكار كهذه الآن؟ هل يمكن لمنتصر أن يفكر بمعانٍ كتلك في لحظة توقيع وثيقة انتصاره بالذات؟ لكن ما الذي تعنيه تلك المفردة الشاذة؛انتصار، أصلاً؟
– العقود جاهزة، لكني لم أكتب قيمة البيع فيها.
– لماذا؟ ألمْ نتفق؟
انتبه الشيخ، واستعاد صوته بعضاً من ذئبيته التي يعرفها عنه. أدرك أنه، بطريقة أو بأخرى، قد ثلم، بكلماته الأخيرة، بلَور كأس الظفر، الرائق الصافي، وعكَره.
– لم نتفق تماماً.
– ثم؟
– يريد أبي أن يبيع بمائة ألف.
حطَ خرسٌ رصاصي على الغرفة لدقائق، راح فيها المفاوضان، كلاهما، يزن الآخر بنظراته، ويعجم عوده، يقيس جلده وصبره، ويختبر نواياه الحقيقية. بالنسبة للشاب، فقد مرح بقلبه فرح خفيف مشوب بالأسى، إذ لوث للعجوز لحظة انتشائه الأخير بذرة غبار بائسة لا تغير من واقع الحال شيئا، أمَا عن الشيخ، فقد قبل الأمر، فاهماً، بشكل أو بآخر، أنه لا مفر، في الحياة، من قبول مبدأ الفوز مثلوم الحد، والخسران المنتشي بالكبرياء المهيض. قال بثبات وحسم:
– لا بأس. المبلغ جاهز.
لم يجد الشاب مفراً من ملء الفراغ الأبيض، الذي كان المحامي قد تركه بالعقود، بالقيمة المتفق عليها تواً، بينما أخرج المضيف دفتر شيكاته البنكية ليحرر له شيكاً جديداً بذات القيمة. تبادلا ما بحوزتيهما، ثم هب البائع واقفاً يستعد للمغادرة.
لسبب ما، ألفى الشيخ نفسه يسأل ضيفه باهتمام، وربما بشئ من الحنو:
– هل تأخرت؟ لماذا لا تجلس معي قليلاً؟
لاح السؤال ناتئاً، مريباً، ومتسماً بشذوذ، موجع لذيذ، في أذني الشاب، الذي جمد بوقفته متحيراً، عاجزاً عن الذهاب وعن القعود.
– كيف حال أبوك؟
– الحمد لله.
أجاب باقتضاب، وبغيظ مكتوم، متسائلاً عما إذا كان الخليفة يسعى لارتشاف ثمالة كأس انتصاره بالاستعلام عن مرض غريمه التاريخي، والتيقن من شلله وعجزه.
– تعرف؟ بقدر ما أشفق عليه، بقدر احترامي له، وبقدر ما كرهته وتمنيت سحقه، بقدر ما أحسده الآن.
– تحسده؟ على ماذا؟
– على ماذا؟ على ماذا؟
أخذ المضيف يتمتم بشرود، قبل أن يتابع بهمس، وكأنه يحادث نفسه:
– على أشياء كثيرة، على صموده في حربه معي طول تلك السنين ببسالة، أو ربما على انهزامه أمامي أخيراً بشرف، أو على سقوطه مشلولاً لمَا عجز عن المواصلة، وأيضاً عليك.
– يستطيع كل إنسان أن ينهزم ويسقط مشلولا، فيرضخ لخصمه، ويضطر لبيع وكالته، التي هي عمره لا أقل لا أكثر، يا فضيلة الخليفة، تستطيع أن تفعل ذلك أنت أيضاً، فلم الحسد؟
– هل تعتقد؟ لا يا صغيري، لا يستطيع كل إنسان أن يفعل ذلك، أنا مثلاً لا أستطيع.
– ذلك لأنك تنتصر دائماً؟
– لا وجود لمن ينتصر دائماً أيها الشاب، أنت لا تعرف شيئاً عن الحياة ومكر الأقدار بعد، رغم نبوغك وشجاعتك، وستعلمك الأيام أكثر بكثير مما تظن أنك تعرف، صدقني.
ران الصمت ثانية لدقيقة طويلة، لم يجد أيهما عنده ما يضيفه للآخر. تحرك الزائر باتجاه باب الخروج، مولياً صاحب البيت والمقام ظهره. غالب تردده، وكراهيته المزمنة للرجل، كي يغتصب تحية أخيرة يودعه بها. حشرج بالقول:
– السلام عليكم يا مولانا.
– وعليكم السلام يا ولدي. وحتى لو أنك نطقت بها ساخراً، فلو احتجت أي شئ مستقبلاً فسأكون سعيداً بتقديم المساعدة.
أجابه الشيخ بنبرة صادقة لا شبهة فيها. استجمع الشاب نفسه ليرد عليه بهدوء بدا مثيراً:
– لا أظن أني سألجأ إليك، أنت بالذات، يوماً ما، وإذا حدث وأن التقينا فيما بعد، فسأحرص، مهما كان الثمن، على أن نتبادل موقعينا اللذين نشغلهما الآن. أمَا آخر شئ أريد أن أعترف لك به، قبل ذهابي، فهو أني أكرهك من صميم قلبي، كرهتك باستمرار، وسأكرهك دائماً.
زفر عباراته الممرورة تلك، وانسل خارجا إلى عتمة الردهة، ثم إلى بوابة الخروج بمعية الخادم الذي كان بالانتظار والاستعداد التام عند باب حجرة الخليفة الشيخ.
– أعرف أيها الشاب، أعرف، لكن، مرة ثانية، من يدري ما تخبئه لنا الأقدار؟
هل همس بها الرجل؟
(2)
بهدوء وشغف، أخذ يقلب بأصابعه، الطويلة النحيلة كأصابع عازفي البيانو، صفحات صورة المخطوط الأرجواني النادر الثمين. لأعوام عدة، بات يتحرق شوقاً، ويتلهف تطلعاً للعثور عليه. وبالرغم من كون خبر وجود هذا المخطوط، وحقيقيته، بات معلوما، بل ومتداولاً، في الأوساط العلمية المتخصصة بالمجال، إلا أنه لم يكن قد قابل أحداً، من الزملاء الباحثين أو الدارسين، أفلح في الاطلاع على نسخة المخطوط الأصلية، أو رآها رأي العين، بما يقطع الشك باليقين، مرة واحدة وللأبد، بشأن نسبة هذا المخطوط المثير إلى محمد أبي عبد الله الأحمر، الملقب بالصغير، آخر ملوك غرناطة، من بني الأحمر، سليلي سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري الخزرجي الشهير.
ولعلة، لعله لم يسبر أغوارها، ولم ينجح في استكناه أبعادها الوجودية، بقي ملاحقاً، طيلة شبابه وحتى انتصاف عمره، بحلم عنيد؛ أن يكون، هو بالذات، أول من يهدي تاريخ خير أمة أُخرِجت للناس تلك اللقية، أو أول من يزيح الستار، بيديه وعلمه، عن حقيقة تهوين، أو تهويل، أكثر من خمسة قرون راح فيها ذلك التاريخ يتأرجح، كالبندول، ما بين الأمل والخيبة، الرجاء والسخرية، أو ما بين القبول والنكران، الإيمان والكفران.
وهكذا، وبالطريقة، العجائبية المعتادة، التي دأبت الأقدار على الاشتغال بها علينا، إنطلاقاً من الحلم، أو الوهم لا فرق، وصولاً إلى إعادة اختلاق الواقع بحيث يصير، ويا للعجب! على قياس الأحلام والأوهام، فقد راحت شؤون حياته الشخصية، ومساره العلمي والمهني، يُعاد تلقيحها وصياغتها على النحو الذي، كان ولابد أن، يُفرخ له مهمة وظيفية وبحثية ما جالت بخاطره يوماً، ليحدس، وإن بغموض لذيذ مثير، أنها ليست إرادته ولا لهفته، بل إرادة قدر ما مجهول ولهفته، ومن ثمْ فقد أودع طفليه الصغيرين لدى أمهما بالإسكندرية، واتفق معها على كافة تفاصيل الطلاق، الذي أصرت عليه، وعلى قيامها، منذ الساعة وحتى آخر العمر، بضم الطفلين لحضانتها، وتنازله عن حقوقه المستقبلية، كوالدٍ، بشأن استعادتهما، ثم حزم حقائبه، وحجز تذكرة الطائرة المسافرة إلى كازبلانكا، ومنها بالقطار إلى العاصمة الرباط، ليتسلم منصبه الجديد، كباحث واستشاري في تاريخ وآثار وعمران الأندلس و المغرب و شمال أفريقيا، بمنظمة الإيسيسكو التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
عامان إضافيان من التحقيق والبحث المدقق، لتثمر جهوده، أخيراً، ما يشبه اليقين بوجود المخطوط/الحلم متحفظاً عليه بخزائن مكتبة المخطوطات النادرة الخاصة بجامع القرويين في فاس. وعلى الرغم من مختلف الصعاب التي جابهوه بها، والاعتراضات والعوائق التي وضعوها بطريق البحث، فقد أفلح، بحيلة ما، وبمساعدة لم يكن ثمة غنى عنها من جانب زميلته، وتلميذته، الباحثة المغربية، في الاطلاع على المخطوط، بورقه الأرجواني المزرق الألوان، وبخاتم الغرناطي الأخير ذاته. بل وأفلحت مناوراته، وهذا هو الأهم، في تصوير بعض الفقرات والصفحات، الأكثر سرية والأقل تداولاً والأشد خطورة، بالمخطوط؛ تلك الفقرات والصفحات التي تناول فيها الأندلسي الأخير بالتحليل والنقد،
وبشئ غير قليل من جلد الذات، لا وقائع وتفاصيل سقوط غرناطة، أو الأندلس كلها، بيد القوطيين والمحررين الأسبان وحسب، كنتيجة طبيعية، يصفها بأنها كانت مقدرة ومحتومة، لخيبة أبائه وأجداده من بني الأحمر، وإنما، وهذا هو الخطير والمثير، وقائع وتفاصيل ما يدعوه كاتب المخطوط بسقوط يثرب بيد القرشيين المهاجرين، بسبب خيبة جدوده الأبعدين من نصارى الخزرج والأوس، وبخاصة جده الأعلى سعد بن عبادة، كبير الخزرجيين، مرشحهم المغدور لخلافة الرسول، وقتيل سهام الجن في خلاء حوران.
راح يلتهم كلمات الغرناطي، المنفي إلى فاس، بعينين مغرورقتين بدموع يتأرجح عمرها بين خمسة قرون إلى أربعة عشر قرناً، مدركاً، بألم يخترق سويداء القلب، أن المأساة كلها فصل واحد وحيد لا يتغير، مهما تبدلت المناظر والشخوص، وأن غرناطة كانت ثاوية، أو غافية، في جوف يثرب، كما أن طنطا والإسكندرية قد استولدتا الرباط وفاس، أم لعلهما قد ولدتا منهما، أو أن الخيبة، في منافي البلاد الشامية والمغربية، أو منافي الشلل والقعود فوق كرسي متحرك، ستظل تتناسل وتتكاثر برغم الاعتقاد، أو ربما بسببه.
يكتب الأندلسي الأخير:
” أومن أن أمير المؤمنين عمراً هو من قضى على جدي بالنفي إلى بادية الشام، ثم بالموت في خلاء حوران، فكيف تريدون مني أن أتعامى عن الوقائع والبينات الصراح؟ أن أتصامى عن صيحته بالسقيفة أن اقتلوا سعداً، قاتل الله سعداً؟ ألم يقل ذلك بلسانه، وسجله الرواة؟ ألم يشجع المهاجرين والأنصار ساعتها على وطء سعد المريض، المدثر بالأغطية، فوق محفته؟ ألم يلحف عليه مطالباً بالبيعة لأبي بكر، ثم له، شخصياً، من بعد موت أبي بكر؟ ألم يبارك نفيه إلى حوران، فيما كان يمانع، بحزم، في خروج كبار الصحابة من يثرب؟ وأخيراً، ألم يقبل ويرتضي تلك الرواية، الساذجة الشائهة، عن قيام الجن برمي سعد بسهامها بينما كان يتغوط في الخلاء؟”.
ويعود الغرناطي لدحض الرواية السيرية الرائجة نفسها، وللسخرية المرة الدالة منها، عبر المشابهة، التي تؤكد الإدانة، بين حادث مقتل جده، وحادث موت الحسن بن علي بُعيد تناوله عسلاً أهداه إياه معاوية بن أبي سفيان:
” لطالما راقني رد بن أبي سفيان على الاتهام الموجه إليه باغتيال الحسن، حين راح يمزح بالقول بأن لله جنوداً من عسل! نعم، فأن يسخر الله العسل، حسب معاوية، لقتل الخصوم والمنافسين والخارجين، لأفضل، على الأقل من بعض الزوايا، من تجنيده الجن لقتل سعد بسهامها أثناء التغوط، بحسب أمير المؤمنين. وإني لأضحك لمزحة معاوية الكريهة الغادرة، بنفس القدر الذي أرثي به لجدية عمر المؤمنة الصارمة. ولكوني ملكاً سابقاً، وسليل ملوك سابقين آخرين، فإني أعرف ما الذي يقتضيه، ويتطلبه، هاجس الحفاظ على الملك، تأمينه، وتوسيعه، من فظاعات وخطايا وبلاهات، ناضحة أكانت بالسخرية وبالطمع الشخصي، أو عابقة بنسائم الإيمان وترهات إقامة، وإدامة، ملكوت الله ودولته فوق أرضه”.
وفي مكان ثالث، نراه يخط بتأثر بالغ:
” ومثلما أنا منفي طريد، بعيداً عن تلك البلاد التي ولدت فيها وأحببتها، تلك المملكة التي عشت سيداً عليها، تلك القصور والحصون والأسوار والجبال والتلال الخضراء، تلك الأسواق والأزقة والناس، الفقراء الودعاء، في بيوتهم البسيطة، وحقول قمحهم التي أنضجت شمس أندلسية، رحيمة، سنابلها المكتنزة بالوفرة المسبية الآن، فقد كان الخزرجي الأخير منفياً طريداً، وقد نأت به الصحارى لما وراء وراء يثرب ذات الحقول والبساتين، ذلك الخزرجي الذي حلم ببناء دولة تظللها عقيدة، عادلة وارفة، أم لعله ملك عضود، وها أنني أبتعثه بعيني حالي ومآلي، فأبصره هائماً في صحارى حوران على غير هدى، لكنه، وبالقطع، كان يسائل نفسه والقدر عما إذا كان قد أضاع، هو الخزرجي الأخير، ملك أجداده، حين قامر باستبداله بحلم مكي ورثته قريش لأبد الآبدين؟ عما إذا كان هذا ما ينبغي عليه، حقاً، أن يبكيه؟ أم لعله يبكي حلماً آخر ذاهلاً وهميا تائهاً؟ حلم مملكة الإله التي تتجاوز كلاً من يثرب ومكة معا؟ وهل ثمة وجود لهكذا حلم فعلاً؟”.
ويتابع الأندلسي الحزين بوحه والأنين:
” من زاوية للنظر، بعينها، فقد كان جدي، على الأقل، أوفر حظاً مني، حين لم يلعنه تاريخ الأمة كما أعتقد أنه سيلعنني. وكيف لا؟ ألم تلعنني حتى أمي بما سيغدو وصمة عار وشنار تبقى تلاحقني أبد الآبدين: ابك كالنساء مُلكا لم تصنه كالرجال، لكن أو قالتها حقاً؟ وبالرغم من شكي في أنها قد نطقت بها، بالأقل حرفياً، أدرك أنه لا فائدة تُرتجى من الإنكار، فستظل الصورة مقترنة بذكري عبر التاريخ، ذلك، وببساطة، لأن التاريخ لا يستغنى، أبداً، عن مشاجب بشرية يعلق عليها حماقات الأقدار وتفاهات القيمين عليها. ولأني مشجب لم يقيض له أن ينضوي يوما تحت دائرة أية قداسة، على شاكلة ما حصل للخزرجي الأخير بمحض مصادفة، قدرية وتاريخية، ربما ما عنت له كل الذي فهمناه، أو توهمناه نحن، عنه وعن مجايليه لاحقاً، فسأغدو ملعوناً أبدياً، بلا رجاء في إنصاف مستقبلي، بخلاف الخزرجي الأخير الذي أحسبه قد حوكم بأن يصير نصف ملعون فقط”.
ثم يتأمل بتسليم هادئ:
” في الصباح، أفيق من ميتتي الليلية. أطارد نتف أحلام باتت تناوشني حتى الفجر، قبل أن تفر، كقطيع غنمات مذعورة اشتمت روائح الذئب بالجوار. شموس الصباحات هي ذئابي، فما أبهى الذئاب المضيئة! أستند لحائط الدار الطيني بظهري، وأرقب الخادمة البربرية وهي تفرش الأرض، المكنوسة تواً بسعفات النخيل، بالقمح وبالشعير، لتنقرها الدجاجات، المتصايحة المتصارعة، بمناقيرها الحادة الجائعة. ما أجمل أن يرقب المرء تلك الدجاجات في تدافعها، الغبي اللجوج، بحثاً عن الطعام، ليفكر أن حياته، هو أيضاً، ليست أكثر من حوش مصارعة ونقار طيور مسكينة غبية، صخاب برئ، في وحشيته المستدامة! وعند المساء، سأرقب، صامتاً ذاهلاً، التماعات كل تلك النجوم المتوامضة، خائفاً من سعة الكون اللا نهائية ومن ضآلتي، أنا المليك السابق لغرناطة الساقطة بين شدقي الخنزيرة الكاثوليكية التي لم تكن تغتسل حتى يجئ يوم الاسترداد والتحرير، فهل ثمة ممالك هناك، بحياض هذه النجمات، تشبه غرناطتي، أو حتى يثرب جدي؟ وهل من مؤمنين وكفار يؤمنون أنهم وحدهم المؤمنون حقيقة، فيقسمون ألا يقربوا الغُسل والاستحمام حتى تتطهر أرضهم من الرجس والهرطقات؟ ثم هل من معبر يصلني وينتقل بي إلى ما هناك؟ أما من ممر يُفضي إلى ما لست أرى؟ ممر منير، أو حتى مظلم؟ لكن، من يضمن لي أنه ليس ممراً لتيه محجوب لا آخر له؟ من يجيب عن الأسئلة؟”.
(3)
ما إن ولجا المنزل، وأغلقا عليهما بابه، حتى بلغت آذانهما أصوات الرياح، التي طفقت في التصاعد تدريجيا، وباتت تنذر بالانقلاب إلى عاصفة. اتجهت، مسرعة، نحو مفاتيح الضوء، وأشعلتها، بالجملة، ليغرق المكان في فيضان نور مباغت. سحبها إليه، من دون كلام، وضمها إلى صدره بقوة. عرف أنها خائفة، وأنه ما من سبيل آخر لتسكين ذلك الخوف، البدائي الخام، غير فعل عشقي، بدائي خام كذلك. هو استدعاء البداءة للبداءة، نداء الطبيعة على الطبيعة، وتعطيل لأي برمجة دخيلة تتعالى على لزوجة الدم وسخونة اللحم. ذابت الشفاه في قبلة، طويلة عميقة، وراح اللسانان يتبادلان اللعق ومص اللعاب. انتزعت نفسها، بخفة، من بين ذراعيه. حدقت بعينيه، التي طالما حارت في لونهما، وهمست بتعب واضح:
– ألم أقل لك؟ كان من المستحيل العودة إلى الرباط، في هذا الجو، ليلاً.
هز رأسه، ببساطة وتسليم، مؤمناً على كلامها.
– الحمد لله أني أتيت بمفاتيح الدار معي، لم نجئ إليها منذ شهور، هي دارتنا الصيفية كما ترى.
من بين المميزات، الشخصية العديدة، التي تتمتع بها مساعدته الثلاثينية هذه، تظل قدرتها على مواجهة الطوارئ، والارتباكات اليومية العادية، هي الأكثر إدهاشاً بالنسبة له. كانت تتمتع بثبات انفعالي، وبمقدرة عظيمة على ابتكار الحلول، العملية البسيطة، لما يظنه هو، باستمرار، أعقد المشكلات الحياتية، وبأقل كلفة ممكنة، مادياً ونفسياً. وحين قرر المجئ لفاس، في محاولة جديدة لإلقاء نظرة أخرى على مخطوطه اللعين، كما تسميه هي، فقد عرف أنه سيعجز عن إتمام هذه الخطوة لو لم توافق على مصاحبته خلال تلك الرحلة. وهكذا أسلم نفسه لقيادها، مطمئناً أن كل شئ سيكون على ما يرام، معها.
– المدينة اسمها إيموزار الكندر، وهي تبعد عن فاس، في قلب الجبل على طريق إفران، أقل من ساعة كما رأيت. طبعا تبدو مخيفة أثناء العاصفة وفصل الشتاء البارد، لكنها بالصيف شئ مختلف تماماً، جمال طبيعي خالص، جبال عالية خضراء، عيون مائية، بحيرات صغيرة، غابات مورقة، شلال قصير، و…
– ووجه حسن.
قاطعها مداعباً، ثم أمسك وجنتيها ورأسها بين كفيه، برقة، وأخذ ينظر لعينيها، مباشرة.
– هل تغازلني؟
-لا، أنا أحاول أن أغويكِ.
– أنصحك ألا تحاول، وفِر وقتك وجهدك للأهم.
– وهو؟
– وهل هناك غيره؟ مخطوطك اللعين يا حبيبي!
أجابته، ثم انفجرت في واحدة من ضحكاتها، المرحة المجلجلة، التي لا يحبها، منها، كثيراً.
نجحت، كدأبها، وبالرغم من ضيق الإمكانيات، في إعداد وجبة عشاء ساخنة كان يحتاجها، بشدة، بعد إرهاق اليوم، وتهاطل الثلوج بالخارج. قال لها بامتنان صادق:
– أنتِ ملاكي الحارس في المملكة.
– وخارج المملكة؟
صمت، طويلاً، على نحو يشي بعجزه عن إيجاد جواب مناسب، ليرد أخيراً:
– لم يعد لدي أحد.
كان قد روى لها، ذات يوم، باقتضاب، وفي سياق حكاياته عن رحلته بحثاً عن المخطوط، قصة انفصاله عن زوجته، وتنازله عن طفليه، للأبد. وكما ينتظر من أية امرأة، عرف أن قراره ذاك لم يرقها، حتى ولو لم تقل ذلك صراحة، غير أنها غدت، ومنذ اللحظة، لا تأتي، ولو كان ذلك في سياق العمل البحثي والعلمي المشترك، على ذكر المخطوط إلا متبوعا بنعت اللعين.
– غرناطي أخير جديد، كما تلاحظين!
تابع، متفكهاً كي يداري عن عينيها اضطرابه، وربما حسرته وندمه. لم تجبه، وتشاغلت عنه بتشطيب المطبخ ومائدة العشاء، وإعداد الأتاي الأخضر بالنعناع.
– لماذا إيموزار، بالذات، وهي بعيدة كثيراً عن الرباط؟
سألها محاولاً تغيير جو الانسداد والبكم الذي أصاب حوارهما السابق.
– ربما لأنها قريبة من إفران، ليس باستطاعتنا شراء دارة في إفران السياحية الباهظة، وربما لأنها على مرمى حجر من مسقط رأسي في صفرو؛ يعني، تبدو إيموزار كحل وسط سحري لمتناقضات وتشابكات كثيرة وغريبة.
– نعم، تبدين لعيني، دوماً، كسيدة للحلول الوسط، السحرية والذهبية، ولكم أغبطك على ذلك.
– أمَا أنت فرجل التطرفات الجذرية، كل شئ، أو لا شئ!
لاحظت هي بجدية لا تناسب الموقف.
– ومع هذا، فقد حسبت نفسي يوماً، عندما كنت شاباً، صالحاً لعقد الصفقات العقارية والجلوس حول موائد التفاوض حول الأرض وتاريخ العائلة، فهل تغيرت؟ أظنني لم أتغير، وأني كنت، دائماً، على نحو ما أنا عليه اليوم.
أشعلت واحدة من سيجاراتها الجيتان المفضلة، وراحت تنفث الدخان بهدوء، قبل أن تصادق على كلامه بأسى:
– أوافق، نحن حقيقة لا نتغير، وجل الذي يتغير هي أفكارنا عن أنفسنا، أو عن معنى الثبات والتغير. قبل عدة سنوات توهمت أني أحبه، وأني غير قادرة على مواصلة الحياة بدونه، لكنه غادرني ورحل لفرنسا، ويكتب لي أنه يفتقدني برغم استمتاعه بالحياة وبالعمل هناك، فهل تغير أي منا، خلال هذه السنوات القليلة، إلى ذلك الحد حقاً؟
– أضاع أبي الجزء الأكبر من ثروته الضخمة، ليخلفنا من ورائه في العراء. كنت طالبا بالجامعة، لا أزال، عندما وجدت نفسي منخرطاً بمحاولة الحفاظ على آخر ما تبقى أمامنا كي لا نمد أيادينا للناس نستجدي العون؛ الوكالة الأم، لكن هذه الوكالة، وكما هو مخطوطي، كانت ملاحقة بلعنة من نوع خاص؛ هوس خليفة وشيخ الجامع الأحمدي باسترداد ميراث آبائه من الأيدي التي تجرأت، مرة، وابتاعتها من ورثة شرعيين آخرين. وهكذا، وكنتيجة لحماقة أبي ونزقه، فقد وجدت نفسي مسؤولا ومفوضاً ببيع الوكالة لعجوز كريه متعفن شرهٍ ومطارد، هو أيضاً، بلعنته الخاصة. يا صديقتي، كلنا، الكل، ملعونون، ومن كان منا بلا لعنة فليبرهن لي على ذلك كي أبتهج به وله.
كانت قد انتهت من سيجارتها الفرنسية المفضلة، فنهضت كي تعد فراش النوم والأغطية.
دخلا إلى الفراش من دون أن ينطقا بكلمة إضافية. كانت العاصفة بالخارج قد هدأت، لكن جو الغرفة لا يزال شديد البرودة. فاجأته حين أدارت له ظهرها، ثم همست:
– تصبح على خير.
حاول أن يلف ذراعه من حولها، يدير وجهها باتجاهه ليقبلها، ويحشر ساقيه، العصويتين المشعرتين، بين ساقيها، اللدنتين الملساوين الدافئتين، فلم تستجب لمحاولته. فح بأذنها:
– أريدك.
زفرت بتعب، وأجابته بحزم:
– ليس الليلة، الأفضل أن ننام، فطريق الرجوع طويل وشاق.
كان قد فقد كل أمل في استجابتها لرجائه، فقال كمن يحادث نفسه:
– أجل، لا يزال الطريق طويلاً وشاقاً.