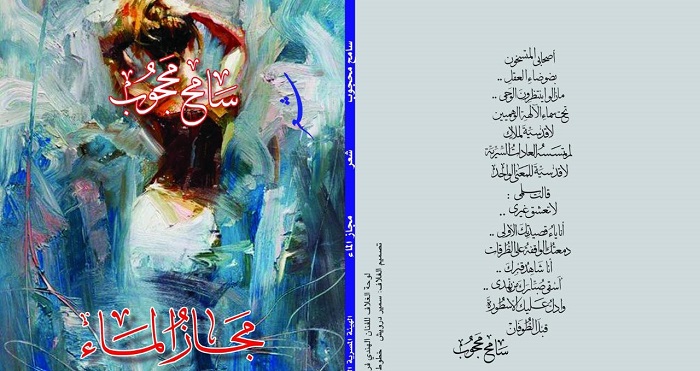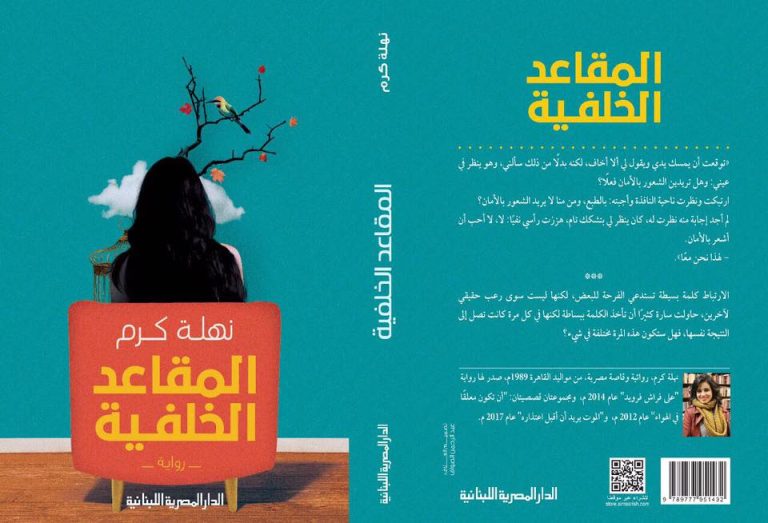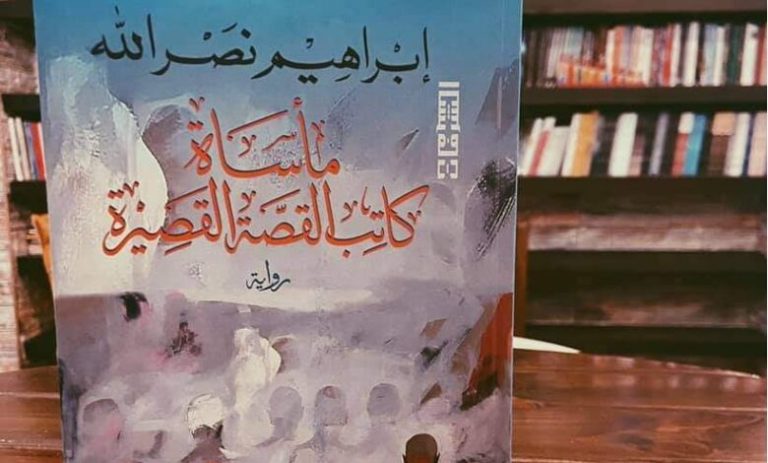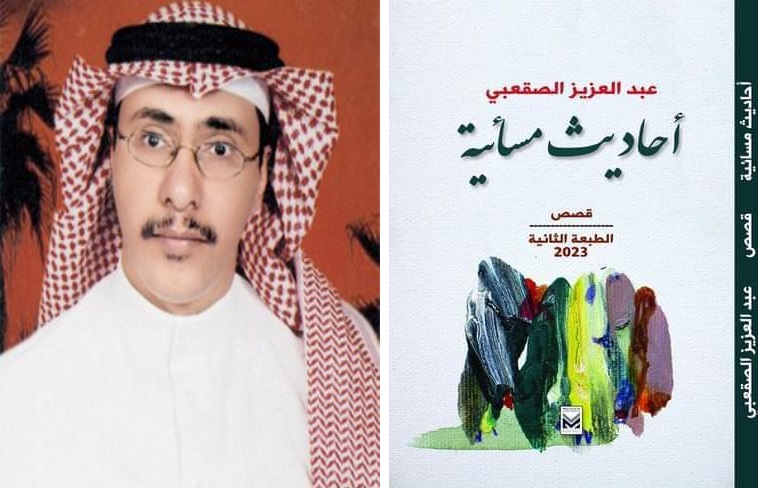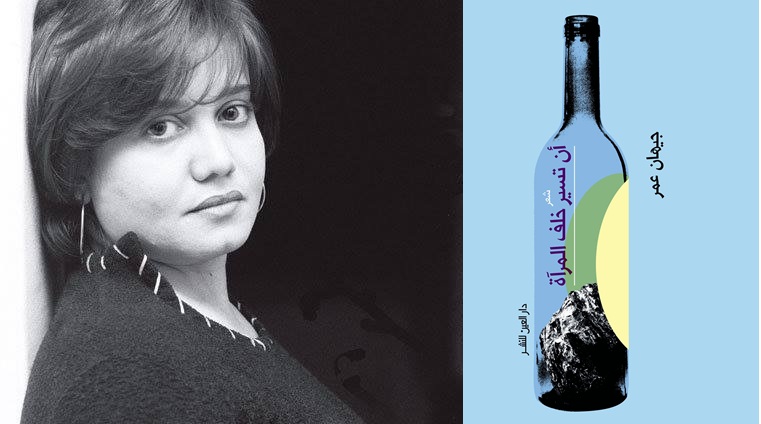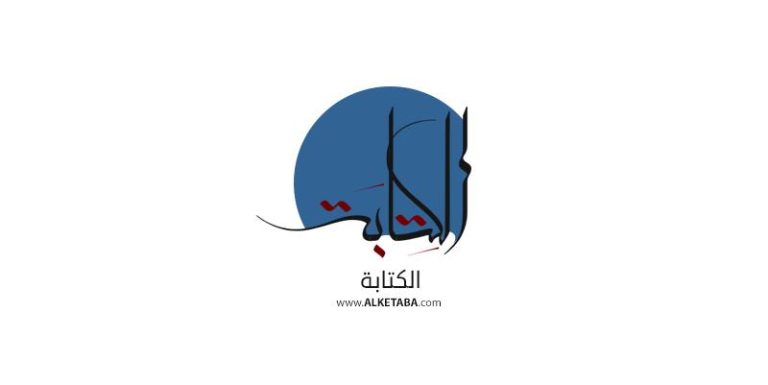وبين بضع حكايات، تتناثر عبارات لوم الوطن هنا وهناك..
حتى إهداؤه – لو أن لي أن أدقق في ملامحه – لأبيه/ ليس سوى اعتذار عن تأجيل للأماني التي لم تتحقق بعد.
تبدأ الحكاية في (مرسَى فاطمة) بالحُب، وتنتهي بالانتظار. “سلمى” هي البداية. سلمى تعبئ حياته بالأمل، بالحياة، بالشعر ينساب من شفتيه. يصفها وكأنه يرى السماء في أوج نقائها، يصفها فترقُّ قلوبنا له وهو يخشى غضبها منه لتأخره عن موعد لقائها. “سلمى” التي يلقاها كل يومٍ في (مرسى فاطمة) وتتعلق بلقائهما حلوى الحياة ونقاء العمر وتلتئم ثقوب القلب. غربته ومجيؤه إلى العاصمة لم يعصماه من الحب، لكن سلمى أخذته على يديها وهدهدته، اختارته من بين كثيرين لتجعله الأسعد والأكثر حظًا بينهم.
وفجأةً تختفي “سلمى”.. هكذا، بلا وداعٍ أو عتاب قبلها.. تختفي لأيامٍ طويلة فتفقد أيامه طعمها وتحلّ لذعةٌ قوية في قلبه. لا يستطيع إدراك الأمر حتى تنهال عليه صدمةٌ أخرى حين يسأل صديقتها عنها فتجيبه بأنها ربما رُحِّلت إلى (ساوا).
من البداية تسقط المفردات العسيرة على إدراكنا ربما. نسعى خلال الصفحات نبحث عن (ساوا) التي غابت في طبقاتها الحبيبة التي لم نعرفها سوى من همهمات حبيبها عنها. يقولُ أنها كانت تخشى كثيرًا من التحاقها بالـ”قولقلوت” في “ساوا” وأنها تتمنى لو حصلت على إعفاءٍ منه مثلما حصل هو عليه. الرواية تدور في إريتريا حيث حالة من الحرب الباردة والساخنة على السواء تدور بين إريتريا وإثيوبيا وعلى حدود السودان ومصر. تأخذ من كل بلدٍ آلامها وأحزانها وتجمعها على آلام الحبيب الذي فقد لتوّه حبيبته في خضم حياةٍ لم يدخلها سوى باحثًا عنها.
كيف تؤخذ “سلمى”؟
كيف وهي.. حامل ! ينكشف السر لنا فقط ويظل في جوفه دون أن يفصح لأحد عنه.
ويقرر أن يذهب بنفسه إلى “ساوا” ليلتقط سلمى من بينهم ويرحل. لم يفكر كيف سيجدها ولا كيف سيخرج بها من قلعة الموت تلك. فقط قرر ذلك. قرره لأنه حين زهد المحاولات وأدخل مفتاحه في بيته، احترق قلبه من اللوعة وهو يتخيل نفسه يعيش دونها، دون “سلمى”. كان سيكتفي أخيرًا وبعد تصريحه لكثيرين برغبته في الذهاب دون أن يعيره أحدهم اهتمامًا، بالاعتناء بأم “سلمى” والبقاء في انتظارها وفاءً لها.. ثم تحول انكساره إلى صرخة داخله تبحث عن “سلمى”. كيف له أن يترك حياته تخفق هكذا.. أن يترك “سلمى” يعني أن يموت، ودخول مفتاحه الباب يعني إنهاء حياته بأكملها.. سيلحق بها إلى (ساوا).
“هل تعلم أنكَ بقرارك هذا تحكم على نفسك بحياةٍ أبدية في إطار العسكرية؟ هل تدرك أنك لن تعود إلى حياتك الطبيعية أبدًا؟”
هل كانت أسئلة “جبريل” صديقه لتجعله يتراجع عن الأمر؟ ربما للحظة.. يكف بعدها عن متابعة الأمل في الحياة لو اختفت “سلمى” بالفعل. يتقدم بخطوات واسعةٍ نحو (ساوا) مبصرًا وجه حبيبته من بعيد. يقف عند موقف العربات المتجهة في اليوم الموعود و(كمشتاتو) مكتظة برائحة الناس المساقين إلى (ساوا) المخيفة.. حاملةً على ظهرها شبابًا يلوّنه الخوف من الآتي، نشيج الأمهات وهنّ يأكلن وجوه الأبناء.. كل شيء يقول أن (ساوا) ليست المكان الذي ينطلق شخص نحوه ليتجه بعدها لأي مكانٍ آخر. لكنه يذهب مخفيًا الأمر عن الجميع إلا جبريل صديقه الوحيد الذي يملأ كفيه بالمال قبل أن يندفع إلى (ساوا).
وفي (ساوا) يظهر العالم الذي نعرفه بأقبح ما فيه، الذُل في أبهى معانيه يتعلم القبح في (ساوا).. البذاءة، التدمير، الخراب.. خراب النفس وتدمير الحياة. يدخل الناس (ساوا) ليتحولوا عبيدًا لأمثال “منجوس” القائد الذي يتفنن في إذلال الجميع. وفي (ساوا) يتقرر لكل مجند رقم.. رقم يمحو هويته/ ملامحه/ جسده ومشاعره وأصله الذي أتى منه. كم كان عسيرًا أن يتعرف نفسه من خلال الرقم.. أن يُختصر هو وحياته وماضيه في رقم. أن يغدو خانةً لا روحًا ولا حياة.
وفي (ساوا) تعرَّف إلى “كدّاني” نموذج الثائر كما يجب أن يكون.. جسد رفيع وأعين ثاقبة واستهزاء من الدنيا على مرارتها وكأنها لا تعنيه في شيء. تنهمر على رأسه الصعوبات، وعواقب تمرده تبدو واضحةً في ظهره المجلود وجسده المهترئ.. غير أن عينيه تقولان طوال الوقت أنا لستُ ضعيفًا كما يبدو الأمر لكم. يمر به أول ما يصل (ساوا) ليجده مجلودًا ومكوّمًا في زاوية.. الجميع يتجاهله، كل من هناك يخشاه، حتى وإن بدا العكس. وبين “كداني” وبينه، سارت الأحاديث حول الوطن وحول “سلمى”، عن وطن كل منهما.. ورأى “كداني” خلاله كيف أن حبيبته هو الآخر وطن له، يقف جواره ليصلا للوطن الأكبر لهما. (ساوا) ليست سوى قطعة من الجحيم هنا. جذبتني أحداث (مرسى فاطمة) لمعرفة المزيد عن إريتريا، لاستشعار أحزان عالمنا الأسود الفقير، وللتحلّق حول مفهوم الوطن الذي لا نكاد نمرّ به. يتشاركان الحديث عن الحُب.. يفيض هذا عن سلماه فيصب الآخر حبه لـ “إلسا” أمامه. ويجتمعا على الوطن المفقود.
يعاني كالجميع في (ساوا) إلى أن يتحول طريقه ببعض الحظ إلى أن يصبح السائق الخاص لـ”منجوس” فتقل معاناته الجسدية ويظل يبحث في الوجوه عن سلمى، يتخطى الحدود، يسرق النظرات داخل الخيمات، ينتهز كل فرصةٍ للسؤال أو التفقّد. و”سلمى” لا تكاد تختفي من خلفية الأحداث. تظهر هنا وهناك كل حين. يراها وهو يغض الطرف عن مشاق الجري لساعات.. العرق وهو يحمل الصخور التي أمضى الساعات في تكسيرها ليعود يحملها إلى مكانها من جديد..دخول الحمام مرتين في اليوم جماعات كالحيوانات كي تنكسر النفوس أكثر وأكثر.. وبعدُ، لا يزال وجه “سلمى” الذي أقسم أن يكون هو ملاذه في البحث.. لا يزال هو ملاذه.
لا يزال يمنحه شكلًا جديدًا من البهجة في كل مرة.
“سلمى بالنسبة لي هي أيضًا حلم بحجم الوطن، بين يديها أشعر بالأمان، ولجبينها الأسمر أنتمي. سلمى لغتي وحدودي وخارطة وعيي واحتياجاتي. أولا يستحق هذا الوطن أن ألهث خلفه حتى لو استقر هنا في ساوا؟”
يتحول “كداني” لمطاردة الوطن بشكلٍ آخر الآن.. يطارد وطنه بحبٍ.. من خلال إلسا، لأن الوطن الحبيبة والحبيبة الوطن. يقول: “العدالة التي ننشدها لا تعني توزيع الظلم بالتساوي. لسنا ضد أداء الخدمة الوطنية، لكننا ضد أن تصبح أبدية.”
لماذا أشعر وكأن الكلام ليس لإرتريا وحدها !
لسنا في عسكرية أبدية.. لكننا أقرب إلى معاناة ساوا من حبل الوريد.
وتبحث “إلسا” لهما عن “سلمى” طويلًا. تبحث إلى أن.. (لا أثر لسلمى في ساوا)!
“كداني” يستوعب ألمه فتضيق عبارته لتتسع “الامتلاء فعل لا يليق بالعاشقين”.. هل يقصد عشق صديقه لـ”سلمى”؟ أم يرمي بالسؤال في وجوهنا؟ امتلاؤنا بعشق البلاد التي يفضحنا امتلاؤنا بها.. فترمينا في مجاهل الزمن غير عابئة؟
“المرأة كما الوطن، حين لا تأتي تضاعف من وجع الانتظار” إلى متى تنتظر سلماك يا تُرى؟
– إلى متى ننتظر استدارة من بلادنا نحو وجوهنا الغائمة غمًا؟ –
يهرب من (ساوا) التي تخرج أناسًا مشوهين.. آملًا في البحث عن “سلمى” من جديد.. سيبحث عن وطنه/ عن سلمى، ربما هربت للسودان ليسقط في ثقبٍ أسودٍ جديد.. (الشِفتا).
وفي الطريق إلى السودان يمر بعدة قرىً.. يسقط بعدها في يد الشفتا: جماعة تعتقل الهاربين إلى السودان وتفرض عليهم مبلغًا من المال يدفعونه في مهلةٍ يقضونها في العمل لديهم كالدواب إلى أن يدفعوها أو يرحلونهم إلى سيناء المصرية.
يعاد على مسامعه لفظة “سيناء” عدة مرات فلا يفهم ما الذي يشير إليه ذلك. وفي دنيا الشِفتا يقابل العديد من المعذبين في الأرض.. أبراهام الذي هرب من العسكرية مثله ليعاني طويلًا واتفق مع الشِفتا ليوصلوه السودان مقابل مبلغ من المال، غير أن السلطات تعتقل والدته وتطالبها بخمسين ألف نقفة عقابًا على هروب أبراهام.. وهكذا يكون هو معتقل لدى الشفتا حتى يتم دفع ما عليه، في حين تكون أمه معتقلة لدى السلطات لمبلغ ضخم من المال.
يروي أبراهام أحزانه فيجترّ صاحبنا ما عرفه عن أحزان الآخرين.. يشير إلى أحزان النساء اللاتي يُجبرن على أعمال لا تطاق. واغتصابهن بدل ما عليهن من المال. أما الأطفال فغالبًا ما يتم تهريبهم إلى سيناء.. ما بال الناس يهددونه دائمًا بسيناء مصر؟ ما هو الوحش القابع هناك؟
وإلى أن يدبّر أمر المال، عليه ومن معه أن يعملوا أعمالًا شاقة “تحلل نومتهم” قاموا قالوا له.
تظهر زينب في الصورة.. يغتصبها الشفتا مقابل ما عليها من مال، ولا يملك أحد الدفاع عنها أو دفع ما عليها، فكلٌ موصوم بما عليه. فيقرر أن يدفع بما لديه من مال ما يفك أسر أبراهام وزينب، على أن يعمل لدى الشفتا لفك أسر نفسه زمنًا طويلًا. وفي لحظة رحيل زينب وأبراهام، يصف لزينب أوصاف سلمى من جديد، علها تجدها وتخبرها عن حبه المستمر لها: “سلمى تميل إلى الطول، سمرتها صافية وشعرها أسود كثيف، على تخوم شفتها العليا شامة خفيف، ولها لثغة ساحرة في الراء،….”
تكفل هو إذن بعمل ما كان على أبراهام وزينب أن يقوما به.. يقطع الأشجار بالفأس الثقيلة وهو مربوط بالأصفاد من قدميه. تحتك به القيود فتجرحه، ويتذكر أبراهام وزينب فتخف روحه قليلًا. وحين يمسه الفأس يجرحه، فيحذره الشفتاي من نقله إلى سيناء لو زادت جراحه تلك.
لم يطل العذاب لدى الشفتا، فقد اتفق ابراهام مع شفتاي بتسليمه لحرس الحدود الإريتري لينال مكافأة على أن يقتسمها مع صديقه ليتحرر صديقه بها. ولكن كيف يؤتمن الشفتا مع كل ذلك. يتضح أن بؤس العالم وظلمه مربوط ببعض الأمانة.. غريب! كيف ينطوي الظلم والعذاب على بعد الوعود الحقيقية؟ كل ما في الأمر أن حفظه العهد ضروري لاستمرار تربحه.. وكأن الجرائم لابد لها من بعض الصدق لتستمر في التكوّن.
بدأت الرحلة من جديد.. رحلة جديدة من الإرهاق والإعياء والبحث عن آثار سلمى/ الوطن.
يلهثون باتجاه السودان. كانت لحظة مربكة حيث يكون خلاصهم في إعطاء ظهورهم للوطن، حين يهربون منه لا إليه. الوطن الكذبة البيضاء تسودُّ في بعض الأحيان. مثلما اسودَّت صورة “سلمى” مرةً حين لم يجد لها أثرًا في (ساوا)، ثم عاد يلهث وراء لثغتها. حُبِس الجميع في سجن الحرس الحدودي ثم انطلقوا إلى (الشجراب): أرض صحراية وخيام بالية ورجال ونساء صائمون عن الراحة والطعام واليقين في أي شيء. كان اللاجئون متراصون في مخيم الانتظار. وحين نفذ الانتظار قرر بناء خيمة يبيت فيها، اشترى القماش والأعمدة وبدأ يعمل في صمت، في حين قدمت امرأة ستينية بفنجان من القهوة وعرفته بنفسها.. “أم أواب”.
وفي الشجراب حلقة جديدة من المعاناة.. حيث لا هم سودانيون ولا إريتريون، لا جنسية ولا حقًا معترف به للجوء ولا طعام ولا استقرار.. لا شيء في الواقع سوى الخوف والمهانة والفقر.. الفقر الموجع. هناك يلتقي صديقنا بنموذجين من الوجع الحي: أم أواب التي تصنع القهوة لكل من تحب، الأم في أبهى صورها.. ترتدي قلادة بها بعض الحلقات الذهبية وبعض الأصداف وتبيع حلقة ذهبية كلما ضاقت الأحوال. لا تملك سوى الدعاء لمن تحب مع فناجين القهوة خاصتها. أم أواب تبحث عن طفلها القديم الذي خطفوه منها صغيرًا، ولا تزال تتوقف عند كل شاب يصل الشجراب عله هو. وفي صندوق أم أواب قبعت بعض ذكرياته المهملة.. صوت المطرب السوداني “أحمد المصطفى” للتغشاه حياته السابقة بكل تفاصيلها، ذلك المطرب الذي طالما سمعه في صغره على يد أبيه دون أن يفهم أنه الآن يحشد ذكريات عمره الماضي بأكمله.
وفي الشجراب يلتقي “أمير” الذي يغدو بسرعة صديقًا. أمير التعب وعيون الحزن. يحكي له كيف اختطفوا كُليته ليبيعوها في إسرائيل وهو في الطريق إليها من خلال (سيناء) محاولًا الهروب من العذاب، واقعًا فيه من جديد. كان يحذره من الهجرة لإسرائيل التي يروج لها السماسرة كي يبيعوهم عبيدًا من أجزاء وأعضاء منفصلة كما فعلوا مع أمير دون إرادته. هؤلاء البدو الذين ما إن يقع أحدهم بين أيديهم حتى يساومونهم على كُلاهم لدفع ثمن الرحلة أو اغتصاب الفتيات كما هو الحال لدى الشفتا وفي (ساوا).
ما هذه الدنيا التي لا تُعاش!
أما صاحبنا فلا يزال يبحث عن سلمى صباح مساء، فلا يجد وجهها بين الوجوه. وكأنه يبحث عن الوطن الذي لا وجود له. وحين يتلقى من كارلا إحدى فتيات المفوضية التي تصل الشجراب عرضًا بالسفر إلى بلد أوروبي يبدأ فيه حياةً أخرى، يرفض الأمر ويقرر العودة إلى مرسى فاطمة.. علّه يجد “سلمى” هناك تنتظره كما كانت تعيد القول عن العودة لآخر مكان التقوا فيه لو اختلفت طرقهم. هل يجدها في (مرسى فاطمة) بعد كل هذه الفجائع؟
وفي بيت حبهما، في (مرسى فاطمة) ذي الناس الطيبين، أين سلمى؟
سلمى تلهث خلف حبيبها، تعرف بذهابه إلى (ساوا) فتقفز خلفه ثم تهرب من هناك إلى السودان خلفه.. من منهما يبحث عن الآخر؟ أين هي سلمى الآن؟
أين الوطن من كل هذا؟
ما هذه الدائرة التي تقتل كل من دخلها مؤمنًا بها. من منا يبحث عن الآخر؟ أنا أم أنت أم الوطن؟
هل هو أمامنا أم خلفنا؟
هل يكيل اللكمات لنا أم يلهث خلفنا يريدنا جواره لا جوار إسرائيل؟
مرسى فاطمة كذلك ليس سوى دائرة.. سلمى والوطن والطفل الذي أجهضته سلمى لتذهب إلى ساوا خلفه ليسوا سوى دوائر مختلطة.
هنا في (مرسى فاطمة)، لابد أن تعود “سلمى” إلى نقطة البداية في الدائرة.