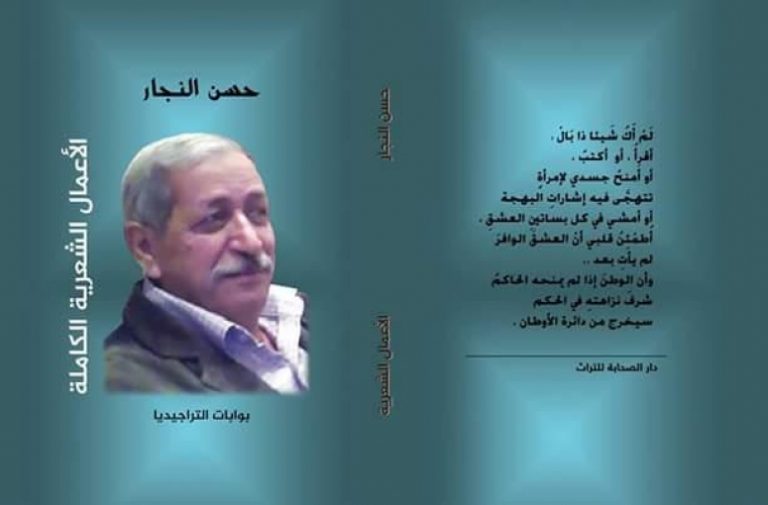د. مصطفى الضبع
“أستطيع أن أكون فذا فى الكتابة عن الألم، لكن شيئا لا أستطيع كتابته عن السعادة”. تطالعك هذه الجملة فى الفاصلة (صفر) المعنون بالإهداء المتصدر رواية محمد صالح البحر “حقيبة الرسول ” الصادرة عن دار العين بالقاهرة 2010.
لك أن ترى العبارة عنصرا أساسيا فى تشكيل الإهداء دون أن تفصلها عن متن الرواية، ولك أن تراها صيغة تأسيسية للنص اعتمادا على صفريتها (وقوعها تحت الرقم صفر)، ولك أن تراها ذلك كله دون أن تعزلها عن دلالة أساسية تقوم على أن من يعيش حياة سعيدة لا يشغل نفسه بكتابتها وإنما هو يعيشها فقط، ولكن الألم وحده هو القادر على إنجاز فعل الكتابة، وهو ما يمكنك أن تدلل عليه من خلال عشرات الأعمال التى تسبق الرواية وصولا للرواية نفسها بما تمنحه لمتلقيها من مساحات استشراف للألم الإنسانى.
الرواية تأتى فى منظومة سردية للكاتب تشكلت من رباعية سردية (روايتين ومجموعتين قصصيتين):
- أزمنة الآخرين ـ مجموعة قصصية- الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة 1999.
- موت وردة ـ رواية- دائرة الثقافة والإعلام – الشارقة 2004.
- ثلاث خطوات باتجاه السماء ـ مجموعة قصصية- الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة 2008.
- حقيبة الرسول ـ رواية- دار العين للنشر-القاهرة 2010.
للوهلة الأولى تكشف الرواية عن مستويين أساسيين فى التلقى يتشكل كل منهما على عدد من العلامات التى تغذى عمق النص وتكشف عن ثرائه :
- الأول: يعتمد على علامات مكانية تتشكل بدورها من مستويين جغرافيين بالأساس (مستوى الجبل – مستوى القرية).
- الثانى: يعتمد على علامات تاريخية الطابع فى مقدمتها تسلسل الأسماء والصفات، إسماعيل – الأم المهاجرة للأب – موسى – إبراهيم – إسماعيل حقيبة الرسول.
- الثالث: يعتمد على علامات بلاغية تزاوج بين لحظتين تاريخيتين: الماضى والحاضر، الماضى الذى يعيد السارد إنتاجه وليجعل من الرواية مدارا يجمع بين مساحتين ساخنتين فى الذاكرة ، مالم يعرفه المتلقى من قبل عن شخصياته ، وما يبثه السارد.
ولكل منها مستوياتها الثلاثية (القولى – السردى – التجريدى) مما يجعلها علامات مركبة والتركيب ههنا يكشف عن عمقها وقدرة السارد على تدشين الرموز منتقلا بها من مستوى سطحى إلى مستوى أعمق، يمكن للمتلقى أن يتحرك بين هذه المستويات حسب قدراته على تلقى مجموعة العلامات والرموز .
أولا: العلامات المكانية
تعتمد الرواية فضاء جغرافيا ينتمى إلى بيئة الصعيد الجنوبية، ومنذ البداية يتجلى أن الكاتب يعمد إلى توظيف سمة جغرافية لها جمالياتها (سمة التضاد بين القمة والسفح، المساحات الخضراء والصحراء) ثم يتجاوز الصيغة التقليدية للبيئة المستخدمة فى السابق متخلصا من كون الجبل موطنا للمطاريد والخارجين على القانون وكون الجنوب واحة خضراء للعادات والتقاليد القائمة على الثأر، وكون الشخصيات تخضع لسلطة القبيلة أولا والعمدة ثانيا، لقد نجح الكاتب فى تجاوز المضامين التقليدية ولم يقع فى أسر مرحلة اعتمدت فيها كتابات الجنوب على زاد لم يتجاوز رؤية الأعمال الدرامية خاصة فى الثقافة المصرية حتى الآن لقد أدرك الكاتب طبيعة نصه واستوعب ثقافة المكان الشفاهية (على ألسنة أبناء المكان) والمكتوبة (بين دفتى الكتب التى سبقته فى التعامل مع المكان وفق منظور يقارب التاريخ دون الوعى بدلالاته العميقة) ففى كثير من الكتابات عن الجنوب اختطت الأعمال لنفسها السير على نهج الأعمال الأولى التى كانت تصر على إدراج عناصر تراها أساسا فى نطاق البيئة (العمدة – الخفراء – المطاريد – الغازية) وهى الصورة السائدة فى كتابات كثير من كتاب الجيل السابق حيث الصعيد مقصود لذاته لا مقصود لغيره فهو لا يوظف توظيفا وجوديا بقدر ما يعمد إلى رصد البيئة بوصفها سياقا دراميا مغايرا لبيئة المدينة فحسب.
منذ السطر الأول فى المتن يقدم السارد الجبل بوصفه قيمة معرفية يتفاضل بها الناس وتمثل عنصر تفرد للأب ومن ثم تأتى الجملة الأولى مفتاحا لدخول العالم:
“لم يكن أحد يعرف الجبل مثل أبي.
وكان الجبل يقوم على رأس البلدة من جهة الغرب، منذ أمد لا أعرف مداه على وجه الدقة. لكن طالما أن عيني تفتحتا عليه من البداية، وقد كان كاملاً وعالياً وعظيماً، تكسوه تلك الحُمْرَةُ التي تلمع في الشَّفَقِ، وتَهَبَه المهابة والقَدَاسة الدائمتين، فلابُدَّ أنه كان موجوداً منذ أمد بعيد. لا يعنيني في ذلك حساب تاريخه جيداُ، كيف هو ممتد في الزمن، فالأزمان السابقة مِلْكُ أصحابها فقط، أولئك الذين عايشوا أحداثها، وطعموا حلوها ومرها، مِلكُ الجبل وحده، من فترة التكوين وصولاً إلى ما ساعد به في إرساء قواعد الأرض، وما حَمل من فوقه من طير وحيوان وبشر وأسرار. أما أنا فليس لي من التاريخ سوى تلك السنوات التي أُعَايش أحداثها، وتجول ذاكرتي فيها مثل حصان جامح في الأرض البَراح، لا شيء يَحُدُّه، وليس من قوة تقدر على إيقافه أو توجيهه صوب ما هو محدد سلفاً واستقر الرأي عليه، ليس سوى الركض قَدراً لا يفارقني، ولا أبرحه حتى وأنا أجلس في مكاني هذا فوق الصخرة الحمراء على سن الجبل. ألهثُ وأحسُ الوجع في قدميّ، وجع الركض لأكثر من ألف كيلو متر بغير انقطاع.
عرفتُ الجبل من خلال أبي، ولم تكن معرفتي به معرفة السائح المُتَمَتِّع. كان أبي يجرني وراءه عصر كل يوم، بعدما يطوي حصير البلاستيك الصغير تحت إبطه، وفي يديّ تضع أمي زجاجة الماء” (حقيبة الرسول ص 7)
كان لهذا المقتطع أن يطول لأنه يكشف عن كثير من الرؤى ويشكل عددا من العلامات الأكثر دلالة فى سياق وعى السارد الذى يسعى إلى نقله إلينا، الجبل هنا يمثل:
- الأبدية أو الدهر بمعناه الأزلى ويمثل مقدمة لسلسلة تبدأ بالجبل ومن بعده يأتى الأب ثم الابن فإذا ما انفرد الابن بالقدرة على اكتناز الحكاية وتقديمها بوصفها عنصرا معرفيا، فالجبل مع الأب يمثلان مصدر المعرفة وينفرد الأب بكونه ناقل الرسالة / المعرفة منفردا ، وبكونه أيضا يجعل من الجبل شخصية يعايشها وفق حالة صوفية دالة على كليهما ( الجبل والأب ) ،والجبل فى مستوى من مستوياته يمثل الطموح الإنسانى، الطموح الذى تناقله الجيلان (جيل الأب وجيل الابن)، طموح المعرفة والسمو .
الأب يعرف الجبل بالفطرة ودون تفكير بكنهه لذا تبدو معرفته بالجبل صامتة استاتيكية فى مقابل معرفة الابن بالجبل معرفة ديناميكية ومن ثم فالسارد / الابن وهو يعرف العالم يفتش حقيبة الرسول بوصفها وعاء تاريخ الأب وليس تاريخ الأب هو ما يقدمه السارد نقلا عن الآخرين أو عن أبيه نفسه وإنما هو يحصل معرفته بشكل عصرى ، ينقب فى الأشياء لمعرفتها يغزوها ولا يتركها تغزوه بعد الانبهار بها.
- المعرفة الجغرافية لدى الأب، والمعرفة التاريخية لدى الابن / السارد، فإذا كان الجبل فى وعى الأب مساحة تاريخه المتطابقة مع عمره فإنه لدى الابن مساحة لعمر البشرية جميعها ومن ثم لا يتعامل معه بوصفه خاصا بالأب فالأب مجرد ناقل للمعرفة السابقة أو عامل على تفتيح الذهب بها فقط “عرفت الجبل من خلال أبى” ص 8، الجبل هنا حالة صوفية ليس بإمكان المريد أن يدخلها دونما حاجة لشيخه الذى يعلمه كيف تكون طقوس الدخول وهو ما كان يفعله الأب “يهش فى وجهى أن أصمت وأتأمل، فيما يذهب في تأملاته التي تمتد وتطول إلى ما بعد مغيب الشمس، متوحداً مع الجبل والصمت والارتفاع الشاهق وتلك المهابة الرائعة التي يقذفها الكون المترامية أطرافه من تحتنا، لكن ما كان يجعل قلبي يسكت وتختفي نبضاته بحيث أكاد أُشْرِفُ على موت محققٍ هو توحد تمتمته الخافتة المنسلخة من أصداء الأصوات الصاعدة مع صوت كنت أحسه يهبط من السماء، ويتردد صداه في فضاء الكون الأعلى من حولنا جليلاً ومهيباً وخاشعاً ومفترشاً المكان بسطوة عظيمة” (ص 10).
- قرين الأب ليس على مستوى العلاقة الدائمة بينهما وإنما على مستوى كونهما شخصيتين متقابلتين ، متنافستين بدرجة ما ، الجبل يعنى الارتفاع الجغرافى ، والأب فى المقابل يعنى السمو الإنسانى ، الجبل يمثل وسيلة الأب لطرح سموه على وعى الابن .
ويتصل بالمكان العلامة الأساسية المطروحة منذ العتبة الأولى “حقيبة” بما تحمله من دلالات تتصل بالسارد وبالأب ثم بالنص فيما يطرحه.
لقد عمد السارد إلى تفتيش الحقيبة بوصفها الصندوق الأسود للماضى واستوعب ما تتضمنه من قيم وجودية بالأساس ،الحقيبة هنا يمكن تأويلها وفق زاويتى نظر :
- أولاهما تتأسس على كون الحقيبة اسما لإناء كما فهمها منتج الغلاف وكما يطرحها النص فى مستواه السطحى .
- ثانيتهما تتأسس على تجاوز الرؤية السطحية إلى مستوى أعمق تكون فيه الحقيبة صفة لتاريخ الأب أو للماضى بوصفه أمانة أو رسالة معنوية خاصة وأن الحقيبة لا تذكر فى مشهد حقيقى على مستوى الرواية وإنما تذكر بوصفها علامة ترد فى الحلم ، حلم الأب ” لكن النوم جافاني وأرسل إليّ بكابوس حقيقي، شيخ أسود في عباءة سوداء وتتدلى من كتفه حقيبة سوداء أيضاً، لا أعرف لماذا كنت أسير في الشارع، ولا أين أتيتُ، لكنني أعرف جيداً أنني أعود الآن إلي البيت. وراح الشيخ الأسود يظهر لي من خلف سور حديقة البيت المقابل، يتصدر الشارع من أمامي……………………………….
فرَبَّتَ علي كتفي ثلاثاً ثم هبط من عليائه يجثو بركبتيه أمامي، أنزل حقيبته السوداء من فوق كتفه، فتحها وئيداً وفي ثقة أخرج منها صورة إسماعيل ابني” (ص 109)
يمكن تأويل اللون فى علاقته بالشيخ الأسود والعباءة السوداء ليكون اتحاد الألوان بهذه الصورة منتجا عددا من الدلالات تحيل إلى الغموض وعدم الوضوح ، كما يمكن أن يمنحنا دلالة الخوف وغياب اليقين والشفافية ، وفى سياق المشهد نفسه لنا أن نرى فى ظهور الشيخ الأسود شكلا من أشكال التشويق الذى يدفع المتلقى إلى محاولة إدراك كنه الشيخ عبر التحرك فى واحد من الطريقين : فإما أن يتجه لتأويل الشيخ الأسود وفق رؤية تاريخية تعتمد على التناص مع منام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقصة الذبيح ، وإما الاتجاه للتأويل وفق ثقافة عصرية تقوم على الخرافة أو على منا تطرحه ثقافة تفسير الأحلام ، وهو ما يجعل الحلم ينحو إلى الانفصال عن الرواية بدرجة تجعل من الرواية حكاية إطارية تحتضن الحلم نفسه فهكذا الأحلام فى سياق النص السردى ، تتجول إلى نص جنينى ينام فى حضن المتن الروائى .
الشيخ الأسود يظهر فى المرة الأولى عبر الحلم أو الكابوس كما يرى الأب ، ولكن السارد يطور ظهوره المتكرر تسع مرات على مدار الصفحات (109-122) متجاوزا فكرة الحلم ومغلقا الباب أمام من يكتفى بتفسير الشخصية وفق ثقافة الحلم فحسب ، فلم يكن التكرار هنا والمساحة التى تكرر فيها ظهور الشيخ سوى نوع من التأكيد على المتلقى بأن الشيخ الذى ظهر فى الحلم يتأكد وجوده فى الواقع فاتحا الباب أمام تأويلات أخرى تتعمق إلى أن تدفعنا للقول أن مساحة من التطابق بين الأب والشيخ الأسود تجعل من الشيخ قرينا للأب ( بالمعنى الشعبى للقرين كما تطرحه الثقافة الشعبية ) أو هو بمثابة ضمير الأب وأعماقه النفسية .
ثانيا : العلامات التاريخية
تتحرك الرواية بين علامتين تاريخيتين تتداخلان وفق رؤية السارد : تاريخ الأب وتاريخ العالم ، الأول صنعه الأب ويشهد عليه الآخرون ممن منحهم السارد الفرصة للإدلاء بشهادتهم السردية ( الأم فى الفصل الثانى ، إسماعيل بن ادهم العبرانى فى الفصل الرابع – سعاد فى الفصل الثامن ) والثانى يتفاعل معه عبر التناص مما يشكل مرجعيتين تتعاضدان فى تشكيل شخصية الابن .
تاريخيا يمر الابن بمرحلتين أساسيتين : مرحلة الطفولة التى كان فيها تابعا للأب حيث تاريخ الابن لم يتشكل بعد ويكون على الابن لإدراك تاريخ الأب أن يستعين بروايات سابقة عليه لاستكمال الصورة أو ليكونوا بمثابة شهود العدل لتوثيق روايته ، ومرحلة الرجولة والنضج حيث استوعب التاريخين وباتت له شخصيته التى تكشف خبرته عملا بقول الحكيم :” إذا فقدت أخاك فقدت ذراعك وإذا فقدت أباك صرت رجلا ” والرجولة هنا عقلية تتجلى فى البناء الفكرى وليست مادية تتكشف فى البناء الجسمانى ففى الفصل السادس تتجلى خبرة الابن فيما يصف به الأب قبيل وفاته :” لا يوجد ما يساوى لمعان الحياة فى عين رجل حين يكون مقبلا على الموت ” ( ص 79) وقد تحقق نضج الابن فى رؤيته للحياة فلم يعد أسير الأب ولم يعش فى جلبابه لذا يقول فى الفصل الأخير :” صحيح أن أحدا لم يكن يعرف الجبل مثل أبى ، لكننى الآن أعتقد أننى أعرفه بطريقة مختلفة ………………… لكننى الآن وقد هدأت نفسى بعدما تخلصتُ من أسطورتي القديمة أعرف جيداً مَنْ أنا، مَنْ أكون، وأين أقف علي وجه اليقين ” (ص 131-132) بالطبع المعرفة المختلفة لا تتوقف عند الجبل وإنما تنسحب على الحياة ، إن فعلا مزدوجا يقوم به السارد فالنص يأتى على نظام مغاير لما سبقه ممن اقتربوا من منطقة البيئة المشتركة ، وما يتضمنه النص من محاولة المغايرة انسحبت على الشخصية التى حاولت رؤية حياتها متخلصة من أسطورتها القديمة ، تلك الأسطورة التى يصرح بها عند وفاة الأب الذى كان ملزما باتباعه مستسلما لسلطة أبوية لا تعنى العلاقة الإنسانية بالآباء وإنما تعنى معنى السلطة التى يمثلونها ، القيمة التى يكون على الأبناء أن يتجاوزونها لصالح حياتهم الجديدة لذا ليس غريبا ان يصرح السارد بأن حياته بدأت فى لحظة موت الآب :” إنه اليوم الأول في بقية عمري، وليس في ذلك أي قدر من التشاؤم، إنها الحقيقة فقط، فكل الأيام الفائتة قد انقضتْ من عمري وخُصمتْ من حساباته، ويأتي هذا اليوم الجديد كيوم أول في بقية عمري، أعيشه كحقيقة وواقع لا مهرب منه، أحكي فيه أسطورتي القديمة وقد مضتْ مع الأيام الفائتة، أحكيها لأتخلص منها فأشعر بطعم اليوم الجديد، عسى أن أعرف كيف تكون الحياة” ( ص 131) .
ومن ثم تأتى نهاية الرواية كاشفة عن المحاولة الناجحة لخلخلة أسطورته أو التخلص منها على حد تعبيره ووقوفه على ارض صلبة :” أنا الآن فوق قمة جبل عالٍ وتليد، أطأ بقدميّ صخرته الحمراء المستوية ………………….. تصفو الأرض من تحتها ويبين ترابها بشكل واضح، أرض مستوية تصلح لأن أسير من فوقها دونما أن تتلطخ قدماي بالدم، وبمعرفة حقيقية تُخبرني بأن كل الأشياء التي كانت راسخة من قبل لم تعد الآن كذلك.
أراني الآن أسير صوب بيوت البلدة بخطي واثقة، لا أحتاج لأي سبب كي أغضب من قدري. فقد اتخذتُ مكاني في المدرسة، صحيح أنه لن يكون بديلاً عن مكان أبي، وأنا لا أريده كذلك، لكنني سأحاول أن أعلم الأولاد شيئاً جديداً، شيئاً يبدأ من هناك حيث أغوار التاريخ الممتدة في الزمن………… غير أنه بكل تأكيد شيء مختلف ومُنْبَتُ الصلة تماماً بما فات، ليس سوى الامتداد والتطور، إنه وليد لحظتنا الراهنة، فالنظر إلي التاريخ لا يجب أن يعني بالضرورة النظر إلي الوراء، طالما أن الحياة تسير بشكل صحيح ولا تقف عند حد الدهشة، أو اجتلاب الذكري، أو الوقوف للغناء فوق الأطلال.
لقد أراد أبي أن يصنع مني رجلاً يحافظ عليه، أما الآن فأنا أصنع رجلاً من نفسي، أراني الآن يتحلق الأولاد من حولي في فناء واسع وكبير ومُظلل بأوراق أشجار كثيفة زرعتها بيدي، وأرى مريم تُقبل نحونا من بعيد، في يدها ورقة بيضاء، ناصع بياضها، وقلم بكر لم يَخُطُّ شيئاً من قبل، وحين تنضم إلينا نبدأ جميعاً في مراجعة الدرس” (ص 132-133) ومع إدراكه لقيمة المعرفة وانتقالها عبر الأجيال فإنه فى السطور السابقة يؤسس لمعرفة جديدة لا تقوم على اجترار الماضى بقدر ما تتأسس على الوعى به ومراجعته ، لقد حكى السارد تجربته دون أن يخضع للماضى أو يقع فى أسره وما الشهود الذين استعان بهم سوى وجهات نظر متعددة ومتباينة تؤكد أن الماضى وإن أتفق على بعض تفاصيله من معاصريه فإنه ليس القيمة الوحيدة التى يجب الالتزام بها فالذات يمكنها أن تصنع تاريخها عبر أوراقها البيضاء ، وما صفات البياض المتكررة فى السطور الأخيرة من الرواية سوى شاهد على هذه العذرية التى كانت مريم رمزا لها ، ومريم هنا فى سياق مجالها الدلالى الذى تتشكل منه صورتها تطرح صورة مستقبلية يراها السارد تتحقق فى مستقبل الأيام :” أراني الآن يتحلق الأولاد من حولي في فناء واسع وكبير ومُظلل بأوراق أشجار كثيفة زرعتها بيدي، وأرى مريم تُقبل نحونا من بعيد، في يدها ورقة بيضاء، ناصع بياضها، وقلم بكر لم يَخُطُّ شيئاً من قبل، وحين تنضم إلينا نبدأ جميعاً في مراجعة الدرس” ( ص 133) ، والصورة السابقة لا تكتفى بوظيفتها الدلالية المشار إليها فحسب وإنما تتجاوزها إلى إنتاج بعد نفسى يوظفه السارد لتخليص متلقيه من الانغماس فى الماضى ، فالمتلقى الذى عاش مع السارد تجربته منغمسا فى ماضيه من الممكن أن يستمرئ البقاء فى الماضى لذا لجأ السارد إلى طرح ما من شأنه أن يخرجه من انغماسه ، إنه فعل المخرج الذى ينجز فيلما عن سجين ويجعل المشاهد ملازما سجينه طوال الفيلم فيكون عليه – حتى وإن لم يتحرر السجين – أن يخرج المشاهد من السجن عبر التأكيد على ان العالم ليس بالضيق الذى عايش فيه بطله وإنما العالم لم يفقد اتساعه بعد (هناك سابقة يمكن الاستيثاق منها بمراجعة فيلم The Shawshank Redemption للبطلين : تيم روبنز ومورجان فريمان ومن إخراج فرانك داربونت)
ثالثا: العلامات البلاغية، بين التناص والتشبيه
يحتاج المتلقى فسحة من الوقت قبل أن يدرك فعل التناص الذى اعتمد عليه السارد ، التناص اختيار والاختيار موقف ، والموقف يعكس رؤية السارد لمرجعياته ، واختياره للعزف على وتر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يكشف عن خلفية دينية لا تخفى على المتلقى ولكننى لست هنا لتأويل فعل التناص فمساحة اقتراب المتلقى منه تتأسس على عامل خارج النص أولا بمعنى معرفة المتلقى بالنص السابق ، وعلى عامل داخل النص ثانيا يكمن فى قدرة السارد على التأثير فى متلقيه من زاويتين : زاوية قدرته على جعل المتلقى يتقبل العلاقة بين النصين واستيعاب هذه العلاقة ، وزاوية قدرة السارد على الإيهام بأن النص اللاحق لاعلاقة له بالسابق فقد يتعامل القارئ مع الرواية بمعزل عن مرجعيتها وعلى الرغم من أن السارد يبث علامات تغرى بالتأويل وتدفع المتلقى للربط بينها ( موسى – مريم – إبراهيم – إسماعيل ) على الرغم من ذلك فقد تظل هذه العناصر بعيدة عن وعى المتلقى للربط بينها وإدراك قدرة السارد على توظيفها .
التناص عند المتلقى المدرك يشبه إنتاج التشبيه بمعناه البلاغى حيث المشبه ( اللاحق ) والمشبه به ( السابق ) والتشبيه هنا يقوم بوظيفتين يحققان مدى واسعا من الحيوية فى النص :
- وظيفة التوجيه : حيث يجد المتلقى نفسه مدفوعا للتوجيه نحو السابق بوصفه مشبها به .
- وظيفة الاستدعاء : حيث يستحضر المتلقى تفاصيل العالم الذى سبق أن توجه إليه ، وهو ما يفتح بابا زمنيا للمرور إلى مساحة حركة بين نصوص متباعدة وحكايات مختلفة تربط بينها روابط خفية .
التناص والتشبيه هنا يجعلان من الرواية نصا تشعبيا ينفتح ليجعل من عملية السرد منطقة عبور بين عالمين تماما مثل عملية العبور التى خاضها السارد منجزا سرد أسطورته التى تخلص منها بالحكى ، وحيث الحكى هنا وسيلة لتجاوز الأزمة فإنه بالنسبة للمتلقى وسيلة لتجاوز أزمته الخاصة إذ يكون فعل القراءة بهذه الصورة قادرا على أن يمنح المتلقى قدرا من الحركة بين العوالم المختلفة تماما كحركة المتلقى للربط بين المشبه والمشبه به اللذين كلما تباعدا ضمن هذا للصورة أن تكون على قدر كبير من التفرد ، وهو ما نجح السارد فى إنجازه حين استدعى قصة إبراهيم وإسماعيل لتكون هناك فى الخلفية نابضة بما تتضمن من قيم تلتقى وقيمة الأب وسلطته أيضا ، وتعرب عن أن لكل منا أسطورته الخاصة التى لن ينطلق فى بناء حياته مالم يتخلص منها وهو ما نراهن عليه مع محمد صالح البحر أنه فى ” حقيبة الرسول ” تخلص من أسطورته لبناء نص قادم هو نص ما بعد الأسطورة ، هو نص يعلن عن موهبة قادمة تؤسس لنفسها مقعدا متميزا فى فضاء السرد الروائى العربى ، لقد أحسن السارد فى اكتشاف أسطورته كما أحسن باختيار زاوية رؤيته للعالم ، وتوظيف قدراته الخاصة فى تشكيل نصه وفق رؤية جادة تمكنه من تقديم منجزه المتميز وليجعل فى النهاية من الحقيبة ، حقيبة أسطورية تحمل عالما لن يتكشف إلا بمحاولتنا الجادة لفتحها وتفتيشها كما فعل البحر.