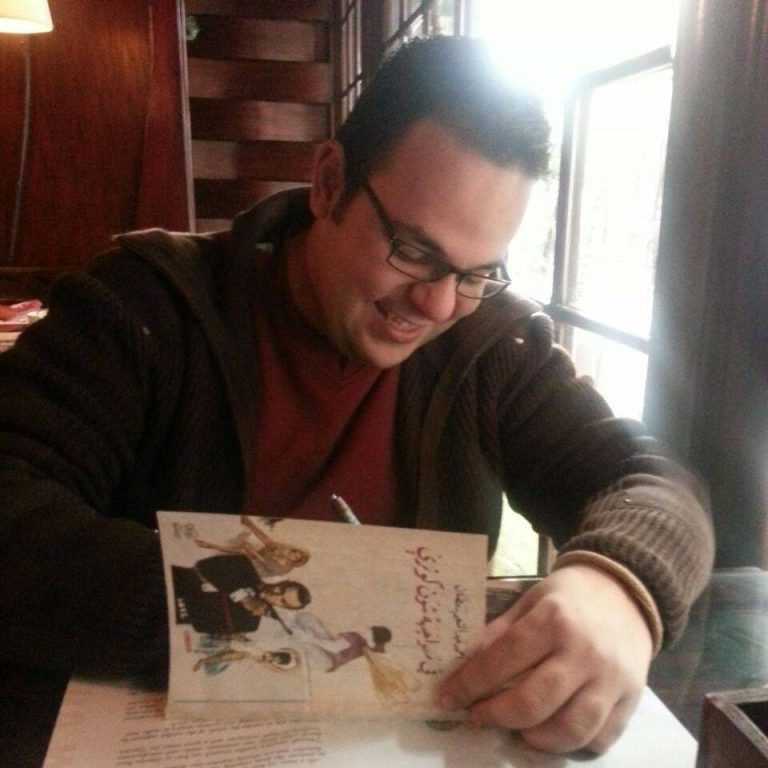في المحطة الرابعة– آسف- سأسميها الفجر لا يأتي القطار.. يا للجملة الشعرية المبتذلة, لا يأتي القطار.. أو كل القطارات لا تتوقف في محطتي.. أو ربما مضى قطار العمر يا ولدي.. لماذا أعتقد دائما أن الليل لا ينتهي وأن الضوء هي حالة افتراضية مخططة لا تأتي إلا بعد الغياب, ها هي الساعات تندلق هباء والقطار لا يدخل المحطة إلا ليغادرها دون أن يفتح أبوابه, وها هو ضوء الفجر يظهر(جملة مبتذلة أخرى) لا يأتي القطار ولا أعرف أحدا ممن يجلسون قربي.. أتمشى باتجاه الأفق الجنوبي علّي أصل.. إلى شيء ما.. ربما.. يناديني صوت خافت ثم يرقد كالعصفورة على كتفي.. لا يوجد مكان تهرب منه من هنا.. سوى خروجك من المحطة ولكنني أعتقد أنهم سكارى.. أقفلوا البوابات بالأقفال السميكة ونسوا الركاب هنا على الرصيف.. كي يلتقوا سوية بعد عشرات السنين، أليس لهذا الغرض تم اختراع أرصفة محطات القطار.. لقد افترقنا في مطار شارل ديجول قبل إثنى عشر سنة ولم نلتق (بحق) من وقتها.. لا أعرف لماذا.. ولكني أقرأ نصوصك.. دور الضحية رائع.. تتقنه بمهارة.. ثم أخذت يتصرخ..أنتم معشر الكتاب شعب “خروات” حقير.. عليك أن تحشر كل نصوصك وكتبك هذه في دبرك.. مع أنني واثقة أنك ستتلذذ.. هيا.. ماذا تنتظر لا مفر من هنا.. خبرني ماذا حدث منذ لحظة افتراقنا عند السلالم الكهربائية الأنبوبية في شارل ديجول.. هيا وبالتفصيل…
في المحطة السابعة– أصبح الأمر مملا- سأسمي المحطة هذه المرة طريق البحر… ففي طريق البحر ثمة أمور يجب أن تذكرك بالبحر..لا أن يعزف المسن في الوقت الضائع موسيقى لنهر الدانوب ..أو أن تسرح الأم شعر بنتها الذهبي الناعم الطويل قبل دخولهم إلى عرض البالية المسائي.. لا أعرف أحدا ممن يجلسون قربي ولا حتى تلك الدمية التي تتقيأ شرائح حزن..أو ذاك الرجل الأنيق بالحذاء اللامع وحقيبة المدراء الهامين والذي يبحث في أكوام القمامة عن شراب مختمر وعن منديل معطر بآخر لحظة حب ذات معنى تسللت قربه…أشعل سيجارة, أحمل الفأر الذي يجلس على المقعد الشاغر ويقضم فتاتا غريبا يبدو كالعظم وأضعه داخل الحيز المبعوج بين لوحة الإعلانات الطويلة وشريحة الزجاج المطعم بالبلاستيك ..التي تغطيها …يداهمني صوت طفل او طفلة (يتعلق الأمر بشؤون الخلافات حول الفجوة المتسعة بين النوع والجندر) ..أيها الشرير هذا ما تفعله بالفأر تلقي به بين جدارين.. ألم تعرفني.. بالتأكيد لا… قبل تسع سنوات قرأت قصتك “البيت السابع” وقد راعتني هذه الفقرة “في البيت السابع زحف الرجل الأبيض الأنيق نحو سرير الطفلة النائمة, ومنذ ذلك الحين لم تعد الأجوبة المُعدّة سلفاً.. تعني شيئاً”. أنت لم تكملها لأنك شرير ولم تجب على أي سؤال لأنك كلبي يتلذذ بأوجاع الآخرين ويشرب العرق ويمز على كبد الأطفال.. ولكني لا أحب العرق.. الكحول إجمالا.. واقرف من رائحة الكبدة.. يعني ممكن أن آكلها إذا كانت مقلية إلى درجة التحجر شبه التام.. أصمت.. أنا لم أكبر منذ ذلك الحين ولا أعرف إن كنت بنتا أم ولد..
في المحطة الثالثة عشرة- سأسميها- المتحف, ينقب المسافرون عن أثار قديمة, ينصبون الخيم السوداء فوق كل حفرة , ويتلفتون حولهم كي لا يضبطهم أحد عندما يجدون عظام موتاهم ..يقف قطار وتنزل منه امرأة بولندية بشعر مكوي وتايورا أربعينيا , تمسح المرأة دمعة جمدها سواد الكحل وبرودة الجو, على شكل قطرة نموذجية..يخرج بعدها رجال كثيرون , تنظر إليهم إلى الخلف بمرارة مستكينة وتمضى وكأنها لن تسامحهم طيلة موتها على ما فعلوه بها داخل القطار, وأنا أتأمل الرجال بالقبعات والكوفيات البيضاء يناديني صوت أبي ثم أجده أمامي (خلافا لما حدث في مسرحية كاسك يا وطن) ..أنا لم أفهمك مرة, لم أفهم مرة تلك الهوة السحيقة بين المخلوق(الصبي المنتظر) الذي خططته بعناية وبين النتيجة ..وذاك الجن الذي ركب الصبي..هنالك سنوات لا أذكر منها شيئا, أنا لا أفهمك أيضا ..لماذا كنت تبتسم في خلقتي طوال الوقت؟ لماذا كنت تخبر البائع المتجول عن ابنك الكاتب, وتهدي الشحادة كتبي بدلا من فتات طعامنا أو قطعة لحم ونقود.. لماذا؟.. لأنني لم أستطع تحمل تفاصيل النص..لأنك لم تستطع تحمل ما ضاع وفلت منك من.. من مشهديات ومكاشفات مشهية في النص..
في المحطة الأخيرة – لا أسم لها, نبقى أنا وقطة صغيرة ولدت قبل أسبوعين على ما يبدو, انتشلها من بين القمامة وأعود إلى “البيت“…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجي بطحيش
شاعر وقاص – فلسطين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصورة من فيلم: طوق الحمامة المفقود 1990
للمخرج: ناصر خمير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص الكتابة