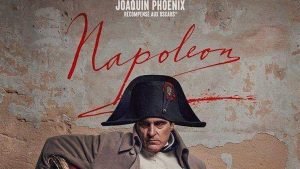أحمد عبد الرحيم
يدور الفيلم التلفزيونى الأمريكى Day One أو اليوم الأول (1989) وقت الحرب العالمية الثانية، حول انتاج الولايات المتحدة الأمريكية لأول قنبلة ذرية فى التاريخ، وفى أحد مشاهده، يذهب الچنرال الذى يدير المشروع إلى زيارة العلماء المُكلَّفين باختراع القنبلة، حيث كانوا حينها فى خلاف صاخب، يردِّدون فيه مصطلحات علمية معقدة، ويتناوبون على كتابة معادلات ما على سبورة. جلس الچنرال يتابع الأمر صامتًا، وبعد انتهاءهم من شجارهم، نهض فى هدوء، وأشار إلى أن ثمة معادلة حسابية خاطئة على السبورة. طبعًا ذُهل الكل لصحة ما قال، وكانت المفارقة ما بين علماء كبار، ورجل لا يمتلك علمهم، ومعادلة غير دقيقة سيترتب عليها – فى هذه الحالة – عواقب وخيمة جدًّا. حسنًا، لماذا تذكرت هذا المشهد وأنا أشاهد بعضًا من المسلسلات المصرية حديثة الإنتاج؟!
السبب أنى لاحظت إصرارًا عجيبًا، مريبًا، من قِبل هذه المسلسلات على أن يتحدث أبطالها باللغة الإنجليزية، مع حشو حوارهم بكلمات لن تفهمها جموع المشاهدين، ليس فى مصر وحدها، وإنما فى الوطن العربى قاطبة. حينما يضع مؤلف العمل الفنى كلمات بلغة مغايرة على لسان أبطاله فهو إما يميِّز ثقافة شخصية، وإما يوجِد مفارقة لها هدف؛ مثل مفارقة فيلم اليوم الأول، لكن عليه ألا يطيل فى ذلك، مع تبسيط هذا الكلام، أو التبرع بمعناه فى جملة لاحقة، حتى لا يبقى غريبًا كما هو. فتلك الكلمات، خاصة مع كثافتها، ستمثِّل عائقًا أمام المُشاهِد سيمنع إدراكه للمعلومة أو الحدث أو المفارقة، وسيشعره بالاغتراب عن العمل الفنى الذى يتعالى عليه، ويحادثه بلغة لا يفهمها. لا أظن أن هناك فنانًا يتمنى هذا لعمله، ويرجو تلك العلاقة مع مشاهده، لكن من واقع ما أشاهده حاليًا، يبدو أن الجيل الجديد من المؤلفين، بل المخرجين والممثلين والمنتجين؛ صاروا لا يعيرون هذه النقطة الجوهرية أى أهمية، مفترضين أن جميع المشاهدين من خريجى الجامعة الأمريكية!
فى مسلسل مثل بدل الحدوتة 3 (2019) إخراج خالد الحلفاوى، أو سوبر ميرو (2019) إخراج وليد الحلفاوى، يصل الأمر إلى أقصى درجات استفزازه حينما تجد جانبًا كبيرًا من المشهد مكوَّنًا من كلمات إنجليزية. شاهدت شخصية تستأذن من لقاء قائلة: “أنا عندى ميشن”، والمقصود mission أى مهمة، وأخرى تسأل: “البرايد ميدز ح يلبسوا إيه؟” والمقصود bridesmaids أى أشبينات العروس! وثالث يدلِّل على سعيه للتحسن بأنه انضم إلى “جروب ثيربى”، والمقصود group therapy أى علاج نفسى جماعى، ورابع يحكى أنه قام بـ”كارير شيفت”، والمقصود career shift أى تغيير مسار عمله، ناهيك عن أكثر من شخصية تعترض، أو تتفاجأ، عبر استعمال لفظة shit أى خراء! وأخيرًا وليس آخرًا، تخبر شخصية أخرى بأن فى حفلتها لابنها “كلاون”، فتفرح الشخصية الأخرى، مؤكِّدة أنها ستحضر الحفل، لأنها تحب أكل الـ”كلاون”، والمقصود من الأساس clown أى مهرِّج؛ وهى المعلومة التى أجزم أن ملايين المشاهدين لا يعرفونها، وبالتالى لن يضحكوا على المفارقة المقصودة!
فيلم “اليوم الأول”
تخيل أن هذا حوار مشهد فى مسلسل مصرى: “أنا لسه متخانقة مع جوزى، وبجد كده إينف”، “الدريس عليكى حلو قوى”، “البوس بتاعى فى الشغل يهمنى ألفت نظره”، لازم نعمل شوبينج”، “بس نظبط البدجت”، “جونجراتوليشن يا حبيبى”، “أى برومس يو فى الجريد تو ح أجيبلك إللى إنت عايزه”. إذا ما لمتنى أنى لم أقم بترجمة هذه الألفاظ، فعليك – فى الأصل – أن تلوم صناع هذا العمل؛ مرة لأنهم لم يعبئوا بك، ومرة لأنهم قدموا إليك لغة هجينًا، غاية فى القبح!
السؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا هذه الفرنجة؟! إذا كانت هذه هى لغة صنّاع الأعمال؛ فليتكلموا فى حياتهم الخاصة كيفما يريدون، لكن هذه دراما، أى فن يفرض قواعد مختلفة. وإذا ما كان مُبرِّرهم أن هذه هى لغة الناس؛ فعدد من لا يتحدثون بهذه اللغة أكثر بآلاف الأضعاف، وهو ما يعنى أن الأغلبية ستجلس دون إدراك لما يقال. وحتى لو كانت ثمة شخصيات فى الواقع تتحدث بهذه اللغة المُختلطة، ويضطلع المسلسل بعرضها؛ فعلى صنّاع العمل استيعاب مُشاهِدهم، واحترام عقليته، والسعى إلى توضيح كلمات النص له، وإلا لن تصله رسالتهم المرغوبة.
إن تقديم شخصية درامية تنسال اللغة الإنجليزية، أو غيرها، من لغتها اليومية ببديهية، أمر يفرض الحذر فى التعامل معه؛ لأنه لو زاد على حده سيضيِّع تواصل المشاهد معه، وصبره عليه. وكم من مؤلفين كبار، من أجيال أقدم، لم يسعوا إلى إنطاق شخصياتهم الإفرنجية، أو المتفرنجة، بهذا الأسلوب المعتل. لقد عرفوا مجتمعهم، وحادثوه بلغة يتوافر فيها عنصر القبولية. لكن من الواضح أن مؤلفى اليوم لم يشاهدوا أعمال مؤلفى الأمس، أو شاهدوها لكن لم يتعلّموا منها؛ ليس لأنهم صاروا يفرطون فى الفرنجة مع شخصية واحدة، وإنما مع شخصيات عديدة!
مثال: فى الحدوتة الثانية من مسلسل بدل الحدوتة 3، نتابع شخصية الفتاة “لهفة” متواضعة التعليم التى تحاول إيهام الآخرين بتعليمها العالى، وذلك عبر حشر العديد من الكلمات الإنجليزية فى حوارها، ونطقها على نحو سيئ. المشكلة لم تكن فى مبالغتها فى الحديث بهذا الشكل طوال الوقت، وإنما – أيضًا – فى حديث بقية الشخصيات من حولها، حتى أبيها الكومبارس البائس، بكلمات من هذا النوع. لقد وصل الأمر، فى هذا المسلسل وغيره، إلى درجة متطرفة، وممجوجة، تطلّبت لوحات ترجمة على الشاشة باللغة العربية!
الأخطر من تعثُّر فهم المشاهدين لحوار العمل الفنى، والتصميم الكريه للفنانين على هذه العقيدة الجديدة، أن ثقافة المجتمع تتأثر سلبيًّا. حينما تغزو هذه الأعمال شاشاتنا، وتحادثنا بلغة أجنبية لأكثر من اللازم، فهذا يعنى الابتعاد عن اللغة القومية، ومن ثم تداعى الثقافة الوطنية. إذا اعتقدت أنى أبالغ، فاعلم أن ميل ثقافة وطن إلى ثقافة أوطان أخرى يعكس ضعف شخصيته الحضارية، واستسلامه إلى حالة مغايرة فى التفكير والمعيشة. اسأل نفسك: لماذا يسعى الاحتلال عند استيلائه على أى دولة إلى ضرب لغتها القومية، وإحلال لغته بدلًا منها؟ ليس الغرض خلق تواصل سهل مع أهلها، وإنما مسخ هوية تلك الدولة، وفصلها عن تراثها وتاريخها وملامحها، وحينما يفقد الوطن ذاكرته، وتتهاوى شخصيته، يسهل تحويله إلى تابع أو عبد. إنها عملية ابتلاع تجعلك فى بطن الآخر؛ ظانًّا أن هذا هو التقدم المنشود. فاللغة ليست فقط وسيلة تخاطب، وإنما أيضًا رسول حقيقة شعب، إذا ما تم العبث بها، عبر إدخال لغة غريبة عليها، فسيؤدى هذا إلى تسميم الرسول، وإضعاف الحقيقة، وإبعاد الشعب عن ذاته، وتحويله إلى كائن ممسوخ الهوية؛ كأنه الغراب الأبيض الذى عجز أن يكون غرابًا أسود، أو حمامة بيضاء، وبقى فى منطقة وسط؛ شاذة ومؤسفة.
احتلال اللغة الإنجليزية لحوارات بعض من مسلسلاتنا المعاصرة أمر خطير. لكن المؤلم بحق أنى لا أجد معترضًا على ذلك. الكل يشاهد، ويفوِّت ما يجهله من كلام، ويتابع فى بلادة، دون أن يسأل نفسه: “ما معنى هذا؟”، و”لماذا يتحدثون هكذا؟”، و”ما عاقبة ذلك؟”، بل يقتنع بالثقافة المشوَّهة المعروضة عليه، مُحاولًا تقليدها فى حياته الشخصية. ومع تدهور حال التعليم، لم يعد لدى الأطفال، والمراهقين، والشباب إلا النجوم كى يتعلّموا منهم. لكن بئس النجوم، وبئس العلم. هذه المرة، المعادلة خاطئة على السبورة، ولا أحد من كتّابها أو مشاهديها يلاحظ أو يهتم. والنتيجة – فى رأيى – مخيفة أكثر من القنبلة الذرية.
…………………………….
نُشرت فى موقع “صحيفة المثقف” – العدد 5208 – بتاريخ 8-12-2020.