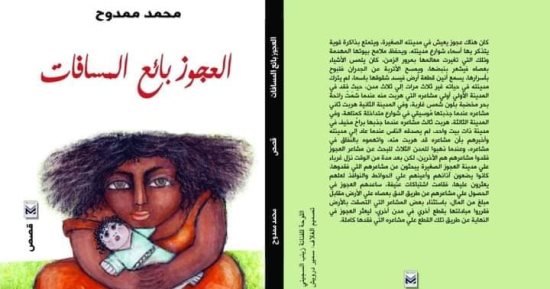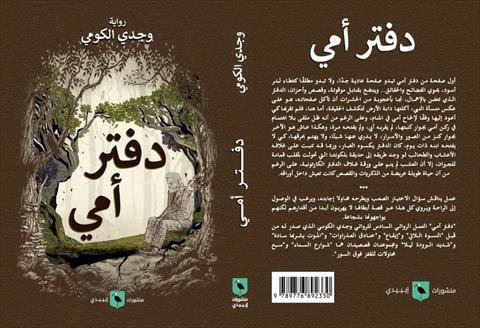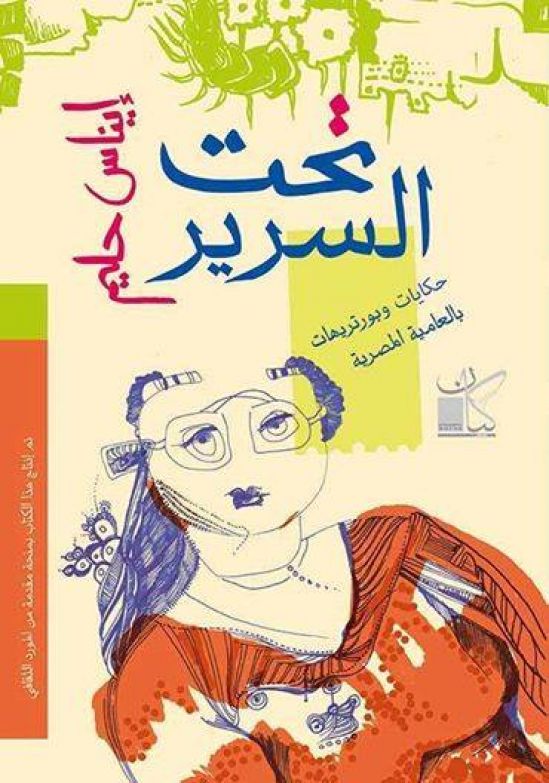هذه المقدمة قد تبدو أحد المداخل المُهمة إلى رواية ” الملك الوجه ” لـ ” محسن يونس ” تلك الرواية التى ضَمّنها الروائى إضافة توضيحية على الغلاف فى عبارة: متن واحد وأربع نهايات. كأننا أمام علاقة مفارقة بين متن هو دائمًا واحد، وعدة نهايات محتملة. الإضافة هنا تؤكد رغبة الراوى فى إجراء حوارٍ فنى مع القارئ، وإدخاله فى علاقة جدلية مع النهايات التى لا ينبغى أن تكون واحدة كالمتن، بل كأنها عدة احتمالات متاحة على الدوام، ويجب أن تملك كل منها وجاهة الحقيقة، وهو ما نكتشفه من خلال القراءة المتأنية والفاعلة مع النص الروائى.
إننا هنا بإزاء ملك له عين واحدة على جانب وجهه الأيسر، وله أذنا فيل. ملك مُشوه ومُضحك، لكنه يحمل عقلًا ذكيًا، ونفسًا ماكرة لئيمة تلعب بمصائر البشر، فتمزقها، أو تطوحها يمنة ويسرة كأى طفل يفعل بألعابه. حاشيته مِئة حكيم اتخذتهم الملكة الكبيرة منذ زمن طويل بطانة للملك المؤسس الذى كان بلا عقل، فصاروا يُورَّثون من ملك لآخر. مستشارون، وقادة عسكريون. لا همَّ لتلك الحاشية سوى الحفاظ على حياة الملك، وتنفيذ أوامره برسم خريطة لمملكة الرمال التى لا تستقر حدودها على حال. لدينا فى خلفية تلك الوجوه الساطعة روائيًا شعب، وهذا الشعب مجرد ديكور. لا صوت، ولا لون. فقط بعض هيئات أدمية غير موصوفة تنعكس على عين الملك إذا ما نظر من شرفة قصره، أو صراخ مذعور على خلفية معارك العامة التى تشغلهم عن حقوقهم.
ثمة علاقة فارقة بين الغياب والحضور، فالغياب يبدو متعلقًا بالمتن ( الملك، والملكة، والحكماء المئة، والمستشارون، والقادة العسكريون لا أسماء لهم. فقط يُكنَّى عنهم بوظائفهم، أو سماتهم )، بينما الحضور يكون أكثر اتصالًا بالدخيل، أو الغريب ( صفوت البرنابى، وتابعه غباشى، والطائر الذى حرص الملك على تسميته بالسامورنيس )، وهو ما يدلل على أن متن الحكاية هنا يتجاوز تاريخها الموضوعى، أو المُتخيل إلى إضفاء سمة النمط عليها، فبإمكانها أن تتوالد على مر العصور بنفس الطريقة، حين يستسلم الإنسان لشروط السلطة المطلقة كأنها قدر إلهى لا فكاك منه إلا بالموت، أو الهجرة. والعلاقة بين الغياب والحضور أيضًا فى لعبة الإيهام تلك تجعلنا فى مواجهة مباشرة مع الكوابيس، تلك البؤر السوداء التى تُدّوم حولنا لتبتلع كل شىء فى غياهبها المظلمة.
حظيت البنية السردية على الجانب الآخر، رغم هلامية الحكاية، واتساعها للإضافة أو الحذف، بشكل متماسك. مُحكّم. كأن الشكل الروائى ( وهو جزء لا ينفصم عن المضمون ) يدعونا ألا نستسلم من ناحية لهذا النظام الصارم، وما يمنحه من أفكار محددة فى مقابل اتساع الحكاية، وإشارتها الضمنية إلى فكرة الأنماط التاريخية المتكررة، ومن ناحية أخرى تُشير إلينا بثنائيتها المتناقضة تلك إلى عدم الاستسلام إلى الفوضى كوسيلة لتفسير العالم، والتاريخ؛ لأن لكل فوضى إطار سردى منظم وراسخ شرط أن نمتلك الرؤية الأعمق لقراءة ما وراء الظواهر مع القدرة على ربط الحاضر بالماضى، وهذه كبرى مراوغات الحكاية التى يُشكّلها السرد، مؤكدًا أن فخاخ التأويل ما هى إلا جزء من مؤامرات هذا التراث الذى يمنحك الشىء ونقيضه فى الوقت ذاته.
ثمة دمج بين وظيفة السارد كُلِّى المعرفة والسارد العضوى، فالصحراوات الخمس ( صحراء هروب المسافات سواء أكانت فى وسع العالم أو قيد حجرة – صحراء أن تدرك فى وهمك ما لا تستطيع أن تدركه فى الحقيقة – صحراء لقاء الثابت والعارض – صحراء ماذا تقول حبة الرمل لحبة رمل ملاصقة لها – صحراء تفقس وهما يحلق نحو خريطة وأربع نهايات ) يتدخل الراوى فيها أحيانًا كالرائى، وأحيانًا كالمشارك بالتعليق، أو التحيز لوجهة بعينها، كما كانت السخرية عنصرًا مهمًا لإبراز التناقض، وكشف طبيعة الشخصيات والحلول، وهى تحيلنا إلى السخرية الكبرى، حيث يبدو عالمنا بضفتيه مهترئًا، لا ثبات، أو أحكام نهائية فيه، ولا حقيقة مطلقة يمكننا أن نرتكن عليها مُطمئنين.
إنها مملكة مخاتلة. حدودها لا تُرسم؛ لكثرة جموح الرمال. كأننا فى مملكة من تلك الممالك التى يعشقها التراث الحكائى العالمى كألف ليلة وليلة، وتأتى دعوة الروائى فى البداية إلى الانتباه متسقة مع جُملِه القصيرة، المتشظية ككسر الزجاج. وامضة. مخاتلة الألوان، والدلالات. كما يعد الحوار تكئة رئيسة للسرد حيث يُشكّل جزءًا كبيرًا من كل فصل بلغته الفصحى الأنيقة والفلسفية فى الغالب، وهو حوار كاشف للأفكار، ومكنون الشخصيات، واتجاهاتها.
جاءت صحراوات الرواية لا كأماكن فقط إنما علامات للفهم، وطرح الأسئلة أيضًا. هل نحن فى مواجهة كوابيسنا والتى تعنى دلاليًا مخاوفنا من السقوط فى مملكة كتلك لا حدود لها، و بالتالى لا هوية، وقطعًا لا أمان للعيش فيها مع ملك ماكر وطائش ومستهين بالجميع؟ أم نحن بمواجهة عالم عجائبى يطمح إلى طرح رؤاه حول عالمنا الواقعى والذى لا تقل كابوسية عن مضامين الرواية المقدمة، حيث الموت بلا ثمن، والحياة بلا معنى أو هدف؟
رَسمت الصحروات علاقات السلطة بمشهدية تعتمد التداخل البصرى، والإضاءات على نتف من تاريخ كل حادث، أو شخصية. واستخدمت المشاهد فى صحراوات أربع، واستخدم التداخل فى الصور والحوارات، والمونولوج فى صحراء واحدة هى ( صحراء لقاء الثابت بالعارض ) حيث نطّلع فيها على حياة صفوت، وأحلامه، ومخاوفه، وكذا تابعه غباشى.
إن الملك بوصفه قناعا للسلطة فى المملكة التى لا هوية لها يبدو على طول المتن الروائى، وفى ثنايا حوارات الشخصيات المُكلّفة برسم الحدود هو الشخص الوحيد الذى يستفيد من مراوغة الرمال، بل يساعد عليها بظهور شبيهه العجيب على الحدود، ومراقبته لكل شخصية فى المملكة يرى فيها الذكاء والتفرد؛ للإطاحة بها عند أقرب فرصة. يحضرنى هنا الحكمة القائلة: ” الجزاء من جنس العمل ” حين أقرأ أساليب الملك فى الخلاص من رجاله، فهو بسخرية لاذعة، ومكر لا يمكن تجاوزه يُدبّر الحيلة تلو الحيلة من فم محدثه؛ ليقضى عليه كأنه القدر. إنه نموذج الأنا النرجسية المتسلطة. الأنا التى تحلم بالفرادة والتملك ويؤرقها القلق, والخوف، والمرآة التى تكشف صورتها، بينما تمثل الملكة ( الحسية التى لا تشبع ) الهو بغرائزه المنفلتة، بينما الحكماء يسكنون موقع الأنا الأعلى الذى تسخر منه، وتطيح بصوته تلك الأنا النرجسية المتسلطة لذات ملوك من هذا النوع امتلأت بهم كتب التراث، وصفحات الواقع المرئية، وبالاتكاء على فعل الإسقاط الروائى كما يدعونا الكاتب من البداية نرى من خلال فانتازيا الرواية بنية الإنسان الأنوى المُشوه نفسيًا، والمُدمر لكل قيمة ومعنى.
فَضْح القصور التاريخى لناسخى، ومؤرخى العصور القديمة أحد ركائز ” الملك الوجه “، فالأحداث محورها قصر المُلك وما يدور فيه، والقرارات التى تُتخذ وتُنفذ، أما الشعب فمجرد ديكور. يُعزز الغياب الضمنى للزمن داخل تلك المملكة هذه القراءة، فرغم حضوره الفيزيائى فى ذِكْر الليل والنهار، وكر الأيام، ووراثة المُلك من واحد لآخر إلا أن حضور الزمن المنطقى غائبًا، فأى تطور ينتظره شعب فى مملكة هذه سماتها. وأى وعى، أو مهارة يُطورها البشر باستسلامهم للتسلط، والديكتاتورية وإيمانهم بقداسة الحاكم، وامتلاك الماضى كل قدرة على تفسير الحاضر وقيادته. إنها كابوسية السلطة المطلقة التى تبرقش الجغرافيا الأرضية بألوان البوار، والتاريخ بألوان الرعب، والأحلام المجهضة.
فى ثنائية أخرى من ثنائيات الرواية تأتى فكرة الثابت والعارض، وتكاد تحوى إضاءة مركزية على جوهر تلك البنية المعقدة بين التراث والحاضر، فالثابت تكمن قوته واستمراره فى رفض العارض، والصراع الدائم معه، وإن لم يتح ذلك للثابت المُكرس فلا بد من احتواء العارض سريعًا، ثم الانقضاض عليه، حيث تكون الخطورة فى تَسرُّب هذا العارض إلى أوصال المملكة، كأنه جداول الماء تحت هضبة تبدو متماسكة، غير أنها ذات لحظة ستتفكك وتنهار.. ولنقرأ هذا الحوار الكاشف ص 128
قال حكيم أخذ يتمخط فى منديله: ” النظام فى خطر أيها الحكيم الثامن.. ألا ترى بداية الانهيار؟! “
” أى نظام؟! “
” نظامنا يا أخى فارع الطول.. نظامنا.. “
” وهل يمكن للعارض أن يهز قواعد الثابت؟! “
” يمكن أن يمحوه لا أن يهزه فقط، وتسمون أنفسكم حكماء؟! “
إن إحدى قراءات الرواية أيضا على المستوى الاجتماعى تشير إلى هذا الخلل الذى صاحب عوارض لم ننتبه لها فى البداية، ثم هاهى تبدو فى مراحلها التدميرية وقد جرت المجتمع صراحة إلى تفكك الهوية الوطنية، وانسحاق الأحلام، والقيم الإنسانية. ” صفوت البرنابى ” كان حالمًا وسط مثقفين حالمين فى مجتمع أطاش بأحلامهم فتشوهوا وشوهوه.. ص 96 ” خُذلنا وخذلتنا ثقافة سبعة آلاف سنة، فلم تصمد أمام ريح هبت فجأة فجرفت الفعل، وشقَّ علينا الاختراع والاكتشاف فى دنيا العلم، فولَّيْنا عقولنا شطر النصوص والأقوال، وكثر من حولنا التدليس اللغوى خاصة مع كثرة افتتاح الفضائيات… “. ” صفوت البرنابى ” يؤرخ بلا قصد، وسط حديثه عن أحلامه القديمة، لذلك الانهيار الثقافى، والمجتمعى المصاحب لانفتاح السبعينيات من القرن الماضى، ويعترف أنه باع أحلامه ليركب الموجة.
هنا حالة تبادل أمكنة مجازى بين مملكة الرمال التى لا يتقدم الزمن فيها للأمام أبدا نحو أى قيمة إنسانية عالمية، وبين الحالة المصرية المعاصرة والتى تدور داخل دائرة، ولا تنفلت من محيطها أبدا إلى الأمام، وهى بالمناسبة ما تشير إليه إحدى النهايات حيث يفكر هذا الملك فى غزو مصر. أما النهايات الأخرى فتراوحت بين مؤامرات امتلأ بها التراث، فتآمرت على عقولنا ووقعنا فى فخاخ تأويلها، أو تبريرها؛ لنقف هكذا ( محلك سر ). لا حركة سوى سوى الدوران حول الذات، ولا فكرة جديدة تنال الاعتراف سوى الفكرة التى تنتمى إلى الماضى.
هذه رواية تشابكات مع التراث، ومع الواقع الحالى، ومع الذات، اتكأ فيها الكاتب على أقنعته الروائية، والرمزية؛ ليورط قارئها فى علاقة جدلية مستمرة مع ذاته وعالمه. كوابيسه وأمنياته. ماضيه وحاضره.