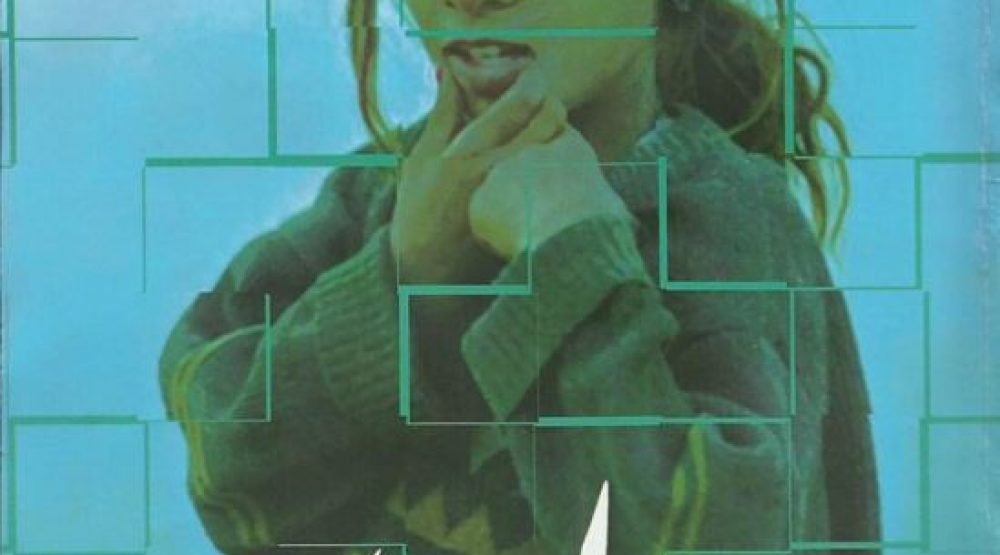التحليل السردي:
أقدم قصص المجموعة زمنيا في الكتابة: «عطيب البخت» والتي تعود في تاريخها إلى 1984م، كتبت بمرسى مطروح، ورغم أن المكانية كسمات حدودية لم تتجسد في هذه الأقصوصة الباكرة على النحو الذي سنشاهده في أقصوصات لاحقة، إلا أن عنصر الرمزية، وتوظيف الرمز في استكناه مشكلات ومعاناة الإنسان في الواقع واضح كسمة مميزة لكتابات ((حتيتة))، فالأقصوصة التي يصبح فيها «عطيب البخت» الذي هو اسم لكل انسان قد يقع في مثل هذه الظروف، مطالبا بأن يترك مكانه وأن يرحل منه، لكي تحل بدلا منه «بقرة»، فغرفة السحرة الأقدمين الملحقة بفيلا ((عبد الرحيم بك))، والتي عاش فيها «عطيب البخت»، ووالده من قبل، تصبح بعد رغبة ((البك)) في أن يأت «ببقرة» لكي تحلب اللبن الذي يحتاجه «كلب» البك، لكي يخرج من اكتئابه بناء على وصاية الأطباء، ولم يجد «البك» مكانا ليضع فيه «البقرة» سوى الغرفة التي يقطنها «عطيب البخت» ليصبح مصير اقامته في مهب الريح، كانت هذه المعادلات الموضوعية التي سنحللها معا، سبيلا لإقامة ادهاشا للقارئ حول قضايا ربما اختفت لفترة لدى الكثيرين من الكتاب الجدد.
تبدأ القصة على النحو التالي: «كان عطيب البخت يعلم أن ثمة أشياء تتمرد، وأن الصراع بينه وبين البقرة حتما سيؤدي إلى نهاية مفجعة، بيد أنه لم يكن يدري أن السحرة المختبئين منذ عشرات السنين في جدران غرفته، ويخاف عليهم من جور الأثرياء، يمكن أن يخرجوا ليقفوا ضده.» صـ99، بداية سلسة لأقصوصة مليئة بالصراع، لكن يبدو أن الكاتب واعي تماما بأن الكتابة الجديدة لا يمكن أن يكون محورها الصراع بين قوى الخير والشر فحسب، بين الثراء والفقر، صحيح هو يعلن انحيازه للفقراء والمهمشين في كتاباته، ويعلن عن مواجهته لأشياء كثيرة لا يرضى عنها، لكنه واعي تماما إلى ضرورة التجديد في الكتابة، ومن ثم مزج بين ثلاثة أشياء في هذه الأقصوصة، وهو الخط الذي سيستمر طوال المجموعة، سواء بزيادة أو نقصان بين بعض المكونات، هذا الخط يتكون من أولا: الرمزية، ثانيا: الانسان البسيط المهزوم في مواجهة واقعه – دون أن يقدم هذا الانسان في صورة بطل أو لا بطل – ثالثا: النهاية المفتوحة غير محددة المعالم.
لقد استخدم أيضا الوصف في عمل مقارنة بين حال «كلب البك» الذي عندما يمرض يجد الأطباء، ويجد الرعاية الكبيرة، والتي كانت وصاية الأطباء في النهاية احضار «بقرة» حلوب حتى يتمكن «الكلب» من شرب لبن طازج، لعل ذلك يساعد في انهاء اكتئابه، وبين «عطيب البخت» الذي تموت أمه، ويتزوج والده ثم يفر والده منه تاركا اياه بمفرده في هذه الغرفة التي تصبح كل شيء له، أما رمزية السحرة التي يتم تقديمها هنا، فيمكن أن تأول بألف معنى، يمكن أن تكون الشعارات القديمة التي يحملها كل انسان لكنه لا يعرف كيف يطبقها في الحياة، يمكن أن تكون المجتمع نفسه والمسئولين، والدولة والنظام وأي شيء من تلك الأشياء التي يمكن أن نخالها، بالإضافة إلى أنها أدت دورا كبيرا في منع رتابة القصة، وتحويل الأحداث التي لا تعدو كونها طرد انسان من حجرة إقامته التي كان يسكن فيها بملحق فيلا لدى أحد الأثرياء للشارع، نجحت في أن تبرز ذلك الحدث البسيط كحدث جلل يستحق أن تتوقف الدنيا والوعي والتلقي تجاهه لكي يبحث في هذا الشأن.
أولى المفارقات بدأت عندما جعل الكاتب الصراع بين بطل قصته، وبين «البقرة»، رغم أن حقيقة الصراع هي بين بطل القصة، و«البك» صاحب البقرة، حتى عندما اضطر «عطيب البخت» إلى مواجهة «البك»، فدار بينهم هذا الحوار الكاريكاتوري:
«وعادت الكلمات تتدفق من فم عطيب البخت رغما عنه:
– أيها السيد .. أرجو أن تتركني أتدبر أسباب المال، وأبحث عن حجرة أخرى .. لا بد أن أنقل كتبي وكتب الأقدمين حتى لا تحدث لعنة للفيلا.
قال عبد الرحيم بك مندهشا:
– أي لعنة .. هذه لعنة على رأسك يا عطيب البخت يا قليل الأدب. ماذا تقول بصوتك الغريب هذا؟ أم تراك جننت؟
ثم أشار صوب الجرو الذي كان يهز ذيله في حبور:
– و شوشو .. شوشو ماذا يفعل .. ألا تعلم أن الطبيب قال إن علاجه في الحليب، وحليب البقر على الأخص .. أتريد أن يموت شوشو .. يا لك من قاس بقلب خال من الرحمة …» صـ104
ووسط هذه الدهشة بين ضرورة أن يكون «عطيب البخت» مترفقا مترحما بـ«كلب البك» – ذلك الكلب الذي يهز ذيله مزهوا! بينما لا يكون «البك» نفسه مهتما لمصير الإنسان نفسه، ترتسم معالم الأقصوصة عبر نحت جانب من جوانب الأسطورة، إنها تغريبة جديدة لتناول مشكلات الحياة، بحيث تحقق إمتاعيه قراءة، كاسرة رتابة عرض الصراع الطبقي التقليدي، الصراع الذي تسرب من لسان «عطيب البخت» عندما قرر أن يعمل فذهب إلى فندق ما فلاحظ فخامة الثياب فقال: «إن الأثرياء عادوا للتكاثر رغم الثورة»صـ100 ، بل هذا الحوار نفسه لم يدر إلا بين خلد «عطيب البخت» ونفسه، وكأنه يخش أن يسمعه أحد.
لذا لم يكن من الغريب أن تكون مفارقة نهاية القصة، أن السحرة الذين كانوا يقطنون جدران الحجرة، والذين كانوا من المفترض أن يقفوا مع «عطيب البخت» في مواجهة هذ الجور و الطغيان، وهو الذي كان يخال نفسه يدافع عنهم ويحميهم، فجأة تحولوا هم أنفسهم لأداة من أدوات التنكيل به، فأخذوا يساعدون رجال «البك» في إلقاء الكتب وما تبقى من المتعلقات في الشارع، لينته المشهد بصورة «عطيب البخت» بين يدي رجال الأمن وهم يجذبونه وهو يتمرغ ويصيح إلى أن يتلاش الصوت.
سنحاول قدر الامكان تتبع الخط الزمني للقصص، لرصد ملامح التطور والتجديد بين هذه وتلك، يساعدنا على ذلك تدوين الكاتب على كل أقصوصة تاريخها ومكان كتابتها، وهو أمر يغفله الكثيرون من الكتاب خاصة في المجموعات القصصية، رغم أن هذا له دلالته التي تساعد الناقد كثيرا، الأقصوصة التالية هي اقصوصة «تل امحيمد»، وهي الثالثة في الترتيب، والثانية في التاريخ الزمني صعودا من 1984م إلى 1989م، أي بعد خمس سنوات من «عطيب البخت»، والفارق الجوهري بين هذه وتلك، أن «تل امحيمد» تعتمد على المكانية أكثر مما تعتمد على الرمزية، وأنها ترصد صراع الإنسان أيضا، لكنه صراع مع الطبيعة والحياة والمكان، أكثر منه صراع مع إنسان آخر، صحيح أنه يمكن للعقل أن يوجه لوما ما لمشكلة مواجهة نقص المياه في هذا المكان الذي كان يسكنه «امحيمد» فقد كان يمكن لقاطني المكان جميعا لو توحدوا مثلا أن يعملوا بئرا ما بمضخات أو بطريقة ما يستطيعون من خلالها مواجهة نقص المياه، بدلا من الحل والترحال، إلا أنه واضح أن الأقصوصة تتناول عالما آخر غير ما اعتدنا عليه، فالأقصوصة نفسها، كُتِبَت في «سيدي براني»، تلك المدينة الصغيرة التابعة لمحافظة مطروح ذات التضاريس الصعبة، والتي يعيش أهلها خبرة غريبة علينا نحن أهل المدن.
كيف يكون شعور الإنسان إذا ما ارتبط بمكان ما، بقسماته ومعالمه، ثم فجأة يجد نفسه مطالبا بتركه ومغادرته بحثا عن المياه؟ وأين تطور البشرية كله وعلمه من هذه الحياة القاسية، سنتوقف عند هذا الوصف لمحاولات ((امحيمد)) أن يجد أملا ما للبقاء في مكانه، يقول الراوي: «كرر إمحيميد المحاولة التي سبقه إليها أهل النجع قبل أن يقرروا الرحيل. ألقى الدلو في البئر. راوح الرَّشاء مجددا. الماء ثقيل بالديدان والتراب والأعواد الجافة. طيلة الصباح وحلقه جاف .. تحجر فيه اللعاب.»صـ20، سنلاحظ رشاقة اللغة في الوصف، ومحاولة ايصال مشاعر ((امحيمد)) دون الاستغراق في منولوج داخلي – على الغرار التقليدي لدى العديد من الكتاب – عبر أمرين، الأول تسمية القصة نفسها بتل «امحيمد» بما في ذلك من ايحاء للمتلقي بقيمة المكان لدى بطل القصة، والأمر الثاني: ترك الكثير من المشاهدات دون تعليق لكي يستبطن منها القارئ ما يشاء، فالنهاية مثلا، ودائما ما تكون نهايات المجموعة مفتوحة على أفق جديد من المجهول، وقد جاءت على النحو التالي: «في البكور مرت عربة إمحيمد محملة بخيمته وأطفاله وزوجته قاصدة الأفق .. ودَّع التل بعينيه، ثم أشاح: لا يريد رؤيته وهو لا يجلس فوقه! وبعد أن ابتعد لحق به سرب الطيور، إلى أن ذابوا جميعا في الحد الفاصل بين الأرض والسماء.»
لا نعرف إن كان ((امحيمد)) وأسرته سيجدون الماء في مكانهم الجديد، لا نعرف إن كانوا سيستقرون في مكان بعينه أو يقصدون مكانا بعينه، ولا نعرف هل وجهته هي نفسها التي توجه لها من يفترض أنهم جيرانه، أم وجهة مغايرة، كلها اسئلة مفتوحة يجيب عليها القارئ بنفسه، أو ينتبه لها القارئ بنفسه.
تقع أكثر قصص المجموعة في حقبة التسعينات، سبعة قصص من أصل أربعة عشر، منها قصتان في حقبة الثمانينيات، وخمس في مطلع القرن الحادي والعشرين، لذا سأتناول من حقبة التسعينات عملين، الأول هو «جبار القائد» والثانية «لوزة» التي استمدت المجموعة اسمها منها.
أما فيما يخص قصة «جبار القائد» فهي التي تتناول الصراع الليبي/ التشادي، الذي امتد من 1978م إلى 1987م، وهو الصراع الذي من المفترض أننا كمصريين لا علاقة لنا به، لكن الكاتب يتناول قيام بعض المصريين بالمشاركة في الجيش الليبي في مواجهة تشاد، خاصة مع توحد الفصائل التشادية في نهايات الصراع ضد الجيش الليبي، وهذه القصة هي أطول قصص المجموعة زمانا وسردا، وتبشر بميلاد قدرة على كتابة الرواية لعلها ستترجم في أعمال قادمة، وقد حاول الراوي فيها استكناه انسان مصري يجد نفسه بعدما أخفق في تحقيق أحلامه وارتباطه بمحبوبته، فسافر إلى ليبيا على أمل رؤية محبوبته التي تزوجت من قريب للقبيلة الممتدة قرابتها عبر حدود الدولتين – مصر وليبا – وعلى أمل تحقيق فائدة مادية ما، لكن كلا الأملين لم يتحقق منهما شيء، إلا أن بطل القصة وجد نفسه في أتون صراع لا ناقة له ولا جمل فيه، بين القوى الليبية والقوى التشادية، معزولا على جبهة ضاع منها تفوقها النيراني مع شراسة المواجهة التشادية، وبدلا من أن يهرب البطل يعود من جديد ليقنع قائده بالهرب. أما السرد نفسه فينطلق من بين واقع مأساوي لمجموعة من الجنسيات العربية المختلفة تعيش واقعا بائسا في ليبيا بحثا عن لقمة العيش.
أما الجديد في هذه القصة، قلة النواحي الرمزية فيها، لتتوارى خلف المنولوج الداخلي وتأويلات السارد نفسه، وظهور خط الحبيبة المختفية، تلك الحبيبة التي يبحث عنها البطل، لكنها فعليا خارج سياق السرد، وخارج سياق ما يتم تقديمه من أحداث، والسمة الثابتة دائما استكناه حال الانسان في مواقف وظروف صعبة لم تتناولها الكثير من الأعمال الأدبية السابقة.
أما قصة «لوزة»، والتي تستمد المجموعة عنوانها منها، فهي لوحة فنتازية من الوجع تجاه طفلة تقع في مكان نائي معزول تتحالف ضدها كل الظروف، بدءا من مكانها نفسه، مرورا بتخاذل السلطات تجاه تحقيق حياة كريمة لهذا المكان، مرورا بوالدها الجاهل، انتهاء بشكلها الذي يبدو كلوحة من القذارة والتشرد.
وطريقة عرض القصة بتقديم مجموعة من المعلومات شيئا فشيئا عن ((لوزة)) هو ما يحقق فيها امتاعيتها الجمالية، رغم ما فيها من جرح لوعي القارئ، فالطفلة التي ينفر منها العديد من المشاهدين لها، مصابة بالتهاب وصديد في أذنها، ورغم تعاطف المدرس معها، واستخراجه لها جواب يُمكِّنُها من العلاج على نفقة الدولة – على ما يبدو، ويعطيه لها، لكي تذهب لوالدها بالمظروف، ويبدو أن الوالد كان يتوقع أن المظروف به أموال، وعندما لم يجد فيه سوى ورقة يرميها في مهب الريح، دون أن يدرك وعيه أن هذه الورقة تحمل بين طياتها شفاء أبنته، ورغم المقارنة التي عقدها الراوي بين الصبي ((فضل)) جارها، والذي تظهر عليه علامات الثراء، و((لوزة)) القابعة تحت خط الفقر، لتنته القصة بالنهاية التالية:
«عند السور الذي هدمت أطرافه السيول الموسمية كان مفترق الطرق .. مشى فضل ناحية بيتهم المشيد بالأعمدة الخرسانية، وتوقفت لوزة مطلقة من تحت رمشيها السوداوين نظرة ناحية خيام نجعهم البعيدة .. وضعت كيس كتبها على الأرض .. جلست جواره مرتكنة بظهرها للحائط .. فكت منديلها .. نظفت أذنيها من الصديد .. حدقت في الفضاء الرحب أمامها .. ثم غرزت رأسها بين ركبتيها .. طوقتهما بذراعيها وعصرت نفسها بقوة .. كانت الشمس تنير ما حولها .. بينما الجبال الملفوفة عند الأفق في ضباب أبدي ..» صـ 1993.
ومع الضباب الأبدي، تنته القصة من جديد تاركة للقارئ أن يحدد في ذهنه ومع نفسه النهاية التي يتخيلها لمصير «لوزة».
في مجموعة القصص التي تنتمي للعقد الأول من الألفية الثالثة، سيعلو خط الأسطورة، ورغبة ادهاش القارئ بالتلاعب بين مخاطبة الوعي واللاوعي، مع التأكيد على خط البحث خلف معاناة الإنسان كإنسان، مع رغبة تقديم ذلك من خلال شكل جديد في الكتابة، من خلال محاولات تجديد في الشكل والطرح.
خير مثال على ذلك «قصة سالم»، والتي تظهر فيها لفتة فارقة بصعود رغبة الملمح الأسطوري، عبر ما يردده الراوي عن سماع لحن من ناي حزين، يقال أن صديق سالم يعزفه له، بعد أن تم القاء كلا من ((سالم)) وصديقه ((عثمان)) في البئر، وسينسج الراوي أسطورة حول ما إذا كانا على قيد الحياة أم فارقاها، خاصة مع سماع اصوات الناي، لكن في خضم ذلك سيتناول قضايا التهريب، وقضايا حلم الثراء، وتعارض طموحات الشباب مع واقعهم البائس، ويرز الراوي على الساحة العمدة، عم بطل الرواية، والذي يظهر أن ولاءه للنظام، ومنصبه أكبر من اهتمامه بابن اخيه، وأنه في ظل حفاظه على منصبه كعمدة للمكان، لا يكترث بحماية أيا من أقاربه.
لا شك أنه طوال المدى الزمني المديد لكتابة الأقصوصات تظهر رغبة ملحة في التجريب الكتابي، وفي تقديم الرؤية عبر شكل جديد، ومنظور جديد، وقد حددت الخطوط العريضة لهذا الملمح عبر المزج بين الرمزية، والإنسان في مواجهة واقعه، والنهاية المفتوحة، لكن هناك محاولات تجريبية لم اتواصل معها، ولم استطع فهمها على النحو الذي يمكنني من القول بأن الكاتب قد أبدع فيها، مثال ذلك «غني سكت»، ومن بين سطورها: «ارتعشت عصا اختلجت أذن كلب تنفست نعجة اجترت هدأت دفأت استكانت اهتزت أذن كلب تلفتت حدقة عين ظلام تلبس برد ليل همد طل خطت قدم راع غني طاف غنى ثم سكت.» صـ17، هذا التوالي لهذه الألفاظ الذي يشبه التداعي النفسي الحر، كرسم لوحة من كلمات تتداعي من خصوصية مكان وحياة ما، لكن رغم هذا لا اجد فيها ما يحث القارئ على القراءة واكمال عناصر التشويق، وقد تكرر هذا الأمر مع «عودة»، ومنها المثال التالي: «باب انفتح .. خطت عتبة الباب قدم قرحت .. قدم ارتعشت ومدت وجها كشف فأصابع صديد عظم ولحما منها اهترأ وصدأ انتظار تشقق .. عبقت رائحة غياب .. إذ سلم هز ظلها ضوء باب تأرجح .. ريح تحركت .. شوق امتد فصمت احتضن صمتا . ذراعان، فانحسر الردنان، فيوم لهف .. فنادى وما نادى، ثم نادى..» صـ 89 لم اتواصل مع هذه المحاولة من التجريب.
إذن نحن أمام كاتب عرف مكونات سرده، وحدد رؤيته وعناصر رسالته، لكنه عبر مخاض زمني طويل من الثمانينيات إلى أوائل الألفية الثالثة وهو يمارس التجريب، لكنه نجح لا شك في ايجاد طريقة مخاطبة للقارئ، تنقل لوعيه الكثير من المسكوت عنه، والكثير من القضايا الانسانية التي انصرف عنها الكثيرون، فضلا عن إثارة قضايا أخرى بعيدة عن مركزية الثقافة العربية، لكونها تقع في أماكن حدودية وهامشية، وفي خضم هذا لم يعتمد على قوة الفكرة ونبلها، وإنما مارس أقصى درجات المحاولة وعنت الذات من أجل تقديم تجديد وتجريب جديد يصل لمراده، وهناك رغبة ملحة للمكانية، وللوصف واستكناه شعور الانسان تجاه ذلك، وبدايات تجريب قصصي اعتقد أن ثماره ستظهر بمزيد من التجريب والطرح مع الكتابات القادمة.
[1]– عبد الستار حتيتة: لوزة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2013م