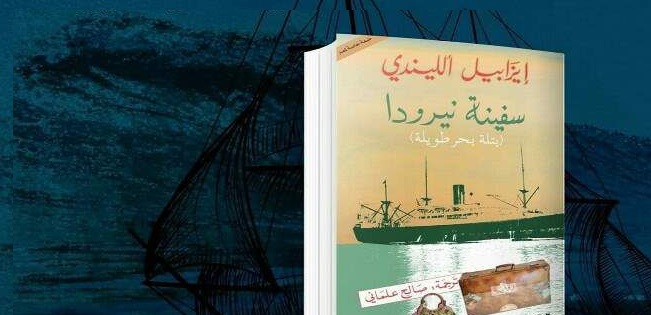هل هذه رواية تاريخية؟ يعود السؤال، من ناحية يمكن القول إنها لكذلك، مادامت تلتزم بالأحداث والوقائع المؤكدة قدر استطاعتها، وتحاول ألّا تخرج عن الروايات الرسمية والمتعارف عليها، أو “التاريخ”، إلّا في حدود التخييل واللعب الفني الحر، لكنها مع ذلك ليست مثل أغلب الروايات التي يمكن أن نطلق عليها هذا الاسم، أي ليست درساً تعليمياً في تاريخ هذه الحقبة أو تلك المدينة، كما أنها لا تستغرق كثيراً في الوصف والشرح والتحليل والتفسير الذي قد يقابلنا في أغلب هذا النوع من الروايات، بل تكتفي بإشارات مقتضبة في الهوامش، أقرب إلى قناديل صغيرة لإنارة طريق القارئ، لا تكاد تأخذه بعيداً عن متابعة رحلة حورس الفيومي إلى مركز النور، الاسكندرية، التي تضطهده وتحتقره ويسخر منه أهلها من اللحظة الأولى لدخوله إليها بحماره وهيئته ولكنته، وحتى خروجه منها مطروداً بلا أملاك ورجوعه إلى نجعه ليعرف أن أمه غرقت وأخته ماتت، ولولا إيمانه بالدين الجديد لما استطاع أن يتحمّل هذا كله.
اسكندرية هذه الرواية شيءٌ آخر غير الاسكندرية الكوزموبوليتانية التي قد نراها محتفى بها وبغرابتها ومتاهات شوارعها وتشعب علاقاتها الإنسانية، سواءً عند لورنس داريل في رباعيته، أو في قصائد كفافيس التي أعلنت عشقاً ممتزجاً بالكراهية لهذه المدينة السحرية. كما أنها أيضاً ليست مدينة إدوار الخرّاط التي رغم حسيتها وأرضيتها تكاد تحلّق في السموات العلى كأيقونة فريدة تستوعب الإنسانية بجماعها في داخلها، ولا هي اسكندرية إبراهيم عبد المجيد الخاصة بالعمّال الغلابة والممرضات الجميلات والسكة الحديد، في لحظات فارقة من التغيّر الاجتماعي. إنها اسكندرية عُمر حاذق، اسكندرية الحكم الروماني الغاشم، والسخرية من الفقراء والفلاحين المصريين والغلابة، اسكندرية لعلّها لا تختلف كثيراً عن اسكندرية اليوم، حيث الناس إمّا متغرّبين لا يجمعهم شيء بتراثهم أو مجرد فلاحين سذج وموضع سخرية، والكل يرزح تحت حكم امبراطورية خارجية هائلة مثل الاخبطوط ولها ملامسها المحلية التي تصل إلى كل فجٍ عميق. إنها اسكندرية القسوة والاضطهاد والإبعاد والسجن والتعذيب، اسكندرية لا تقبل الاختلاف أو الآخر أو التعددية، شيءٌ لا علاقة تربطه تقريباً باسكندرية يوسف شاهين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين.
هذا الفلّاح الساذج المغترب في الاسكندرية هو نفسه الرسّام العذب الرقيق الذي أبدع بورتريهات الفيوم الشهيرة والبديعة، وهذه هنا ليست معلومة تاريخية بقدر ما هي اللفتة الخيالية التي اشتغلها حاذق في لعبته الروائية، وقد استطاع في ظني أن يستنطق تلك الوجوه الخالدة التي تبدو وكأنها رُسمتْ أمس فقط، ونظرات عيونها الواسعة المتساءلة أو الأسيانة، والتي تطل علينا من وراء السنوات والحقب والأماكن، لتطرح سؤال الإنسان ذاته، سؤال المصير والمعنى والخلود والحرية. تتبّع عمر حاذق رحلة هذا الرسّام وتطوّر وعيه برهافة وسلاسة، من اعتقاده في الديانة المصرية القديمة، وتعصبه لآلهتها المتعددة، إلى إيمانه بالمسيحية، ملمحاً ببساطة ودون جعجة مدرسية إلى الأواصر والصلات العميقة والعضوية التي تربط التراثين والعقيدتين، فكأن حورس الشاب لم يكن عليه أن يقطع مسافة شاسعة من الدين القديم إلى الجديد، بل إن هي إلّا خطوة واحدة في الاتجاه نفسه. يقول بطلنا الشاب حورس: “كنتُ أحلم بالحياة الأبدية والنجاة من المحاكمة أمام إله العالم السفلي أوزوريس الذي قام من موته كما قام يسوع، لذا حفظتُ المحرمات التي سأقسم صادقاً أمام الإله أوزوريس، أنني لم أفعل منها شيئاً، لأنها المحرمات ذاتها التي نتعاهد عند المناولة ألّا نقربها. هكذا أصحبتْ المعاني الجميلة أكثر ألواناً.” وهكذا أيضاً أصبح لرسم الوجوه لدى حورس الشاب معنى أكثر عمقاً وروحية من مجرد كسب قوت يومه أو بلوغ المجد والشهرة في فنّه، بل يصير المغزى الديني لفنه خيرٌ وأبقى.
رغم الخلفية الشعرية، بل “الخليلية”، لعمر حاذق، فقد أتت روايته الأولى تكاد تكون نقية من مشكلات اللغة الشعرية، سهلة الزخارف ومعقدة الصور وغريبة المفردات، فعرف كيف ينسج مشاهده معتمداً في الأساس على لغة الصورة والمشهد والانتقالات السلسة والملعوبة بذكاء بين كل فقرة وأخرى، دون أن يفوته توشية سرده بصورٍ شعرية صغيرة وحادة مالَ غالباً إلى أن ينهي بها فقرات سرده. ولولا شغفه بالأشعار المصرية القديمة التي رصّع بها الرواية دون ضرورة كبيرة في ظني لما أعاق أي شيء تدفق سرده السيّال والهيّن، ولولا كذلك السرعة والتلهف في الصفحات الأخيرة من روايته لانتظم إيقاعها كوحدة سردية متماسكة. كل هذا لا ينفي أننا أمام تغريدة سردية صغيرة، تغرّد للحق والحب والجمال، بلغة بسيطة ونقية، ومشهدية تنصت للطبيعة المصرية، سواءً طبيعة الأرض في مظاهرها الساطعة أو الطبيعة الإنسانية الطيبة والمعقدة والغنية لإنسان هذه الأرض.
حاول عُمر، وهو الشاعر في الأساس، أن يتفادى قدر استطاعته أي صراع جمالي ما بين فنان الكلمة وفنان الصورة، واستطاع أن يجعل بطله الرسّام يستلهم الشعر المصري القديم أولاً ثم النصوص المسيحية الدينية ثانياً، ولو أني أرى أن صانع الصورة يشعر بدرجةٍ من التفوق الفني والجمالي على خالق الكلمة، بما أن عمله يخاطب العين دون حاجة لترجمة عند اختلاف اللغة. ثم نأتي إلى النهاية الحزينة عند الحكم على رسّامنا بالموت غرقاً كخارج عن الديانة الوثنية للامبراطورية الرومانية، وفرحة بطلنا بهذا المصير، واستقباله له برحابة صدر وفرح صوفي، وكأنه لم يعد على هذه الأرض (أو في هذه المدينة التي هي العالم كله الآن) ما يستحق التشبث به والبكاء عليه، وكأن الحياة الأخرى، باختلاف الأديان، هي الأمل الوحيد والرجاء الأخير في حياة تظلها الحرية والكرامة والعدالة.
عمر حاذق مبدع هذه الرواية الصغيرة الجميلة قُبض عليه مؤخراً في إحدى المظاهرات الخاصة بذكرى خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، وحُكم عليه بثلاث سنوات سجناً، ثُم فصل من عمله في مكتبة الاسكندرية رغم أنه لم يرتكب أية جريمة تخل بالشرف، بل لم يرتكب جرماً من الأصل، ويحق لنا أن نسأل – كما تساءل هو في روايته عن فقراء بلاده: متى يخرج عمر حاذق إلى النهار؟ ليس ذلك النهار الغيبي الغريب، بل نهار هذا العالم، وهذه المدينة، التي لا تمنحنا الفرصة لنحبها كما يجدر بعشاق مخلصين للفن والجمال والحياة.